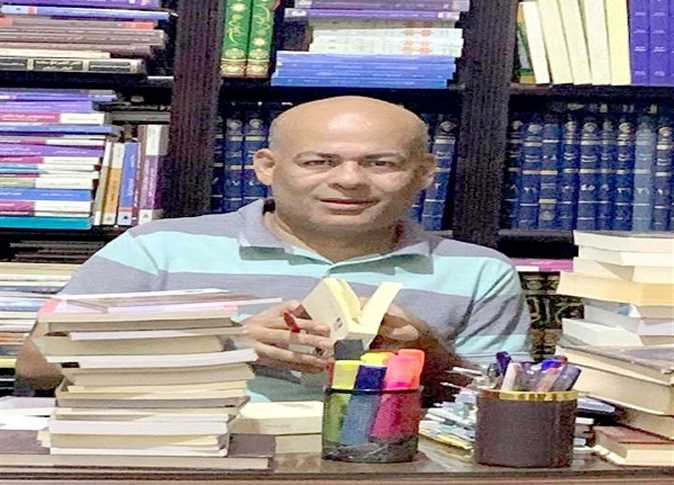محمد فيض خالد
بطعم الغربة
اتفقنا سويا على تأجيِل موعد الزفاف لخمس أشهر، طلبت مهلة، تنقصنا بعض الكماليات، ومن الأليق تجهيزها، وافقت على مَضضٍ، جاء حديثها الأخير على استحياء، لكنه حياء بنات الريف المستحب، في حديثها القصير اشعر وكأنني نُقلِت فجأة للفردوس، خمس دقائق كافية للسلام، وسماع صوتها الذي يشبه وشوشة الأمل، تمت خطبتنا بعد عام ٍونصف من سفري، أتذكر حديثنا الأول، على الرغم من قرابتنا لكني اشعر بالحَرجِ، فمحادثة الإناث عقدة تلازم الريفي، يعتبرها العوام انفلات لا يقبله العرف الصارم، لحظتها لم يخرج صوتي، قاومت لثوانٍ ريقي المُتحِّجر، جففت بلل يدي أكثر من مرة، اشعر بأنفاس الانتظار، بدت على الطرف الآخر تعاني ما اعانيه، لم يتحول حديثنا للتسلية، بل هو الشغف؛ الذي وجدت فيه الأمل، وملجأ لأوجاعي.
بمرور الأيام توثَّقت الرابطة؛ ينشرح صدري كلمَّا أوغلنا، بدأت اشعر بأحاسيسٍ جميلة تتمدَّد فيَّ، وكأنَّ هذه العواطف تحتل قلبي وتسلبه إراداته، إنَّها أعراض الحب في أرقى معانيها، لم يمض الأجل المُتَّفق عليه، وجدتني وقد اضطرب كلَّ شيٍء وتراقص أُنسا من حولي، إنه خيط الأمل الوحيد الذي يصلنا بالحياة، فجأة قررَّت السفر، تساءلت وأنا أتناول التذكرة من موظفِ السفريات في تَوجسٍ:” هل تغيَّرت الدنيا كما يقول الناس، فالغياب خراب دائم في القلوب، لا يهمني ما دامت هي معي”، دون مقدمات انفجرَ بوجداني انفعالٌ صاخب، اشعر بثقلِ الأيام، تمر الدقائق كدهر، يظهر الأفق يترنح ثملا تحت ضوء النهار الوليد المنبعث في فتوة، نهار شتوي شديد البرودة، أيام قلائل تفصلنا عن نهاية العام، لم احفل بشيء من حولي، اعددت حقيبتي، تأكدت من وزنها، مررّت يدي في ابتهاجٍ فوقَ بدلة العُرس، داخلتني نشوة لذيذة، انقلب قلبي أمام ريح رخية، تحمل عبقا شهيا لم أحسه من قبل، في العمل انهيت إجراءات الإجازة، وقَّع المدير في ترَددٍ، طَالبني في صَرامةٍ بضرورةِ التَّواصل، فقد يحتاجني لبعض المهام، دفع لي الورقة وقد ارتسمت ابتسامة شاحبة فوق وجهه الأسمر، قائلا في تثَاقلٍ:” بالرفاه والبنين “، انفتحت بداخلي مجاري السعادة، حين احاطني الزملاء، تهتف حناجرهم بالتهنئة، برز صديقي ” كمال”، تتعلق ابتسامة حلوة على شفتيِه:” على موعدنا، قبل الحادية ننطلق للمطار”، في انتظار اقلاع الطائرة اشتبكت في رأسي الخيالات، أحاول الضغط على أعصابي حتى تهدأ، من حولي امتلأت المقاعد بالمغادرين، فَاضَ المكان بأحاديثهم السَّاذجة، لحظتها استعجلت الإقلاع، امضيت ما تَبقَّى من الدقائقِ عصبي الخواطر، شاغبت في رأسي أسئلة كثيرة، عن أولِ كلمٍة انطقها في حضرتها، جعلت اتخيَّر أنسب العبارات، أخرجت صورتها، طاَلعتني تبتسم في عَفويٍة، تحركت شفتاي في صمت بعبارات الاشتياق، في الطائرة أسندت رأسي في غفوة، انتبهت على صوت المضيفة؛ تطالبني بإحكامِ رَبط حزام الأمان؛ لقد وصلنا، خارج الطائرة، لفحتني برودة الفجر القارس، تَلاحقَ الركاب في سباقٍ مزعج داخل صالة الوصول، نشطت يد موظف الجوازات لختم الوثائق، عند البوابة الخارجية قفزت دمعة ساخنة من عيني لم أجد لها تفسير، في همٍة دفعت العربة أمامي، عن بُعٍد صَدحت الحناجر بنشيدٍ مُوحَّد، تُرحِّب بالقادمين، جَمعٌ هائل من المستقبلين شِيبا وشُبابنا، من خلف حاجزٍ حديدي متهالك أشرف عليه رجل عظيم الهيكل، دقيقة والتحمت الأيدي مسلمة، تشابكت العيون في اشتياق، لأول مرة اشعر بقسوة الغياب وسطوة الغربة، طالعت الوجوه من حولي التي رسمت الأيام عليها بوحشية حفرها الغائرة، أخاديد من الأسى، نعم أعرف الجميع، حاولت ابتلاع المفاجأة، انخرطت في عناقٍ حَار، ارتجَّ لساني، اكتفيت بابتسامةٍ لطيفة أرد بها السلام، بالسيارة تبارى القوم في حديثٍ متشعب، الزراعة، الغلاء، الطرق الجديد، أحاديث فكهة، انجذبت نحوها في تَسليةٍ، اطوف في خيالٍ مرح، انتزع نفسي من غربتي انتزاعا، بدأت بالسؤال عن أحوالِ الأهل، فلان وعلان، وعلى فَتراتٍ اتحسَّس في وهٍن أثر المعاول الممتدة، ارمم الثقوب التي احدثتها بجدارِ العمر، أيامي التي تهدمت، سنواتي التي تحولت لركام، نجحت في أن اتخفَّف من مذاق العذاب، اصطدمت عيني بالحقولِ الممتدة بلا نهاية بالخضار، على الُبعد، بدت قريتنا نائمة في وهنٍ، تتأرجّح أشباح البيوت في استسلامٍ تحت خيوط الضَّبابِ العنيد، على رأسِ الدَّرب، استقبلني الوالد، وقد انهملت عيناه بدمع ضاحك، طوقَّني بذراعيهِ، استسلمت لهما في حنوٍ، جعلَ يشمني كرضيعٍ صغير، احتضنتني أمي في عناقٍ طويل، انهالت على خدي بسيل من قبلاتها، ومن بعدها اجتمع الجيران في تهَللٍ، زحفت بداخلي مشاعر حلوة، قفز قلبي على إثرها كعصفور، ساعات قضيتها في رِحابِ الأهل قبل أن اقصد بيتها في تَشوقٍ، ما إن رأتني أمامها حتى بَرقَ وجهها، طافت ابتسامة حلوة تسبح فوق شفتيها، تَمسَّكت في استماتٍة بما تَبقّى من وقاري، أقاوم صرخة تكاد تنفلت مني ، نظرت على استحياء وهي تشد عينيها بعيدا عني، قائلة:” حمد الله عسلامة “، شعرت وكأنَّها تضمني بعينين مرحتين، ألقيت إليها بنظرة حنان، كرشوةٍ أرشوها بها، بعد يومين بالتمام اجتمعَ الشمل، أخيرا ضمدت جراحي الغائرة، هدأت نفسي واطمأنت خواطري، استسلمت لهذه السعادة لأتناسى مذاق الفراق المر، اشعر وكأنما أخذت جرعة جديدة من الحياة، سكنت سحابة الحيرة، مرت الإجازة سريعا، وهكذا الأوقات الحلوة، اقترب موعد الرحيل، في إحدى الأماسي، قلت لها بابتسامةٍ مُجهدة، انفث كلماتي في ضيق:” السفر بعد أسبوع “، بحلقت فيَّ بوجٍه مَصعوق، أحاطت بها الدهشة، لتقول وعي تشهق في ضجر:” كتب الله لك السلامة “، ثم اغرورقت عيناها بالدموع، على الفور قفزت دمعة من عيني، جعلت أقاوم مرارة في صدري، وفي كل يوم يشتد بي الفزع، يحيطني طوفان جارف لا يتوقف، بدت نظراتها متوسلة، وكأنَها في مأتمٍ جاءت ساعة الوداع، شعرت وأنا أخرج من البيت بروحي تنسل من بين جنبيَّ، ارتعشت عينا أمي أمام عيني، وهي تَدَّعي الهدوء، قالت في غمٍّ:” صحبتك السلامة “، اشتعلت النار في رأسي من جديد، سقطت دمعتان صامتتان من جفني، وفي الطريق للمطار زَحفَ الضيق لصدري كثعباٍن مُخيف ، طريق غير منته آخره آلام لا تنتهي، تلفه الزوابع، اشعر باختناق، اشد أنفاسي من جُبٍّ عميق، تتصاعد أبخرة الغيظ أمامي، لا شيء يملأ الفراغ الممدد كجثة، حاولت أكثر من مرة الوقوف في وجه العاصفة، لكني هزمت، فالحياة وظروفها القاسية لا يرحمان.
وصلت أخيرا، ألقيت بنفسي عن عَمدٍ في أحضان العمل، كآلةٍ لا تحس، تجاهلت عذاباتي، المرار المنسكب في حَلقي، وضعت كلَّ شيٍء في دولاب الذكريات، حتى يأذن الله.
**
خطوة فوق البساط المخملي
هذا يومي الأول، حضرت مبكرا، وتلك عادة أصيلة لا يأتها غير أبناء الريف، فتكشف جغرافية المكان ما يشغلني مع البدايات، بدت المكاتب مقفرة، شاخصة كأشباح نائمة في ضوء خافت، هدوء تام يلف المكان غير حثيث قادم من فتحات التكييف، أزيز لطيف يضخ برودة تلسع جلدي، دقائق وتوافد عمال النظافة في زيهم البرتقالي المميز، وجوه أسيوية حفر السهر والكد فيها أخاديد مخيفة، عيونهم المحمرة، تتناثر في فوضى روائح التوابل الحريفة، مشتبكة بعرقهم الفج، ذلك الخليط المنفر آخذ بأنفاسي ما اشعرني بالاختناق، عمت الفوضى الوسط، اغرقت الأرض بسوائل التنظيف، تناوب العمال جلي البلاط في همة ونشاط، بقسوة طغت روائح الكلور والفينيك، جعلت اقطع الممر ذهابا وإيابا في خطوات متئدة هربا منها، وقد دخلت نفسي ثانية عالم الوحشة، لا أفهم رطانة هؤلاء، استقرت جلستي في ركن بعيد، امتدت يدي نحو صحيفة قديمة، تشاغلت بمطالعتها علي اتخلص من هذا الهاجس، أثر الهواء البارد الممتلئ بالخمول في جسدي، بقيت على صمتي الأول، لم ينقذني منه غير حضور الفراش، ألقى التحية في تودد بوجه باسم، في الخارج كانت الشمس قد طرحت شباك ضوئها على بساط الأرض لفت فيه البشر والحجر، حام الرجل من حولي، لكنه آثر في الأخير اختصار المسافة، هز رأسه الأشيب، قائلا في حماس:” تشري شي؟”، بعث سؤاله في قلبي يقينا، أحسست بالراحة تسري بين جوانحي، فأنا الآن لا اشعر بالغربة، اقترب باشَّا واضعا كوب الشاي أمامي، آنست لحديثه المقتضب، اسمه ” محمد جاسم ” بنغالي، قدم البلاد منذ عشرين عاما، من راتبه الضئيل، يعول أمه العجوز، وأسرة مكونة من زوجة وخمسة أبناء، جميعا سلكوا طريقا للتعليم، يحلم باليوم الذي يستقر فيه يهنأ بداره التي بناها، ومزرعته، إلى الآن يشعر بالغربة، حتى بين جدران داره الذي التهم سنوات عمره، وافترس صحته، أبعده عن قريته وأنساه رفاق العمر، الذين تآكلوا بمرور الأيام، تندت عيناه بغلالة شفافة من الدمع، عاجلها بمندله ثم مضى، يتعزى الرجل بتلك الذكريات عزاء من قلت حيلته، يرضى منها بالقليل حتى لا تذهب نفسه حسرات، بدون إنذار أضيئت الأنوار، اختفى عمال النظافة، لم يمض طويلا حتى دبت الحركة في المكاتب، تمشت الضوضاء في الممرات، تقاطر الموظفون، تسبقهم ضحكاتهم المجلجلة، نقاش محتدم في الرياضة وهمومها، موجات متصلة لأزيز آلات التصوير، نقر أصابع منتظم فوق لوحات مفاتيح الحواسب، من الوهلة الأولى تطالعك لوحة مصرية رسمت بحرفية.
يتحرك في الممر أربعيني محتقن الوجه، ارتسمت عليه سيما الجد، يتنقل بخطوات متزنة، تلعب شفتاه من غير كلام، يجر بقدميه نعلا ثقيلا، تعود أن يستفتح يومه بالوضوء، طقسا صباحيا تعوده و لزمة من لزمات المكان، اقبل السكرتير من بعيد، تقدم محييا في أدب، عاجلني محتفيا:” نفطر اليوم سويا”، اقتحم قلبي تيار الطمأنينة، لم افكر طويلا، بدأت اقضم السندوتش، جاء الفراش بكوب الشاي الساخن، هو الوحيد القادر على تبديد برودة الأجواء، ثوان قليلة، وعم الإدارة الهرج، مبكرا اعلن الحضور عن أنفسهم؛ بتلاوات قرآنية ذات نغم أخاذ، صرخت بها أجهزة الحاسب، تطالعك مسوح الملائكة في كل حجرة، تغلبك رائحة المعطر الفواح، تتصاعد في عنفوان أبخرة الحلبة والأعشاب المغلية، جلابيب بيض محشوة بأجساد رجراجة، وجوه محمرة تطفح بالصحة، محاطة باللحى المشذبة، تمشت السعادة في صدري، وشوش الأمل في أذني، اشعر وكأنني نقلت فجأة إلى الفردوس.
رأيته لأول مرة، يختلس نظرات حذرة، كان في منتصف عقده الخامس، بدى أمامي كصنم، بوجهه الأسمر، ممتلئ الجسم، لا عيب فيه سوى مؤخرته التي امتلأت ازيد من اللازم، للحقيقة فالرجل أنيق لدرجة ملفتة، تعجبني كثيرا تركيبة الألوان الهادئة التي يعتمدها، رابطة عنقه المرزكشة، الدبوس اللامع الذي يتوسطها، حذائه الأحمر اللميع، يده المزينة بساعة من ماركة معتبرة، لا اعرف من يكون، لكن هيئته تكشف عن شخص مهم، مكتبه العتيق، الخزانة الخشبية المحشوة بالملفات من كل صنف، التعليمات التي يسديها لمن حوله في عنجهية غير مفهومة، بمحاذاته كانت جلستي فوق مكتب متواضع، سريعا أخرجت نفسي من بؤرة اهتمامه غير المبرر، تقتحمني عينه في مطاردة لا تنتهي، حركة كرسيه السريعة من تحت جسده الثقيل، ساقه المهتزة في انفعال، نقره المتواصل فوق المكتب، انهمكت مجبرا في مطالعة عبثية، وقشعريرة مؤلمة تتمشى في جسدي، حمدت الله أخيرا، لقد غاب عني في مكالمة طارئة، لكني لم أغب عن ناظريه، طرقت أذني رطانته العجيبة، حديثه الهجين المطعم بكلمة عربية وأخرى لجنس كلام لا افهمه، في هستيريا يطلق ضحكته المصهللة، متبوعة بلزمة لا يتعداها:” يا راجل.. يخرب شيطانك…قوووول غير كد””، بعد قليل تشاغلت عنه تماما.
اقنعت نفسي بالمبررات التي تعينني على التكيف على مضض مع الواقع الجديد، لم يكن الخضوع المذل، بل مجاراة؛ كقشة تتحرك فوق وجه الماء، ينقلها التيار من مكان لآخر، ظروف الحياة القاسية التي تدفع بك صيدا سهلا، لهذه النفوس المتهيجة للافتراس.
**
صحتك بالدنيا
بعد وصولي في إجازتي السنوية بثلاثة أيام، وأنا اشعر بآلام حادة في المعدة لا تبَرحني، لهيب متواصل يحرق أحشائي، بصفة مزمنة يباغتني، تهيج الأمعاء، وينتفخ البطن، ويثقل جانبيَّ، عكَّرت انتكاستي صَفو من حولي، انتاب الزوجة القلق، ألحَّت في استماتٍة أكثر من مرةٍ، بنبرةٍ متوترة:” لابُّد وأن تعرض نفسك على الطبيب، حالتك مقلقة”، أقول مُتهربا، حتى لا ازيك من ارتباكها والأبناء:” قريبا نذهب سويا، لا تقلقي، اشعر بتحسن الحمد لله”، لم تختف نظرة القلق والانزعاج، تبوح عيناها الحائرتان بما يسكن صدرها من توجس وخوف، خاصة مع نوبات القيء المتكررة.
في صبيحةِ اليوم التالي، ارتدت ثيابها في عجلٍ، وقفت أمامي بصوت يهدر بالضب، قالت:” لقد حجزت موعدا، طبيب الباطنة متواجد تمام الواحدة لنتحرك الآن “، في العيادة شعرت لأولِ وهلةٍ بأوجاعي، تفجَّرت الألم في بطني المتُخم بالعلة، تناثر المرضى فوق المقاعد في وجوم مميت، أنات الصغار الذين افترشوا الأرض ، تبوح عيونهم الذابلة بالتعب والمرض، أصوات القيء تتأتى من دورة المياه، أكياس الأدوية المثقلة بالوصفات، الأشعة والتحاليل، حديث هامس ، ودعاء متقطع يخرج من فمِ عجوزٍ مُجهد يتمنى الشفاء لكل مريض، وضع الطبيب يده الباردة فوق بطني المنتفخ، انكب عليه يفحصه في حرص زائد، اغرقه بمادة لزجة، مرَّر ذراع جهاز الأشعة، حركه حركات دائرية مرارا، قبل أن يقطب وجهه، ليتساءل في هدوء:” منذ متى وأنت تُعاني هذا الألم؟”، وقبل أن اجيبه، هزَّ رأسه متخففا من ارتباكه:” مبدئيا هناك حصاة بالمرارة، لا تنشغل بها، عليك القيام بإجراء تحليل عاجل لتشخيص الحالة بدقة “، ندَّت من زوجتي همسة مكتومة، لعله قرار أملاه اليأس وختمت عليه الحيرة، اقتحمني صوتها كنغمةٍ عذبة، وهي تُعدِّل ملابسي في حنو ، حاولت دون فائدة إخفاء بوادر حزنها بابتسامٍة مُتكلفة، “بعد ثلاث ساعات تستلم النتيجة ” كان رد فني التحاليل، عندها ابتسمت مجهدا، ابتسام فيما يشبه الطمأنينة، قلت في سري:” لا بأس”، بعد ثلاث ساعات امسك الطبيب نتيجة التحاليل، قلَّبها بين يديه، ردَّد بنبرةٍ مأساوية:” ميكروب حلزوني، جرثومة المعدة، حمى التيفود”، انشق قلبي تحت وطأة المفاجأة، قالت الزوجة مترفقة:” هل يمكننا التَّغلب على هذه العراض، فإجازته قصيرة؟ “، علت شفتيه ابتسامة ملتوية، أجاب بسرعٍة:” لا تترك جسدك فريسة سهلة لوجبات المطاعم، قطعة الجبن ورغيف اضمن لك، زوجتي تحرص على نظافة الأكل لدرجة الهوس، وو”، لم يكمل كلامه، بعد أن رميته بنظرةٍ صدَّته عن الاسترسال في الحديث، فَرغَ أخيرا من كتابةِ وصفته، امتلأت الورقة بالدواء، قبل الأكل وبعده، غامت نظرته خلف غشاوة رقيقة، أكمل في حدة:” بعد أسبوعين موعدنا، مع السلامة “، هزيلا خرجت من بابِ العيادة، ضحكت هازئا بصوت غير مسموع، نظرت إليَّ الزوجة برفق، ثم ابتسمت ابتسامة أذابها القلق، لتقول:” بعد العلاج تستقر حالتك إن شاء الله “، امسكت بذراعي وكأننَّي طفل صغير، تخشى عليه أمه السقوط، في الخارج كانت سماء الخريف الرمادية واضحة تٌخبر عن نفسها، تفرَّقت سحب بيضاء نقشت صفحة الفضاء، تلاعبت رياح ناعمة بكناسة الشارع، على إثرها سرت في جسدي قشعريرة مؤرقة، مرَّ أسبوعان، قال الطبيب وشعور بالنجاة يعمر وجهه النحيف:” الحالة مستقرة، لكن نصيحتي لك، لا تقرب الدهون، أكثر من الفاكهة والخضراوات، تجنب الأكل ليلا “، أنصت إليه في سكينة، جعلت أبدي أسفي بتحريك رأسي، والاكتفاء بالابتسام في صمت، أخيرا تنهدت الزوجة في ارتياح، طالعتني بعينٍ ذهب عنها الرَّوع، لهث فكري في اجهادٍ مقلق، اندلقت أمامي ذكرى الأيام الخوالي دفعةً واحدة، وجدتني شابا يافعا يستقبل الحياة بعفويةِ الريفي السَّاذج، ارتدي جلبابي الأخضر السكروتة، تتقاذفني الحقول صباح مساء، تحصد يدي من خشاشِ الأرض، التهم في شره ٍعِيدان الحِلبة الخضراء، قرون الفول البلدي، رؤوس اللفت، حبات البلج، واأسفاه؟!، لقد خانتني قواي، خذلني جسدي، تهدمت قواي بالتدريج، أجهزت أمراض الغربة على الفلاح النحيف، افترسته الرفاهية المزعومة، غيرت شكله وبدلت أحواله، ضمرت عضلاته الصلبة، تهدلت بطنه بعدما انتفخت بالزيوت، والمشروبات الغازية، واللحوم المجمدة، صغيرا كنت اهرب للطبيعة، أذرع الغيطان، اتسلق الأشجار والنخيل، اناجي طيور الفضاء حين يكدر نفسي القلق، لكني الآن، وسط معسكر رذيل، ورشة عمل بشرية بلا دين، لا تعرف طريقا للإنسانية، آلات صماء تلهث خلف المال، تغير جلدها ووجهها بلا رحمة.
في المطار، ظَهرَ الارتباك على وجه ضابط التفتيش، طالبَ بنبرةٍ آمرة أن افرغ فورا محتويات الحقيبة، هاله منظر الأدوية، قطب، متسائلا:” لماذا احضرت كل هذا الدواء؟!، أخرجت على الفورِ وصفات الطبيب، أعلن بنبرتهِ الحزينة:” كان الله في عونك “، استقبلني صديقي بحفاوةٍ، هَمسَ في أذني:” أعددت لك طبختك المحبوبة “، في السكن أخرجت محتويات الحقيبة، ذهل الحضور، صَوَّبوا عيونهم بحذر، صعدوها في صمت، امتدت الأيدي تفحص الأدوية، مصمصوا بشفاههم، مع الأيام وطنَّت نفسي على هذه العادة، احمد الله على كُلِّ حَالٍ، لأني لا أزال على قيدِ الحياة.
**
أنا والثعلب
مُذ هبطت على المكان، وصُفرة موجعة تتَمشَّى بوجهه الشَّاحب لا تفارقه، تحترق نفسه في أحيان، يتصاعد دخانها حين يلقاني، لا اعرف سببا وجيها؛لم تكن العتبة الجديدة مجهولة، بل هي أرض مطروقة، فسنواتي التي قضيتها بالأوقاف تشفع لي، تتشابه التفاصيل، وتتلاقى المعايير، فشهادة ميلادك لابد وأن تخطها يد الدين، الذي أصبح وسيلة مواصلات مضمونة، يمكنها حملك بأمان؛ واجتياز المخاطر، هبط صاحبنا مع من هبط بتزكية أحدهم، قضى سنوات طوال مُصحَّحا لمجلةٍ تصدر عن المؤسسة، وذلك من صنوف العبث، تطوع أحدهم فأخبره أوان سفره، أن القادم الجديد يتفجَّر موهبة، كاتب لا يُشق له غبار، اثقلت كتاباته صفحات الأدب في الجرائد والمجلات المصرية والعربية، ونجم أطعم المكتبة بمؤلفاته، همسات الثعالب تنبئ عن عدمِ ارتياح، يعانون جميعا ثقل الصبر على احتمالِ الصَّدمة، خاصة حين قدَّمني لهم رئيس القطاع، صَرحَ في رنةِ ارتياحٍ:” زميلكم الجديد، هنا مكتبك “، بهتوا في صمتٍ مُوحِش، وكأنَّهم في مَأتمٍ، اشعر وكأنني اسبح في بحر من العيون الملُتهبة، أعلن أكثر من زميل بالمؤسسة على سبيل التَّفكه:” هذه الإدارة البقرة الحلوب، والوصول إليها صعب، كان الله في عونك “، في هذا المكان تُقدّم القرابين سخية على المذبح، أرخصها الدين والمروءة، ينسلخ المرء عن قيمهِ لنيل الحظوة، وتثبيت مكانه ، منذ يومي الأول اشعر بالغربةِ، اغلقوا على أنفسهم في تكتمٍ مُحيّر، في مكتب جانبي كانت جلستي، فلا تسمع إلا همسا، يتهادى من خلف الأبواب، حتى أولئك الذين ظننت فيهم الحكمة والرزانة، بدوا أشد تطرفا في عداوتهم، تبتسم الوجوه ابتسامة مجهدة، لكن عيونهم لا تزال مُعقدة من الضيق، ظنَّوا بيَّ شرا، وحُقَّ لهم أن يظنوا، حسبوا أنني عين الرجل، أتى بي ليراقب حركتهم، ويحسب أنفاسهم، وفك طلاسمهم، جو كئيب، موبوء، تَغشاه الخيانة من كلّ مكان، كل شيء مُبالغٌ فيه، حتى صلواتهم مزعومة، تشعر وكأنك في سيركٍ صاخب، كل لاعب يقدم نمرته بمهارة، ما إن تنفض الفريضة، حتى يتلاحق الاستغفار، يستدير كبيرهم ويشرع في إلقاء خاطرة مختصرة، عن قيمةِ الخير، و أثر العطاء، والتعاون على البر، تسقط رؤوسهم على صدورهم في تمثيلٍ سَاذج، انظر إليهم في احتقارٍ، تداعبني الابتسامة، فمهما ارتفعت قوى الإغراء بالديانة، فمثلي عصي لا ينخدع.
بعد أسبوعٍ عَادَ ” ناصر” من إجازته، مصري جنوبي، فارع الطول، نحيف البنيان، في هيئةٍ معتلة، تكسو وجهه الضامر لحية مزيفة مهملة، اعرفها جيدا، وضعها ليختبئ كغيره من خلفها، جواز مرور يُمكِّن صاحبه من البقاء، و يكتب له السلامة، عرفت أن بيده مقاليد الأمور، بحكم الأقدمية، يَتصَّرف كيفما شاء، أرقام العملاء، الجهات المتعاونة، سهلت له أن يصبح نافذا لدى الكبار، ساعدت طباعه الشخصية، وادعائه المعرفة أن يصبح نجما، سَلَّمت عليه، ارتعشت عيناه أسفل نظارة عريضة، هرش ذقنه في ارتجاف عفوي، تحرك شاربه الكث الذي اندسَّت فيه أنف مُقرف، نهجت أنفاسه متلاحقة في إعياٍء ، ليقول في خُبثِ ثعلبٍ ماكر:” لقد حصلت على مؤهلي الجامعي من محافظتكم “، سكت قليلا، ليغيم وجهه في ذُهولٍ مُوجع، ظلَّت عيناه مبهورتان لا اعرف سببا لذلك، غير القلق الممرض، ما إن يقترب من بابِ المكتب حتى يعود أدراجه، وكأنَّما يشد إلى سرٍ خطير، تركته يتقلَّب في نيرانهِ، لازمت مقعدي لا أبرحه إلا لسبب، يتابعني بنظراتٍ هزيلة، يَمطَّ عنقه في ارتياب، وكأننّي اهيأ لقبضِ روحه، يزعجه أن اكتشفت زوره وبهتانه، في حديثنا العادي يُطالعني بعينين متوسلتين، ودمعة تكاد تقفز منهما، بدأت اشعر بالشَّفقةِ تجاهه، أكاد أن اصرخ في وجهه:” حتى وإن كنت ضحل المعرفة، فالأمر سهل يا صديقي، فحظوظ الدنيا بيد الله “، قلت مواسيا ذاتَ صَباح:” جميعنا يكمل نقص أخيه، عملنا الخير، وتنافسنا محمود “، من بعدهِ شعرت بالقَلقِ يشتد به، يحتويه ليغرقه، اكره فيه نظرات الثعلب، تلك المحشوة بالخوف، تتراءى في وجهه بوادر الفضيحة، لكنه يفشل في اخفائها، على مدار عامين كاملين لم اقف له على تعبيرٍ لغوي شيق، جميعها جمل ركيكة حشا بها المحررات الرسمية، في سَخفٍ لا يليق بتاريخ المؤسسة العريق، كلمات استهجنتها قريحتي ومجَّها ذوقي، أقول لنفسي مستغربا:” كيف لشخص تصدى طوال تلك السنوات للكتابة أن يصدر عنه مثل هذا الخلط، لكنها حظوظ الدنيا وأقدارها “.
مع الأيام أمن جَانبي، فتحوَّل خوفه لمَكيدةٍ، نصحني بعض الزملاء تجاهل سخافاته، فهو خبير في ضُروبِ الوشاية، وتدبير المؤامرات، طُلبِنا لاجتماعٍ طارئ، علينا إعداد ورقة بموضوعٍ معين، ازداد انزعاجه، ابتلع ريقه بصعوبةٍ، في الخارج قال بابتسامٍة يواري بها قلقه:” من المستحين أن تكتبها أنت ؛حتى لا نضيع وقتنا “، في كلِّ عملٍ مشترك تتضاعف كراهيته لي، ويَتفجَّر بداخلهِ بركان الغضب، عندما يتراءى فشله.
عدت من إجازتي السنوية، في مكتبهِ اطلعني ” ريحان ” على ما طُبِخَ خلفَ الكواليس، لقد بذلَ كلّ حيلةٍ لإقناع مدير الإدارة؛ لحبسي في السرداب، بدعوى أنه المكان الأمثل، فالمبدعين أمثالي يلزمهم الهدوء، سطعت الفكرة في عقولِ من حوله، ضحكت متأسيا، لماذا يقدم القوم على مثل هذه الحيلِ، وهل يَليق بمؤسسٍة عريقة أن تصبح أخلاق البعض فيها بهذه التَّدني، كيف للموهبةِ أن تصبح جناية، تهمة، في بيئةٍ مُحرضٍة تعيسة، لا تعرف غير الغدر والخيانة، وصناعة الحلفاء، لم تشفع نوايايّ الحسنة، بِتّ ومع كلِّ صَباٍح اعصر على نفسي مائة ليمونة؛ لكن شيئا لم يَتغَّير، فوجودي يظهر معايبه، وهذا كَافٍ للخلاص، ما أقبحَ الإنسان حينَ استسلامه للغربةِ وأمراضها، ما أقسى تلذذه بها، هنا تتعانق جميع المتناقضات، تشتبك في وقاحةٍ، تتحول القيم المثلى لرذائل، الدين ركوبة توصل لكلِّ غاية، مرات اشفق على ” ناصر”، لم اقصد تعريته ، وإظهار سوءاته كما تَوهَّم، مسكينٌ، ستظل تُطارده كوابيسه، تلعن عجزه، حتى وإن فارقته.
**
أبو العز
في لقاءنا الأول، ابتسمَ إليَّ كَأنَّه يُطمئنني، امتلأ وجهه الأبيض الُمشرب بحُمرةٍ بفرحٍ متراقص ، زادَ من أُلفته، اشعر وكأنَّما أعرفه منذ زمنٍ، مَدَّ يده مُسلِّما في تَلطُّفٍ زائد، لا أعرف غيره في المكان، بعد عباراتِ التِّرحَاب المتلاحقة، اكتسى وجهه بالجديةِ، قائلا:” هل فطرت؟”، عندها تلعثمت، قبل أن اجيبه في استبسالٍ:” الحمد لله “، من فَورهِ، قامَ في اندفاعٍ لا يليق بجسدٍ ضخم كجسده، غَابَ قليلا قبل أن يعود؛ مُمسكا بكوبِ الشاي، قَرَّبه وهو يَنظر نحوي بعينين صامتتين، لا أدري كيف أنفكّ أسار لساني، من فوري شرعت في سرد حديثٍ مَلأ الفراغ، جُذِب الرجل ليشاركني إياه، ” أبو العز ” هكذا عَرفته، أتاني صوته عبَر الهاتف ضَاحكا مُستبشِرا، يتكلم في عُجالٍة، تقطع كلماته تنهيدة مريحة، عقب اتصالٍ يتيم تقابلنا، حَدَّق بنظرةٍ خَجلة، ليتساءل بعد هنيهةٍ في تردد:” هل وقَّعت عقدا؟”، هززت رأسي وأنا ابرز له صورة ضوئية منه، انعقدت على شفتيه ابتسامة صادقة، ظَلَّت متوهجة، تساءلت وسحابة من الحيرةِ تلفني:” لماذا صارحته بهذه السهولة، لماذا هذه الثقة؟”، رفع حاجبيه، انتزع بصره وألقاه ناحيتي في ونس:” لنشرب قهوة فرنسية “، داهمتني الدهشة لقراراته المفاجئة ، في أسبوعي الأول حاولت تمرين نفسي على تقبل طباع من حولي، اعترف بأني فشلت، أقاموا -ومنذ اللحظة الأولى لمجيئي- سدا منيعا، متاريس عصية، يستحيل تجاوزها، لعزلي عنهم وعن مجريات العمل، بدوا وكأنَّهم يُخفون سِرا عظيما، تواصوا على كِتمانهِ، لم اكترث طويلا لهذه السَّخافات، لم تتوقف نظراتهم تعد أنفاسي، تلاحقني طافحة بالخوفِ والريبة، تغرق وجوههم الكئيبة، يأكل الفضول صدورهم ، أصواتهم المرتعشة، ابتساماتهم الماكرة، تنز عيونهم المرتخية بالمكر، كلماتهم المشفرة، أحاديثهم الطويلة، همساتهم غير المنتهية، تدور خلف الأبواب المغلقة ، ماذا يخفون، لماذا يخشون وجودي؟!.
يهاتفني ” أبو العز ” في لُهاثٍ مُفتتَحِ كلّ صَباحٍ، وعلى فمهِ ابتسامة طازجة:” الفطار جاهز”، أدمنت هذه الجملة على صغرها، بت انتظرها بفارغِ الصّبر، ينشط عندها ” أبو العز”، فيشرف بنفسهِ على تجهيزِ المائدة، تتطاير دعواته المُلّحة تُحمّس الزملاء في أُلفةٍ، اشعر في رنةِ صَوتهِ براحةٍ عجيبة، وثقة افتقدها، كان الرجل الأقرب لجميع الموظفين، له في كلَّ طابقٍ صديق مُقرَّب، سهّلت بشاشته المعهودة، وسعة صدره، وتجاوزه عن صغائر الأمور؛ لتهبه جواز مرورهِ لكلِّ قلبٍ بسلام، ووسط هذا كله اشعر بحمله الثقيل، مجاهدته لإخفاءِ عبوسه بابتسامةٍ مُتكلفة؛ يُغطّي بها قلقه، في ليلةٍ صَفت نفسي فيها، هَتفَ بخاطري هاتف:” عن سببِ الحزن العميق المُتأتّي من داخلهِ، الخيط المُتدلّي من أعماقهِ “، استغفرت الله قبل أن اُسلِم عيني لنوم عميق، وقُبيل الفجرِ، انتبهت، وسعادة عارمة تتمدد في صدري، رأيت شيخا في ثيابٍ بيض، يحمل طفلا جميل الطَّلة، تهلل وجهي في إشراقٍ، فاندفعت في فُضولٍ أسأله:” ابن من هذا؟”، أجابَ في استبشارٍ:” ابن أبو العز “، ارتجفُ قلبي فرحا، ، في نهايةٍ اليوم تصادفنا عند المَخرج، سَلمَ في عُجالٍة، ثم قال في حَميميةٍ:” اليوم اسافر ، دعواتك “، بادرته في ارتياحٍ: “إن شاء الله تسمع خيرا”، رأيت بريقا يسطع من عينيهِ، رَماني بابتسامةٍ مُشرِقة، طَالعني بعينين سَاهمتين، كمن يراني لأول مرةِ قَبل أن يَبتلعه الفضاء، تشاطرنا الفرحة بعد أشهر؛ بُشِّر بقدومِ ولي عهده بعد صَبرٍ طويل.
**
في مُقتبلِ الدَّهشة
بالجهة المقابلة لمحطة الأتوبيس الرئيسة بالعاصمة، تتلألأ يافطته الزرقاء، نُقِش اسمه بحروفٍ بيضاء غليظة، ما إن تعبر الشارع حتى تلفحك رائحة الطعام، طوعا أو كرها يسيل لعابك، خليط سحري أخاذ، تشابكت فيه خيوط المقلي والمشوي والمسبك، في الخارج استقرت شواية ضخمة، تتراقص في بطنها دجاجات صُفرٍ، انتظمن في سيخٍ معدني كعقد الكهرمان، تنزّ تلك الحَبات بالدَّسم ِ، في بُطءٍّ وعلى مَقربة منها بسطَ معلم ضخم البنيان بسطة عريضة، تدلى منها هرمان عظيمان من اللحم، قمع أحمر من الشاورما، تلفح وجهه النار، يحكه على فتراتٍ حَكات ماهر خبير، يحرك سكينة كمايسترو يقود فرقته الموسيقية، لتتساقط على إثرها نشارة رقيقة، طالعته في تأنٍ، لم استطع كَبحَ ابتسامتي الجائعة، التصق عيناي به، أردّد بصوتٍ خفيض ما يسكن ثعابين بطني ويخمد جوعي، اعترف وحُقّ لي الاعتراف؛ بأن أول راتب تقاضيته، سطع في خاطري أول ما سطع ذلك المشهد المهيب، مشهد مطعم “كروان المدينة “، في ظهيرة ِيومٍ صائف، اقتربت من الكاشير، وقبل أن يسألني، عاجلته في حماس:” أربعة شاورما دجاج “، بجوار القمع الأصفر الدوار اتخذت مجلسا، احتضنه في تسليةٍ ومرح، يَتفجَّر الأمل بين جنبات صدري، لينفتح من بعدها الهويس.
في بداياتِ عملي بالوزارة، اشتركت ومجموعة صغيرة من الزُّملاء في وجبةِ الفطار، لك أن تعذرني، فمكوناته تستحق المخالطة والمجالسة، تزهو أقراص الطعمية في خُضرةٍ لذيذة، اُغِرقت أطباق الفول والحمص في زيتِ الزيتون، كل هذا يستحق الانجذاب، يلقي ” عشري” مراسل الإدارة قطِعا من أشعار مديحه المعتاد ُكلّ صباح، يُمجّد في خُضوعٍ صاحب المطعم، ذلك المحسن الذي يغمره والمساكين أمثاله بعطفه وكرمه، عندما علم بأنه مصري:” ربنا يجعل بيوت المحسنين عمار “، في يوم من الأيام، وبعد الانتهاء من العمل، جمعني حوار خاطف مع صديقي الأثير”س”، هو وبشهادةِ الجميع من أصحاب الكُروش، لكنَّني أقول بأنه من أهل الذوق الرفيع والمِزاج العالي، يٌقدِّر اللقمة الطيبة، شرّق بنا الحديث وغَرّب كعادته، اطلعني في مَرحٍ خبيئته، هناك وفي مكانٍ منزوي من عمارةٍ مهجورة، مطعم شعبي رخيص، يُقدِّم أصنافا مُحبّبة للبسطاء، تنفع في معالجةِ آثار البرد المزمنة، العدس والبصارة، نظرت إليه باهتمام محموم، لم اماطله طويلا، استسلمت على سبيل التجربة، في مدخلِ المكان شيّعني العامل بنظرةٍ مَسطولة، تطل عينين أحمر محاقهما بلون الدم، قطب جبينه متنحنحا، وضع الأطباق أمامنا كآلٍة صماء، داخلتني الكآبة، فنظافة المكان تثير في نفسي القشعريرة، اقسمت برأس أمي ألا اعود ثانية إليه.
في مفتتح عامي الأول بالوزارة عُقدِ ملتقيا أدبيا كبيرا بأحد الفنادق المميزة، دُعي إليه وجهاء الأدب وصناعه من الوطن العربي، يومها انتشيت بفرحٍة عارمة، انتبت من نومي على رنين الهاتف، على الطَّرفِ المقابل رئيس القسم، قال بصوتٍ يملأه الخُمول:” اليوم تتواجد مبكرا بالفندق، تنتظرك بعض المهام “، في البهو المُتسَّع زَاغ َبصري، وانحسر فكري في الوجوه المترعة بالنعمة، لطمتني رائحة الطبخ النفاذة، جذبتني أصوات الملاعق تزعق في بطونِ الأطباق بجرسٍ مُسلٍ، موسيقى هادئة تنساب عن بُعدٍ وسط أضواء خافتة، على بعد أمتار من المدخل نُصِبَ بنر كبير لإرشاد الضيوف، على مدار يومين كاملين قضيتهما، شعرت وكأنني في جنةِ عالية، قطوفها دانية، اشفقَ الفلاح البسيط في نفسي عليَّ لفرط الرفاهية والنعيم، جَثمَ البوفيه وهذا ما يعنيني ممتدا على بُعدِ البصر، تُزينه صنوف الطعام في ألوانٍ بديعة، لم اتردد طويلا، تخففت سريعا من ارتباكي، اقتحمت في جَسارةٍ كغيري، اطوفُ من حوله أجمع ما لذ وطاب، هذه المرة الأولى التي اصادف مثل هذا الفردوس، بعد دقائق تناثر المشايخ في شرهٍ مُلفت، تسابقت الأيدي تنَزح في افتراسٍ مُخيفٍ، يُقدِّر هؤلاء القوم الدَّسم، ويعرفون مواضعه في مثل هذه المحافل، لا يقطع الصمت المطبق سوى همسات الحضور الجافلة، ورنين الملاعق تحتضن الأطباق في حميميٍة، ونَحنحة مصطنعة تُنبّه القادم من الخلفِ أن يلتزم الدور، في تلك الأثناء، وبينما كل امرئٍ منشغل بنفسه عن أخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تأويه، يطلق أحد المشايخ عقيرته بصوت ندي مجلجل:” يا شيخ حسب النبي، تعالى هنا، قرب يا جدع، الصنف دا معتبر أوي “، ترفع الحواجب في اندهاش، غالبَ الحضور ابتسامة حبسها اللَّقم المتواصل، سريعا غاصت الابتسامة فوق الشفاه، عليَّ أن التحق بالركب في طوافهِ حول الصواني، لا تزال تتردد بين شفتَّي ابتسامة خجولة، جاهدت كثيرا في مغالبتها، في التَّحرر من قيدها، علَا وجهي الارباك، فأنا اجهل ما يكون بتلك الأطايب، لم اورط نفسي، مغرفتين من الأرز الأصفر بالمكسرات، قطعتين من الشواء، ملعقتين من السلطة الخضراء فهي أمور معلومة بالضرورة، بدى الأكل مثاليا، لكن رهاب المرة الأولى يلازمني، ولعل هذا ما عَكَّر صفو مزاجي قليلا، على الطرف المقابل لمحته، جلس يترقب، ينقر بالشوكة نقرات رتيبة، تلوح في سحنته المصفرة آثار الانزعاج، ارتعشت عيناه أمام عينيَّ، من فوره نكس وجهه يدير ملعقته في الطبق منفعلا، لا اعرف سببا وجيها؛كي يسري في قلبي برود الثقة، بدون مقدمات نزَعّ نفسه من مقعده، اقترب مني وقد ارتخت عيناه شيئا فشيئا، انفكت تقاطيع وجهه الصارمة، قال في عصبية:” لقد تورَّطت في اختياراتي، غرَّني المنظر، اطعمة غريبة يا رجل على أمثالي “، ثم ضحك ضحكة باهتة، استقبلت تصرفه بابتسام، نفخني الغرور برغم المرارة، زفر أنفاسه في صمت، تناوب على التهام قطع الحلوى في شراهة منكرة، دلق من بعدها علبة مشروب دفعة واحدة، ثم قَلَّب شفتيه قرفا، صدقني، من بعدها مَرّنت نفسي على أمثال هذه المواقف، خبرت بالممارسة، مواقع الفائدة، فلم اعد اندفع على عماية.
قضى الله أن لا اعود للبيت في الظهيرة بعد العمل، شُغلت في عملٍ جديد يستمر حتى المساء، قال صاحبي ” منعم “، بصوتٍ مُتحفّز:” انتظرك على الغداء، مطعم جبل النور، الكباب الإيراني شهي وسعره مناسب “، أمام النار حَدّق فيّ عملاق إيراني، انهمكَ في تصميغ أسياخ اللحم، هالتني تقاطيع وجهه الصارم، بعد دقائق عبََّق المكان برائحة الشواء، رائحة تخطف العقل، مبدئيا وضَعَ العملاق طبقا، حَوى قطع البصل الأبيض، أعواد الجرجير والرجلة وليمونة كبيرة، ثم أردف بالكباب، امتلأت خياشيمي وسال لعابي، تأرجح شارب جليسي، من فوره التهم حبة الطماطم المشوية، بعدها اجهز على الكباب، تجشأ بصوت غليظ، قام إلى العملاق نفحه الحساب، في وناسةٍ شَرعَ يخلل أسنانه، وقد قفزت ابتسامة طارئة فوق وجهه:” هنا تستطيع أن تملأ بطنك بسعر ملائم “، قادتني حماسته الزائدة؛ لتكرار الزيارة أعواما دون انقطاع، أثناءها انتفخت جوانبي، وانبعجت بطني، وضاقت عليَّ ملابسي، وفوق هذا، عصفت بأمعائي حموضة مزعجة، يفور جوفي باللهب، لعنت نفسي، وجبل النور، والعملاق الإيراني الذي يخلط اللحم بلية الخروف وشحمه، ضاق صدري واسودت الدنيا في ناظريّ، فأنا من القلائل الذين لا يطيقون لحم الضأن ودسمه
تزاحمت مخيلتي بالصور وأنا افتح زجاجة الدواء، علها تسكن علة بطني المحترق…