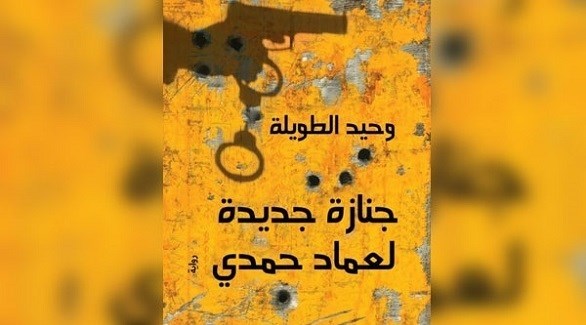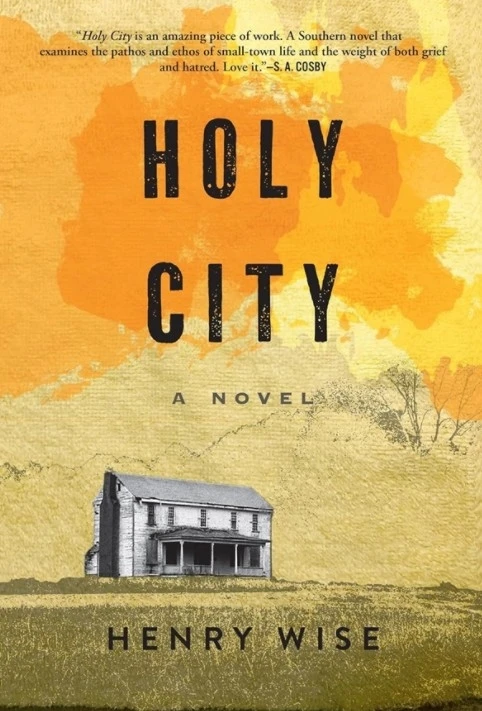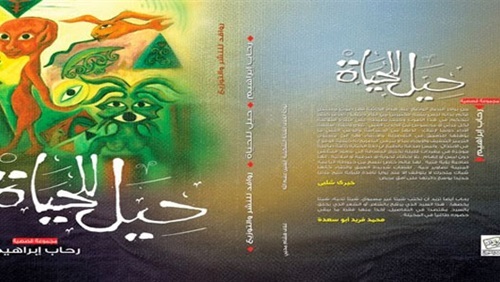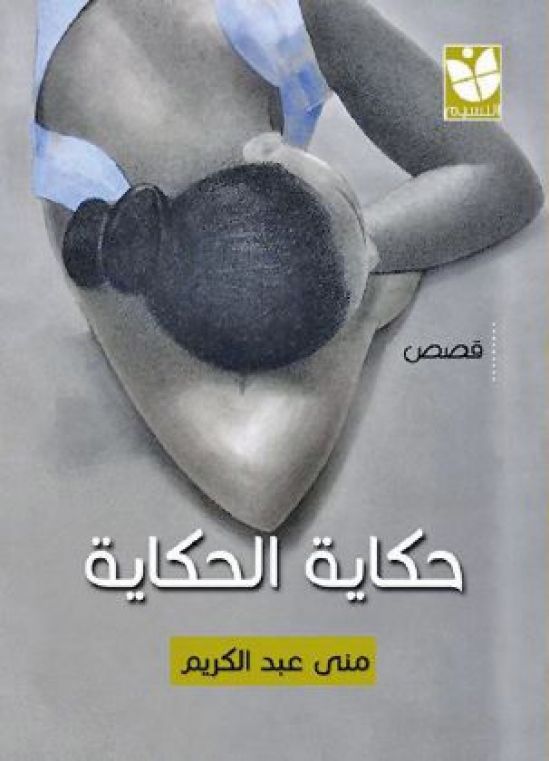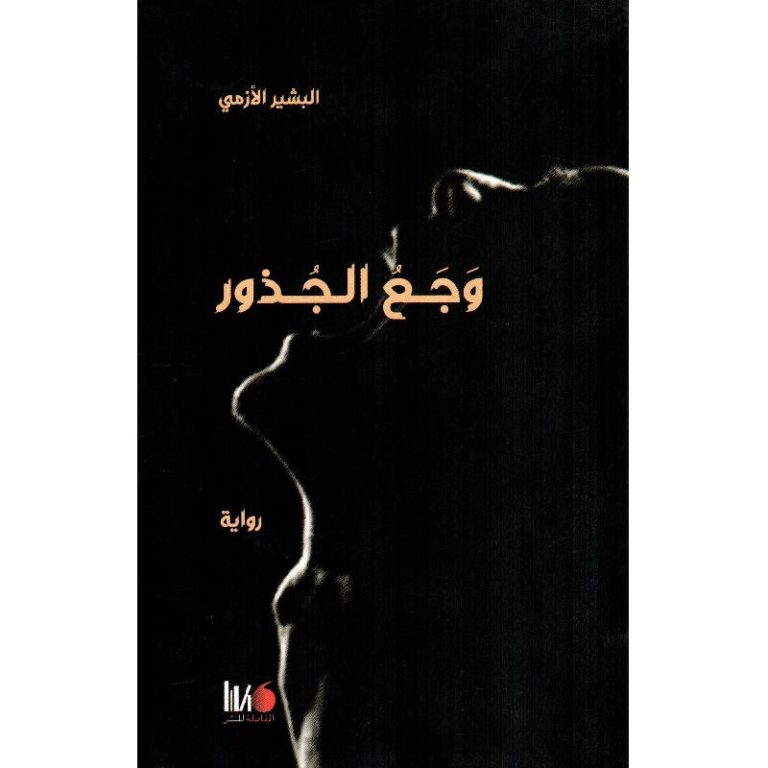جمال القصاص
هناك دائما جلادون يعبثون في فراغ المشهد من أجل أن يظل محكوما ومنضبطا على أمن النظام، أو على الأقل أمنهم الخاص، حتى وهم يصارعون أنفاسهم الأخيرة في الحياة… مشهد يتجدد بقوة في رواية وحيد الطويلة “جنازة جديدة لعماد حمدي”، الصادرة حديثا عن دار الشروق بالقاهرة، وهو مشهد ليس ببعيد عن مشهد الختام في روايته السابقة “حذاء فلليني” حيث يتدخل المخرج الإيطالي الشهير لضبط إيقاع الجريمة ومفارقاتها الدامية، لتليق بأبطالها الذين اختلطت في ذواتهم خيانة الذات بخيانة الوطن والحب والحياة.
كانت صرخة فلليني الشهيرة “استوب” كلمة السر لضبط هذا الإيقاع، لكن المشهد لم ينضبط على مسرح الرواية والواقع معا، فلا يزال يعج بالدم والحروب وأشتات اللاعبين من كل صنف ولون في بلاد نخرها سوس السلطة حتى أصبحت غريبة عن نفسها… في الطريق نفسه شكلت جملة “كل شيء يحدث في الحمام” في روايته الأسبق “أبواب الليل” كلمة السر الموجعة في فضاء مقهى “لمة الأحباب” التونسية، حيث عالم متهرئ من البشر، يقتات على ما يتساقط من بلطة النضال من ذكريات وأحلام، صارت ومضا متخثرا في أزقة العمر والثورة.
لا يبتعد عماد حمدي عن هذا السياق، فرغم أنه رمز عابر وشجي في الرواية، عاش البطل وقائع جنازته في أثناء خدمته بالبوليس، إلا أنه منح الرواية اسمها، ويتردد صداه في قصصها ومفارقاتها، وجرائمها كزمن هارب، ورمانة ميزان تبحث عن كفتين عادلتين، ربما تعيد إلى المشهد سخونته وهو يصرخ في وجه عبد الحليم حافظ، بعد أن لطمه” انت مش ابني… انت لقيط”.
لطمة شهيرة، في فيلم شهير وبطل غادر الدنيا وحيدا مفلسا ليس في جعبته شيء من مجده الغابر، سوى زفرات من الألم والحزن، هي الزفرات نفسها التي يحصدها بطل الرواية في صراعه مع كينونة تساوى فيها المع والضد، تغلفها فجوة من عبث الحياة والأقدار، تضيق وتتسع كل يوم، لكنها لم تستطع أن تردم عاطفيا المسافة بين الرغبة والفعل، أو بين الحلم والواقع فيتحول كلاهما إلى عقدة، تتناثر حولها الحكايات والخطايا، يشد خيوطها الجلاد من طرف، بينما تشدها الضحية من الطرف الآخر، وكأن كليهما قناع للآخر، يمكن أن يتبادلا الأدوار، كلما اقتضت الحاجة… “اسمع قولا واحدا، ضابط المباحث الناجح يقاس نجاحه بتعدد مصادره بالمسجلين خطرا، يتمشون داخل عباءته، ويربطهم من شواربهم في سلسلة مفاتيحه”.
ينتصب سرادق عزاء “هوجان” ابن “ناجح”، الوريث الشرعي لوالده، الملك المتوج على عالم المسجلين خطرا، والذي قتل غدرا بعد أن ارتفع سقف نفوذه، مشكلا بمفارقات الحزن والسخرية والحيرة في معرفة القاتل، زمن الرواية الخاص المفتوح على قوسي البداية والنهاية، بينما يشكل الإهداء الذي يستهل به الطويلة لعبته الروائية “إلى المسجلين خطرا: تصحبكم السلامة”، تحفيزا للقارئ، للدخول في اللعبة، عبر ضمائر المخاطب بوتيرتها المباشرة، والمستترة، المسكونة بلطشات حريفة من العامية والحكم والنوادر والأمثال ابنة الذاكرة الخاصة والوجدان الشعبي، لإثارة حواس القارئ بشكل أعمق حتى لا يدخل إلى الحكاية بجسده فقط تاركا روحه علي العتبات. وفي الوقت نفسه، تجعل السرد وكأنه طائر يحلق باللغة.
يبدو الصراع مثقلا بعذابات الضمير والواجب، فبطل الرواية، ضابط البوليس السابق، تحت وطأة ماضيه الطيب يقدم رجلا ويؤخرها لتقديم واجب العزاء لرجل يدين له بالكثير عما حققه من نجاحات في مهنته… “ناجح” كبير مرشدي الحكومة ومرشده الخاص، وعينه الأخرى، والذراع التي لا تتأخر لمساعدته في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها، وتقديم الأدلة ضدهم، بل تلفيقها أحيانا. حين ضاقت مسافة العلاقة بينهما بدوافع إنسانية محضة، تحولت إلى تهمة، غادر على إثرها المهنة، بعد تحقيق عبثي معه… “أنا ضابط مباحث يا باشا، إذا لم أقابل المجرمين والمسجلين والمرشدين لأمارس عملي فماذا أفعل، هل أقابل نقيب الأطباء؟!”.
يحتدم الصراع محفوفا بالخوف أحيانا، ومخاطر الغدر أحيانا أخرى، فالسرادق ضخم، عامر بحشود المعزين من كل صنوف الإجرام، وأيضا صنوف الكيف، والضابط أصبح لا حول له ولا قوة، انتهت رقة المشهد وغلظته أيضا، وحده ناجح من يملك ضبط الإيقاع، ولو بدمعة حارة، تنزلق عفويا من عينيه على ابنه… ويعود الزمن بالضابط البطل خطوة للوراء: “ناجح يعمل لصالحي، لكن لصالح نفسه أولا، يغنم نقودا وسمعة وتقربا من الحكومة، ويبقي رأسه بعيدا عن أي مقصلة”.
تلعب صيغ السرد بتنويعاتها وحيويتها الفنية دور الوصل والقطع بين قوسي الحضور والغياب، كما توفر للكاتب السارد مسافة ما، بينه وبين الشخوص والوقائع ليرى ما وراء المشهد… وإمعانا في الغرابة، كثيرا ما يتحول من راو عليم إلى مراقب، ينظر بزاوية أعلى بصريا من خط الأفق في اللوحة، بينما تومض وظيفة متخفية وراء توريط القاري في اللعبة، الذي يحذره بين الحين والآخر: “لا تتهور احترس، لا تلتفت يمينا أو يسارا، لا تستجيب لنظرة أحد”، “لا تستغرب”، قف مكانك”، “في هذه اللحظة ستبدو بهيئة لص أو قاتل، لا ترتكب أدني حماقة يستشف منها أنه يمكن أن تكون عاشقا، إلا إذا استطعت أن تبرز عشق الإجرام، وهذه حكاية أخرى”.
لا يقتصر هذه التحفيز على تهيئة القارئ للدخول في اللعبة فحسب، وإنما ليلعب دور الونيس، أو بلغة السينما “السنيد” للبطل المتردد في دخول السرادق، كأنه مجس اختبار لما يكمن وراء الحكاية، وما تخفيه في لفائفها من أسرار وألغاز، وأن مفتاحها ليس بيده، ولا بيد الكاتب نفسه، وإنما كلاهما متورط في دهاليز عالم شائك وملتبس، تختلط فيه الألوان والمصائر، فلا الأبيض أبيض، ولا الأسود أيضا، ثمة منطقة مبهمة تتشكل في عالم القاع ودهاليزه، حيث تتسع الهوة، وتنقلب معادلات الوضوح والغموض: لصوص ومحتالون، نصابون وتجار ممنوعات ومخدرات، باعة ضمير وشهود زور، ضحايا وجلادون محتملون وعابرون، مجرمون بالصدفة وبالسخرة، يعرفون كيف يموهون على جرائمهم، حتى في جيوب النظام… “مخطئ من يتصور أن المسجلين لا يحبون الحكومة، هم يعرفون نظرية المقص جيدا، إذا ما انفتح وجرح رؤوسا، تعود أطرافه لتتجاور، ولو بمسافة، كلاهما يحتاج الآخر، مع أن كل طرف ينظر في طرف آخر”.
تحت هذه المظلة تتنوع الحكايات، وينفرط عقدها في الرواية، فلكل مسجل، ولكل ضابط حكاية، وراءها أخرى تتصل بها من طرف ما، تعري الشخوص، وتسقط أقنعة التواطؤ بينهم وبين ذواتهم، وصورتهم البائسة المراوغة في الخارج، صورة مشوشة ومضطربة تثير التعاطف والسخرية والسخط معا، فهم مهانون تحت الطلب، اغتالتهم ضرورة الحياة والوجود، أدمنوا اللعب على كل الحبال، بأجسادهم ونزواتهم، تتكشف طبيعتهم من أسمائهم (عبقرينو/ رجل المطافئ، أبو شفة، قنبل، عماد لون، آيات/ جسد المشارط والأمواس، كلبش.. وغيرها) بل وصل الأمر إلى ما يمكن تسميته “غسيل الجريمة”، لتبرئة الجناة الأصليين… “أحيانا تحس أنه مشتاق للحبس كأنه بيته، أحيانا يحضر كأنه ذاهب لامرأة يعرفها جيدا، لا يريدها ولا يرفضها”، “شحتة يأتي لسعادتك كل يوم وأنتم تعيدونه، أنه يسألني كل ساعة، جذمته ذاب قعرها، أصبحت من غير نعل، وصار يمشي على الجورب… إنه يسألني متى تحبسونه يا سعادة البيه”. لكن الحبس لعشرات المرات، وبالأجر، لم يستر حياة شحتة، أول مسجل يعتزل بلا مؤثرات خارجية ولا مباراة اعتزال، ويتزوج من آيات بالمحبة، بعد أن دهسها الجميع، ولتأمين حياته فكر أن يبيع كليته، ثم انتهى به المطاف لبيع إحدى خصيتيه، إنه مثل أقرانه من أخوة القاع، مهما ارتفع شأنهم يدركون أن دورهم الحقيقي ومكمن بطولتهم المقموعة أن يظلوا على الحافة لا يبرحون ثوب المسجل خطرا الذي فصله النظام على مقاسهم فقط، ليظلوا هكذا أشبه بعالم لقيط، لا يملك شرف الانتساب للوطن.
يعي ذلك برهافة بطل الرواية “فجنون” عاشق الرسم والموسيقى خريج المدارس الفرنسية، والذي أطلق عليه زملاؤه هذا الاسم كدعابة تمزج الفن بالجنون ، يطارده إجبار والده لواء الشرطة السابق في أن يورث أبناءه هذه المهنة حفاظا على مكانة العائلة، ليتحول إلى ضحية لصراع خفي في الداخل، يجعله مشتتا بين دوره الصارم المحدد كضابط بوليس كل مهمته تعقب الجريمة وحفظ الأمن والنظام، وبين حلمه المكبوت الممسوس بروح الفن والولع بالألوان؛ “لا تكذب على نفسك، أنت استمرأت هذه الحالة لتنسى بها كل رغباتك، كل يوم قضية جديدة تغوص فيها، كي لا تسمع أي صوت يذكرك بحالك، البيت أصبح فندقا يتيما، تعود إليه لتستحم، وتنام مثل القتيل”.
إنها معادلة اللوحة في عين الرسام، طاقة من التجسيد يبتلعها الواقع كل يوم بنمطيته وجرائمه وحكاياته التي تتناسل في حبل لا بداية له ولا نهاية، لكنها في كل الأحوال تحتاج إلى طاقة أعلى من التجريد، من الحذف والبتر والإضافة، حتى يمكن التشبث بإرادة الحياة، ولو في صدى صرخة تعلو فيها نوازع الإدانة والعجز، في داخل البطل… “ما يطمئنك قليلا أن معظمهم وربما كلهم ينظرون لك كمسجل خطر حقيقي، وهذه رتبة لم يصل إليها أي ضابط آخر، موقنون أنك تعرف عنهم أكثر مما تعرف أيديهم”.
بهذا الإيقاع الموجع يبلغ زمن الرواية الخاص، زمن سرادق العزاء الضخم ذروته دراميا، ويمهد له الكاتب، بـ”أربع لوحات ورقصة”، عنوان مميز بين فصول الرواية الثلاثين المرقمة، كأنها رقصة الذبيح الأخيرة، حيث ينهي “فجنون” مع منتصف الليل مساحة التردد المشتعلة في داخله ويدخل العزاء، لا أحد يلتفت إليه، بل لا يجد كرسيا شاغرا إلا في أحد الصفوف الخلفية، وحين يصل إلى “ناجح” يفاجأ بأنه يسلم عليه بفتور، وبالكاد يتبادل معه كلمات العزاء المعتادة.
هذا الزمن الذي لا يتجاوز واقعيا مدار الساعة، استطاع وحيد الطويلة بمهارة استثنائية، أن يوسع مداراته، ليتحول سرادق العزاء إلى مصفاة تلملم شتات الحكايات من الخارج، تنقيها من شوائبها وأزمنتها المتكسرة، حتى يصبح الصراع خالصا لنفسه، بين بطلي الرواية الرئيسيين، فجنون، وناجح، يشاركهما السرادق كشاهد عيان، ليس فقط على بطلين لم يفلحا في العيش تحت مظلة التضاد الرخو، إنما على مجتمع تداعت فيه الفروق بين الجلاد والضحية.