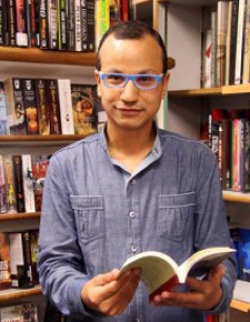منذ فترة طويلة قرأت إحدى قصص مصطفى زكي، وهي القصة الأخيرة في هذا الكتاب، بعنوان الكابينة رقم (4)، في إحدى إصدارات جماعة إطلالة الأدبية السكندرية، وهو واحدٌ من أعضائها الأساسيين، وعندئذٍ شعرتُ أنني أمام قاص موهوب، لديه ما يقوله، ولا يُقلّد أحداً، وهو خصال لا غنى عنها لأي كاتب ومع هذا فقد أصبحت أقرب إلى العملة النادرة، رغم تكاثر الكتب والكتّاب وتدفق الأعمال الأدبية من دور النشر صباحاً ومساءً.
جين تمكنتُ أخيراً من الإطلاع على مجموعة قصصية كاملة لمصطفى زكي تأكدتُ من حدسي المبدئي، ووجدتُ أن أغلب قصص الكتاب تحتفظ بالسمات ذاتها التي جذبتني في الكابينة رقم (4): الحرص على المشهدية دون الإخبار، فهو يرسم مشاهده بالصورة والحركة واللون والظلال، كأي سيناريست واعٍ، ومع ذلك لا يتنازل – إلا عفواً – عن جمال اللغة واستقامتها وجزالتها، والشائع الآن – للأسف – أن من يروي حكايته بالمشهد والصورة ليس عليه أن يصفّي لغته وينقّيها ويغربلها، وكأنّ درس كتابات إبراهيم أصلان كأن لم يكن.
من اللمحة الأولى للغلاف الذي أحسن حاتم عرفة استلهام روحه عن أجواء المجموعة ككل، ينتقل إليك هذا الإحساس الشتوي البارد، وانطباع الوحدة، والفقد، والخذلان، وهي كلها نقاط ارتكاز في أغلب قصص الكتاب.
على سبيل المثال القصة التي ذكرنا سابقاً، وهي آخر قصص الكتاب، الكابينة رقم (4)، تجري بكاملها ذات ليلة شتوية ممطرة، يدوّي فيها الرعد ويشتعل فيها البرق خلال نوّة عيد الميلاد بالإسكندرية، بينما يبقى يجلس رواينا في سنترال محطة الرمل خلال ورديته المسائية وحيداً يستمع إلى الراديو الذي يخربش ولا تصفو موجته إلّا لدقائق معدودة ثم يختفي صوته بسبب الكهرباء الاستاتيكية في الجو. لكنّ الفرق الأساسي الذي يميّز قصة كهذه عن دُرر إبراهيم أصلان، في عمله البديع وردية ليل على سبيل المثال، أننا هنا لسنا أمام مجرد حالة وجدانية تحتشد بتفاصيل صغيرة كأنه أغنية ناعمة أو لوحة شاحبة، بل إلى جانب هذا، مع فارق الخبرة في اللغة والأسلوب بالتأكيد، أيضاً أمام لغزٍ صغير لا تكشف القصة عن طبيعته فضلاً عن حله، فالراديو يتحدث عن اختفاء مواطنين، بعض هؤلاء المُعلن عن اختفائهم أتوا بالفعل إلى السنترال، ودخلوا الكابينة رقم أربعة للاتصال بالقاهرة التي ينقطع الخط معها باستمرار، في هذا الجو العاصف. هُنا ثمة فجوات واضحة في السرد، لا نرى زبائن السنترال هؤلاء وهم ينصرفون، فكأن الكابينة رقم 4 تبتلعهم، وتتمتصهم مثل ثقبٍ أسود. لا يبدو انعكاس هذا على الراوي الذي يتصرف باعتياد وطبيعية ويظلّ مركزاً اهتمامه على الراديو وما يذيع وأحوال الجو والنوّة إلى أن يصل رئيسه في العمل في تفتيش روتيني، ويدور بينهما حوار يوحي بوجود شيء مخبوء وغامض بينهما، كأن ثمة تواطؤ واتفاق على الصمت أو الإنكار. غير أن القصة تنتهي بقول رئيس العمل للراوي: “إذن..هيّا بنا…”، بعد طيف ابتسامة يظهر وسرعان ما يختفي على شفة راوينا.
هيّا بنا إلى أين؟ أين يختفي هؤلاء المتصلّون؟ ما القوة الغامضة في الكابينة رقم (4)؟ ما سر التواطؤ الغريب بين عامل السنترال ورئيسه؟ لا إجابات من أي نوع تقدمها هذه القصة، تحتفظ بغموضها حولها مثل هالة رمادية، رغم أنها تستعين في رسم هذا الغموض ذاته بأشد أدوات الكتابة السردية وضوحاً وصراحةً وهو المشهد البصري الذي يتطوّر أمام عينيّ القارئ مباشرةً. فتنجم المفارقة عن وضوح كل شيء وغموضه في اللحظة ذاتها، ولم تكن هذه هي الحالة الوحيدة في الكتاب التي ينطوي فيها المشهد البصري على حس الغموض والخفاء والإلغاز المتحقق في هذه القصة.
قد ينبع هذا الغموض من ألغاز لا حلول لها كما في القصة الأخيرة من الكتاب، أو من جثة شخص مجهول في المشرحة، تحيط دبلة بأحد أصابعه عليها كلمة هالة، ومن خلال هذه الكلمة وهي عنوان القصة يمتزج راويها بالجثة مجهولة الهوية على نحوٍ غريب. أو قد يأتي ينبع الغموض من مشهدٍ سحري تماماً، حيث ترتفع امرأة في الهواء وقد انشق السقف من أجلها لتطير وتذوب في الزرقة، بعيداً عن مطارديها الذين لا نعرف ماذا يريدون منها أو ماذا فعلت. مشهد قد يذكّرنا بطيران ريميديوس الجميلة عند جابرييل جارثيا ماركيز في رواية مئة عام من العزلة، لكن المشهد عند ماركيز يخلو من ذلك الجانب الروحاني الشفّاف الذي ألحّ عليه قاصنا السكندري. والأمثلة على ضباب الغموض المغلف لعوالم قصص المجموعة كثيرة.
على مستوى أكثر تقنية جاء تشكيل اللغة مُعتماً، كأنه يلزم مجموعة محددة من الألوان الداكنة التي لن يحيد عنها إلى النقاط المضيئة والألوان الفاتحة والمرحة إلا فيما ندر. القصص كأنها كلها تدور في عز الشتاء، بين الريح والمطر والنوّات، في أجواء من الموت والاحتضار والعجز والمرض، الشخصيات سواءً كانت ذات سمت واقعي ويومي أو أسطوري ومفارق، تنوء على الدوام تحت ثقلٍ خفي أو تحمل ذنبها ساعية للتكفير وللخلاص، وهناك قصتان من قصص المجموعة، تحملان هذا العنوان نفسه: خَلاص.
لم أستطع أن أجد مُبرراً واضحاً وراء تقسيم المجموعة إلى قسمين متساويين، يحتوي كلٌ منهما على ثماني قصص، يفصل بينهما نص من فقرات مرقمة أقرب إلى الشعر الرومانسي المنثور، ولم يساعدني في هذا عنوان كل قسم، على التوالي: وجد، غبش. ذلك أن أحوال عدم وضوح الرؤية والهرب والمشاعر الحسية المكبوتة، إلى آخر الموتيفات الأساسية في الكتاب، موجودة بهذا القدر أو ذاك في كلا القسمين، دون تغيّير بارز في التقنيات والأسلوب.
لولا اختلاط الفصحى بالعامية في بعض جمل الحوار دون داعٍ، وكذلك الإفراط في درجة الغموض حتى الاستغلاق التام أحياناً، والميل لاستعمال ضمير المخاطب (أنتَ) في غير موضعه المناسب أحياناً أخرى، لكنّا أمام مجموعة قصص لا تشبها شائبة، حتى مع إقرارنا أن القاص مازال يتلمّس السبيل نحو طريقته الخاصة، ومع كل قصة يدق باباً جديداً من حيث العالم والأسلوب لعلّ وعسى. ومع هذا فقد استطاع أن يوحّد أجواء قصص كتابه بحيث تتراسل فيما بينها بما يشبه تيار الطاقة الكهربية نشعر به يسري في الجو خلال نوّة عاصفة في ليل الإسكندرية.