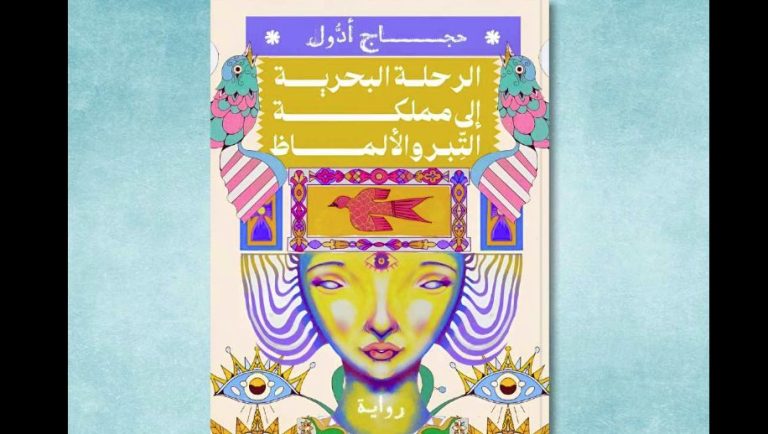ولسبب أجهله استقرت عيناي على العمارة المقابلة، وقد ألفاها سكان المنطقة مهجورة، لا يكاد يذكر الواحد منهم يوماً رأى فيه سكاناً لها، إلا ما يتردّد على لسان بعض الصبية عن سكانها من الجن .
لا أعلم سبباً لتأمّل هذا الكهف المظلم ، البعيد كل البعد عن الحياة التي أبحث عنها بين الشرفات، لكن شيئاً ما استوقفني بشرفة الطابق العاشر، أي الشرفة المقابلة لشرفتي، فقد أبصرت شبحاً يتحرّك، خمّنت أنه قد يكون حيواناً تعساً، كلباً كان أو قطًا ، دفعه حظه البائس إلى التسلل إلى هذه المقبرة، أملاً في العثور على ما يسدّ الرمق أو يُذهب الظمأ، لكنه فوجئ بنفسه سجيناً لخرابها .
هممت بتركه لمصيره وأشحت ببصري بعيداً عنه، لكن مشهد صعوده السور استوقفني، لم يكن حيواناً بل هو إنسان، إنسان تنتصب قامته فوق سور الشرفة!
صحت تجاهه محاولاً جذب إنتباهه ، لعلي أنجح في إثنائه عما ينتوي فعله، وظننت أني قد نجحت في مهمتي حين رفع رأسه نحوي ، لكنه قفز .
تصلب جسدي من هول المفاجأة، وحين استعدت السيطرة عليه نظرت إلى الشارع فلم أجد جثة، وأبصرت حركة المارة طبيعية لم يعتورها خلل !
كنت واثقاً من حقيقة ما رأيت، وقد تيقّنت من ذلك حين رفعت بصري فجاءني الصوت من خلفي .
– لم كنت تحاول إثنائي عن الانتحار؟
ارتعدت مفاصلي ، وتهدّجت أنفاسي ، وقد استبد بي الرعب حتى ظننت أن جسدي قد استحال تمثالاً من الفولاذ .
كان صوتاً نسائياً شاباً ، رقيقاً ، وإن كان ذلك لا يخفف من أثره في نفسي . أغمضت عينيّ لدقيقة واستدرت ببطء ، ثم فتحتهما فأبصرتها واقفة في مواجهتي . منعني الرعب من الصراخ ، فانشغلت بتأمّلها . كانت شابة في أواخر العقد الثالث من عمرها، هكذا ظننت ، شعرها الأسود معقوص خلف رأسها ، عيناها السوداوتان حزينتان ، خاتمها في يدها اليسرى يقول لك ” متزوجة “، ونظرتها تقول لك ” لست سعيدة ” ، وكيف لا وقد انتحرت يا غبي !
كرّرت سؤالها . .
– لم حاولت إثنائي عن القفز؟ وأشارت بيدها باتجاه العمارة المهجورة .
حاولت استجماع شتات نفسي، وقلت . .
– فعلت ما ارتأيته صواباً .
فقالت ساخرة . .
– الصواب إذن من وجهة نظرك هو أن تواصل الحياة ؟ قل لي سبباً واحداً يدفعك إلى الإستمرار في حياتك !
فكّرت في زوجتي التي انتقلت الى جوار ربّها منذ سنوات طويلة ، ثم فكّرت في أولادي الذين هجروني ، بل هجروا الوطن كله . ثم رددت إليها سؤالها معكوساً . .
– بل قولي لي أنت سبباً واحداً يدفعك إلى الإنتحار .
قهقهت ساخرة، ثم تهاوت فوق مقعد قريب منها ، وأخرجت من جيبها علبة سجائر أشارت بها نحوي فاعتذرت، فالتقطت منها واحدة وضعتها في فمها وأخرجت قداحة أشعلت بها سيجارتها، ونفثت دخانها، وصمتت مكتفية بمراقبة سحب الدخان .
وأخيرا تكلّمت . .
– حسناً . . كنت طالبة في كلية الآداب ، في العام الرابع على وجه التحديد ، حين رأيته للمرة الأولى ، كان معيداً بالكلية ، عُيّن مؤخراً بعد أن أنهى فترة تجنيده . كان حضوره القوي يجذب إليه الطلاب من كل حدب وصوب ، بالأخص الطالبات (غمزت بعينها) كنّ مغرمات به، لكن واحدة منهن لم تحببه كما أحببته أنا .
أحببت الذكاء الذي يشع من حدقتيه حين يتحدث ، أحببت ابتسامته الصافية حين يستمع، أحببت الحماسة التي يُلقي بها أشعاره ، ألم أقل لك أنه يكتب الشعر ؟ آه .. لقد أحببت أشعاره .
ثم تخرّجنا من الكلية ، وانصرفت كل واحدة الى حياتها ، باستثنائي أنا . فقد كانت حياتي معلّقة بكلمة تخرج من بين شفتيه فتسكن قلبي ، لكني لم أملك الشجاعة الكافية لمصارحته بمشاعري ، فقد تربّينا على أن الولد هو من يُبادر ، فأما إن بادرت البنت فتلك جرأة غير محمودة ، فانتظرت، وطال إنتظاري .
ثم فاجأني العريس الأول ، فرفضته بحجّة رغبتي في استكمال دراستي ، ووافق أهلي على مضض، وقدّمت أوراقي للالتحاق بدبلومة الدراسات العليا، شئ ما في نظرته كان يدفعني إلى الانتظار، لكنه لم يقل شيئاً، ولو قالها لانتظرت .
ومرّت الأيام والشهور ثم الأعوام، لا أنا نلت الماجستير، ولا هو تكلّم .
ونفدت حججي أمام العريس المتفاهم، الذي قبل أن يؤجّل زواجنا حتى أحقق ما أريده لنفسي ، لكني كنت قد فقدت الأمل في تحقيقه ، وكرهت الانتظار فتزوّجنا .
لكني لم أكن مدركة لتبعات قراري هذا، فقد تناسيت أني وإن منحت جسدي لرجل آخر فإن روحي معلّقة بمن أحببت، وارتباطي بآخر لن يطرده من قلبي .
بت أستحضر صورته أثناء لقائي مع زوجي في الفراش، وأحس بقبح خيانتي لزوجي الذي لم يسئ لي قط .
ثم زارتني صديقة لي من أيّام الجامعة ، وضبطت نفسي أستدرجها للحديث عنه ، ولم تكن تعرف الكثير ، لكنها كشفت لي الكثير .
شاهده عدد من صديقاتنا شائخ الوجه، رثّ الثياب في فترة قدّرتها فكانت عقب زواجي مباشرة، قبل أن يتركَ العمل بالجامعة وتختفي أخباره .
لقد أحبّني مثلما أحببته .. هل تصدّق ذلك؟ وربّما أكثر، من يعلم !
لكنه لم يستطع مصارحتي لظروفه المادية السيئة ، ولم أستطع أنا الانتظار تحت وطأة ضغط الثلاثين ، وشبح العانس .
أطفأت سيجارتها ثم استطردت . .
– قل لي إذن سبباً يجعلك تصرّ على مواصلة الحياة ، مادمت لن تحياها برفقة من أحببت؟
* * * * *
حين انتهت من سرد قصتها ، لم أجد ما أعلّق به عليها ، كما أني لم أرد دفع نفسي إلى التفكير في جواب لسؤالها ، فالتفت نحو الشرفة ، وشردت ببصري نحو البناية المهجورة، أحاول أن أرى شرفاتها بالكيفية ذاتها التي رأيت بها شرفات البنايات الأخرى ، لعلي أعثر فيها على أثر للحياة، وقد كان، حين لمحت في الطابق التاسع شبحاً آخر ينتصب بقامته أعلى الشرفة استعداداً للقفز، فصرخت في هلع وأنا أشير بيدي نحوه محاولاً جذب إنتباهها ، لكني حين استدرت إليها لم أجدها في مكانها، رغم أن الهواء مايزال مشبّعاً بدخان سيجارتها!
تركت مسألة إختفائها جانباً ، وركزّت إنتباهي على إثناء الواقف بالشرفة عن القفز ، ولما انتبه إليّ رفع إليّ بصرَه . ورغم بعد المسافة والظلام الذي يكتنف البناية ، إلا أني أكاد أزعم أن تعبير الدهشة كان مسيطراً على ملامح وجهه ، لكنه على أي حال قفز .
لما نظرت الى أسفل لم أجد جثته ، ولم ألحظ تأثراً في حركة الشارع ، فتوقّعت أن أجده خلفي ، ولا أزعم أني لم أُفاجأ بذلك ، أو أني انتصرت على الخوف هذه المرة .
– لم حاولت إثنائي عن الإنتحار ؟
الغريب أن الصوت كان نسائياً شاباً ، حتى ظننت أنها الفتاة ذاتها قد عاودت إلقاء نفسها . لكني حين إلتفت إليها طالعني وجهها الحزين . كانت شقراء ، بعينين زرقاوين ، وشفتين مكتنزتين ، جميلة في العشرين من عمرها إن لم أخطئ التقدير .
– ما حكايتك ؟
إندهشت قليلاً وقالت . .
– رغم أنك لم تجبني عن سؤالي ، لكن لا بأس ، فقد كنت بحاجة إلى مستمع .
جلست على المقعد ذاته الذي جلست عليه الفتاة التي سبقتها ، ثم تنهّدت بصوت مسموع وقالت . .
– كنت شابة جميلة تحلّق كفراشة بين أسوار الجامعة . لا تلتفت إلى الشباب الذين يحاولون استمالتها، وتتصنّع جهلها بالبريق الذي يضئ عيون أساتذتها حين يرونها ، فقد علّمتني أمي أن عود الثقاب لا يشتعل إلا مرة واحدة ، فقررت إدخارها للعريس المنتظر .
كنت أفاضل بين هذا وذاك ، وأعقد المقارنات بين كل من طرقوا باب شقتنا التي أعيش فيها مع والدتي منذ توفي والدي .
كانت أمي تحدّثني عن ضرورة ستر البنت ، وعن حاجتنا الماسة – نحن الولايا – إلى رجل . لكني كنت أتأنّى في إتخاذ قراري ، فأنا لن أتزوج إلا مرة واحدة .
لكن الإنتظار لم يطل على كل حال ، فقد جاء يخطبني ضابط في الجيش ، برتبة نقيب . كان وسيماً وبخاصة حين يتأنّق في زيّه العسكري . لم أجد صعوبة في الموافقة ، فقد كانت أحواله المادية على أفضل ما يكون ، وسيم ، ذو سلطة ونفوذ ، وهو أكثر مما أتمنى .
فرحت به أمي ، واحتفت به كواحد من أبنائها ، ثم تمادت حتى قدّسته ككاهن ، ثم عبدته كإله ، وصارت في حضوره تردّد : آمين .
حتى عندما فرض عليّ الحجاب ، فالحلوى المكشوفة تجذب إليها الذباب . وحين منعني من الخروج ، وقرن في بيوتكن . وحين أجبرني على ترك الدراسة ، وما حاجتك إلى التعليم !
حاصرني بالأوامر والنواهي ، ونحن لم نتزوج بعد ! ضقت ذرعاً بسيطرته وتسلّطه ، فصارحته برغبتي في الإنفصال ، فحدّثني عن فشل محاولته في هدايتي وإصلاح تربيتي المعوجّة ، ثم إنصرف .
لم تغفر لي أمي خطيئتي ، وراقبتني بغيظ وأنا أعود إلى الجامعة ، ثم وأنا أخلع الحجاب .
حتى جاء يوم أسود ، كنت في طريق العودة إلى البيت عقب إنتهاء يوم طويل بالجامعة ، فإذا بشاب يدفعني بمطواة في جنبي إلى ركوب التاكسي الواقف إلى جوار الرصيف ، فخضعت له خوفاً ، وقد كان حريّاً بي أن أتحلّى بشجاعة المقاومة ، لكني ضبطت نفسي خائفة مرتعبة ، يهتز جسدي بعنف من فرط الخوف .
حملنا التاكسي إلى منطقة مهجورة ، وأجبرني أحدهما على خلع ملابسي ، فلمّا تخشّب جسدي بلا حراك دفعني فسقطت أرضاً ، ثم انحنى الآخر فوقي ينزع عني ملابسي ، وأنا في حالة من الإعياء لا تسمح لي حتى بإدراك ما يحدث من حولي ، فقد كنت شبه فاقدة للوعي رغم أن عينيّ بقيتا مفتوحتين !
لم أنتبه إلا على صيحة أحدهما . .
– بنت بنوت !
فردّ الآخر وهو ينظر إلى الدم بين فخذي . .
– لم تعد كذلك .
فصاح الأول . .
– لقد خدعتني !
فدفعه الثاني بيده جانباً حتى يتسنّى له قضاء وطره ، بعيداً عن مناقشات زميله التي ستفسد عليه ااإستمتاع بصيده .
لكن الأول ضربه بعصاً غليظة على مؤخرة رأسه ، ثم حملني إلى التاكسي ، ولم أسترد وعيي إلا في المستشفى ، يطالعني وجه أمي المنكسر ، وقد شاخت فجأة .
حين غادرت المستشفى توقعت منها أن تحمّلني مسئولية ما لحق بي ، بل بنا وبسمعتنا ، لكنها ماتت، وتركتني الى نفسي .. ألومها أم ألوم خاطبي أم ألوم المجرمين ، أم ألومك أنت ؟
قل لي إذن سبباً يجعلك تصرّ على مواصلة الحياة مادمت لن تحياها حراً ؟
وصمتت ، فصمت .
* * * * *
أقسمت على أن أوقف نزيف المنتحرين ، فما إن رأيت شبحاً جديداً يتمايل في شرفة الطابق الحادي عشر حتى انطلقت عدواً إلى باب الشقة ثم توقفت أمام المصعد أضغط بحنق على زر استدعائه ، فلما طال انتظاري ، حسمت قراري فانطلقت أعدو هابطاً عبر الدرج ، وقد كان جديراً بي أن أتأنى في اتخاذ قرار مماثل ، بالنظر إلى شيخوختي وحالتي الصحية ، لكن الأمر لم يكن يحتمل مزيداً من إهدار الوقت ، وإهدار الفرص .
حين بلغت الطابق الأرضي ، هبّ حارس العقار واقفاً وقد بان على وجهه الفزع ما إن رآني ألهث ، حاول الإطمئنان على صحتي وسؤالي عما دعاني إلى نزول عشر طوابق عدواً عبر الدرج ، لكن الوقت كان يداهمني فلم ألتفت إليه ، وأكملت عدوي نحو البناية المهجورة ، لكني حين بلغتها وقفت أمامها متردداً ، أفكّر في مدى بلاهة تصرّفي ، وما إذا كنت بحاجة لإستشارة طبيب نفسي ، لعلي كنت أتوهم كل ما جرى ، وإلا فلمَ لم يلاحظ أحد من العالمين إنتحار الفتاتين سواي !
لكني توصّلت إلى عقد إتفاق مع عقلي ، يسمح لي بمقتضاه أن أكمل جنوني حتى نهايته ، على أن أخضع إليه بعدها ، ثم خطوت الخطوة الأولى نحو مدخل البناية .
ما إن خطوت الخطوة الأولى حتى لمست تبدل الأشياء ، فكانت الحياة تدب في كل ما حولي بصورة تدريجية ، فتستعيد الأرضية السيراميك ألوانها المنسية ، وتستعيد الواجهات الرخامية بريقها ، وتتلألأ النجفة المعلقة في سقف بهو المدخل ، حتى المصعد دبت فيه الحياة ما إن مررت بجواره متخذاً طريقي نحو الدرج .
احترت في مسألة الصعود هذه بين الخوف من إستخدام مصعد الأشباح هذا ، وبين الصعود عبر الدرج ، فقدّرت أني هالك في كلتا الحالتين فاخترت أيسرهما ؛ المصعد .
في الطابق الرابع فاجأني المصعد بتوقفه ، وكاد قلبي أن يتوقّف معه ، حين فُتح الباب عن إمرأة في الخمسين من عمرها ، نظرت نحوي بابتسامة ودودة وهي تقول . .
– مساء الخير .
ثم تركتني في حيرتي في الطابق التاسع ، حين غادرت المصعد وكأن الحياة هنا كالحياة ، لكني لا أحسبها كذلك .
وأخيراً توقّف المصعد في الطابق الحادي عشر ، فغادرته متروياً في خطواتي ، تحسباً لأية مفاجأة ، فإذا بي بين شقتين ، واحدة عن يميني والأخرى عن يساري ، حسبت موقع البناية وخمّنت أيهما تطل على البناية التي أسكنها فكانت اليسرى .
وجدت بابها مواربا فدفعته ببطء فتسلل إلي صوت أسمهان : ” يا طيور ، غني حبي وانشدي وجدي وآمالي ، للي جنبي ، واللي شايف ما جرى لي ” .
دفعت الباب ودخلت الشقة ، فرأيت فتاةً شابة جميلة ترتدي فستاناً أنيقاً ، بديع الألوان ، والقسمات ، تتراقص على إيقاع الأغنية في رشاقة ساحرة ، تضفي على الجو رونقاً ملائكياً ، لا يتناسب مع الظلمة التي غرقت فيها البناية .
لقد أخطأت في تقدير الشقة إذن ، حتماً أخطأت ، ربما كانت الشقة اليمنى هي المقصودة ، وربّما الأمر كله خطأ ، مجرّد خيالات رجل مريض ، يعاني من الوحدة ، لكن ما أنا واثق منه تمام الثقة أن هذه الفتاة الساحرة ، التي تكاد تحلّق من فرط خفّتها ، لا يمكن أن تكون بصدد الإنتحار ، أو حتى راودتها الفكرة في يوم من الأيام .
كنت لأنصرف لولا أنّي رأيتها تُحرّك ذراعيها ، كمن توشك على التحليق ، وهي تتجه نحو الشرفة ، فصرخت فيها فزعاً . .
– إنتظري .
فالتفتت نحوي ، وركضت حتى صرت في مواجهتها ، وصوت أسمهان بيننا : ” والزهور فاحت بعطر الأماني ” .
– أعلم ما أنت بصدده الآن ، وأياً تكن دوافعك ، فإن الإنتحار ليس حلاً !
ضيّقت حدقتيها محاولة تخمين هويّتي ، ثم اتسعت عيناها فجأة وهي تصيح . .
– آه ، إنه أنت .
ثم استطردت ساخرة . .
– أنت من كنت تصيح في البناية المواجهة ، وتلوّح بذراعيك كالغريق .
ثم ضحكت ، وقالت . .
– إذن فقد حضرت لإثنائي عن قرار الإنتحار ..؟
ثم جادة . .
– لماذا ؟ قل لي سبباً واحداً يدفعك لمواصلة الحياة .
لكنها لم تمهلني الفرصة للإجابة ، إذ استطردت . .
– أتعلم ؟ لا تهمّني أسبابك . تكفيني أسبابي للإنتحار .
والتفتت صوب الشرفة . فصحت . .
– حسناً ، قولي لي أسبابك .
لم أرد من ذلك سوى المماطلة ريثما أفكّر في طريقة أتّقي بها شر الكارثة ، وربما عثرت على الحل في حديثها .
لكنها قالت ببرود . .
– ولم قد أفعل ؟
فاحترت في سؤالها لكنني قلت يائساً . .
– فلتكن تلك رسالتك إلى العالم .
صمتت لبرهة متفكّرة ثم قالت وعلى شفتيها إبتسامة عابثة . .
– يبدو لي أمراً يستحق إضاعة الوقت .
ثم ضحكت فجأة وأغرقت في الضحك ، ثم توقفت فجأة أيضاً ، وأجهشت بالبكاء ، وأنا بين هذا وذاك واقف كما التمثال ، لا أحرّك ساكناً .
جفّفت دموعها ، وأشعلت سيجارة ، ثم قالت مختنقة بدموعها . .
– لقد كذبوا علينا .
ارتمت بجسدها إلى جوار الأريكة واستطردت . .
– حدّثونا عن محمد علي ، وصمتوا عن خرفه .
حدّثونا عن عبد الناصر ، وصمتوا عن بطشه .
حدّثونا عن حرب أكتوبر ، وصمتوا عن إنتفاضة الغلاء .
حدّثونا عن ميلاد الرئيس وقداسة الرئيس ، حتى أن عمر الرئيس ظلّ ثابتاً طوال المرحلة الابتدائية!
حدّثونا عن واجب التصويت ، وصمتوا عن التزوير .
حدّثونا عن الدين ، وقالوا لنا : الدين لله ، والوطن للجميع . لكن الحقيقة أن دين الدولة : الإسلام ، والوطن للرئيس .
صمتوا عن أفكار نيتشة ، وروح بوذا ، وحلم أتاتورك .
لقد كذبوا يا أستاذ ، لقد كذبوا .
أجل يا حضرة الناظر ، لقد كذبنا ، كانت مناهج نقرأها ، وتعليمات ننفذها ، لقد كذبنا يا حضرة الناظر .
– قل لي إذن سبباً واحداً يدفعك للإستمرار في الحياة مادمت لن تعرف الحقيقة ؟
لم تنتظر جوابي ، فقد نهضت من تلقاء نفسها ، واتجهت صوب الشرفة ، ثم التفتت نحوي فلمحت دمعة تحدّرت على وجنتي ، فقالت . .
– أما عن رسالتي للعالم ، فقل لهم : ما عاد ينفعكم الكذب .
ثم همّت بصعود السور فاستوقفتها . .
– انتظري .
فالتفتت .
– أين كنتم طوال هذا الوقت ؟
اندهشت لكنها قالت بعفوية . .
– لقد كنّا هنا طوال الوقت ، كيف لم ترنا ؟
فخاطبتها مستجدياً . .
– أما من فرصة ثانية ، أصلح بها خطئي ؟
فأجابت بحسم . .
– لقد تأخّرت .
ثم قفزت ، ودوى في الأفق صوت ارتطامها ، فنظرت إلى أسفل، فأبصرت الشارع مضطرباً، والجثّة محاطة بالمارة المندهشين، يقلّب الواحد منهم بصره في كل الجهات ، باحثاً عن النقطة التي سقطت منها . لكنهم – أبداً – لا ينظرون صوب البناية ، التي اعتادوا رؤيتها مهجورة !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد الحمراوي
قاص وروائي مصري
صدر له روايات: آخر أيام الماضي ـ متتالية أمل