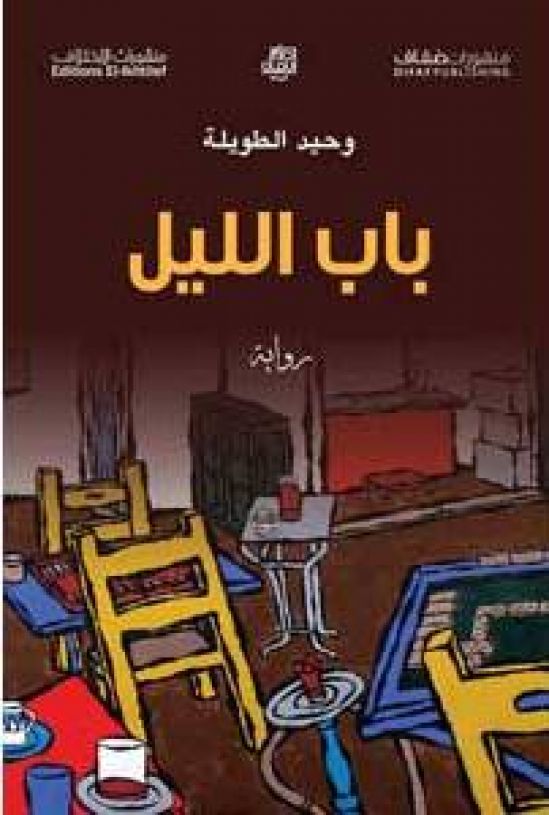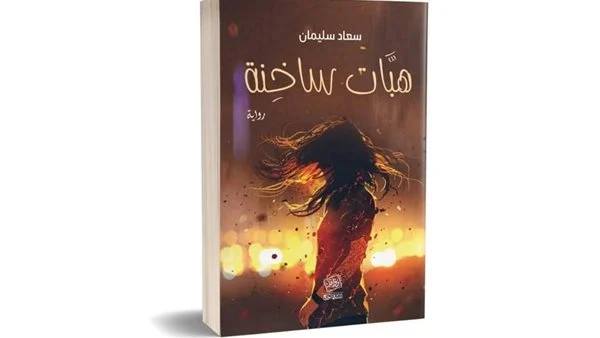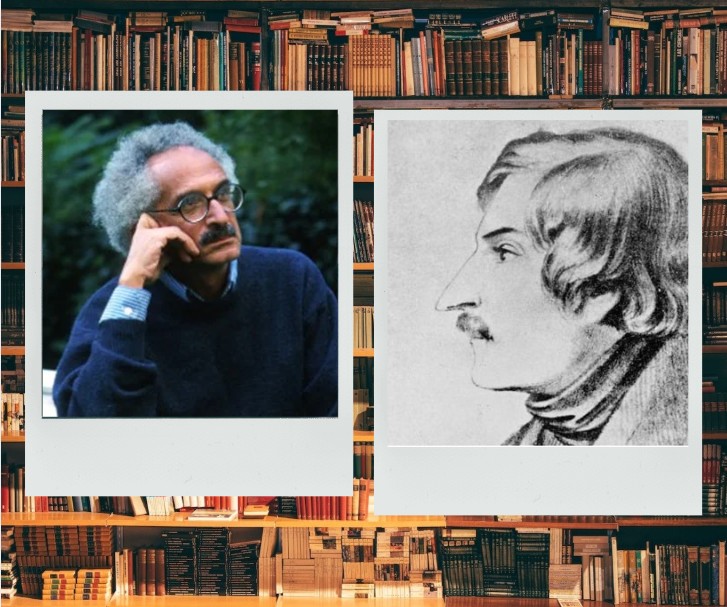طارق إمام
في مجموعة محمود خيرالله الأحدث، كل ما صنع الحداد، يهيمن الخصام كفضاء، كملاذ للذات. الخصام اختيار لابد منه إن أرادت القصيدة تأكيد موقعها من الوجود الذي يصنعها وتعيد هي تشكيله، في جدلية موارة، لا يسبق فيها أحدهما الآخر ولا يستبقه.
خصامٌ، يبدأ من لغة شعرية تنحاز لذلك الكيان المفتوح على احتمالات شتى، وهو قصيدة النثر. ليست قصيدة النثر شكلاً منبتاً، الموقف من القالب الشعري هو خصام أعمق للقالب الوجودي.. لذلك، فالقصيدة نفسها، “موضوع” في نص كل ما صنع الحداد.
الانحياز للنسبي، دون أن يعني النسبي تهميش السؤال الإنساني، النسبي في الحقيقة هو تكثير للاحتمالات، وبالتالي تكثير للأسئلة وطرق الصياغة، وليس أبداً تنحية لها. الالتفات للهامش ليس إنكاراً لوجود المتن، لكن طريقة لتقويضه. تؤكد القصائد على ذلك، لغة وفضاء، طارحة تساؤلها الخاص جداً، تعريفها الشعري، لقصيدتها نفسها.
…
القصيدة كذات شعرية
من الملفت أن أكثر من نص يتخذ من “القصيدة” كمفهوم، كتصور، ككائن، موضوعاً له. نص “عالق كقبلة” مثلاً، مكرس، عبر مقاطعه السبعة، لتملي أوجه القصيدة عبر الذات الشاعرة، التي تصحبها منذ الطفولة، وتكبر معها:” جاءتني مرة/ وأنا صغير/ كنت أمسك جلباب أمي/ وكان الناس كلهم/ في السوق/ خائفين/ إلا هذه السيدة/ التي أخرجت ثدييها للعالم/ لكي تقول لجارتها إنها بريئة/ كانا أبيضين تماماً/ وكتبت عليهما العروق الزرقاء/ أجمل القصائد”.
القصيدة امرأة عابرة في سوق، تأسيس لا ينبغي أن نغفله، عري أمام جميع المتشحين، وجرأة وسط خائفين.
العلاقة، التي تفجرت من تلك الصدمة، لن تكون أبداً متهادية، لكن فيها الشقاق، والشجار، والخصام:” صفعت القصيدة الباب وراءها/ وخرجت غاضبة/ لأنني لم أحسن استقبالها بالأمس”.
وفي نقض للتصور العام عن علاقة الذات بقصيدتها، تنزع الذات الشاعرة عن نفسها قناع تبني الشعر كمعادل دائم للوجود: ” أكتبها حين أفلس تماماً/ وحين لا يقبلني الناس في أي عمل/ وحتى وأنا أتذكر ذلك الرجل/ الذي مات منذ ثلاثة عشر عاماً/ دون أن يسلم علي/ ودون حتى أن يعرف/ كيف يكتبها”.
نحن أمام هدم لتصور فوقي يجعل من القصيدة بديلاً عن الوجود، و يرتقي بالشاعر ليصبح نبياً، رائياً، أو حتى قناعاً مفارقاً. إن هذا التفكيك يؤسس لتصور جمالي في الحقيقة، بقدر ماهو فكري، فاللغة الشعرية هنا، أزاحت حمولات بلاغية عديدة، باحثة عن جوهرها الشعري دون أن تفقد بعدها التداولي.
ليست القصيدة أيضاً ذلك الخطاب الموجه للجميع، على القصيدة، أن تختار متلقيها، وأن تستبعد من لا يليقون بها. إنه تصور آخر يجعل من اختيار “”المتلقي” حقاً أصيلاً للقصيدة، مثلما يحق له بالمقابل اختيار قصيدته ” يا من أخذتم كل الهواء/ وكل الزهور/ لأجل بلكوناتكم ومقابركم/ يا من تذكروننا دائماً بالسؤال:/ من أنتم؟ ومن أين/ لا تقرأوا هذه القصيدة/ فهي مكتوبة لغيركم/ لغيركم بكل تأكيد”.
اتساقاً مع ذلك التأسيس، تُسقِط الذات الشاعرة قناعاً آخر، هو الإيهام، بمنطق بريختي ربما، ما يجعل من عملية الكتابة عرضاً عارياً. نص ” مثل سيارة مستعملة”، على سبيل المثال، هو لعبة، فالقصيدة نفسها التي نقرأها هي مشهد للذات الشاعرة أثناء كتابة القصيدة. بهذا، تصبح القصيدة التي تحققت، التي نقرأها كخطاب جمالي تام، هي نفسها القصيدة التي لم تُكتب بعد:” العاشق الهش/ الذي لم يخسر شيئاً/ لأنه لم يكن لديه ما يخسره/ الضعيف إلى حد النكسة/ وإلى حد الجلوس طوال الليل/ هكذا/ لكي يكتب قصيدة عن نفسه”.
“أنسنة” القصيدة، طريقة أخرى لنزع القداسة عنها، لخمش ألوهيتها التي تجعل منها كائناً غير متجس ولإنزالها من عليائها المُصطنع: ” تدلت ضفيرتها/ صغيرة جداً/ وشاحبة/ وآخر ما تبقى لها من طفولة/ خسرتها لعبة/ لعبة/ وحين خرجت من العيادة/صفعت الباب وراءها/ كأنها تلومني”.
تتنقل الذات إلى ضمير المخاطب. إنه تحول لافت، لأن العلاقة، وإمعاناً في تأكيد الجدل، تتخذ شكل المواجهة: ” ليس ذنبي أنني صدقتك/ جين جئت إلي/ وحيدة وعارية/ وصدقت الموتى/ الذين يأتون دائماً معك/ كأنك ابنتهم جميعاً”. إنها علاقة رجل وامرأة هنا، غير أن حتى هذه العلاقة، ستصنع قانونها لتخرق القاعدة، ما نسميه “الإخلاص”.
القصيدة، قادرة على خيانة شاعرها، هذه المرأة، بالضرورة، تنام دائماً في سرير رجل آخر، ” تركت أصابعها في يدي/ ذات مرة/ وانصرفت متعجلة/ وحين أغلقتُ الباب غلى نفسي/ وجدتُ خاتماً من شاعر آخر/ في واحد من هذه الأصابع”. إنه، مجدداً، تصور يهدم النقاء المفتعل، ويؤكد على حقيقة هامة نسميها “التناص”.. الشعر فى جوهره اختلاط أنساب، ولا وجود لقصيدة من صلب شاعرها بالكامل.
…
مراوحات الذات
جدل فائر، بين توحد الذات وتبنيها لصوت جماعة، بين همسها وزعيقها، بين عبارة شعرية مقتصدة جافة بلاغياً، وأخرى منداحة متشبعة بالصور.. بين كل ذلك، تتخلق القصيدة.
الذات، في تراوحها بين الداخل والخارج، تغير من زاوية رؤيتها لتكشف في كل مرة تفصيلة من وجودها، ولا يكتمل المشهد إلا باكتمال القصائد. الذات الشاعرة تلتفت لنفسها، تحتل الصدارة، ليتحرك الخارج كله على خلفيتها، عبر صوتها المفرد، ثم تفعل عكس هذه التقنية بالضبط، فتصير صوتاً ينوب عن جماعة، صوتاً متعدياً، تتكشف ذاته على خلفية ما تنفتح عليه من ذوات أخرى، ذوات هي مرايا للذات في الواقع.
ينتظم هذا التراوح البنية الأشمل للمجموعة ـ عندما نقرأها كنص كبير ـ لنكتشف أن هذين المنحيين يتناوبان الحضور بالعدل. بين حضور الذات كوجود متجسد يتملى نفسه، وحضورها كصوت يتأمل عالمه، تتوزع القصائد.
…
تبدأ الذات الشاعرة النص بتأمل يدها، مناط الشر فيها، سوءتها الحقيقية.
لا تعري الذات جسدها، لا ترفع ورقة التوت عن عضوها الذكري، بل تعيد تعرية اليد ـ العضو العاري منذ نولد ـ مجازياً.
تنزع الذات الغطاء عن الكف التي تكتب، كأنها تقترف القصائد، اليد، المستقلة عن مشيئة الجسد، كأنه سلطتها التي يجب أن تحاربها.
اليد عورة الذات. اليد هي الفردية المنبتة عن قطيع أعضاء ملتصق بها، هي “يد تذهب إلى الموت بمفردها “.
اليد هي القطيعة مع النقاء الأول، ” ولدت مسالمة/ وبعد دورة أو دورتين/ لم تعد يداً بريئة”.
هكذا تطلق الذات الشاعرة تعريفها الشعري لنفسها، بمجاز يتكئ على عضو، “لا يتداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى”، يلخص وجود الذات كلها. تؤسس الذات عبر هذا النص الافتتاحي بالفعل، لوعيها بالوجود، لانقسامها على نفسها: ” أخفيها عن نفسي أحيانا/ كأنها جثة/ لم تعد خشنة/ ولم تعد قادرة على ارتكاب شئ”.
ذلك المنحى التأملي، هذه اللغة الشعرية المكتظة بالصور الصغيرة المتكثرة، خالقة صورة كبيرة، يشبه هدوءاً يسبق عاصفة. الخصام الذاتي، لن يلبث أن ينفتح، كموجة عاتية، على السياق، في النص التالي مباشرة، “كل ما صنع الحداد”، الأطول بين نصوص المجموعة، والمجزأ على عشر قصائد. إنه أيضاً النص الأكثر غضباً، والذي يحضر اسمه عنواناً للمجموعة، كأنه الأجدر بأن ينوب عن كل عناوين القصائد على الغلاف.
ليس من همس في هذا النص، ليس من مواربة في الطرح، ليس من التفاف حول المباشرة. في هذا النص، أنا تواجه أنتم، تقيم قطيعة، حد أنها تمنع هؤلاء حتى من قراءة قصيدتها. أنا، هي صوت جماعة لا صوت فرد، حيال جماعة أخرى، تملك كل شئ.
“يا من رأيتم العجوز ينزف/ فهربت سياراتكم بسرعة/ يا من بيننا وبينهم/ كل ما صنع الحداد”.
في هذا النص تصل اللغة الشعرية لأقصى درجات التخفف من كثافة المجاز، كما تتخذ أشد صورها تداولية كجسر بين الدوال وفضائها الدلالي غير الملتبس بحال، لذا، فأفق التأويل هنا يضيق لأقصى حد. وفي الحقيقة، لا يبدو لهذه القصيدة أنها تطمح في أكثر من ذلك، حتى إن أحد مقاطعها عنوانه: “بكل وضوح”. إنها قصيدة غاضبة، تُحوِّل حتى المجازات لتجليات للسلطة:” يا من تعيشون هنا/ لا تصدقوا السحاب الذي في السماء/ إنه فراء زوجة الرئيس/ …../ حتى الماء لا تصدقوه/ رغم أنه زحف أميالاً على بطنه/ ليدخل أبدانكم برأفة/ ليس إلا/ دموع الذين جاعوا/ لكي يتعطر أحفاد الرئيس”.
تعود الذات للداخل، في الحركة التالية، “مثل سيارة مستعملة”. تبدو أشد ضعفاً وتسليماً، خانتها أحلامها، واتخذت الحرب منحى جديداً، كأنها خرجت من القصيدة السابقة منهكة، طامعة في استراحة محارب:” تقوده أحلامه/ مثل سيارة مستعملة/ ويتجرع الحرب كل صباح/ على الشاشة/ كأنها واحدة من أفلام الكرتون”.
لكن الذات، في الحركة التالية، لن تلبث أن تعود صوتاً ينوب عن جماعة، لكن في صورة جديدة تماماً، بل وغير متوقعة. الذات كصوت للعائلة. في “عن عشرين إصبعاً ودمعتين” يتحقق مفهوم ندر اختباره في قصيدة النثر المصرية، هو التصالح مع العائلة، تلك الجماعة الصغيرة التي تتفق فيما هو أعمق حتى من الأفكار، المصير المشترك.
الذات الشاعرة تبدل من موقعها كصوت للجماعة، من الموقف الطبقي الواضح، لآصرة الدم. ” نعبر الشارع مسرعين/ نكون حبلاً مشدوداً بين شجرتين/ يرفع ملابس العائلة/ عن الأرض”.
إنه تحول ملفت، نحو همس شديد، لكنه أيضاً تحول في الخطاب الشعري، الذي يجعل من الذات ذاتاً غنائية، حد أنها تقترب، لأول مرة، من الروح السنتمنتالية: ” عن ابتسامات أربعة/ وخمسين ألف ضحكة/ عن الصغير/ يرفع يدين قصيرتين فجأة/ حين أضيع تماماً وراء البيوت/ عن دمعتين في عينيها/ تسقطان مباشرة/ في قلبي…”.
عندما تعود الذات الشاعرة لجماعتها الأوسع، بعد هذه القصيدة، سيظل هذا الأفق قائماً. لقد استبدلت الذاتُ بالغضب نوعاً من الشجن الشفيف، الأسى الإنساني، في قصيدة “عمل”. بدت لي هذه القصيدة ـ الثانية من نهاية المجموعة ـ وجهاً للقصيدة الثانية من بدايتها، “كل ما صنع الحداد”. فضلاً عن التكوين العام المتشابه للقصيدتين ـ عنوان كبير تنضوي تحته قصائد قصيرة ـ فحضور الذوات الهامشية يتحقق مجدداً، لكن الشعرية هذه المرة تنبع من منطقة مختلفة، من كشف إنساني، وجودي، أوسع من التصور الذي يوقف التعاطف على طبقة.
ثم تنتقل الذات، في حركة أخيرة، لتقف على مسافة قريبة من حيث بدأت. “أفضل ما يمكن أن يحدث لي”، الذات، كأنا، تحضر في العنوان، في القصيدة الأخيرة، مثلما حضرت في “يدي أسوأ مني”، أولى القصائد. إنهما وحدهما القصيدتان اللتان تطل الأنا من شرفتي عنوانيهما. المعركة الأخيرة للذات الشاعرة، مواجهة جيوش نمل، بغية إبادتها. يختفي الوجود الإنساني للذوات في هذا النص النهائي. الذات في قمة وحدتها، تتبنى لغة متقشفة جمالياً إلى أبعد حد، تحقق الشعر بشكل رئيسي من المفارقات المتوالية، ومن الصورة الشعرية الكلية التي يطرحها النص. لكن معركة الحاضر، العبثية، تستدعي كل خيبات الماضي، شخوصه التي أبيدت في القطارات المحترقة وتحت ثقل الصخور المتساقطة على بيوت صغيرة، كأن المعركة دائماً عبثية. الذات، عوضاً عن معاركها الكبيرة، توقف وجودها على معركة نهائية، عليها فيها أن تبيد قطيعاً جديداً من نوعه: ليس قطيع السادة أو أصحاب السلطة، لكنه قطيع نمل: ” هزمتُ جيوش النمل لكن في الجولة الأولى، عاد بعدها من حيث لا أحتسب، ساد وانتشر، وملأ المقاعد والسجاجيد، وصار النملُ معركتي الأخيرة”.
كأن الذات تُنهي نصها باحتمال من اثنين: البقاء أو الفناء، كأنها تعدُ بوجود جديد لن يتحقق إلا بتعميق معركة أخيرة.
اللغة
اللغة الشعرية في “كل ما صنع الحداد” تتأسس على التفات دقيق للمشهدية، تصنع توازناً رهيفاً بين منحى تشخيصي، يجعل من بعض الذوات شخوصاً تبطن حكاياتُها القصائد، ومنحى تجريدي، لازم للشعر، يلخص الذوات إلى دوال شعرية.
تخلق اللغة الشعرية مجازاتها من التشبيهات في الغالب، لذا فهي تبدو منحازة للخيال الذي يعمق المفارقة، وليس للتخييل الغامض الذي لا يحيل إلا لنفسه: ” تقوده أحلامه/ كأنه سيارة مستعملة”، “حاسبتها/ في أوقات كثيرة/ كأنها آخر المذنبين”، “وجدتها معلقة على كتفي/ كأنني اكتشفت سلاحاً في ذراعي”، ” المرأة التي تجعد في وجهها/ ثمانون عاماً/ كأن الموت يرسم لوحته الأخيرة في ملامحها/ وشمت الشقاء تحت ذقنها/ كأنها تبصق عليه”. الإحالات التي يمكن اجتزاؤها كثيرة وهي ماثلة بامتداد القصائد، وتكاد تكون تلك الآلية الرئيسية في خلق الفضاء الصُوَري للقصائد.
أيضاً، هناك استفادة محسوبة من أفق السرد المتاح للنص الشعري. بعض القصائد قد تنطلق من بنية سردية: ” ذات صباح/ اقتحم الشارع ثلاثة هياكل عظمية/ لشهيد/ وقتيل/ ولرجل مات من الجوع/ اقتحموا الشارع منتصبين وشجعاناً/ وسط صراخ الناس من الخوف/ من دون أن يفهموا/ لماذا انكسرت عظام الميت جوعاً/ مثل زجاج سفينة غارقة/ حينما بدأت الجماهير تهتف”. (مظاهرة). هنا، قصيدة تتبنى منطقاً سردياً واضحاً، تبدو أقرب لأمثولة، حكاية خيالية مؤدلجة أو تنطوي على موقف أخلاقي محدد، لكن الكثافة الشديدة تنقذ النص من الذوبان في السردية، لتبقيه كصورة شعرية.
أيضاً، من الملفت، أن تتحقق قصيدة بالكامل من منطق الحوار، وهي خصيصة سردية بامتياز: ” ـ لماذا لم تسقط الجدران فوق رؤوسهم؟/ ـ لأنهم سندوها برموشم.. يا سيدي./ ـ ولماذا لم تنفجر أنابيب الغاز في بيوتهم؟/ ـ لأنهم ملأوها بدموع أطفالهم.. يا سيدي…”.
الالتفات للسردي، يتحقق أيضاً على مستوى “شكلي”، في قصيدة مثل ” أفضل ما يمكن أن يحدث لي”، فالسطور غير مقطعة على فضاء الصفحة، بل متصلة، وليس اللجوء لهذه الطريقة محض تجريب شكلي، فالقصيدة، فى واقع الأمر، أقرب لسطر واحد طويل، استعان بالفواصل في أضيق حيز ممكن، تحققه على هذا النحو طباعياً، تأكيد على اتصاله، فضلاً عن انفتاحه على تقنية “الفلاش باك”، السردية بامتياز، بحيث يستدعي المشهد الآني نظيره المفارق زمنياً:”ذكرني النمل المتكور على نفسه ببشرٍ كثيرين تكوروا، هم أيضاً قبل أن يموتوا، وبأن أغلب من عرفتهم ماتوا بعدما تقوست ظهورهم”.
في “الجارية”، تحضر خصيصة سردية أخرى عميقة، هي الالتفات لتاريخ الشخصية. التصور التقليدي للشعر لا يحتفي بتعميق الشخصية، بل فقط باستحضار بعدها الرمزي. الجارية، ذات شعرية، لكن ملتبسة بحكايتها، واختبارها شعرياً هو محك صعب، لأنه يلتقط الشعري من أفقه السردي. ” بالأمس/ ماتت الجارية/ أم كل العبيد/ الذين تطوحوا في قطارات الضواحي/ المرأة التي أرضعت العالم/ حليب حزنها/ وحين ماتت/ مشت أصابع كفها معنا/ في الجنازة”.
في كل هذا الانفتاح على تقنيات السرد، تبدو القصيدة أمام رهان جديد خلقته لنفسها: نقض الأفق الذي اصطُلِح على “شعريته” حيال آفاق أخرى اصطُلِح على “سرديتها أو نثريتها”، لتصير المعركة الأخيرة حقاً، قدرة الشعر على أن يتحقق، حتى في الموت.