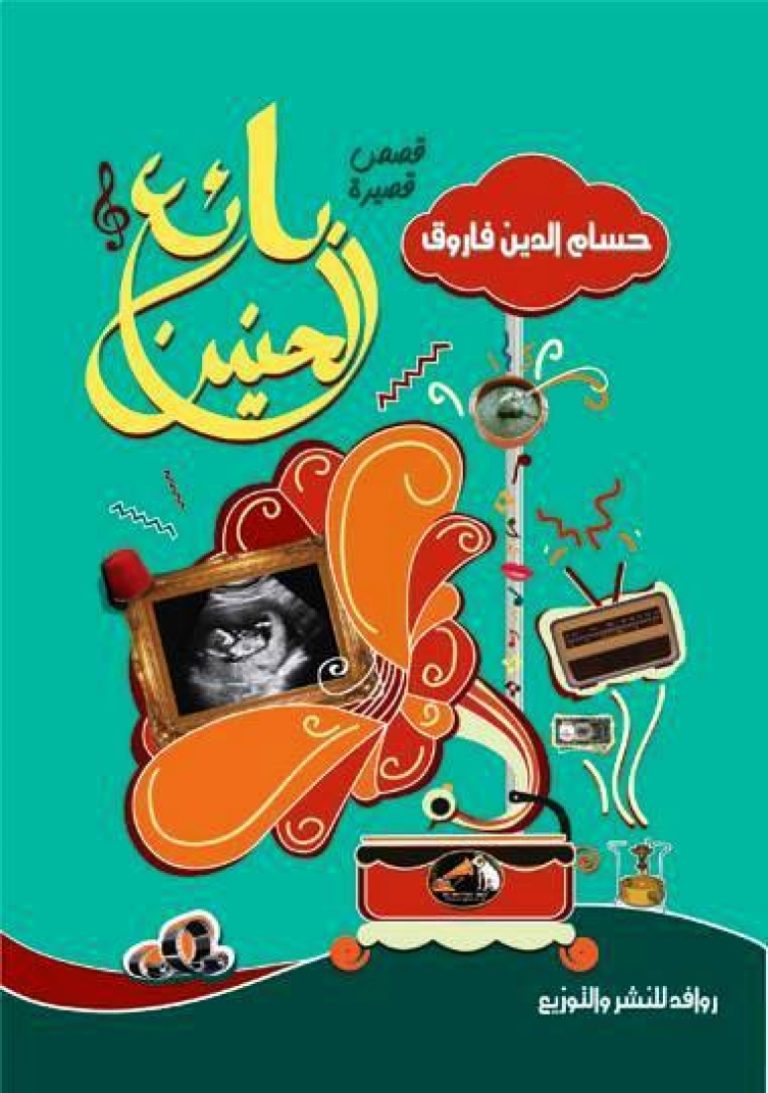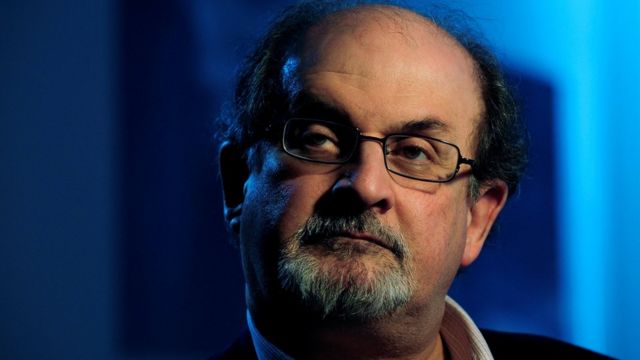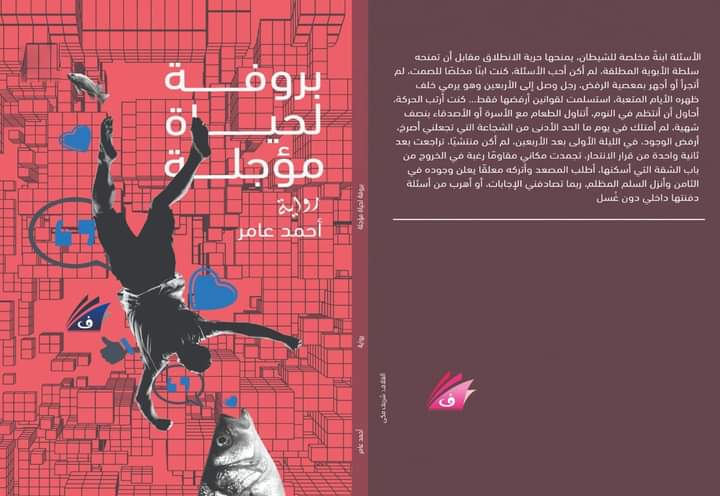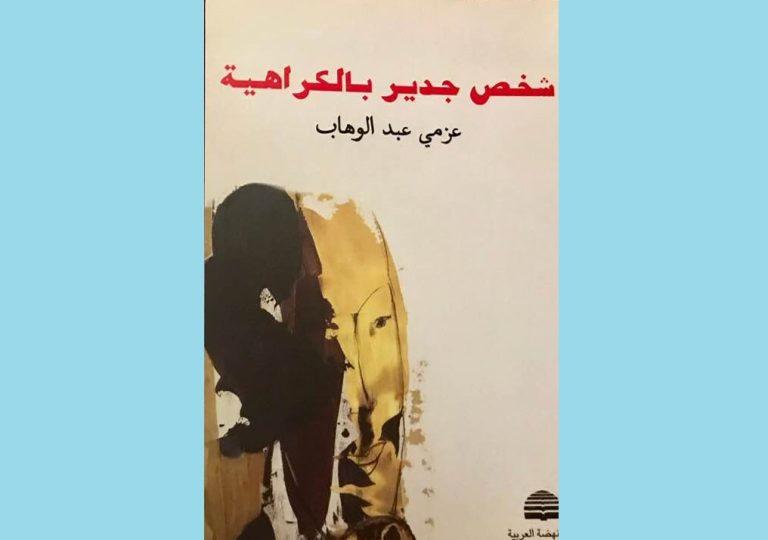أميرة مصطفى محمود
مَن منا لم يسمع باسم “فرانكشتاين” في صباه كتعريف لوحشٍ مخيف قاتل، بهيئة بشرية محرفة مشوهة لم تقصّر السينما في استغلالها كمادة رائعة لأفلام الرعب؟!
كانت هذي هي فكرتي الراسخة القديمة المقرونة بهذا الاسم، حتى صادفت كتابا يحمل الاسم نفسه. كنت أعلم سلفا بمحض الصدفة أن الوحش “فرانكشتاين” هو من صنع كاتبة روائية إنجليزية تدعى ماري شِلي. ولم أكن أعرف شيئا عن وحشها غير ذاك المقتبَس الذي شاهدته في أفلام السينما.. حتى قرأت نصها الأصلي.. والآن صار يحق لي القول، أن من لم يقرأ تلك الرواية لم يتعرف بعد بحق إلى هذا الاسم، حيث استطاعت الكاتبة، أن تسطر ببساطة شديدة، الأوجه الفلسفية العديدة الأزلية لمسألة شائكة!
صورت الكاتبة من خلال البطل المخترع فرانكنشتاين ومخلوقه الغريب الوحش، أن للجريمة وجوه أخرى عميقة داخل شخص الوحش وصانعه، سوف تفهم وتكتشف أنك قد تتعاطف مع وحش قاتل وقد تدين ضحيته. فليس الحكم الأعدل على الأمور بظاهرها. لن يمكنك غير أن تلتمس بعض العذر لذاك المخلوق على وحشيته. ذلك الذي اكتشف وجوده صدفه بلا مقدمات وبلا أصل ليتعرف إلى نفسه وإلى العالم بجهوده الفطرية وبغريزة الحياة والبقاء، بطريقة صورتها الكاتبة بمنتهى الدقة لتعكس الوجود الأول للبشر على الكوكب.
ذلك المسخ الذي تعلم أول ما تعلم: عن الطبيعة من حوله ومشاعر الحب والخير بفطرته، صار تدريجيا يتعرف إلى مصطلحات ومعاني الشر والعدوان والظلم من خلال ما سمعه بالصدفة وتعلمه من تاريخ البشر وأفعالهم البغيضةـ ثم جعل يكتشف قبح منظره وبشاعة صورته التي لا دخل له فيها وتدارك فيما بعد كيف أنها فرضت عليه المقت والوحدة والعزلة واللعنة والطرد الأبدي من الأنس البشري والرفقة والعطف الذي كان ينشده من البشريين بدافع من قلبه المفعم بالحب والخير والمساعدة. يظل هذا الكائن يتعذب كثيرا بلعنته التي حلت عليه بلا جريرة أو ذنب ارتكبه اللهم إلا محاولته الغريزية للتدثر بالعطف والألفة والصحبة بين رفقاء من البشر. يكتشف أنه منبوذ ملعون فيحزن ويغضب ويثور ويلعن صانعه الذي خلقه وتركه بوحشية بلا رحمة من دون أن يؤمّن له السعادة والرفقة على الأقل بمخلوقة كريهة من جنسه. ها هنا تشعر ببؤس هذا المسخ الذي حوله إلى وحش وتُقر بحقه في أن لا يكون وحيدا طريدا في العالم بلا رفيق وبلا مأوى عاطفي، وإنها في واقعها معاناة إنسانية قاسية ملحة يشق على النفس تحملها والله يعلم بحاجتنا إلى الونس والسكن والمودة وإلا لكان ترك آدم وحده بلا مخلوقة من ضلعه، وإن كنت أتساءل لتوي لماذا جعلها الله من ضلعه ولم تكن مستقلة في مادتها عنه؟! أأراد الله بهذا، تأكيد قوة الرابطة المنوطة بقلوب الزوجين كرابطة أصيلة جذرية عميقة للسكن والسكينة والألفة قبل أن تكون للتناسل أو لمجرد الصحبة العابرة المؤقتة!
بالفعل لم يفت الكاتبة أن تبرز تعاطف الصانع مع ذريعة صنعته، حتى أنه كان قد أوشك أن يذعن لمطلبه ويخلق له بدافع من الشفقة والخوف، المخلوقة التي تؤنسه لولا أنه نكص وعده ولم يفعل، رعبا مما قد يجرّه على البشرية من دمار جراء وجود وحشين بدلا من وحش واحد. لكنها بنفس الوقت لم تغفل إدانة هذا الكائن في جرائم ارتكبها بحق أناس أبرياء بدورهم ولم يقترف بعضهم أي ذنب سوى فزعهم وخوفهم الطبيعيين من بشاعة شكله وهروبهم الفطري منه ورفضهم الفوري المطلق للفرصة التي كان يحلم بها في القرب والمؤانسة والعطف، لتضعنا بذلك الكاتبة في دائرة فلسفية مفرغة من الحيرة والتأمل في جانب كل من المتهم الضحية. فترى الوحش يسأل سؤالا مثيرا للجدل والشفقة في آن إذ يستنكر كون صانعه ببساطة وأريحية ينفر منه بدل أن يعطف عليه ويتهمه ويدينه ككل البشر وبمثلهم يسعى إلى قتله.. في حين أنه لا أحد كان سيدين أولئك الذين نبذوه أو حتى إن كانوا قتلوه بفزعهم.
إنها فعلا مسألة شائكة وبالغة القسوة والواقعية: أن تجد عذرا وذنبا لكل من الجاني والمجني عليه في الآن نفسه مما يزيد الحكم صعوبة ومأساوية.
وإن كانت الرواية انتهت بكون الكائن أطلق العنان لوحشيته ونزعته الانتقامية حتى أنه بدم بارد قد أهلك صانعه.. إلا أنها صورت معاناته الفظيعة مع الندم واحتقاره لذاته عن جرائمه الوحشية التي اختتمها بهلاك فرانكنشتاين نفسه وقرر بعدها أن يضع حدا لحياته وبؤسه وجحيمه.
هي رواية لا يسعنا غير أن نندهش بقدرتها على تصوير كل تلك المشاعر المتضاربة والمواقف الصادقة المحيرة، بتلك البراعة والدقة وإن كان العدل يحتم علينا أن نمتن كثيرا لـ “هشام فهمي” لترجمته المتميزة، ذلك أن ثمة ترجمات عديدة يمكننا بوضوح أن نلحظ أنها لا تدر على نصها الأصلي غير النفور.