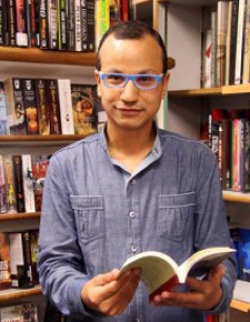لست محتاجا بالطبع للإشارة إلى أناقة لغة محمد المخزنجي، و حرصه الدائم على الاختيار الدقيق للمفردة، إلى جانب السلاسة العجيبة في بناء جملته، حتى تكاد تشي بموسيقى خفية. سوى أن لغة السرد في هذه التجربة اكتسبت خصوصية، ليست جديدة تماما على عالمه، بل شهدناها في مجموعته السابقة أوتار الماء، و في أغلب كتاباته غير القصصية. تنبع هذه الخصوصية أساسا من ثراء العالم الطبيعي الذي تتأمله و تتناوله. فأمام ثراء الوجود الفاحش بكل ما فيه من عناصر و مخلوقات، لا تمتلك اللغة إلا أن تستدعي بدورها جميع مقومات ثرائها الخاص، حتى توازي ذلك التنوع غير المحدود، في الأصوات و الألوان و الأشكال و الإيقاعات المختلفة لكل حياة أو بيئة أو حتى لكل كائن حي على حدة، مما يخلق دهشتنا بتلك اللغة التي تكشف عن كنوزها، بهدوء آسر، و دون ضجيج تجريبي أو استجلاب للغريب المهجور كذلك. فنحن أمام لغة سرد حريصة على صفائها و نصاعتها، حتى عند مقاربتها لحالات أقرب إلى الحلم و الفانتازيا، حالات تغري باللعب اللغوي و إفلات الزمام، كما هو الحال مثلا مع قصة ” الأتن ” ، فمع أن السرد يبدأ فيها من نقطة وادعة مطمئنة، تجري مجرى التفاصيل اليومية المعتادة ، غير أنها سرعان ما تتسلل إلى الواقع الحلمي المفارق، و ينتقل الزورق بالراوي من نهر النيل إلى نهر التيبر بروما لحظة احتراقها تحديدا…كل هذا، و اللغة حانية بالمتلقي كأم رءوم، تهدهده و تأخذ بيده من مستوى إلى آخر بيسر و هوادة، و كأنها لغة تتشبث بالحب، وحده، في مقاربتها للعالم، و في مخاطبتها لأذن و عين و وجدان قارئها.
غالبا ما تطول الجملة الواحدة، و تنقسم إلى عبارات عديدة، قصيرة نسبيا، مربوطة بالفصلات و الفصلات المنقوطة، بحيث لا نكاد نرى النقطة إلا عند نهاية كل فقرة تقريبا. و ما قد يبدو في هذا على أنه استطراد للوهلة الأولى، أراه حرصا على التحليل و الاستيضاح و إحاطة المشهد الفسيح الشاسع من كل جوانبه تقريبا، بقدر ما أمكنت اللغة و شروط التأليف في نهاية الأمر.
لكن ثمة معضلة أخرى لم تتمثل في جمال اللغة و أناقتها، بقدر ما تعلقت بالسرد، الذي كان عليه أن يوقف تتابعه أحيانا، من أجل إضاءة نقطة هنا و فض اشتباك هناك، حتى يتسنى للقارئ متابعة الحكاية، دون ارتباك و لو هين، أضف إلى التفسير هنا الضرورة الحيوية للوصف، شبه التفصيلي و الممتع جدا مع ذلك، الذي يهدد تدفق السرد، غير أن كاتبنا خرج من مطب كهذا بأكثر من سبيل، فأحيانا ما تأتي الإضاءة المعوقة للسرد بحالة مستقلة ، و إن لم تنفصل بالطبع عن بنية النص ككل، مثل الفقرة التي تبدأ بعبارة: ” الدببة تحب النساء! و كنت أحسب أنها تكتفي بحب العسل البري و تجن بالتهام الخصي،….” فبدون هذه الفقرة، لا تتضح الحكاية الأساسية، غير أنها تمثل، في حد ذاتها، قطعة سردية منمنمة من 13 سطرا و كلمة! يمكن فصلها، على سبيل اللعب أو التجريب، و التعامل معها كوحدة مستقلة، بديعة. أما عن الوصف فغالبا ما ورد متضمنا في حركة السرد نفسها، و إذ ينفصل عنها و يستقل في فقرة قد تمتد لعشرة سطور مثلا، فإنه يستعين بصيغ حيوية و أسلوب طائر خفيف، فيه لمسة من توتر و تشوف.
* جدل الغواية بين الإنسان و جاره الحيوان
على عكس ما يوحي به الكتاب من الخارج، و ربما ما أوحت به بعض الأخبار التي نشرت عنه، لن يعثر قارئه على كل تلك العجائب المذهلة و كأنها من عوالم أخرى ، على الأقل ليس هذا هو مربط الفرس، لكنه سيجد أمامه كذلك الهم الإنساني في لحظته الحاضرة ماثلا ، بل و ملء السمع و البصر، بمستوياته السياسية و الاجتماعية، إلخ. و منذ القصص الثلاث الأولى القصيرة للغاية و الموجعة للغاية ، عن حيوانات إحدى الدول، بعد الغزو الأمريكي لها، لعلها العراق أو أي دولة أخرى سابقة أو تالية، بالطبع يلوح الهم الإنساني دونما خطاب مباشر أو نواح وجداني مبتذل على ما صار إليه حال العالم الخرب. و إن اعترضت السرد أحيانا أسئلة لا تخصه من قبيل الرعب الذي يولده الإرهابيون في الهند و بالطبع في كل مكان من العالم، في قصة ” على ظهر فيل “، ذلك السؤال الذي يستشعر المرء أنه طال قليلا و أثقل سطور القصة. لكن المدهش حقا في قصص المجموعة هو طبيعة العلاقة الجدلية المطروحة بين الإنسان، الكائن الواعي و المفكر على هذا الكوكب، و بين الحيوانات، و تلون هذا الجدل بألوان عديدة، إذ يجد الحيوان نفسه في سياق مجنون و هدام، من صنع الإنسان، فيتم سحل الفرس الأم و مهرها الصغير في شوارع العاصمة بعد نزول المارينز بها، لمجرد أنها كانت ملكا للدكتاتور، و تحول الجنادب إلى لعبة مطلية بطبقة نحاسية لتنضم إلى السوق الهائل الذي يزيف أي شيء و كل شيء، و الجواميس التي تثور على النور الليلي الأحمق الرخيص الذي أفسد الحياة في قرية كاملة ، و تتحول البغال إلى مهربين للسلع المحرمة من دولة إلى دولة و لا ندري مع نهاية قصتها إذا ما كان العريف فرحان سوف يتمكن من إصدار الأمر إلى عساكر وحدته الحدودية بإطلاق النار عليها أم لا. يقع الإنسان حينا في غواية سمكة و كأنها فراشة من فراشات البحر، فيأخذ السباح الماهر و العريس الجديد بمطاردتها إلى أن تقوده إلى أبعد و أعمق مما يتصور. و حينا آخر تقع الدببة في فخ غرام الفتيات الجميلات، فيتم صيدها و نزع أنيابها و مخالبها لترقص للسياح من أجل اللقمة، لكن في القصة نفسها تنتقل الغواية إلى المرأة الشابة، الطعم، لينبت بداخلها شيء كالحب تجاه هذه المخلوقات في لحظة استعادتها للنداء الغريزي الأقدم من استقلال الإنسان بمملكته. و يصل تماهي أحد الشبان الأفارقة و ولعه بالأفيال حد التحول إلى واحد منها، في لحظة سحرية غامضة، تركها الكاتب بلطف و حرص معلقة قيد الاحتمال الذي يشفي على الاستحالة. و كيف يمكننا أن ننقل حالة اليأس الكامل إلى حيوانات برقة و نبل الخيول فتكتئب إلى حد الانتحار الفعلي، أو كيف يمكن لنا أن ننفخ فيها الأمل و نغمة التشبث بالحياة . نلمس في كل تلك الوجوه المختلفة طبيعة العلاقة بين ما هو إنساني و ما هو حيواني، هذا الجدل تحديدا، في ظني، أنه أهم و أبلغ مقاصد قصص الكتاب، و الحيوان هنا ليس مجرد مرآة صافية يرنو فيها الإنسان إلى صورته، بل أيضا لاعب مشارك و ناطق و فاعل إلى أبعد حد، و لكن ليس على النحو الذي يؤنسنه و يجعله ناطقا بالحكمة على طريقة كليلة و دمنة أو حتى جورج أورويل في مزرعة الحيوان، بل بما يحفظ له وجوده المستقل و حضوره الخاص و مداره المغاير.
رصع المخزنجي كتابه باقتباسات و أقوال تنتمي إلى التراث العربي القديم، للجاحظ و القزويني و غيرهما، كما تنتمي إلى المنجز الغربي الحديث في استقراء منطق الحيوان النفسي و الوجداني، و جاءت هذه الأقواس مثل دعوة للبحث و المشاركة و استثارة فضول القارئ، إلى جانب كونها مدخلا مشوقا للقصص، التي كانت في غنى تام عن أي مدخل، بالضبط مثلما هي في غنى عن أي تعليق شارح أو مادح، و هو الذنب الذي سعدت باقترافه.