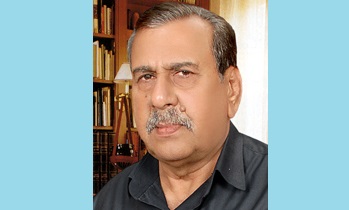عاطف محمد عبد المجيد
ما زلتُ أذكر، حتى اليوم، مُدَرِّسِي في الصف الأول الابتدائي بطوله الفارع وبمعطفه الأسود الشتوي.
كنت ومعي بقية التلاميذ نشعر نحوه بشعورٍ هو مزيج من الحب والخوف والاحترام.كنا ننظر إليه وكأنه كائن مختلف لا يشبه الآخرين، الذين كنا نقابلهم في الأماكن الأخرى.لقد كانت علاقتنا به علاقة أبوية وربما أكثر، غير أننا لم نكن نراه ولا يرانا سوى في قاعة الدرس، وسوف يكون غَدُ اليوم الذي يرانا فيه في الشارع، أسودَ علينا!
وعلى الرغم من هذا لم نَكُنْ نُكِنُّ له سوى كل احترام وتبجيل، لأننا فهمنا بفطرتنا البريئة، أنه لا يريد سوى مصلحتنا نحن، وأنه لا يُسْعدهُ إلا تفوقنا.أما اليوم فلم يعد هناك مَن يحترم المدرس أو يُقدِّره أو يخاف منه، إذْ فقدت صورة المدرس القديمة محتواها واُستُبْدلت مفرداتها بمفردات أخرى.
وبعد أن كان يُنادى المدرس بأفضل الألقاب، أصبح ثمة من ينادي مدرسه باسمه مُجردًا هكذا بلا لقب، هذا إن لم يقل له يا ” أسطى…أو يا مِعَلِّم..أو….!”. المدرس الذي كنا نتحاشى أن يرانا في الشارع بعد وقت المدرسة في ما مضى، بات اليوم مَن يراه في وسائل المواصلات من تلاميذه واقفًا فلا يقوم له لِيُجْلسه مكانه. حقًا ثمة فرق شاسع بين مدرس الأمس البعيد وبين مدرس اليوم: الأول كان يطل على تلامذته وطلابه بقامة سامقة تعتز بكرامتها وعزة نفسها، وتتحلى بأنفة لا يضارعه فيها سواه، تستند إلى تمكنه من مادته العلمية التي يمارس تدريسها متقنًا إياها عن طريق القراءة والاطلاع والتدريب لتحسين المستوى، مما يعود إيجابًا على تلامذته.
أما الثاني فقد ضحّى بكل غال ونفيس مقابل جنيهات معدودة يتقاضاها مقابل درس خصوصي.إنه اليوم يركض وراء النقود بعد أن تعطفت الدولة عليه وتبرعت له براتب هزيل يأخذ أضعافه عامل في هيئة النظافة والتجميل!
قبل اختراع المدارس كان المدرس/ المعلم يتخذ مكانًا ثابتًا ومعروفًا، يذهب إليه كل طالب علم.وقتها كان الطالب لا يستنكف أن يُقَبِّلَ يد معلمه، الذي لم يكن له من مأرب سوى أن يُعلِّم طلابه، تبجيلاً واحترامًا وتقديرًا لدوره ورسالته التي قد تصل، بشروط معينة، إلى مرتبة الأنبياء.غير أنه وبعد اكتشاف المدارس، أقصد بناءها، ومع مرور الأزمان، تغيرت نظرة المجتمع إلى المدرس، بعد أن تغير دور المدرس واختلفت طبيعته.الآن ليس ثمة فارق كبير بين بائعي اللبن وبين بعض المدرسين إذ أنهم يجوبون الشوارع، هؤلاء بوعاء اللبن وأولئك بحقائبهم المكتظة بالأوراق، شيتات ومذكرات، طارقين أبواب البيوت، التي منها ما يفتح ويشتري ومنها ما لا يُعيره قليلَ اهتمام!
بالطبع هناك ظروف حياتية واقتصادية أدت بالمدرس إلى أن يسلك هذا الطريق، وبهذا الصنيع تحوَّل المدرس من يدٍ فوقية وقامة كبيرة، لها وزنها وتقديرها، إلى يد سفلية، باتت تمتدُّ في انكسار إلى يد ولي الأمر وإلى يد الطالب أحيانًا آخذة منها أجر الدرس الخصوصي، ليس هذا وحسب، بل وصل الأمر إلى أن تساوى المدرس، في نظر ولي الأمر وكذلك الطالب، مع مهن أخرى فقدَ أصحابها من زمنٍ هيبتهم ومكانتهم بين الناس، بعد أن تحول إلى جابي نقود وفقط.
وبالتالي، وبدلًا من أن ينظر الطالب، صغيرًا أو كبيرًا إلى المدرس، النظرة التي يستحقها، متمثلًا قول أمير الشعراء أحمد شوقي: قم للمعلم وفه التبجيلا / كاد المعلم أن يكون رسولا، راح ينظر إليه وكأنه كهربائي أو سبَّاك، مع الاحترام لهما، جاء ليصلح مصباحًا أو صنبورًا تعطَّل عن العمل، ثم يتقاضى أجره ويغادر مع الدعاء بألا يُرى مرة أخرى!
من ثم أصبح المدرس شخصًا غير مرغوب فيه، يدعو الجميع بأن يباعد الله بينهم وبينه، كما باعد بين المشرق والمغرب!
لا يرغب الطالب، الذي فقد التعليم فائدته وجدواه في نظره، مما يراه أمامه من تجارب سابقيه في السلك التعليمي، في المدرس وكذلك ولي الأمر الذي يرى في المدرس صورة أخرى لمحصل الضرائب الذي يجيء ليقوم بتفريغ كل جيبوبه من محتواها، ويتركها خاوية على عروشها، فريسة للاقتراض من الغير، وللوقوع في الضوائق المالية.
وبدلًا من الدعاء بالخير الذي كان يناله المدرس في ما مضى من أزمان، من الآباء ومن الأمهات، لأنه تفانى في تعليم أبنائهم، وراعى خالقه وضميره اليقظ في تعليمهم، راح الآن يحصد آلاف الدعوات بكل سوء، إما لأنه لم يُراعِ ضميره في تعليم الأبناء، وإما لأنه استوحش واستوغل في الدروس الخصوصية، بإجباره للطلاب عليها ومغالاته في أسعارها، وإما لأنه ترك، أو لم يترك الطلاب ليغشوا في الامتحانات!
لقد تخلى كثيرون من مدرسي اليوم عن كرامتهم وكبريائهم وقيمتهم، رغمًا عنهم أحيانًا وبإرادتهم أحايين أخرى، في طريقهم إلى ميدان الدروس الخصوصية، وضحوا بالبحث وبالقراءة وتحسين المستوى تحت ذريعة أنْ ليس هناك وقت، إنهم محقون، فهم يستيقظون في السادسة صباحًا، وربما قبلها، ليذهبوا إلى مدرستهم التي يغادرونها بعد الظهيرة تقريبًا، بادئين رحلة تنقلهم في ما بين المنازل والبيوت موزعين موادهم على الطلاب وهم في منازلهم، مواصلين هذا العمل حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم التالي، إلى أن يعودوا نائمين إلى منازلهم، ويستيقظون وهو نائمون، ويذهبون إلى مدارسهم وهم نائمون، ويُدرّسون وهم نائمون. وهكذا تنقضي حصصهم الدراسية ما بين تثاؤب وفَرْكِ أعين..وهلمَّ جرَّا!
وبهذا، وبسبب لعنة الدروس الخصوصية التي أصابت المدرس، التي لم تكن موجودة في الأساس في قاموس مدرس الأمس، الذي كان يذهب إلى مدرسته صباحًا ليعود منها بعد الظهر، ليمكث بقية يومه في منزله بين كتبه مُطّلعًا وقارئًا لا في مادته هو فقط ولكن في شتى العلوم والمجالات، ليكون مدرسًا بحق، فقدَ مدرس اليوم كل شيء حتى بدا مستواه في مادته العلمية يضمحل عامًا بعد عام، بعد أن توقف تمامًا عن القراءة والاطلاع عن كل ما هو جديد في مجاله، منذ عام تخرجه تقريبًا.
لقد جنت الدروس الخصوصية على المدرس الذي كان قديمًا يرفع رأسه عاليًا، فقط لأنه معلم، وحوّلته إلى مدرس فقدَ عزة نفسه في تودده إلى الطالب وولي أمره بعد أن تنازل عن أشياء كثيرة لم يكن لمثله أن يتنازل عن بعضها، وكل هذا في صحة النقود!
لكن ماذا لو أعادت الدولة للمدرس هيبته قائلة له: ارفع راسك فوق أنت مدرس، مانحة إياه الراتب الذي يتناسب طرديًا ودوره في المجتمع، حتى يتفرغ كليةً لتدريس مادته، منفقًا وقته في البحث والدراسة والاطلاع وتحسين المستوى بمعرفة كل ما يجدّ في مجال تدريسه مما يعود بالنفع الوفير على المتعلمين، وفي الأخير يُخَرِّج المدرس طلابًا حقيقيين يكونون بناة المجتمع على أساس علمي سليم بدلًا من أن يُخرِّج طلابًا لا يفقهون أي شيء في أي شيء، بل يفشلون في كتابة أسمائهم بشكل صحيح؟!
وقبل أن أضع طبشوري أؤكد أنه ثمة عدد من مدرسي اليوم لا يختلفون قيد أنملة عن مدرسي الأمس، بكل ما لديهم من صفات نبيلة، غير أنهم لندرتهم تاهوا في الزحام.