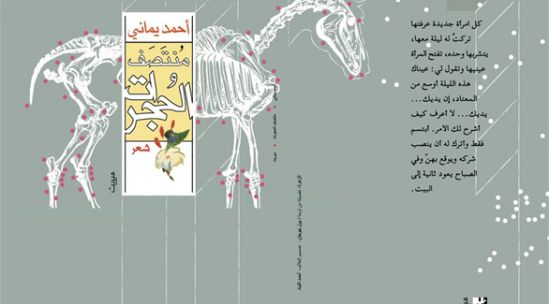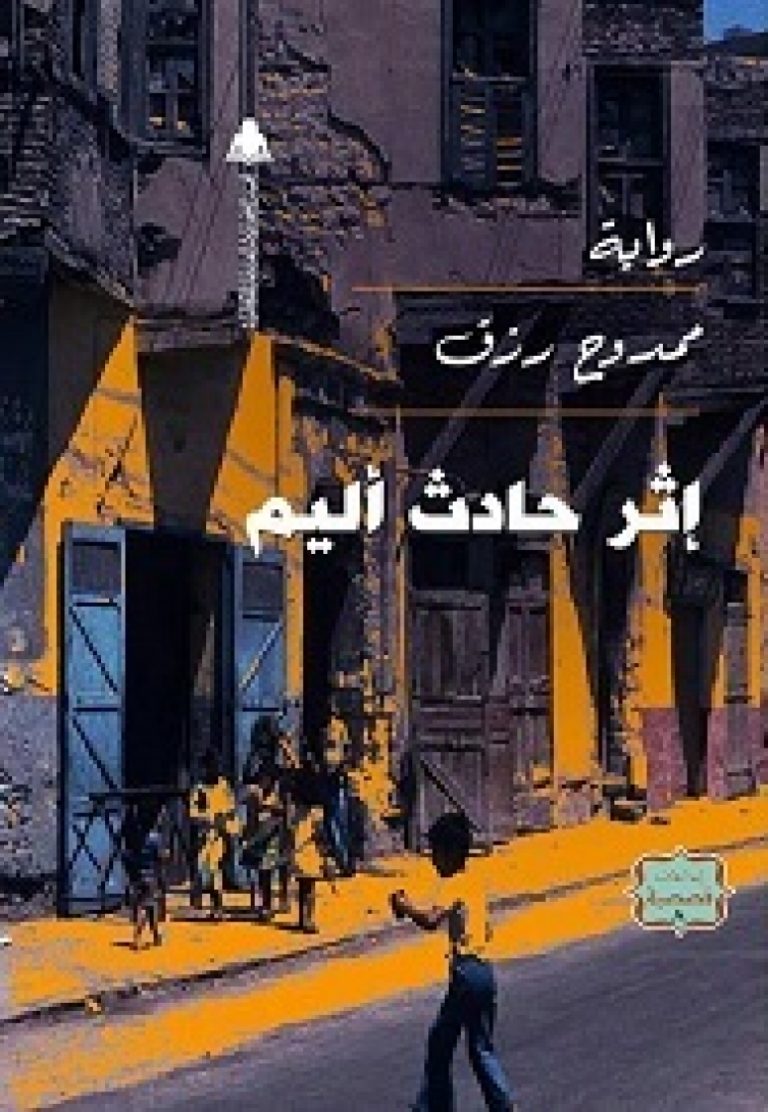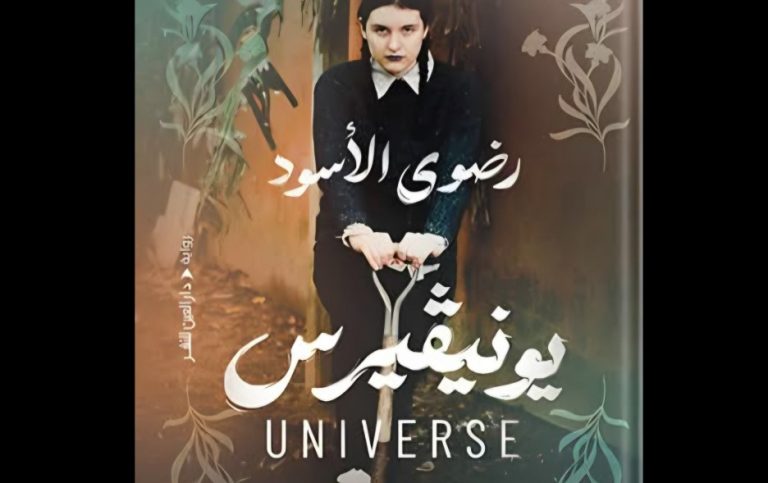ممدوح فرّاج النّابي
“لكي تُمارسَ تأثيرًا على شخصٍ ما، لا بدّ، وأن تمنحَه شيئًا من روحك”
(على لسان اللورد هنري في رواية “صورة دوريان غراي” أوسكار وايلد)
“آفةٌ أن يكحِّله الله بالظلمة السرمديّةِ.. أم آيةٌ.. أن يقود خطانا إلى النور هذا النبي الضرير؟ / كروان يجدِّف في الظلماتِ.. يفتش عن مدن ضائعاتٍ… وعن سفن غارقاتٍ / ويقرأ ما غيَّب الموت من أوجهٍ.. ويكلّم من في القبورْ”
(أحمد عبد المعطي حجازي: سارق النار)
في كتابه “نظرية الأدب” عرض جوناثان كولر لإشكالية – صارت ظاهرة فيما بعد- عندما تساءل عن انصراف أساتذة الأدب عن دراسة “ملتون” إلى دراسة “مادونا”، وعن دراسة “شكسبير” إلى دراسة الدراما التلفزيونية التي تُعالج مشاكل الحياة المنزلية والعائلية، وبالمثل يكتب أساتذة اللغة الفرنسية كتبًا حول السجائر، في حين تهيمن فكرة البدانة على عقل الأمريكيين، كولر أخضع هذا إلى شيوع حقل “الدراسات الثقافيّة” الذي كسر مركزية النص، وغيّر من مفهوم الأدب الذي لم يعد حكرًا على الأدب الإنشائي المقروء، وإنما انفتح على مختلف الفنون الجميلة كالغناء والرقص والموسيقى والرسم والنحت والعمارة، وغيرها من فنون، إضافة إلى ارتباطه بوشائج مع فنون كالمسرح والسينما ووسائل الاتصال المتعددة، ومن جهة ثالثة انفتح على العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة والمعارف الطبيعيّة، وعلى ما دخل مؤخّرًا من فنون جديدة (لفظية وبصرية) تنتجها فئات مهمّشة أو خاضعة لأشكال من التمييز التي تسمح بها بعض البُني الاجتماعية السائدة، كالأغاني الشبابية والمسلسلات التليفزيونية والإعلانات الطرقية: المرئية ومتعددة الوسائط، وهتافات المتظاهرين، ولافتات الدعاية الانتخابية … وغيرها. (عبد النبي اصطيف: ما النقد الثقافي؟ ولماذا؟ مجلة فصول، ع 99، ص 17).
في حقيقة الأمر، يعود الاهتمام بالظواهر الثقافية إلى نظريات ما بعد الحداثة، وما أفرزته من أطروحات جديدة، وقد نشأت الدراسات الثقافيّة كما يقول كولر “بوصفها تطبيقًا لتكنيكات التحليل الأدبي على المواد الثقافية الأخرى، أي إنها “تعالج الصناعات / المنتجات الثقافية بوصفها “نصوصًا” يمكن قراءتها” والبحث عن مضمرتها؛ لأن “الجمالي” مجرد قناع يُخفي وراءه أنساقًا ومضمرات عديدة، وهو ما نتج عنه نشوء “الدراسات الثقافية” وقد تفرع عنها “النقد الثقافي” الذي اعتبره الناقد عبد الغذامي “يشمل وجوهًا عديدة من الحياة وليس الأدب فقط”، وهو ما أسهم في إدراج نصوص وخطابات كثيرة تحت معيته بعد أن تمّ هدم أهرامات البنية المُغلقة للنصوص – التي حصرتها الشكلانيّة الروسيّة في “الأدبية” – والعمل على نقد كل أشكال الثقافة.
وما إن فتحت نظريات ما بعد الحداثة الباب للاهتمام بالهامشي وغير العادي والأقليات، حتى توالت الدراسات التي سلّطت الضوء على الكثير من ظواهر الحياة اليوميّة، والشخصيات الأكثر جماهيرية على نحو ما فعل رولان بارت في “أساطير الحياة اليومية” (1957)، حيث قدّم نماذج الأساطير الجديدة لعصره، إذْ لم تعد الأسطورة “رهنًا بالماضي” وإنما للحاضر – أيضًا – أساطيره، ما دامت الأسطورة كلام، فكل “ما يخضع للخطاب هو أسطورة” وبناءً على هذا جعل من مفردات الحياة اليوميّة والظواهر اللافتة أساطير جديدة، فدرسَ بارت علاماتها وكشف دلالاتها، مع إنها تبدو للرائي بعيدة عن الأدب وأشكاله النخبوية والشعبية، إلا أنّه أخضعها للدراسة والتأمُّل، فكتب عن الصُوَر الفوتوغرافية، والمعارض الفنيّة، والألعاب الرياضيّة (مصارعة المحترفين والملاكمة)، والطعام، وإعلانات السّيارات والمنظفات، وغيرها من موضوعات كانت بعيدة عن الدرس النقدي، فجعلها أشبه بأساطير الحياة المعاصرة، ثم في تطوّر لاحق خضعت الظواهر الجديدة التي حلّت مع دخول الفضاء السيبراني، لاهتمام النقاد والباحثين فبدأ الاهتمام بالاستوري، والسليفي، واللايك، والمنشورات وغيرها من تقنيات تُستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعلات الجماهير عليها، ومن ثم العمل على قراءتها وتحليلها.
وقد احتلت الدراسات الثقافية مكانة كبيرة في حقل الدراسات النقدية في الفترة الأخيرة، وكان من سمات هذه الدراسات أنها قوّضت مفهوم التعالي والنخبوية والأدب الرفيع، في مقابل شيوع الاهتمام بالعادي والهامش والأقليات وغيرها من ظواهر لم تكن الأضواء مُسلّطة عليها من ذي قبل. ولا يعني اتصال الدارسات الثقافية بالظواهر الشعبية والمهمشة، أنها بعيدة عن الفلسفة بوصفها مجالاً أكاديميًّا، بل على العكس تمامًا فهي ذات اتصال بالفلسفة التي من شأنها أن تجعل مقاربة أية ظاهر ثقافية مجالاً للتوظيف الفلسفي.
البعد الإنساني للأدب
ما يجمع بين عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين (1889- 1973) الذي تحلُّ الذكرى التاسعة والأربعون لرحيله هذا الشهر(28 أكتوبر) وإدوارد سعيد (1935- 2003) رائد الدراسات الكولونيالية، والمفكر السياسي البارز، والأديب العالمي غابرييل جارسيا ماركيز (1927 – 2014) هو قدرتهم على كتابة نصوص تؤكد الترابط بين النصوص وبين الكيانات البشرية والسياسية والمجتمعات والأحداث، أي أنها نصوص تتماس مع واقع الناس واهتماماته، على الرغم من أنها صادرة من موقع نخبويين، لكنهم مثقفون- في المقام الأوّل – يمتثلون لدور “المثقف” الفاعل الذي لا ينعزل عن واقعه بل ينغمس في قضايا جماهيره، فلا يقف منها موقف المتفرج المكتوف الأيدي، المنعزل في برجه العاجي أو صومعته الإبداعيّة، لا همّ له سوى إنتاج نصوصه وتجويد إبداعه، وهو ما عبّر عنه طه حسين وكان سباقًا أيضًا فيه، لبندا وغرامشي وإدوارد سعيد، في حديثهم عن المثقف وطبيعة دوره. ففي حديثه عن علاقة جان بول سارتر بالسينما في مقالة نُشرت في مجلة “الكاتب المصري” بتاريخ (نوفمبر 1947)، قال صراحة ما نُسب للاحقين: ”وكما أن الأديب لا ينبغي أن يعتزل في برجه العاجي وأن يوحي منه إلى الجماعات كتبًا أو فصولاً لا تتصل بحياتها اتصالاً مباشرًا، وإنما ينبغي أن يعيش مع الناس في الأرض ويشتق كتبه من نفوسهم، لا ينبغي أن يعتزل في برجه العاجي ليوحي إلى الناس قصصًا تعرض عليهم في السينما دون أن تكون هذه القصص مشتقة من حياتهم مصوّرة أدق تصوير وأصدقه لما يجدون من ألم ولذة، وما يحسون من أمل ويأس وما يثور في قلوبهم من عاطفة وشعور…”(ص: 84).
الثلاثة كمبدعين تعاملوا مع هذه الشخصيات التي تناولوها من منطلق أولاً البُعد الإنساني للإبداع، وثانيًّا لأنها ظاهرة جماهيرية، وبتعبير رولان بارت “أساطير يومية”، فسارة برنار، وتحية كاريوكا وشاكيرا، هن بالفعل أساطير في مجالاتهن بما قمن به من مغامرات، وما لحق بهن من متاعب في سبيل الوصول إلى المجد، وهو ما كان له صداه الواسع لدى الجماهير (لهم ولأعمالهم)، فجاءت كِتابة الكُتَّاب الثلاثة لهذه النماذج من موقع دور المثقف المتعايش والمنغمس مع واقعه، وأيضًا باعتبار هذه النماذج علامات سيمولوجية تُرشد لقراءة ما خلف الظاهرة، على نحو ما وجهت نظرة بارت الثقافية التي اعتنت بـ “بهارج المجتمع والحوادث المتفرقة والصور والملصقات والممارسات اليومية كانت كلها عبارة عن علامات، وبالتالي فقد ساهم مساهمة كبيرة في “إيقاظ القارئ على قضية المعنى” (قاسم المقداد: مقدمة “أساطير الحياة اليومية”، ص 6).
فطه حسين الذي كتب عن “بول فاليري” و”أندريه جيد”، و”فولتير”، و”جان بول سارتر”، و”ريتشارد رايت”، ومقدمة ترجمة محمد عوض محمد لـ “فاوست” لجوته (1929)، علاوة على ذلك أنه كان أوّل من قدّم إلى الثقافة العربيّة شخصية “فرانز كافكا” ونظريته الكافكاوية في الأدب عندما أشار إليه في دراسته “الأدب المظلم” في مجلة “الكاتب المصري” (سبتمبر 1946)، ثم ترجم له قصته “طبيب القرية” بعد خمسة أشهر من مقالته التعريفية به التي جاءت بعنوان “فرانز كافكا” (مارس 1947)، ما علاقته بسارة برنار، ولماذا يكتب عنها؟ بالطبع تساؤل سيطرحه الكثيرون، لكن الجواب يكمُن في شخصية طه حسين نفسها، التي ينطبق عليها وصف “تِمُثي برنَن” لأستاذه إدوارد سعيد، بأنه يتصف بشخصية “المفكر الواسع الاطلاع، والراغب في معرفة ما لا يعرف”، واتساقًا مع هذا الدور كتب عن السينما وأهميتها كوسيلة مستحدثة يجب على الأديب الذي يقدر الحياة الاجتماعية ويُشارك فيها وفي احتمال تبعاتها ألا يُهملها إلى جانب غيرها من وسائل مستحدثة.
وهو الأمر الذي ينطبق على إدوارد سعيد أيضًا، أما ماركيز، فالكتابة عنده جاءت من موقع الصحافي، الذي يرصد الأخبار ويحلّل الظواهر، ومن هذا الموقع كتب عن بيل كلينتون مقالة فاتنة بعنوان “عاشق غير ناضج”، وأيضًا ما كتبه عن هوجو شافيز مقالة بعنوان “لغز رجلين يدعيان شافيز”. لكن أحيانًا تفرض المهارة التي تُحْدِث المتعة، سطوتها كدافع إلى الكتابة وهو ما حدث مع الشاعر محمود درويش عندما كتب عن “ماردونا” بعد انتصار الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم عام (1986) كما أخبرتني الصديقة الروائية منصورة عزّ الدين.
بالطبع الفضل كل الفضل في التوسّع في قراءة مثل هذه الظواهر وفك شيفراتها بدراستها دراسة علمية، يعود إلى بارت الذي بيّن للناس عبر التعمّق بالنظرة لليومي والمعيش والهامش، وقراءة العلامات، إلى التعمق في هذه الأشياء، التي بيّنت للناس قُدرة المجتمع على الإفصاح عن نفسه من خلال العلامات التي يُرسلها. وهو الأمر الذي استلفت انتباه الدكتور سيد البحراوي فكتب عن “لغة السلام شوبنج سنتر” وإن كان وظف العلامات ودلالاتها في سياق اهتمامه بمحتوى الشكل، والاستفادة من النقد الاجتماعي الشامل أو ما أسماه “محتوى الشكل” في فهم علمي لظواهر حياتية قد لا تتصل مباشرة بالأدب أو الفن، مثل اللغة” (في نظرية الأدب: ص 178)، وناقش خلالها كيف أن المجتمع يسعى إلى محاولة التلفيق بين ما هو إسلامي وحداثي، عبر إدخال مفردات من لغات أخرى (إنجليزية أو فرنسية، أو إيطالية، أو ألمانية) في الاستخدام اللغوي “العربي” بما يمثّل تشويهًا واضحًا لتركيب تلك اللغة وتشويشًا واضحًا في أدائها لوظيفتها التواصليّة، ناهيك عن إهدار قيمتها الجمالية” (في نظرية الأدب: ص 177) في تأكيد لمفهوم “الحداثة المعطوبة” الذي أشار إليه فيصل دراج في تعامل المثقفين الحداثيين أو آباء الحداثة مع ظاهرة مي زيادة، فارتدوا إلى أفكارهم الراديكاليّة على الرغم من ارتدائهم ثياب الحداثة والدعوة إليها. فتجاور العلامات الثلاث (السلام / شوبنج سنتر / للمحجبات) كان بمثابة التزييف للوعي، بما إنها نقيض لما تؤديه بالفعل.
ألا يحق لي (وحدي على الأقل) أن أتحدث عن سبق طه حسين لبارت في تسليط الضوء على أساطير الحياة اليومية، والالتفات إلى الظواهر التي تشغل الناس، ودرسها، وبمعنى أدق تطويع النقد الأدبي وتوسيع مجاله لقراءة ما هو خارج النصوص الإنشائية إلى قراءة الواقع نفسه، وتحليل سياقاته، وما ينتج عنه من ظواهر وفنون مرئية (هنا على الأقل)؛ فطه حسين كتب عن ظاهرة سارة برنار في أبريل 1923، باعتبارها نصًّا، وحلّل أسباب اهتمام الجمهور بها، وكيف أنها خلقت أسطورتها بنفسها عبر شخصيتها، وبراعتها في الأداء، وأيضًا لغرائبها وحيلها اليومية، وهذه الاهتمامات هي ما تشغل المهتمين بالدراسات الثقافيّة، والناقد الثقافي (خصوصًا) من جهة، ومحللي الخطابات من المهتمين ببلاغة الجمهور من جهة ثانية، أما بارت فكتب نصوصَ كتابه “أساطير” كما يقول “بين عامي 1954 – 1956، أما الكتاب نفسه فقد نُشر عام 1957″، ومن ثمّ يعد طه حسين رائدًا في التعامل مع الظواهر الثقافية وعلاقتها بالجماهير، وإن كان يعزى الفضل لبارت في أنه “ساهم مساهمة كبيرة في إيقاظ القارئ على قضية المعنى”، وتعامل مع الظاهرة على أساس علمي.
قوة التأثير
بالنسبة لطه حسين قد يبدو الأمر وثيق الصلة بطبيعته كمفكر يحيط بالظاهرة من جميع جوانبها، وأحيانًا يطوف حولها لاستكناه مضمراتها، فالمعروف عن طه حسين أنه لم يكتب عن الرسول الكريم سيرة صريحة (مباشرة) كما كتب محمد حسين هيكل في “حياة محمد” (1935)، ثم العقاد في “عبقرية محمد” (1942)، وإنما كتب عن الحوادث التي رافقت ظهور الرسول عليه الصلاة والسلام تارة على نحو ما جاء في “على هامش السيرة” (1933)، وتارة ثانية كتب – في “الوعد الحق” (1949) – عن الشخصيات المهمَّشة التي كانت إلى جوار الرسول الكريم، والتي لم يكن لها سندٌ اجتماعيّ من أسرة أو مال أو سلطان إلى أنْ تحقّق وعد الله كما جاء في قوله: “وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ” (النور: 55).
فالشخصيات التي كتب عنها طه حسين هي – في الأصل – مُهمَّشة في التاريخ الإسلاميّ، علاوة على أنها كانت مُستضعَفة وقع عليها الظلم دون أن تَقْدِرَ على دفع ضيمه، ومن ثمّ كان اهتمامه سبّاقًا بالمهمّشين والضعفاء، وهو ما التفتت إليه دراسات ما بعد الحداثة فيما بعد، لكن حديثه لم يأتِ من قبيل تسليط الضوء عليهم بنقلهم من الهامش إلى المركز أو المتن، أو حتى إزالة الغبن عنهم (كما تهدف دراسات ما بعد الحداثة)، وإنما لبيان أثر الرسول في هؤلاء المستضعفين، وهو الأثر الذي نقلهم إلى المركز بعد التحوّل الذي حدث في حياتهم قاطبة، وكأنه يريد أن يتحدث عن أثر الدين الجديد وتأثيره على نفوس أوائل الصحابة وكيف تبدلّت حياتهم من الذل إلى العزة، ومن الضعف إلى القوة، أي من النقيض إلى النقيض، ببيان التأثير مباشرة لا بالحديث عن مولد الرسول وحياته وبعثته إلخ من سرديات حرص مؤرخو سيرة الرسول الكريم على تتبُّعها، طه حسين خالف هذا، ونفذ إلى جوهر الرسالة مباشرة عبر تأثيرها في الناس وتحديدًا الضعفاء والمهمّشين، وهو ما واصله في كتابه “الشيخان” (1960) عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب ، ثم في الفتنة الكبرى بجزأيه “عثمان بن عفان” (1947)، و”علي وبنوه”(1953).
غاية المنهج الذي اتبعه طه حسين في كتابة السيرة واضح بكل جلاء في كتابه “مرآة الإسلام” (1959)، فالكتاب تقسيمته تشير إلى بيان فعالية الإسلام في الجزيرة العربية؛ فالجزء الأول من الكتاب تحدّث فيه عن واقع الجزيرة العربية قبل الإسلام، وما كانت تعانيه الأمة العربية من تخلُّف ثقافي وحضاري مقارنة بالأمم المجاورة لها، التي كانت لديهم نهضة حضارية واقتصادية، واصفًا أجواء الحياة بمختلف أنماطها كمهاد إلى التغيير (أو الانقلاب) الذي سيحدث بعد ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وصولاً إلى بعثته ونزول الوحي، فتبدأ النقلة الحقيقية، وتغيّر الأحوال بتتبع أثر المبادئ الإسلامية التي أرساها الرسول في مقابل أثر التخلّي عنها، وهو ما انتهى إليه الحال بالفتنة الكبرى التي تركتْ آثارها العميقة الدامية في تاريخ الإسلام طوال عصوره حتى الآن، بعد أن اهتزت مبادئ الإسلام لدى الجماعة الإسلامية خلال الفتنة الكبرى، ثم إغفال تطبيقها تدريجيًّا في عصر الأمويين والعباسيين، وهو ما آل إلى حالة الشقاق والنزاع التي تجسّدت في صور الأحزاب السياسية والفرق الكلامية والمذاهب الفقهية، وبعبارته بعد أن قامت أمور “الدولة الإسلامية على الغلبة حرصًا على المنافع العاجلة”، وبناء على هذا النهج يمكن قراءة حديثه عن سارة برنار في ضوء هذا السياق، لا باعتبارها شخصية مهمّشة أو ضعيفة، وإنما باعتبارها شخصية أحدثت تأثيرًا، وهذا الأثر واضح في استقبال مرضها ثم وفاتها، وهي النقطة التي تشغل بال طه حسين في كتاباته البحث عن قوة التأثير، وهو ما سيتكرر عند إدوارد سعيد في اهتمامه بتحية كاريوكا، وماركيز في اهتمامه بشاكيرا، ومحمود درويش في اهتمامه بماردونا، وغيرهم الكثير والكثير.
في ظني أنه لا فرق بين سارة برنار أو تحية كاريوكا أو حتى شاكيرا أو بيل كلينتون أو ماردونا، فالكتابة عن هذه الشخصيات جاءت كضرورة فرضتها واجبات المثقف العضوي أو الملتزم [بتعبير سارتر] الذي ينخرط في واقعه ويستجيب لتأثيره، وكذلك لاعتبار هذه الشخصيات ظواهر تكشف في إحدى تجلياتها إننا نعيش في عالم يغصُّ بالمعنى، والتي نحتاج لأن نفتح أقواسًا بالتساؤلات كي نفهمها ونحلل ظهورها وصعودها والأهم كيف تَجاوب الجمهور معها بالإيجاب (في الغالب) على الرغم من تعارضها (في كثير منها) مع ما يؤمن به، الشيء المهم الذي يؤكده الاهتمام بمثل هذه الظواهر ويجعلها تقع تحت دائرة الأساطير على نحو ما فعل بارت أن ” للحاضر أساطيره، مثلما كان للماضي أساطيره الخاصة به”.
طه حسين اتخذ من نظرتي الاحترام والتقدير التي أولاها الناس (على اختلاف ثقافتهم وطبيعتهم، ومكانتهم) للفنانة سارة برنار؛ ليكشف عن قوة تأثير الفن الجادّ على الجماهير الغفيرة التي تنوّعت ما بين عظماء وجماهير عادية اصطفوا جميعًا إثر خبر وفاتها الأليم “فالناس يتحدثون بموت “سارة برنار” أو لا يتحدثون إلا بموت سارة برنار، وإذا كثير منهم لا يكتفي بالحزن الصامت، أو الإعجاب المتقصد، بل يتحدث ويشرح ويفصل ويروي ما سمع وما رأى، ويصف ما أحس به وما شعر به حين شهد “سارة برنار” تلعب في ذات الكاميليا أو في النسير أو في المجد أو في غيرها من القصص” (طه حسين: من بعيد، ص 21)، وإدوارد سعيد عبر دراسة بويطيقا جسد تحية كاريوكا رصد التحولات الثقافية والاجتماعية والسياسية في مصر التي حدثت إبّان السبعينات والثمانينات، وتأثير الهجرة إلى بلاد النفط على الثقافة المصرية، وبالأحرى على الهوية المصرية.
أما ماركيز فكتب عن ظاهرة شاكيرا، لأنها بمفاهيم العصر الحديث غدت أسطورة حقيقيّة؛ بأسلوبها ورقصة البطن المشهورة بها، وملابسها، ومن ثم صارت أيقونة حرص الجميع على تقليدها واستنساخها، الغريب أن النسخ المستنسخة منها جاءت مشوّهة على نحو ما حدث مع نموذج تحية كاريوكا التي صعُب تكرارها. ماركيز ركّز في لوحته الفنية عنها، على معاناة الفنان من الشهرة، والملاحقات التي تطارده بسبب الحوارات الصحفية، والأحاديث التلفزيونية وغيرهما، لكن في ظني المقالة المهمة لماركيز كانت عن الرئيس بيل كلينتون، لأنها تُقدِّم صورة للرئيس المثقف، صورة (غير مرئية) داخلية للرئيس عكس تلك الصورة التي شاعت عنه بعد حادثة مونيكا لوسينكي، أو تلك الصورة التي أراد أعداؤه أن يصدروها له، لكن ماركيز تجاوز هذا كله ليفتش في عقلية الرئيس ورؤاه.
العميد وسارة برنار
يوثّق طه حسين علاقته بسارة برنار، برحلته إلى فرنسا، وبالأحرى بلحظة وصوله إلى فرنسا، حيث يلفت انتباهه عند وصوله باريس حدث وفاة سارة برنار، ويتساءل عن كينونتها، ولماذا هذا الاهتمام بها؟ ومِن تساؤلاته يبدأ التعرُّف على شخصيتها عبر آراء الناس فيها، وكذلك ما كُتب عنها، فيقول “تركت القاهرة يوم الأربعاء ووصلتُ إلى باريس يوم الثلاثاء، فإذا الناس يتحدثون بموت “سارة برنار” أو لا يتحدثون إلا بموت سارة برنار….”. حدث الموت يسترعيه، لا لأنه وقع بطريقة غير مشروعة أو مثيرة أو غرائبية، وإنما لما لاحظه من أثر فعل الموت على الناس، على نحو ما سمع، ومن هذا الأثر استطاع أن يعرف تأثيرها الكبير واللافت الذي استدعى هذا الحديث حول شخصيتها وهو ما أظهر مكانتها، ومن ثمّ تأثير الفن الجادّ في الجمهور.
كعادة طه حسين في التسجيل يرصد عبر حاسة السمع كبديل عن الرؤية المباشرة، كل ما يتعلّق بحديث الناس عن أُبهة ومجد سارة برنار، وكذلك افتتان الناس بها، وافتتانها بالناس، وما تكسبه من مال لا يحصى، وفيما تنفقه، ورخائها وعسرتها، وعلاقتها بكبار الناس وزعمائها، وما بينها وبينهم من صلات قوية وضعيفة، وما أهداه إليها العظماء من تكرمة، ثمّ يتطرق للحديث عن جمالها الباهر، وصوتها الساحر، وأعاجيبها وألاعيبها وافتتانها في كل شيء، في الهزل والجد، في التمثيل والتصوير والتفتيش.
بعد هذه المقدمة يستعرض لسيرتها ومسيرتها الصعبة قبل أن تصل إلى ما وصلتْ إليه، فقد “تجشمها الأهوال وتكلّفها الأعاجيب، وتثب بها من أوروبا إلى أمريكا وإلى استراليا ثم إلى مصر، ثم إلى فرنسا، ثم إلى السويد والنرويج وغيرها من بلاد الله” (من بعيد: ص 22)
محاولة فهم تأثير شخصية سارة على الجماهير تدفعه إلى تساؤلات كثيرة عن موقف الناس منها، وهو موقف يصفه بأنه “موقف الحائرة الدهشين، الذين يعجبون ويعجبون إلى غير حد”، ما الذي دفع الناس إلى هذه الحيرة؛ هل هو الإعجاب “بالذكاء النادر؟ أم “بالجمال الباهر” أم بالصوت الساحر” أم بالقوة التي لا حد لها؟ أم بالأمل الذي يخشى اليأس ولا يحسب له حسابًا؟ بالنفس التي ليس لها مثيل…” وينتهي إلى أن الناس يعجبون “بهذا كله … سواء مَن أحبها؟ وسواء منهم من أبغضها. كل بها معجب وكل لها مُكْبر في كل وقت وفي كل طور” (من بعيد: ص 22)
ثم يصف لنا أثر صدى خبر النبأ الذي أذاعته الصحف بأنها مشرفة على الموت “فجزعوا وهلعوا وأسرعت جماعاتهم المختلفة إلى بيت المريضة، فازدحمت حوله وامتلأت بها الشوارع”، وقد قُدّر للبعض بأن يُتاح لهم الدخول، فدخلوا للسؤال والاستعلام، والكتابة لها، وهناك فريق لم يقدر له، فخرجوا وانصرفوا، أما الذي لم يتح له الدخول فرابط “في الشارع يتنسم الأنباء ويتصيّد الأخبار، يرى الصحفي فيسأله، ويلمح الطبيب فيستنبئه”، وقد زاد عدد الجماهير لما نعيت إليهم فـ”لم يخلُ الشارع ولا البيت من هذا الجمهور” ويوم تشييع الجنازة ذكرت الصحف أن “600 ألف من أهل باريس اشتركوا فيه، وأن ألفين من الشرطة اشتركوا في حفظ النظام، وأن أرصفة الشوارع التي مرت بها الجثة كانت مكتظة بالناس على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم وأسنانهم، وأم الزهر كان ينثر على التابوت من أولئك الذين ثقلت بهم سطوح الدور والحوانيت”.
الأمر كما يصف طه حسين لم يقتصر على الجماهير، بل تنافست في تشييع الجنازة “الجمهورية وبلدية باريس”، وكذلك اشتركت فيه “أوروبا وأمريكا” وتنافستا “أيهما تقوم بنفقات الجنازة”، وهناك “من الملوك والملكات من أرسل إلى أسرة الممثلة يعزيها ويعطف عليها”.
حالتا الإعجاب والتقدير اللتيْن رأى عليهما تعامل الناس والحكومة والصحف لشخصية سارة برنار، هما الدافع الأساسي من وراء كتابة المقالة، فهو لم يكن يعرف باسمها إلا بعدما صادف أثناء رحلته إلى باريس من مظاهر حزن وتشييع لجنازتها، وسمع أحاديث الناس عنها وكذلك ما روته الصحف، وهو ما يدفعه إلى المقارنة بما يحدث في وطنه، فالتعجب موقعه الأساسي هو التحسُّر على مصير مثل هذا الفنان، وما يلاقيه في وطنه، ومن ثمّ لا يتردد في أن يعلن غضبه وسخطه لنقيض هذا الاحتفاء والتقدير في وطنه، فيتساءل: “كنت أسأل نفسي إلى أي حد يبلغ إعجاب الناس بالنبوغ وإكبارهم للنابغين إذا كان هؤلاء الناس من الرقي العلمي والخلقي بحيث يفهمون النبوغ والنابغين… وكنت أذكر مصر في هذا كله وأسأل نفسي: متى يُتاح لمصر نابغة كـ”سارة برنار”، أو على أقل تقدير متى يبلغ أهل مصر من الرُّقي العلمي والخلقي ما يمكّنهم مِن أن يقدّروا نابغة “كسارة برنارد” لم تبلغ في السياسة ولا في الدين، ولا في العلم، وإنما نبغت في الفن، وفي فن هو سيء الحظ جدًّا عند المصريين، نبغت في التمثيل الذي يزدريه أكثر المصريين، ويفهمه قليل من المصريين على غير وجهه، ولا يفهمه حقًا بين المصريين إلا نفر يكادون يحصون” (من بعيد: ص 24)
لم يتح لطه حسين لقاء سارة برنار على عكس إدوارد سعيد وماركيز اللذين أتيح لهما اللقاء المباشر، فالأول التقى تحية كاريوكا أكثر من مرة (مرة وهو مراهق، ومرة شاهد مسرحيتها، ولقاء ببيتها مع المخرجة نبيهة لطفى)، أما الثاني فقد أتيح له لقاء شاكيرا بوصفه صحافيًّا يغطي حفلاتها، وكلاهما إدوارد سعيد وماركيز، تحاور مع كاريوكا وشاكيرا وجهًا لوجه، وهو الأمر الذي يفطن إليه طه حسين، فلا يأتي تعامله مع الشخصية بناء على معرفة مباشرة، وإنما عبر وعي وسيط، هو ما أخبره به الناس، أو ما اطلع عليه بقراءاته، ومن ثم يقدم سيرة موجزة لحياتها منذ ولادتها عام (1844) في باريس أو برلين، أما مكان ولادتها فلا يتفق عليه أحد، وقد ذكرت هي نفسها موضعيْن لميلادها، انتمت إلى أسرة رحالة، لا تستقر في وطن ولا يطمئنون إلى دار، ثم رحلة انتقالها من الدير إلى التمثيل؛ إذ أنها كانت ترغب أن تكون راهبة، لكنها اشتركت في قصة دينية مدرسية، فأُعجب بها “الدوق دي مورني” ونصح بأن تتخصص للتمثيل، ثم ذهبت إلى الكونسرفتوار، ونالت إعجاب أساتذتها. ثم يتحدث عن إخفاقها في بدايتها كممثلة، وإن كان يعمم القاعدة بأن أكثر النابغين تعثروا في بداياتهم قبل الانطلاقة الحقيقيّة، ويرجع السبب لعدم توفيقها لكونها صاحبة “طرائق مختلفة، ومذاهب غريبة لم يألفها الجمهور، ولم يطمئن إليها”، ثم اتصالها ببيت موليير، ولعبت فيه القصص المختلفة على تباين عصورها ومذاهبها.
لكن أهم ما جاء في تحليل ظاهرة سارة برنار هو مقارنتها بالسيبياد الأتيني المشهور، وملخص الربط هو كيفية إثارة الجماهير ودفعهم إلى استمرار المتابعة والاهتمام بكافة الوسائل، فيقول “إن السيبياد كان له كلب فَتن الأتينيين فتحدثوا عنه دهرًا، فلما انتهى إعجابهم به كفوا عن الحديث فيه، فقطع السبياد ذنب الكلب ليعود الأتينيون فيذكروه”. هكذا كانت أعاجيبه وحيله كي لا يكفُّ الناس عن الافتتان به والتفكير فيه. وبالمثل فعلتْ سارة برنار كانت “فتنة باريس وكانت تحرص على أن تظل فتنة باريس، فكانت تفعل كل شيء يجعلها حديثًا لأهل باريس. ويضرب أمثلة لأعاجيبها على نحو:
- إنها كانت تملأ غرفتها بالهياكل العظمية.
- تنام في تابوت مُبطّن بالحرير الأبيض.
- تستأنس كثيرًا من الحيوان الوحشي.
- ترتدي أزياء مختلفة غريبة، وأحيانًا ترتدي زي الرجال، وأحيانًا زي النساء.
- تدهش الناس بمقالاتها وصورها وأحاديثها.
ثم يتحدث عن رحلة انفصالها عن بيت موليير وباريس كلها، وإن كان انفصالها كما يصفه جاء عنيفًا بوقوفها أمام القضاء الذي حكم بغرامة، وسافرت بعدها إلى لندرة (لندن) ثم السويد والنرويج ثم إلى أمريكا. ويعتبرها طه حسين أحسن سفير نشر الدعوة الفرنسية في أقطار الأرض، وأحسن تمثيل “للعقل الفرنسي والفن الفرنسي والأدب الفرنسي” وعلى الجملة يقول “إن سارة خدمت فرنسا ورفعت ذكرها إلى حد لم يبلغه كثير من قوادها الفاتحين” (ص: 28)، وعندما يأتي الحديث عن براعتها في فن التمثيل فإنه يحيل الكلام إلى الناقد الفرنسي “جول ليمتر” الذي كان مفتونًا بها، ويرى أن مصدر نبوغها وافتتان الناس بها يعود إلى ثلاثة مواضع: صوتها، الذي سماه فيكتور هوجو “الصوت الذهبي”؛ حيث يقال إنها كانت تتغنّى في تمثيلها بالشعر والنثر جمعًا، وأيضًا حركتها في التمثيل، فكما يقول “جول ليمتر” بأنها “أحدثتْ في التمثيل ما لم يحدثه أحد قبلها، فكانت تلعب بجسمها كله، أي أنها كانت تحقق ما تمثله، فلم تكن تُخيّل إلى الناس أنها تلثم أو أنها تُعانِق، وإنما كانت تلثم وتعانق بالفعل، وكانت تفعل ما هو أبلغ في الدهشة من اللثم والمعانقة”. أما السبب الثالث فهو ذكاؤها، فكانت أقدر الممثلين على فهم الفصول التي تلعبها.
طه حسين في هذا البورتريه الذي رسمه لسارة برنار، اقترب إلى حدٍّ كبير من دراسات الجمهور التي تعتني بتحليل استجابات الجمهور لظواهر بعينها، فيتخذ من مشهد موت سارة برنار كدليل على هذه العلاقة، فيقدم تحليلاً ضافيًّا لها، مُتتبعًا سمات الشخصيّة الطبيعيّة، ثمّ ما تتخذه من حيل وآلاعيب من أجل إثارة الجمهور، واستمرار الانشغال بها، وهو ما يعرف في بلاغة الجمهور باستراتيجيات الإقناع والتأثير في الخطاب كعامل مؤثر لاستقطاب الجمهور، لكن مع هذا الاقتراب من حقل دراسات بلاغة الجمهور، إلا أن الدراسة الثقافية هي الطاغية في تعامله مع ظاهرة سارة برنار كشخصية مؤثرة وفاعلة، إضافة إلى تساؤلاته عن أي مدى نكون متأثرين بالأشكال / الظواهر الثقافية.
صورة الفنانة في عملها
يقدم ماركيز في نموذج شاكيرا صورة الفنان في عذابه، فهي دومًا في حالة مطاردة، وعلى عجلة من أمرها، لا يُقدّم صورة للفنانة تحت الأضواء وإنما (إذا استعارنا عنوان جيمس جويس ببعض التحريف) صورة لمعاناة الفنان بسبب هذه الأضواء التي تفرض عليه حياة صعبة يغيب فيها حقه الطبيعي في الحياة الطبيعية والاستمتاع ببساطتها، فالفنان دائمًا خاضع لسلطة الآخرين، أيًّا كانت صورة الآخر؛ لقاءات صحفية، وتليفزيونية، حفلات، حضور مهرجانات، فحياته نظامها لا بد أن يتماشى مع مواعيد الآخرين وارتباطاتهم دون حساب لوقت أو راحة الطرف الأول. فعبر تنقلاتها الكثيرة، ووقعها تحت سلطة الآخر، يكشف صورة مغايرة وإن كانت سلبية للحياة التي يحياها الفنان، فهو مسلوب الإرادة، دائما هناك سلطة تحركه، وهو منصاع لإرادتها؛ لأن الانصياع من شروط المحافظة على النجومية واستمرارها.
بخفة وسلاسة ينفذ ماركيز إلى غرض مقالته، الذي ليس هو شاكيرا في حد ذاتها، بقدر ما هو تسليط الضوء على وسائل الاستلاب الجديدة، حتى غدت إكراهات سلطة النجاح والجمهور، بمثابة عوامل إمبريالية تعوق حركة الفنان، وتسلبه إنسانيته، ووجوده فيضحى مجرد ترس في آلة يدور مع بقية التروس كي تدور الآلة بأكملها، وعلى الفنان الذي يصل إلى القمة، عليه أن يدفع فاتورة هذه الشهرة، ومع الأسف ثمن الفاتورة من حياته الشخصية، وحريته، وحقه في الاستمتاع بالحياة، فشاكيرا تتحامل على نفسها حتى إن مرات قليلة “هي التي سمحت فيها بظهور الإرهاق عليها… فطوال سلسلة من الحفلات بلغت أربعين حفلاً أحيتها في الأرجنتين لم يظهر عليها أدق أمارات التعب” (ماركيز: “غريق على أرض صلبة”: ص 68).
وعبر تعدد اللّقاءات والحوارات والسّفريات يعكس ما تعانيه شاكيرا، وكأنها تفتقد ذاتها التي تغيب تلبيةً لاحتياجات الآخرين، فيصف لنا يومًا لها هكذا:
“كانت قد وصلت إلى بوينوس أيرس ظهيرة الثلاثاء الأول من مارس، وظلت تعمل حتى منتصف الليل دون أن تجد حتى الوقت لتحتفل بعيد ميلادها الثاني والعشرين، الأربعاء عادت إلى ميامي حيث عقدت جلسة طويلة لاستعراض الصور الفوتوغرافية الخاصة بالدعاية كما قضت وقتًا طويلاً في تسجيل النسخة الإنجليزية من شريطها الجديد. في يوم الجمعة واصلت التسجيل من الساعة الثانية مساء وحتى صباح السبت ثم نامت ثلاث ساعات وقامت لتواصل التسجيل حتى الثالثة مساء، في تلك الليلة تمكنت من النون بضع ساعات ثم استيقظت مبكرة صباح الأحد لتسافر إلى ليما. وهناك وفي منتصف يوم الإثنين سجلت برنامجًا تلفزيونيًّا، ثم قدمت عرضًا على الهواء وشاركت في الساعة الرابعة في برنامج تجاري وتوجهت لتحضر إحدى حفلات الدعاية وظلت بها حتى الفجر” (ماركيز: ص 66).
هكذا غامت شاكيرا الإنسانة في متاهة الفنانة، التي لا تجد وقتًا لنومها، ومع إن النجومية تطغي على شخصيتها إلا أن إنسانيتها هي الغالبة فهي إنسانة مسؤولة، ولديها التزامات كثيرة لم تكن أقل ألما، فالفرقة من الموسيقيين والمصورين والعازفين ومهندسي الصوت، تهتم بهم فردًا فردًا، وتعاملها معهم لا يأتي في إطار عملها الموسيقى وفقط، بل تهتم بظروف كل فرد. ثم يكشف عن جوانب في شخصية شاكيرا، وهي عوامل توثق لعلاقة النجم بجمهوره أشبه بتلك العلاقة التي ذكرها طه حسين عن السيبياد الأتيني المشهور، ورغبته في أن يكون في بؤرة الضوء، فهي على عكس المطربين الذين يفضلون تركيز الأضواء عليهم حتى يتجنبوا مواجهة الجمهور، أما شاكيرا فقد اختارت العكس “فلقد طلبت من فنيي الإضاءة ألا يركزوا الأضواء على وجهها، بل على الجمهور حتى تتمكن من رؤيتهم والعيش معهم أثناء الغناء”، فكما تقول “الاتصال يجب أن يكون كاملاً”، ويأتي تبريرها لهذا الفعل، كتأكيد على المشاركة القلبية للجماهير فتقول “أحب أن أرى عيون الناس وأنا أُغنّي لهم” (ماركيز: ص 70).
أما الظاهرة الأكثر ارتباطًا بحياة شاكيرا (كما يقول ماركيز) فهي “تأثيرها الهائل على جموع الأطفال”، فقد بلغ الهوس بشاكيرا مبلغًا عظيما، فجميع المدارس الابتدائية من جميع المستويات الاجتماعية، قد تحولت إلى حقل استنساخ لشاكيرا؛ فالفتيات يرتدين ملابسهن مثل شاكيرا ويتحدثن بطريقة شاكيرا ويغنين كشاكيرا”، كما أن الشرائط المقلدة لشاكيرا هي العملة الرائجة للمبادلة بين الفتيات وتباع أمام أبواب المدارس، صارت شاكيرا بالنسبة للفتيات النموذج الذي يستوجب تقليده بكل خصوصياته “فحلى الشعر والأسوار والأقراط” هي سوق رائج للتجار، كما إن المجموعات الدراسية فهي بمثابة تجمعات صغيرة وبعد مراجعة الدروس والواجبات، يبدأ الحفل، وبالمثل تحولت أعياد الميلاد إلى احتفالات، فلا يحلو الغناء أو الرقص إلا مع أغاني شاكيرا”.
ثم يبحث في أسباب كيف حقّقت شاكيرا هذا، ويرجعه ليس فقط بسبب ذكائها ودقة حكمها، بل بسبب النضج الذي قلّما تجده فيمن عمرها. لكنه يعود إلى طفولتها التي كانت عبارة عن قفزات متتالية، فتاريخها يؤكد أنها حفظت الحروف الهجائية كاملة وعمرها 17 شهرًا، وفي سن الثالثة كانت تُغني الأرقام، أما في الرابعة فقد رقصت رقصة البطن دون معلم في إحدى مدارس الراهبات… مع بلوغها السادسة لحنت شاكيرا أولى أغانيها، وبين الثامنة والعاشرة من عمرها كتبتْ أوّل أبياتها الشعرية وأُولى أغانيها شعرًا وموسيقى… وفي نفس الفترة من عمرها تقريبًا وقعت أوّل عقد في حياتها للترفيه عن عمال مناجم الفحم في “ثريخزن” بمرتفعات “جواخيرا”. ولم تكن قد تخرجت بعد عندما تعاقدت معها إحدى شركات الأسطوانات على أول أسطوانة لها”. علاوة على هذا فهي فتاة ذكية واثقة قوية مراوغة، لديها أفكار خاصة حول الفن والحياة على الأرض والحياة الأبدية ووجود الله والحب والموت، تشتري الكتب، ولكن لا تقرأها، فليس لديها وقت لقراءتها، كما تشعر بالحنين تجاه الأصدقاء الذين تتركهم خلال وداعها المتعجل في المطارات، وهي تعرف أنه من الصعب العودة لرؤيتهم مرة أخرى. ومن عاداتها أن المكان المفضّل لها للاستماع إلى الموسيقى هو السيارة بصوت عالٍ، فهو “المكان النموذجي للحديث مع الله، والحديث مع نفسي ومحاولة الفهم”. وعن التلفزيون فهي تعترف بأنها تكرهه، وتقول “إن أكبر مظاهر التناقض فيه… يوحي بوجود الحياة الأبدية ومع ذلك يبث شعورًا لا يطاق من الخوف من الموت وفقد المعاني”.
عوامل كثيرة أشار إليها ماركيز جعلت من شاكيرا واحدة من الشخصيات صاحبة قوة التأثير في الآخرين، بل هناك من العوامل ما يدرجها كأسطورة من أساطير الحياة اليومية المعاصرة، فأولياتها نادرة الحدوث، لم نألفها عند غيرها، وأسلوبها في الرقص والغناء صعب تكراره، وكأنه بصمة خاصة بها.
تحية إلى راقصة
قد يبدو للقارئ أن إدوارد سعيد خالف اهتماماته في مجال النظرية النقدية، ودراسات ما بعد الكولونيالية أو أطروحاته السياسية، وتوجه إلى الكتابة عن الرقص، مبتعدًا عن كتاباته النخبوية، عندما كتب مقالة ضافية عن الراقصة تحية كاريوكا. المقالة كانت بعنوان “تحية إلى راقصة” نشرها أولاً في مجلة (ريفيو أوف بوكس) في عدد سبتمبر (1990)، ثمّ نُشرت في مجلة الآداب البيروتيّة (عدد 6/7: 1994)، الحقيقة أن مقالة إدوارد سعيد المُحتفيّة بالراقصة المصرية (التي تبدو – ظاهريًّا – نقيضًا للنخبوية المهتم بها إدوارد سعيد) تدخل في إطار اهتماماته كمثقف في المقام الأول (وفقًا لأطروحاته في “صور المثقف”)، وناقد ثقافي في المقام الثاني يقوم بتقويض التخوم بين الأعلى والأدنى، والمركز والهامش، فمثلما يكتب عن كلاسيكيات الأدب يكتب عن مسلسل تلفزيوني أو راقصة، ومحلل سياسي في المقام الثالث يقرأ التحولات وفقًا لمسار الأيديولوجيا المهيمن، فالأدوار(المختلفة) التي عكستها المقالة تؤكد تنوّع إبداعاته واهتماماته، وأنه كسر حاجز النخبوية الدال عليه مظهره الأنيق، وكتاباته الجادّة والمتنوّعة، بالاتجاه إلى البوب آرت أو الثقافة الشعبيّة.
المقالة على بساطة أسلوبها (على غير ما كتبه إدوارد سعيد في “الاستشراق” (1978) أو “الثقافة والإمبريالية” (1993) أو “العالم والناقد والنص” (1993) وغيرها)، وعمق تناولها التحليلي لظاهرة تحية كاريوكا (وهي سمة إدوارد سعيد منذ تحليله لخطابات اللورد كرومر في الاستشراق، ومقارنته لرحلة الطيب صالح المعكوسة إلى الشمال في “موسم الهجرة إلى الشمال”، برحلة كورتز إلى “قلب الظلام”)؛ كأنها تمرين عملي لكل الأدوار التي شغلها إدوارد في كتاباته المستقلة والمحدّدة الموضوع: سياسة، أدب، موسيقى، وغيرها. فهنا تظهر تعدديّة إدوارد سعيد، وثقافته المتراوحة بين ما هو نخبوي وشعبي أو هامشي، وهو الدور الذي يتصل اتصالاً وثيقًا بدوره كناقد ثقافي بامتياز، على نحو ما قدّم في كثير من كتاباته، فتحية كاريوكا لا تقل أهمية عن “جيمس جويس” وهو يُحلّل أنماط المثقف في “صورة الفنان في شبابه” أو عن “جين أوستين” وهي تعرّي الإمبراطورية العجوز في “روضة مانسفيلد” أو حتى “ألبير كامو” وما يظهره من تناقضات التجربة الاستعمارية في “الغريب”، وغيرها من تمثيلات لكتاباته عن كُتاب نخبويين، في مقابل تحية كاريوكا بنت البلد بما تعنيه الكلمة (كنموذج عبرت عنه في أعمالها أو بشخصيتها عندما ذهبت إلى مهرجان “كان السينمائي” عام (1956) أثناء عرض فيلم “شباب امرأة”، فمرت على السجادة الحمراء بالملاية اللف التي ترتديها المرأة الشعبية) باعتبارهما تمثيل لفئات اجتماعية مهمَّشة، وهي كذلك تتساوى مع نظرته للروسي “إيفان تورجنيف” في “الآباء والبنون” (1962)، وهو يرسم صورة لروسيا الريفيّة في الستينات من القرن التاسع عشر.
فتحية كاريوكا كانت بالمثل ترسم صورة لمصر في مفترق سياسي صعب، متناقض أيديولوجيا وسياسيًّا وعقائديًّا؛ فأصدقاء الأمس صاروا أعداء اليوم، والمركز صار تابعًا، والهوية صارت مسخًا، وهو ما مثلته تحولات جسد كاريوكا خير تمثيل، حيث عكست هذه التحولات عبر أدوارها السياسيّة والنقابيّة التي كانت استجابة لظروف العصر، ما بين امرأة كانت تنتمي إلى اليسار الوطني (وقد سجنها عبد الناصر في الخمسينات، لانتسابها إلى رابطة السلام الموالية لموسكو”، ثم دورها في مسرحية يحيا الوفد المناقض لإيديولوجيا الخمسينات، وصولاً إلى اليمين (التوجه الإسلامي) وإن لم تنتمِ إليه فكريًّا، إلا أنه تمثلت شكليًّا عبر اللقب والملابس والاكسسوارات داخل شقته ا(صور مكة والمصحف).
وفي ظني أن المقالة قراءة واعية من منظور نظريات ما بعد الكولونيالية، فجسد تحية كاريوكا في توازٍ مع “مصر” كلاهما واقعٌ تحت تأثير سلطة على اختلاف أنواعها؛ أولاً، سلطة الرجال الشهوانية، وهو ما عبّر عنه إدوارد سعيد في زيارته الأولى (1950) عندما كان مراهقًا، حيث أثاره هو وأصدقاؤه جسدها المثير للإغواء والشهوة، فحسب قوله إنه عندما رآها كانت “تنضح بشهوة فردوسية ” (خارج المكان: ص 242) ومن تأثير سحر جسدها وإغوائها الذي “يستحيل على المرء النيل منه”، يرسم صورة حسيّة بعين المثارة غرائزه فيقول “كانت ترقص، ويرافقها جلوسًا المطرب عبد العزيز محمود، فتلتف حوله وتتلّوى ثم تدور حول محورها باتزان محكم إلى حد الكمال، وكان ردفاها وساقاها ونهداها أبلغ بوحًا من كل ما حلمتُ به أو تخليته في نثري الاستمنائي الفظ” (خارج المكان: ص 242)، وثانيًا: السلطة الأيديولوجية بكافة توجهاتها التي كانت واقعة تحت تأثيرها، بدءًا من إيمانها بالشيوعية، ثم هجومها على اليسار كما تجلّى في مسرحية “يحيا الوفد” (1975)، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة / الزيارة الأخيرة (1989)، وقد تحولت إلى “قبضاي يزن مائتين وعشرين رطلاً”، وهي المرحلة التي ظهر تأثير تيار الصحوة الإسلامية في الجزيرة العربية، لاحظ (لقب الحاجة / والملابس السوداء، والمصحف، وصور المعالم الإسلامية في شقتها).
والأخيرة تعكس سُلطة الثقافة الوافدة أو الثقافة الإمبرياليّة – لو استعرنا عنوان كتاب إدوارد سعيد نفسه – التي لم تكن خفية لا مرئية، النازحة من بلاد النفط مع نهاية السبعينات وبداية الثمانينات وتأثيرها على محو الهوية، كما سعى كورتز “في قلب الظلام” (1906) لجوزيف كونراد (1857 – 1924) وإن كان خاب سعيه بعدما احتجزه السكان الأصلانيين واعتبروه أشبه بالوثن، وفشل مارلو في استعادته، أي أن الثقافة الأصلانيّة (في قلب الظلام) هي التي انتصرتْ على الثقافة التبشيرية (الوافدة)، حيث جاء كورتز مبشرًا بالدين المسيحي، فبدلاً من أن يعتنق أهل البلاد ما جاء مبشرًا به كورتز، وجد نفسه مجاريًا لهم في طقوسهم وعاداتهم. وفي هذا إشارة ذكية من إدوارد سعيد إلى قوة تأثير الثقافة الأصلانية التي غلبت على ثقافة المبشرين، في دلالة مباشرة إلى ضعف الهوية التي أدت إلى هذا الاختراق، فكورتز ظل يقاوم تأثير الطقوس والعادات، تارة ينجح، وتارة يخفق، حتى من شدة التأثير الواقع عليه، رفض العودة مع مارلو، إلا أن مارلو أخذه بالقوة ومع الأسف جاء موته على ظهر السفينة تأكيدًا لقوة الثقافة الأصلانية التي سلبته إرادته، وهو ما جسدت تحية كاريوكا نقيضه تمامًا فقد انتصرت الثقافة الوافدة، وفرضت هيمنتها، وبعبارة سعيد – نفسه في سياق آخر – صار “المواطن الأصلاني تحت السيطرة”.
فالجسد المتحرّر من كل قيود والعصيّ على الإمساك به، صار تابعًا لا في حركته وفقط، وإنما في قراره (هجومها على الشيوعية بعد توجه السادات إلى المعسكر الأمريكي)، وأيضًا في هويته الشكليّة (قارن بين ملابسها عندما رآها في سن المراهقة، وصورتها عندما زارها بصحبة المخرجة نبيهة لطفي”، وأيضًا في خطابه اللغويّ (تبدل صيغة الاسم من العالمة إلى الحاجة)، ومن ثم وكأن سعيد يريد أن يقول إن الجسد (وما يوازيه / مصر) الذي كان مركزًا وقبلة للآخرين، صار تابعًا وخاضعًا كليًّا لتأثير الثقافة الإمبريالية التي معالمها صارت غير خافية بل مرئية في كل مكانٍ، ولا يوجد دليل أكبر من تبدّل هويّة تحية كاريوكا (العالمة)، إلى (الحاجة) تحية كاريوكا، وهو ما كان إيذانًا بتفكيك إمبراطورية العالمة تحية كاريوكا، التي خالَها “سوف ترقص إلى الأبد”.
جاءت المقالة في إطار سرد ذاتي / شخصي إذْ تناول سعيد علاقته بالراقصة عبر أطوار عمرية متعدّدة تبدأ بمرحلة المراهقة، وما أثارته فيه من رغبات، حيث كانت “تثير الغرائز الحسيّة، لكنها تبقى نائية يستحيل على المرء نيلها”، ثم مرحلة النضج إذْ شاهدها في موضعيْن الأوّل في عرض مسرحي عام 1975، إبان عودته من سفريته الطويلة (خمسة عشر عامًا) بعنوان “يحيا الوفد” وكان محملاً بشعارات إيديولوجية مضادة لحلف عبد الناصر، وتنحاز انحيازًا سافرًا إلى معسكر السادات وحليفه الأمريكان، وقد أصابه العرض بخيبة أمل، لتعارض صورتها في خياله (صورة المراهقة والتي عاد إليها في مذكراته خارج المكان 2003) بما رآه، فقد كانت تحية كاريوكا واحدًا من الرموز الجنسيّة العظيمة في شبابه هو ورفاقه الذين تسلّلوا إلى الملهى الليلي في إحدى الليالي عام 1951، وظن أنها “سوف ترقص إلى الأبد”، لكن كانت الصدمة عندما شاهدها تؤدي في المسرحية “دور القروية الأكثر فظاظة وصراخًا”، إضافة إلى غياب صورتها المثالية التي ارتسمت في ذهنه منذ مراهقته، وهي ترقص بابتسامة هادئة وتدور حول عبد العزيز محمود الجالس في بلادة كما وصفه، فما إن رآها حتى افتقد مظهرها وأسلوبها، فكما يقول “غابت المُغرية السمراء المصفرة، الراقصة الرشيقة الحافلة بالأناقة والإيماءات البارعة التنفيذ”، وتحولت إلى “قبضاي يزن مئتين وعشرين رطلاً” (إدوارد سعيد: “تحية إلى تحية”، مجلة الآداب ص: 94).
ثم جاءت المرة الثالثة عندما زارها في بيتها بصحبة صديقته مخرجة الأفلام الوثائقية نبيهة لطفي، وكانت هذه المرة بمثابة رثاء لها، فبدت أمامه بصورة تُثير الشفقة وهي ترتدي زيًّا إسلاميًّا، إذْ بدتْ وكأنها تنتمي إلى معسكر اليمين الدّينيّ، لا بزيها وحده حيث كانت (متشحة بسواد، وتغطي ذراعيها بِكُمَيْن طولين، وتكسو ساقيها بجاربين داكنين)، بل بكل نمط حياتها بما في ذلك مظهر شقتها بدءًا من المصحف الذي يحتل الصادرة على الطاولة القريبة، وصور الكعبة في كل مكان، ولقبها (الحاجة) الذي نادتها به صديقتها نبيهة لطفي، وصلاتها بعد سماع صوت الأذان، لم تكن تحية الجالسة أمامه وتغيب للحظات لتؤدي صلاتها أو تتمتم بدعاء خلف المؤذن، هي تلك التي سحرته بابتسامتها الهادئة ورقصها الرزين غير المفتعل، كانت أخرى، ومن هذه الأخرى بكل ما حملته من تغيرات على مستوى الشكل (المظهر الخارجي – الذى بدا إسلاميًّا، وما أكّده اللقب الذي صارت تُنادى به “الحاجة” في تناقض للقب “العالمة” بما يحمله من ثراء معرفي وثقافي كما بدا في كتابات المستشرقين) هكذا خلال رحلاته التي جاءت على فترات، يرصد لنا مشهد التحولات التي ظهرت على الجسد والشخصية معًا، وكأنه يريد أن يقدّم مقارنة لواقعيْن؛ واقع الراقصة التي رآها في صباه، والحاجة التي تشكو الزمن وغدر الزوج، وتجتر أمجاد ولّت.
لم يكتفِ إدوارد سعيد (في لوحته الفاتنة عن تحية كاريوكا) بتقديم الصُّور المتناقضة التي بدت عليها كاريوكا خلال أطوار حياتها المختلفة، بل كشف عن توازي هذه الصورة مع أطوار المجتمع المصري الذي شهد هو الآخر تحولات خطيرة على مستوى تركيبة سكانه وأيضًا على مستوى الأيديولوجية الحاكمة، وتبدلّها من معسكر الانحياز للشيوعية (الاتحاد السوفيتي – عهد عبد الناصر)، إلى النظام الرأسمالي (أمريكا – عهد السادات)، والتباين بين السياستيْن عهد مبارك (وهو الطور الذي ظهرت به تحية في آخر مراحها، الاحتفاظ بلقبي الراقصة والحاجة دون شعور بأن ثمة تلفيقًا أو نفاق المضمون للشكل، فالمجتمع الذي كان مفتوحًا ويسمح بالاختلافات والتيارات المتباينة، تحوّل إلى مجتمع شبه مغلق، متشنج في صراعاته وخلافاته (على نحو ما عبّر العرض المسرحي يحيا الوفد) و أيضًا مائل إلى الظلامية والعنف اللفظي (النكات السمجة في المسرحية / شتائم تحية كاريوكا لزوجها فايز حلاوة) والمادي (مقتل السادات على سبيل المثال)، وكأن هذه الصورة بمثابة رؤية تنبؤية لما سيصير عليه المجتمع المصري من تحوّل بتأثره بأموال وثقافة العائدين من بلاد النفط، ومن ثم سعى لقراءة الأسباب التي جعلت منها “أروع راقصة شرقية على مر الزمان”، كما وصفها، فزَاوَجَ إدوارد سعيد في قراءته لشخصيتها التي خرجت من وسط اجتماعي فقير إلى حد ما، وإن كان لها باع كبير في السياسة، فعمها قتله البريطانيون. وبين أدوارها المتعدّدة الثقافيّة (لعبت دورًا مهيمنًا في تشكيل الثقافة المصرية)، والنضالية (نشاطها السياسي والنقابي)، وشخصيتها الفنية كراقصة حيث لا تنتمي إلى راقصات الطنطنة أو “فتيات البار أو الساقطات”، وإنما تنتمي برقصها البديع، وهالتها الرهيبة إلى “عالم النساء المتحررات اللواتي يتجنبن الحدود الاجتماعية الضيقة أو يزلنها، فهي مرتبطة بمجتمعها أكثر” ومن ثم فهي عنده تنتمي إلى “فئة العالمة” التي تحدّث عنها الرحّالة الذين زاروا مصر في القرن التاسع عشر.
لم تكن المقالة مجرد قراءة سيمولوجية لبويطقيا الجسد، وإنما اتخذ من الجسد البوابة لقراءة تاريخ مصر وتحولاتها السياسية، عارضًا لمسيرتها الفنية والسياسية، والأدوار التي لعبتها فنيًّا وسياسيًّا ونقابيًّا، فكان جسد تحية كاريوكا بالإحلالات والتغيرات البيولوجية (كبر السن / والبدانة) والشكلية (بدلة الرقص والحجاب) مرآة لتحولات المجتمع المصري. ثم عاد إلى تحية كاريوكا مرة ثانية عندما كتب مذكراته “خارج المكان” (1999) واصفًا تأثير رقصتها الإيروسية عليه في مراهقته التي “تثير الغرائز الحسيّة، لكنها تبقى نائية يستحيل على المرء نيلها”.
جاءت العودة إلى تحية كاريوكا في المذكرات في إطار ذكريات المراهقة والشباب، وقد كانت هذه الذكريات ربما هي الدافع الأساسي للزيارة في مرحلتي النضج والكبر، فالصورة التي التصقت في ذهنه في مراهقته عن الراقصة لم تتغير، باعتبارها رمزًا للإغواء غير المصطنع، والرقص البعيد عن النطنطة والصخب، ففي مراهقته كانت صورتها هكذا على نحو ما صوّر في المذكرات “إنها تحية كاريوكا أعظم راقصات زمانها، ترقص، ويرافقها جلوسًا المطرب عبد العزيز محمود، فتلتف حوله وتتلّوى ثم تدور حول محورها باتزان محكم إلى حد الكمال. وكان ردفاها وساقاها ونهداها أبلغ بوحًا من كل ما حلمتُ به أو تخيلته في نثري الاستمنائي الفظ، وتنضح بشهوة فردوسية. ولمحت على وجه تحية بسمة تنم عن لذة متفلّتة من كل قيد، يعبر فمُها المفتر قليلاً عن نعيم النشوة، يلطف منها مزيج من السخرية والتمنع يصلان حد الاحتشام” (خارج المكان: ص 242)
يحتفظ بهذه الصورة الباذخة في ذهنه إلى أن يعود إليها في البورتريه الضافي، فيؤكد أنها “أروع راقصة شرقية في كل الأزمان”، العجيب أن هذه القناعة لم تتغيّر على الرغم من أنها صارت في “الخامسة والسبعين”، فهي على حدّ قوله ما زالت “فاعلة في حقلي التمثيل والتحريض السياسيّ”، والأهم أنها “ستبقى – أسوة بأم كلثوم – الرمز الملحوظ لثقافة قومية”، هذه هي النقطة الفاصلة التي يكتب من أجلها البورتريه والتي تعود بإدوارد سعيد إلى اهتماماته، إذن هو يريد قراءة الواقع بكل إشكالياته السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، عبر تحولات الجسد.
يرصد إدوارد سعيد لتحية كاريوكا بعض السمات التي جعلتها عنده من أروع الراقصات، فقد جسّدت في أوج أيامها “نمطًا خاصًا جدًّا من الإغراء، هو الأشد سلاسة والأقل تصريحًا من بين مجموع الراقصات، وهو – في ميدان الأفلام المصرية – نمطٌ شديد الوضوح للمرأة التي تفتك الناس بسحرها” (إدوارد سعيد: “تحية إلى تحية”، ص 91)، فعبر رقصتها الهادئة التي كانت تؤديها راسمة على وجهها ابتسامة هادئة، تكشف عن سمات الرقص الذي يتوازى مع فن مصارعة الثيران “لا يتمثل في كثرة الحركات التي يقوم بها الفنان، بل في قلتها”، فجوهر الرقص العربي يتمثل في إحداث الأثر عن طريق الإيحاء بشكل أساسي (لا حصري)، أما عن جمال رقصها فيكمن “في تكامله؛ في الإحساس الذي تنقله إلينا بجسد مذهل في لدونته وتناسقه، جسدٍ يتماوج عبر سلاسل معقدة (وإن كانت تزيينية) من العوائق المصنوعة من الشاش والأحجبة والقلائد والأسلاك الذهبية والفضية، التي كانت حركات تحية تنفخ فيها الحياة عمدًا” (إدوارد سعيد: “تحية إلى تحية”، ص 92).
ينسب تحية كاريوكا إلى عالم النساء المتحرّرات اللواتي يتجنبن الحدود الاجتماعية الضيقة، أو يُزلنها، كما إنها ارتبطت بمجتمعها ارتباطًا عضويًّا حيث اكتشفت لنفسها دورًا آخر وأشد أهمية كراقصة ومغنية، إنه دور العالمة، وهو الدور الذي تحدّث عنه الرحالون الأوروبيون، فالعالمة ذات إنجازات كثيرة، فالرقص واحد من هباتها المتعدّدة التي شملت “المقدرة على الغناء، وقراءة الشعر القديم، والتحدث اللبق”(إدوارد سعيد: تحية إلى تحية: ص 93).
يستعرض تاريخها الفني، وأدوارها التي قدمتها ومنها الاسم الذي اقترن بها (العالمة)، منذ الدور الذي أدته في فيلم “لعبة الست” (1946)، ثم فيلم “شباب امرأة” (1956) الذي تؤدّي فيه تحية كاريوكا دور الأرملة القاسية والمتعطشة للجنس، ولا ينسى تاريخها الشخصي، فيسرد لميلادها وعائلتها، ودور بديعة مصابني في تعليمها الرقص، وزيجاتها المتعدّدة، وعلاقتها المتوتّرة بزوجها الأخير فايز حلاوة (يكتبه فايق حلاوة) واستنزافه لها ماليًّا، وغيرها من أمور شخصية تكشف حجم معاناتها في سبيل الوصول إلى مجدها. لكن حُبّه لتحية جعله يأمل في أن تظل ترقص إلى الأبد، إلى أن تحدث الصدمة بعد عودته إلى مصر في صيف عام (1975) بعد غياب خمسة عشر عامًا، وكانت آنذاك تلعب دورًا في مسرحية “يحيا الوفد”، كانت المسرحية مُؤدلجة، تحمل شعارات سياسية زاعقة تتحامل على عبد الناصر في مقابل مجاملة السادات المنتشي بنصره، وبالأحرى هي تجسيد حي للمناخ العام بعد أن تغيرت بوصلة السياسة المصرية من المعسكر الروسي بعد أن طردهم السادات، وراحت تطرق أبواب المعسكر الرأسمالي الأمريكي.
الدور السياسي الذي لعبته في المسرحية كان نقيضًا للدور الحقيقي الذي لعبته في الحياة العامة، فهي كانت في الأربعينات والخمسينات شديدة القرب من الحزب الشيوعي، وفي عام 1988 كانت من الفنانات اللاتي وقفن إلى جوار الحق الفلسطيني، والتحقت بسفينة العودة الفلسطينية، إضافة إلى دورها في نقابة المهن التمثيلية. هكذا أعاد إدوارد سعيد ترسيم الخريطة السياسية المصرية وتحولات الثقافة والمتغيرات التي حدثت خلال حقبة السبعينات والثمانينات عبر قراءة (جمالية – ثقافية) لتحولات جسد تحية كاريوكا. فلم يكن جسد كاريوكا سوى المرآة التي عكس من خلالها الواقع وما حاق به من إحلالات وهيمنة وزحزحة لمركزيات، وهدم لإمبراطوريات.
بعد استعراض عَلاقة المفكرين بهؤلاء الفنانات أو سارقات النار لو أحلنا لقب بروميثيوس عليهن (إن جاز بالطبع)، فهن أيضًا عطفن على البشر لا بالنار التي سرقها بروميثيوس من الآلهة، ومنحها لهم كي ينتفعوا بها، بل بما مَنحن البشرية من جمال ورقة ومتعة، نتساءل: هل وقع المفكرون أسرى سارقات النار؟ الجواب، بالطبع نعم، وكانت النتيجة أنهم بعد أن “نهلوا” من فيضهن كتبُوا أجمل بورتريهات عن اللاتي سرقن لبّ الجمهور، وعقول المفكرين، وقبلها أرواحهم، وبقدر ما كشفتْ هذه اللوحات الفنيّة / أو الصُّور القلميّة عن مبدعات (فنانات) جابهن واقعهن وتحدين كل الظروف ليبقيْنَ كالفراشات في وسط الضوء، غير مباليات بوهجه، أو حتى باحتراقهن، دون أن التخلي عن قوة التأثير في المحيطين، إلا أنها كشفتْ في المقابل عن رهافة حسّ المفكرين وتأثُّرهم بالجمال بكافة صوره، ومن ثمّ قدرتهم على تطويع كتاباتهم استجابة – أولاً – لقوة تأثير الجمال عليهم، وثانيًا، لأحاسيسهم التي خضعت ولانت لسلطة الجمال، لذا كانت البورتريهات كاشفة عن قوة التأثير، وأثره ليس فقط على الجمهور العادي، بل على المفكرين أيضًا، الذين وقعوا تحت سطوة قوة التأثير.
……………………………………………..
*نشرت في جريدة أخبار الأدب المصرية، عدد(30 أكتوبر 2022)، بمناسبة الذكرى 49 لوفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين (28 أكتوبر 1973).