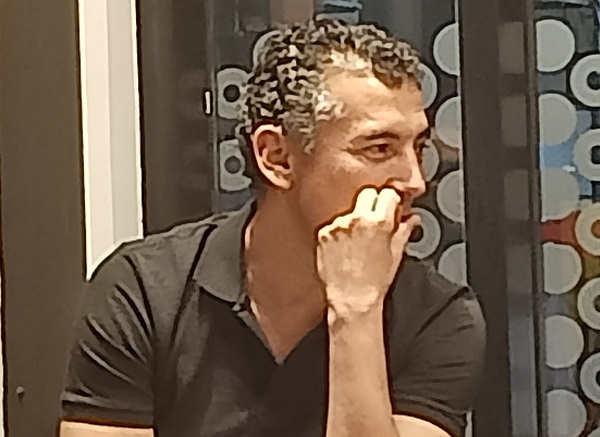ويبزغ السؤال: هل التقاليد هي السبب؟ أم أن بعض التيارات المتشددة هي التي صنعت تلك الحالة؟. المتتبع للمشهد، يجد أن بعض المتحدثين باسم الدين صدروا المشهد، ورسخوه عبر المورثات التي يكن لها أغلب الشرقيين احترام شديد، لكن الغرابة، أن الأمر لا دين به ولا تقليد. وبالعودة إلى صدر الإسلام، حيث عنفوان الدين، نجد أن حادثة الهجرة الشهيرة للمدينة، كان أحد أهم أركانها، السيدة أسماء بنت أبي بكر، التي قامت ببطولة تسجل بمداد من نور، على صفحات الذهب، في شجاعة المرأة، وإقدامها، غير آبه بكلمة تتناثر، أو قول يُعاد. فقط دورها العظيم، الذي وُكّل إليها، وأدته على أكمل وجه، ماخره عباب الصحراء، تجابه وحشتها، وتوصل الطعام لنبي الإسلام وأبيها، وتربطه بإزارها، حتى تعرف بذات النطاقين. لم يتحدث الصحابة حينذاك قائلين: “ايه اللي وداها هناك”، أو انتقدوا اختيار سيدة، بدلاً من رجال، وأبناء أبي بكر كثر، ولا تنقصهم حصافة، أو جرأة.
وبالغوص أكثر في أعماق السيرة النبوية، التي يتناسى البعض أحداث مشهورة منها، تعرج على قيمة المرأة في المجتمع الإسلامي المزعوم، حيث كانت السيدة فاطمة الزهراء، حب النبي، وابنته الأقرب إلى قلبه، تتحمل مسؤولية أسرتها في إباء، أسرة رجلها علي بن أبي طالب، وأبناء هما الحسن والحسين، ومع ذلك، كانت تتولى بذاتها، طحن القمح والحبوب بالرحى، حتى أنهكها العمل، وشق عليها كل تلك الأعمال، فذهبت لأبيها رسول الإسلام، تطلب منه خادمة، تعينها على أمور دنياها. من يحلل هذا المشهد، في عصرنا هذا، مع اختلاف أسماء وألقاب، ونسيان هالات مقدسة، قد يذهب إلى توبيخ تلك الزوجة، التي سأمت العمل، وطلبت خادمة تساعدها.
الأمر أصبح مختلطاً، الصواب غائب، والخطأ ذائع، والشخص البسيط في حيرة من أمره، هل يقسو على امرأته، ويمنعها حقوقها، بوازع ديني زائف، ورسوف في تقاليد مغلوطة، أم ينفتح، ويطلق عليه ممن يتحلقون حوله، ألفاظ نابية. فلدينا في المجتمع المصري على وجه الخصوص، والعربي بشكل عام، ولع بفكرة سلوك أقصى اليسار، أو ولوج أقصى اليمين، أما نقطة الالتقاء في المنتصف، والوصول إلى الفكر الوسطي، الذي هو في الأصل يعبر عن فكر منطقي، غائب عن أذهان كثيرين، بتنحية العقل، والإذعان لما يقال.
كما أن الخوض في قضايا فرعية، مثل ضرورة الختان، وصوت المرأة الذي لا يجب أن يُسمع، وإرضاعها لزميل الغرفة، وعقلها الناقص، ودينها المنقوص، يجعل الأمر يبدو في منتهى السخف، ويبتعد عن جذر تكريم المرأة، وحظوتها حيز مرموق في أي مجتمع يروم التقدم، ويدخل في قشور، مجتثة لا تسمن ولا تغني من جوع. فالأنثى الزوجة والأم والأخت والابنة، هي صور في النهاية تنصهر في بوتقة واحدة، مشكلة إطار المجتمع، وراسمة مستقبل الأمة.
المجتمع الذي يقول “مرة” ولا يجري على لسانه الهمزة التي تجعلها امرأة، أو يكرر كلمة الحرمة، ولا يعرف أن الحرمة الحقيقية في أن ينتقص من دور المرأة، ومن كيانها الإنساني في الأساس، ويدهشني للغاية، من الذي يحجرون على زوجاتهم، ظناً منهم أن نجاحهم ينتقص من قدرهم، رغم أنه كما تقف سيدة عظيمة خلف كل رجل، فإن رجل عظيم تتسند عليه كتف المرأة. الاثنان لا غنى عنهما، ولمّا خلق الله البشر، خلقهما معاً لحكمة، ليعيشا معاً، لا ليعيش أحدهم، وتعيش الأخرى تابعة له. ويهالني أن أقابل أب يستاء من خلفته للبنات، لأنهن – كما يهيأ له – لن يحملن اسمه، مع أن الفتاة يحلق باسمها الثاني اسم الأب، ونجاحها نجاح للأب، كما هو نجاح للفتاة، والزعم بأن الفتاة ضيفة في المنزل، حتى يحملها زوجها، زعم من شأنه أن يحقر من قيمة الأنثى، ويوطأ لفكر يتسم بالتخلف.
الحل في رأيي يكمن في الحب، تلك الكلمة التي باتت مجرد كلمة، يتغنى بها فقط، وتستعمل كثيراً في السينما، لكن لا يقدم أحد على تطبيقها على أرض الواقع. لقد قال أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته الشهيرة مضناك جفاه مرقده: ويقول يكاد تُجنّ به فأقول: وأوشك أعبده. فالشيء الوحيد الذي أراه يمكن أن يصمد أمام أي معول للهدم: الحب.. أن تحب بصدق من الأعماق، أن يخفق قلبك خفقة القلب التي تفوق السيول في جريان مائها. وقتئذ سوف تلتمس للمحبوب كل فعل، وتختلق له كل سبيل، وينزوي الإحجام بعيداً، وترى البينة على حقيقتها، وتنظر بعين يتوارى فيها التحفز، فهي قدس الأقداس الذي في محرابه يكون التعبّد، واعتناق الدين المختلف.. دين الحب؛ فكل ابتسامة لها تراها الأكثر سحراً، وكل حديث تلفظ به هو الأعذب، وكل تصرّف تقدم عليه هو الأصح فعلاً، وكل خطوة تحثها مثل يُحتذى. فكما قال مولانا ابن عربي: أدين بدين الحب أنّى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. وإن كان التحدّث عن نظريات العقل وإعمالها، فيكون ذلك غائباً في الحب، فالمخ هنا يتلقى إشارات العمل من عضلة تنبض بالحياة.
الحب هو الحل الأوحد، الذي يجعلنا نرى المرأة ببصيرة نافذة، لا بأعين عليها أقفالها، ويقيض لنا حب الحياة، فالأنثى تجلي للحياة في أبهى الصور.