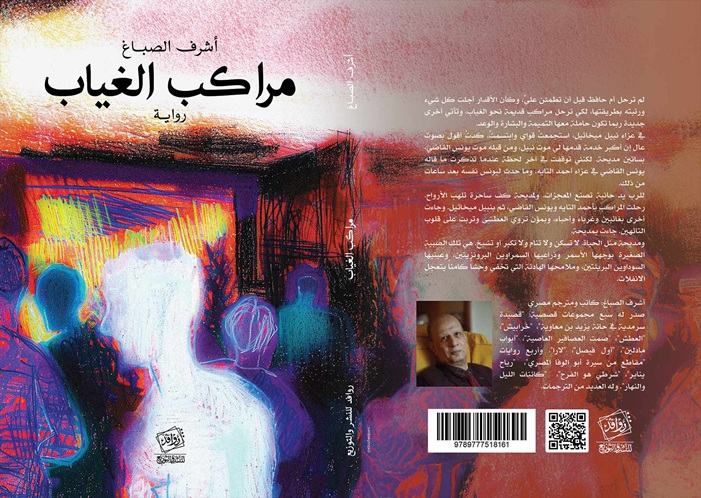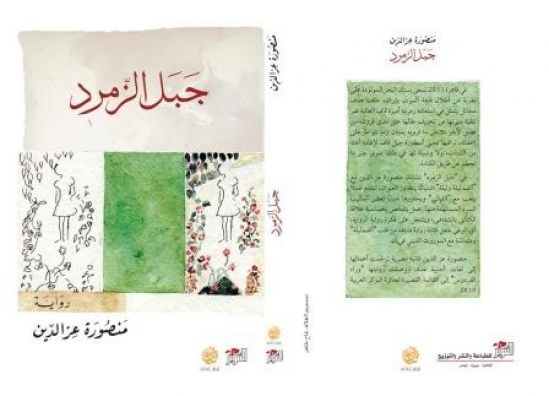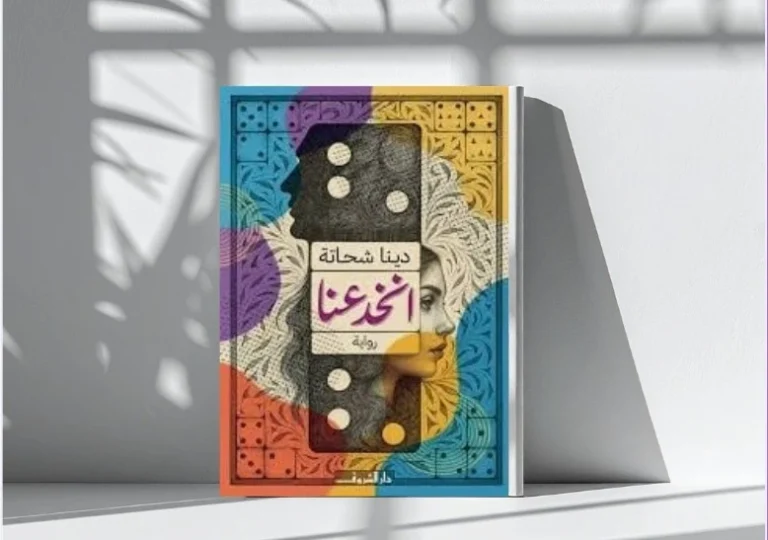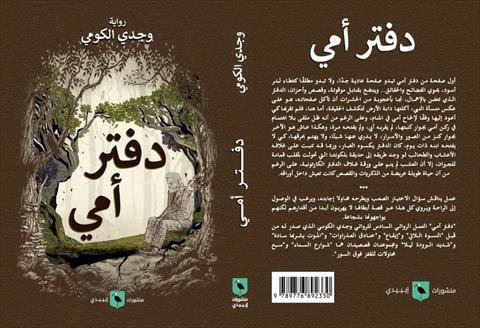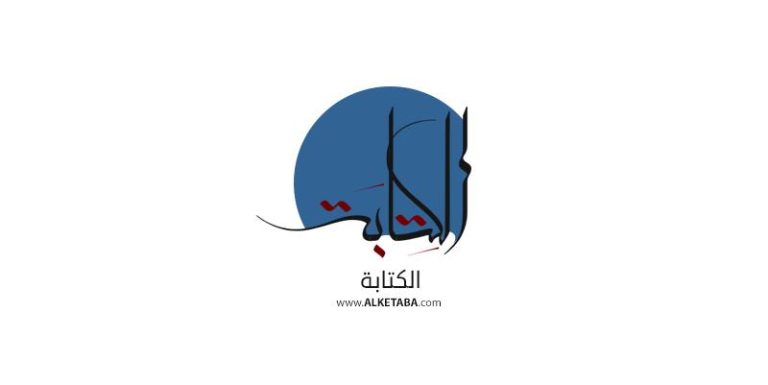| رشيد برقان | |
| قدمت هذه الورقة بمناسبة الحفل الاختتامي لمشروع جمعية أبعاد ـ مراكش حول “القراءة أداة لترسيخ المواطنة” يوم 17 ماي 2013 بخزانة ابن يوسف مراكش. | |
تمهيد:
تنزع كل تجربة إبداعية نحو السير في مسارين مختلفين، يظهر أولهما في الانضباط لإكراهات الجنس الأدبي، حتى تستحق الاندراج تحته. أما ثانيهما فيظهر من خلال الهروب عن هذا المسار لتخطّط التجربة فرادتها وتعلي إيقونتها الخاصة. وتبدو التجربة القصصية للأستاذ محمد زهير، فضلا عن إمتاعها، مغرية، إذا تستفز القارئ الفطن، من خلال ماتقدمه من إمتاع، وتعاند الناقد الملحّ على التأطير والتصنيف[1]؛ فالقراءة المتعددة والمتأنية للمجموعة القصصية “أصوات لم أسمعها” تخلق تنازعا بين مكونين أساسيين في المجموعة يمكن تسميتهما على التوالي المكونات المختلفة والمكونات الموحَّدة؛ فالمجموعة يوحّدها جنس القصة وفق ما نجده في النص، ووفق ما أشّر عليه صاحب النص في الغلاف. ولكن امتداد زمن القراءة يكشف عن تنوع واختلاف في القصص يمكن على الأقل الوقوف على أربعة أنماط من القصص تجعل هذه التجربة متفردة وغير قابلة للحصر في مجال ضيق. ويتعلق الأمر ب:
- القصص الواقعية[2] أي التي تتخذ من الواقع اليومي البئيس والسوداوي موضوعا لها. ونذكر في هذا الصدد “الوليمة” و”الرديفان”. ونجد في هذا الصنف قصصا تنهل من الذكرى، خصوصا لحظة الطفولة، كما هو الحال في “شرفة على الماء”، وأخرى تعود إلى الماضي، أو الزمن البعيد، خصوصا “أصوات لم أسمعها”، و”إيكاروس”؛ وهي قصص ذات شحنة حنينية قوية جدا مفعمة كلها بالأسف وعنف الذكرى.
- القصص الخيالية المحضة التي تسبح في عالم أسطوري معلن عن مفارقته لمنطق الواقع، خصوصا حينما تتحدث عناصر الطبيعة، وتكتسي حلّة من العواطف الإنسانية هي التي تفسر حركتها وتحدد هويتها. والمرجع هنا هو قصة “ألوان الطيف” ذات البعد الخرافي.
وهناك قصص خيالية تكتسي طابعا تاريخيا توثيقيا تسافر في خطوط توازي بين روايات مختلفة لحدث واحد تراوح بين راو شفوي، وآخر شعبي، وثالث عالم هو المتحكم في دواليب السرد، وهو الذي يستمرئ لذة إلقاء الحدث في بحر الرواة ليرى كيف سيتم تمثّله، وإلى ما سيؤول. وتقع الإحالة هنا على “أنوار الشموس”.
- وهناك نمط ثالث من القصص ذات بعد تأملي خالص، يفسح السارد فيها مجالا كبيرا لتأملاته الخاصة، و ينحت عالما من القيم والمثل لايمكن أن يلجه إلا من باب الخيال الممتع. ويمكن أن تقف هنا عند “تنازع” و”السفر”.
- نمط رابع يمكن أن نسميه “القصة اللغز”؛ وهو عبارة عن قصة تسير فيها الأحداث نحو نوع من القدرية التي يفرضها السارد على الأحداث من أجل أن تمكّنه من حل لغز سبق أن طرحه وواجهه في بداية القصة، مثلما نجد في “خفق الغيم”.
وإذا نظرنا إلى هذا التنوع والتعدد في أنماط الكتابة القصصية، وأضفنا إليه مجموعة من المؤشرات، من مثل كون المجموعة القصصية “أصوات لم أسمعها” هي باكورة إصدارات الأستاذ الإبداعية، وليست باكورة أعماله؛ إذ إن تجربته القصصية تمتد لما يزيد عن الأربعين سنة، ولكنها بقيت منثورة في الجرائد والمجلات. وهذا مؤشر، وهناك مؤشر ثان هو كون القصص غير مذيلة بتاريخ كتابتها أو نشرها الأول.
تمكننا هذه المؤشرات مجتمعة من القول إن المجموعة القصصية “أصوات لم أسمعها” منتقاة إذ إنها ليست كل الأعمال، ولكنها فقط الأعمال التي وقع عليها الاختيار لكي تكون الأصوات التي لم تسمع بمافيه الكفاية، وإلا فإن المسموع أكثر.
وفضلا عن الانتقائية يبدو أن تدخّل الكاتب كان يهدف إلى تعمية الفروقات الموضوعية بين القصص، لكي تتوجه القراءة رأسا إلى المنتوج في كليته، وأن تنظر إليه بوصفه عملا أدبيا متماسكا موحّدا، أي نصا. وفي هذا مؤشر على أن الكاتب ينظر إلى تجربته ككل متناغم، ولا يؤمن داخلها بالقطائع، على اعتبار أن الذات المبدعة، وإن نهلت من مصادر شتى، فإنها تصهرها كلها وتصدرها في آخر المطاف مدموغة بمياسم عامة هي ما يشكل فرادة التجربة وخصوصيتها. وكأن الكاتب، من خلال هذه العملية، يفصح لنا عن تعريف للإبداع يتجاوز القواعد والقوانين، وينفلت من أسرها ليفصح عن الذات التي تبقى واحدة سواء في مواجهة الواقع أو في مواجهة الذات أو الذكرى.
- بصدد الموضوعات
- الواقع بين الحضورالغياب
يلاحظ القارئ للمجموعة أن الواقع لا يحضر إلا قليلا في النصوص، فالكاتب يتعمّد الهروب من الواقع الحاضر نحو الذات أوالذكرى أوالخيال أوالتأمل؛ وحتى عندما يحضر هذا الواقع يكون ملفوفا بغلالة ضبابية قاتمة، يقول: « المساء مضبّب، والأصوات باهتة. الشمس انحدرت إلى مغيبها، وتركت الزمن البارد يثخن في المكان وفي الأحاسيس. المساء والضباب والبرد اللاسع والسفر.. والقطار إذا عبر يتركك نهبا لغربة موحشة، تشعر معها كأنك ريشة في مهب الريح ..»[3]. وفي قصة الرديفان يقول: « وفي ليلة خريفية، وأنا أجاذب أرقي المزمن، نفذ من دغل الليل الكثيف صوت شارد ينشد قصيدة ابن زريق البغدادي الأسيانة:»[4].
والقصة التي نجد فيها تماثلا بين أحداثها وأحداث الواقع هي قصة “الوليمة” حيث تنقلنا إلى عالم هامشي ناءٍ حاول فيه “سعيد الفرحان” أن يكون سعيدا فعلا دون أن يفلح. لهذا عاند الواقع، وحقّق رغبته الأخيرة، وسار نحو مصيره المأساوي؛ فسعيد موظف بسيط في الطرف النائي من المدينة، يتوزع راتبه بين الضروريات، دون أن يسمح له أن يحلم حتى بليلة يحتفل فيها مع زوجته.
لقد قبل السعيد السكن في أطراف المدينة، وخضع للمواضعات الاجتماعية، وانخرط في نظام العمل الاجتماعي، وفعل كل ماهو مطلوب من شاب متعلم في مجتمع مديني حديث دون أن يحقق أحلامه. وهكذا حين تصارعت داخله الضرورة المجتمعية، والرغبات الذاتية اختار ذاته، وحقّق أحلامه، وانحدر نحو الهاوية، متماهيا مع البطل الإشكالي، راسما صورة لواقعية سوداوية، حتى وإن لم تظهر في القصص كلها، فإن ضلالها تمتد إلى كل المجموعة القصصية، وإن اتخذت تجليات مختلفة ومتنوعة تراوغ دائما الواقع الحاضر دون أن تفلح في الإفلات منه.
- حيوية الخيال
إذا بدا حضور الواقع الحاضر في هذه المجموعة ضئيلا سوداويا، فإن التخييل يحتل حيزا مهما في المجموعة، بل يعدّ هو المجال الفسيح الذي يتيح للمجموعة أن تتنفس هواء الحرية، وتحسّ بالانطلاق، وأن تعانق قيما تتجسّد وتحاور، بله تشاكس الشخصيات الواقعية؛ ففي قصة “تنازع” يحاور السارد ويراود الإلهام الذي يبدو أولا شخصية، ثم ما يلبث أن يتحوّل إلى قيمة يراودها السارد عن نفسها، ويريد انتزاع سرّها.
وفضلا عن مراودة القيم ومحاورتها يحضر الحلم كثيرا في المجموعة بوصفه مظهرا مغايرا للواقع، ومجالا متحررا من قيوده؛ ففي “شرفة على الماء” تعمّد الصبي النوم في بيت “للاحليمة” واعتمد على الحلم ليشبع شغفه وحبه لهذه المرأة؛ يقول:
« وكانت تلك أول ليلة أنام فيها في بيت للاحليمة، قريبا من ابنها سعيد.. رأيتها في الحلم مرارا، تأخذ بيدي وتداعبني وتحضنني وتعطيني الليمون والكعك والرمان .. رأيتها تحت شجرة ظليلة تدعوني، ورأيت سعيد يسرع إليها قبلي، فتأخذه وأجري خلفهما، ورأيت زوج للاحليمة يصلّي وأمي تناديني وهي تمسك بإظمامة نعناع أخذتها من أبي، ثم وهي تحتضن سمية أختي، وسمية تبتسم لسعيد، وأنا اسأله أين عوينتي للاحليمة، فيمضي ولا يلتفت إلي»[5]. وإذا لم يسعف الحلم الطفل هنا، فإنه في قصة “خفق الغيم” سيسعف السارد في فك اللغز، وفي تعويض التعثر الذي أصابه جرّاء عدم تعرّفه على صديق طفولته ومفتاح لغزه؛ يقول: « وفي حُلمي جاءني طيف يوسف الطيفي متلبسا بطيفي، وبطيوف أصدقاء قدماء آخرين، لا يعبرون لماما إلا في الأحلام فقلت له:
ــــــــ اعذرني يا يوسف فالزمن يفترس العمر فيفترس وهج الحضور.
فقال لي:
ــــــــ عذرتك يا ….
وبدا مترددا في تذكر اسمي كأنه نسيه !.. فابتسمت، وقلت له بدوري:
ــــــــ لاترهق نفسك، فالذاكرة بياض كالأعظم النخرة»[6].
وكما يبدو من خلال هذا المقطع فإن الحلم مكّن الشخصية، ليس فقط من تذكر صديق الطفولة، بل نقل عطب النسيان إلى يوسف الطيفي، في حين أنه هو الذي التقى السارد، وهو الذي عرّف بنفسه. يقول:
« قبل أيام التقاني في الشارع صديق قديم، من زمان الدراسة الأولى، ناداني باسمي فصيحا صريحا، فأحسست من ندائه عمق معرفته، ولكنني لم أتذكره. عتمة الذاكرة لم تسعفني، فاكتفيت بالابتسام..
– ألاتذكرني؟ أنا يوسف الطيفي .. كنا معا في مدرسة باب الخميس..
– إيه .. يوسف الطيفي.. يوسف الطيفي..
حاولت استعادة المتسرب والنفاذ إلى المترسب .. ضوء شاحب راعش في العتمة، وخلاله ينبثق خيال طفل هزيل أسمر قصير، لا علاقة له بتاتا بالرجل الطويل الصلب المتين، الذي التقاني ..
– إني أكاد أراك من بعيد ..
– ولكني لم أخطئك..
وتحاضنّا .. قلنا كلمات محدودة متلعثمة من جهتي، فصيحة من جهته، وصار كل منا في طريق .. »[7].ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويبلغ التخييل قوته وقمة عنفوانه مع أنسنة الطبيعة، وإضفاء قيم وتصرفات إنسانية عليها في عملية تفسير حركات الطبيعة وفق منطق أسطوري يرى في العالم مجلى للعلاقات الإنسانية المعقدة؛ فقصة “ألوان الطيف” تفسير أسطوري جميل لعلاقة الشمس والبحر انطلاقا من ملاحظات حقيقية، وتفسير إنساني لها يستحضر منطق الحب، وما يحوم حوله من أحاسيس وانفعالات جياشة.
والقصة في صورتها هذه تعود بنا إلى التفسير الأسطوري للعالم، وتستعيده بجمال وتألّق ينافي إخفاق التفسير العلمي وجموده، وتفسح المجال لقوى صغيرة ضعيفة، مثل عباد الشمس، أن تطمح وتصرّ على طموحها، وأن تعاند قوى عظيمة مثل البحر، وتزرع بذرة الغيرة والحنق في قلب البحر الذي يكتفي برعونته وقوته لغزو العالم، بما فيه قلب الشمس. في حين أنها لاتطلب، فيما يخص الحب، إلا اهتماما وكلاما جميلا؛ تقول الشمس عن عباد الشمس مقارنة بينه وبين البحر:
« الولد رسمني بإحساس في نفسه، وأنا زدت ألوان صورته ابتهاجا، لأنه مسّ شغاف نفسي، ولد هشّ يحسن التغزل بمحاسني، ويجيد الرسم. ينتظرني في كل صباح، فأعود إليه ولا أخلف الميعاد، ويلازمني مسكونا بالحكاية التي أغوته، فأرى في صورته صورتي التي كانت تلهم العشاق.
أما البحر فقوي، يستقبلني في السرير ولا يحسن عبارات الغزل، يأخذ مني ولا يمنحني. لذلك أغادر سريره كل صباح، ولا أعود إليه في المساء إلا وأنا متعبة مرهقة.»[8]
وإذا كان التفسير الأسطوري للعالم قد ظهر نتيجة الرغبة في امتلاك الطبيعة، ونتيجة لضعف المنطق العلمي، فإن استعادة هذا النمط من التفسير، عبر بوابة الإبداع والسرد، تطرح أكثر من سؤال. ويبدو أن الرغبة في القبض على اللحظة المارقة وامتلاك الزمن هي التي تجعل المثقف يوقظ اللغة من سباتها، وينفث فيها حياة وحيوية لا تزال كامنة تحت رماد يحتاج إلى نفخة أو نفحة مبدع. وكل هذا بحثا عن توازن نفسي بين أحلام الذات وضغوطات الواقع.
ولعل من شأن هذا الالتجاء إلى الأسطورة أن يعود بنا إلى ضغط الواقع ورغبة الذوات في امتلاك الزمن؛ فليس العلم وحده الأداة التي ابتكرها الإنسان لمصارعة الزمن وقهر الوقت، ولكن الخيال قادر على إبداع وسائل جمة تعاند الزمن وتخفف ضغط الواقع، وتسمح للانسان بالهرب من قدرية الواقع، وما يمارسه على الذوات من إرغامات.
وفي آخر المطاف لامناص من الإقرار أن الإنسان كائن حر، وأن المبدع هو الأكثر حساسية تجاه هذه الحقيقة، والأكثر إلحاحا في طلبها. لهذا فكل الوسائل ممكنة، بل هي مشروعة من أجل أن يتبوأ الإنسان مقعدا تحت سماء الحرية البيضاء. ولابدع والحال هذه أن يلجأ المبدع إلى الخيال والأسطورة التي تشعره بالحرية والحيوية الخاصة بالكائن الإنساني الذي يرفض كل الإكراهات والإرغامات، ويلح ويصرّ، إن كان لابد من قيد، أن يكون عبدا للحب. أوليس العلم، في حد ذاته، إرغام وإخضاع للانسان بمنطق الطبيعة؟
وفضلا عن ماذكر تمنح الأسطورة المبدع فرصة لاكتشاف ذاته والتعرف عليها؛ فقد بات من الواضح أن العلم لايقدم تعريفا شافيا للذات، وأن الظلال المجهولة من ذات الإنسان لاتزال خارج الدائرة التي يستطيع محاصرتها. وأنه لايزال على عاتق المبدع أن يحلم ويغامر خارج الحدود المألوفة من أجل القبض عن النقطة التي لمّا تزل غامضة مبهمة، وأن الأسطورة، في هذا الصدد، هي خير معين.
- قصة اللغز أو متعة الكتابة:
شكّل الحدث وكيفية إدارته وتدبير مساراته إحدى الأسباب الأساسية التي تفجّر المتعة وتشدّ المتلقي، وتجعله أسيرا لمآلات يقدرها السارد على شخوصه. ولعل الحدث الأكثر بروزا وشدا للانتباه هو ذلك الحدث اللغز والملفوف بغلالة من الغموض كلما زادت وتكاثفت كلما ازداد انتظار المتلقي وتتبعه. وقد نال هذا النمط من الحبك حظا من مجموعة “أصوات لم أسمعها”، خصوصا قصة “خفق الغيم” وإلى حد ما “أنوار الشموس”؛ ففي “خفق الغيم” يعثر السارد على ورقة ملغومة غير واضحة المعالم، لا من حيث المصدر، ولا من حيث المحتوى، ومنذ لحظة قراءتها تصبح هذه الورقة هي الهاجس المؤرق للسارد. وتتشابك كل الأحداث حول فك لغز الورقة دون أن يفلح السارد في ذلك، يقول: « واتجهت إلى البيت منعطفا عن الموضع الذي لقيني فيه يوسف الطيفي.. في يدي لوحة جمال ملفوفة داخل جريدة، وفي نفسي يضطرم شوق غامض الأسرار… سآرق هذه الليلة أيضا، ولا أعرف ما سيكشف عنه ضوء الصباح ..»[9]
ويتسم حضور اللغز في قصة “أنوار الشموس” بطعم مختلف؛ إذ إن السارد لم يعد ضحية لغز عثر عليه، ولكنه هو ناصب الشرك حيث أوقع فيه مجموعة من الشخصيات ليربح هو متعة التلقي والتأويل، ويتمتع بتدخلات الشخوص في متن هو الذي وضعه بين أيديهم؛ فالقصة تحكي عن مخطوط كان “خالد الكتبي” يعتقد أنه عثر عليه، في حين أن السارد هو من وضعه في طريقه؛ يقول: « أطلق خالد الكتبي العنان لخياله، فنسج الحكي على هواه، وذلك قصدي. بعته المخطوط بطرقي، وها أنا “سعيد الطائي” أستعيده منه بطرقي. بعد أن سار ذكره وصار بؤرة ألغاز. فكم نسج خيال “خالد ” الكتبي من حكي، وكم أغرى غيره، ومنهم “سليمان” الراوي بنسج حكي آخر. فتمتد الحكاية وتتشعب، وينسخ بعضها بعضا كالكتابة على صفحة الماء، الذي يشرب الحكاية ونشربها نحن إذ تشربه، فتتناسل وتمتد بلا نهاية»[10]. ثم بعد ذلك سيكمل السارد “سعيد” الطائي لعبته عندما سيعهد بالمخطوط إلى طالب من أجل نسخه، ليس لغرض النسخ، ولكن ليثير عواطف الشاب الطالب ويستخرج أحاسيسه؛ يقول: « عرفت قصده، ورضيت، سلّمته أوراقا مهلهلة النسج، لايستقيم لها مسار، محكيها مداور مقطّع الأوصال، كثيرة الشطب كثيرة الأعطاب .. فلملمها بخيوط عشق غائر يسكنه. اتخذ الأوراق ذريعة للقول عن نفسه. سرّب إلى المنسوخ ما في ذاته، فكتب عن ذاته بين مسار مكتوب الرملي، وعلى محمله، الذي ركبه إلى أقاصي نفسه. مازج ذاته بذات الرملي، واجدا معناه في معناها. مازج الكتابة بالكتابة، كما لو كان على موعد معها. وجد منافذ البوح لما في نفسه، فباح بصبوته، فتداخل قول الرملي بقوله وتماهيا، فليست بينهما مسافة ولا بينهما حد أو فاصل، كتدفق الماء في مجرى الماء ..»[11].
- الخاصيات السردية
- الوصف
ينبني النص السردي على مكونات أساسية ضمنها الحدث والحوار والوصف، وحينما ننظر في مجموعة “أصوات لم أسمعها” نجد ضمورا للإحداث وامتدادا قويا للوصف مع حضور وازن للحوار خصوصا الحوار الداخلي.
والوصف باعتباره نشاطا فنيا « يمثل باللغة الأشياء والأشخاص والأمكنة. وهو أسلوب من أساليب القص يتخذ أشكالا لغوية كالمفردة والمركب النحوي والمقطع.»[12] وهو يحضر بقوة حيث نجد الجمل البسيطة أوالمعتمدة على العمدة فقط قليلة، بل قد نجد ترادفا للأوصاف واستعمالا كثيرا في الجملة الواحدة مثلما نجد في المقطع التالي:
« أنا البحر الممتد الجارف العاتي.. هل أغار من زهر هش متنرجس..؟ »[13].
والوصف يطال كل المكونات وخصوصا الشخوص، وهو وصف بعيد عن الموضوعية، مغرق في الذاتية، ينم عن أحاسيس الشخصية أو السارد، وميلها نحو موضوع الوصف؛ ففي قصة “السفر” يتواجد السارد مع رجل وامرأة في القطار، وقد تعاطف السارد مع المرأة وكره الرجل، يقول في وصف الرجل: « في العربة الأولى لم أجد مكانا، وفي الثانية وجدته، لكن شخصا متعجرفا كان يحتله، جذبت المصراع ودخلت، نظرته وحشية مقتحمة وبدنه ثقيل.
ــــ اسمح لي أن أجلس..
تزحزح ببطء متشنج كأني أنا الذي تطاولت على حقه !..»[14].
فمنذ الوهلة الأولى تتحدد عبر الأوصاف (متعجرفا، وحشية، مقتحمة، ثقيل، متشنج) علاقة التوتر بين السارد والشخصية. ولكنه عندما لمح امرأة في المقطورة تغير الوصف وانصبغ بصبغة مخالفة؛ يقول: « الآخرون في المخدع صامتون، بعضهم أغمض عينه متناوما، وبعضهم يرى بعيون زجاجية، إلا امرأة شابة لمحت على وجهها ظل ابتسامة»[15].
ثم بعد ذلك سينخرط في مقارنة تعكس مواقفه، وتجرنا إلى التعاطف معها والمصادقة على مواقفه؛ يقول:
« كانت تقابلني وتنحرف بوجهها الوضيء عن الرجل المتعجرف. حين زاحمته، أبعد رجليه عن قدميها. مثله يستفز عنفك حتى وإن لم تكن بطبعك عنيفا. لم ترفع المرأة رأسها عن الكتاب، ولكن ملامحها جدول ماء في صحراء السفر. والمتعجرف بجانبي يباشر النظر إليها بعنف فيعكّر صفو جدول الماء ..»[16].
وتنسحب أحاسيس الشخوص إلى الفضاء المحيط لتخلق جوا عاما غالبا ينسجم مع التفاعلات الداخلية للشخصيات؛ فمنذ بداية القصة نستطيع أن نتنبأ بالمصير المأساوي لشخصية سعيد الفرحان، ونستطيع أن نكتشف حجم الباروديا الساخرة النابعة من اسمه مقارنة بعالمه المحيط؛ يقول:
« أسكنتني الحاجة على سطح هذا المنزل القصي، في هذا الحي القصي، في طرف المدينة القصي. حي نبت بفوضى في خلاء قاحل هو في الأصل امتداد القرية في الضاحية، وتحوّل بالتدريج إلى حي قابع هناك، لا هو امتداد للمدينة الجديدة، ولا هو من طبيعة القرية القديمة. مساكن قامت كيفما اتفق، فتناسلت وتكاثرت وطما سيلها ونغلت بالناس والحيوان والأشياء. انحشر في أقباء المساكن الفوضوية طوفان بشر أنا واحد منهم. اسمي “سعيد الفرحان”، موظف صغير في وكالة بريدية صغيرة، اشتغل فيها وحدي في مواجهة زحام بشري لاينتهي..»[17].
وخلال الوصف تتنامي كثيرا استعارة[18] الشجرة ومعجمها للتعبير عن المرأة، وعن مدى الاحتفال بها؛ فللا حليمة امرأة ظليلة لها حضن وارف وغناء يانع تتصرف بعفوية وارفة.
وكما تقترن صورة للا حليمة بالشجرة تقترن أيضا وبقوة بالنور والضوء، ف “للا حليمة” أجمل النساء اللائي ضوّأن صبى السارد، ترتبط في فضاء روحه بإشراقة شمس بهيّة تعاند الشمس التي في السماء .. فقد « كان الطفل في فناء الطابق العلوي من البيت المشترك متكئا على الجدار، في انتظار أن تصل الشمس إلى جسده الصغير فتدفئه. الشمس دثرت أعلى الجدار، وتنحدر متباطئة لتدثره كله، وتغمر جسده الصغير المرتعش الذي كان يراقب بعينين فرحتين إشراقها.. وقبل أن تصل إلى أسفل الجدار، وقبل أن تصل إلى جسد الطفل المرتعش، خرجت “للا حليمة” إلى فسحة مسكنها الجديد، في الطابق السفلي من البيت المشترك .. شمس صباح أخرى أطلّت على الطفل من حيث لا يحتسب. في كامل بهائها وكامل رونقها ومهابتها، شمس تتضوّع ابتسامة ورهافة .. أشارت إليه: “انزل” فنزل منجذبا إلى بهاء الطلعة ..»[19].
وتبقى استعارة الماء الأكثر حضورا خلال الوصف، يقول في قصة الرديفان:
« تخرج كائنات الأعماق في الليل، وترخي الذاكرة العنان لذاكرتها… ليس بإرادتي يجفو النوم مضجعي، ولا بإرادتي يأتي حين يشاء… لليل سلطانه كما للنهار، والعمر بينهما قشّة في مهب الريح، جدول ينزف راغما حتى النضوب، دون عزاء .. في الليل، حين يجفو النوم مضجعي، أتمدد على الفراش في الظلام، وأسمع الموسيقى الهادئة، تمتزج بأصوات كائنات الليل الخارجة من مكامنها، فأتخيل كأن ماء الجدول اختلط بماء الموسيقى الهادئة، وطفقا يتسربان إلى جوف أرض رملية قاحلة.. »[20]
لقد استعير معجم الماء هنا لوصف العمر الذي ينقضي، وكذلك لوصف الموسيقى التي تبلسم جراح العمر النازف. وخلالهما يحضر الماء لرصد هذا الجريان الممتد في حركة الأشياء وهذه القدرة على التسرب والتغلغل إلى عمق الأشياء.
وفي “إيكاروس”، ورغم ارتباط هذا الاسم في القصة بالنار والاحتراق، يحضر المطر الملازم للبدل والعطاء مع اسم الشخصية أولا “فاضل المطري”، حيث نجد مضاعفة للكرم والعطاء في اسم الفاعل “فاضل”، وفي الاسم المنسوب للمطر، بل يمكن الزعم أن النار والاحتراق هنا ليسا حاضرين إلا من أجل القبض على الماء، يقول: « وأسألك: لماذا تحرق ما تكتب؟ فتقول لي: حتى أشعر نفسي بأني دائم البحث عن الماء المنفلت مني، فلا يتلامح لي إلا كلمح سراب ..»[21]. ومثلما لم يقبض فاضل المطري على الماء ماء الإبداع، لم يفلح سارد الأصوات غير المسموعة في استرجاع لحظات صفية التي مضت، ولصفية أيضا علاقة بالماء، يقول:
« بيت قائم على ربوة تطل على حقول الزيتون واللوز، وعلى النبع، حيث صادفتك. نبع عذب يتدفق ماء، فيتدفق شعرا. فالماء هو خدين الشعر..
أدركت فيما بعد، العلاقة بين الماء وبين الشعر، فأدركت أن نبع الماء الذي كان يواجه مسكني في تلك القرية، لم يكن يتدفق ماء فقط، بل كان يتدفق ماء وشعرا… وكنت أرى الماء ولا أنتبه إلى الشعر.. وحيث أدركت أن الشعر خدين الماء، لم يعد في إمكاني أن أرى تدفق ماء النبع، الذي لم يفارق عطشي شوق النهل منه .. سألت عنه بعد سنين. فقيل لي: غاض قبل أن يجف. فحزنت كثيرا. ولو كان بإمكاني أن أستعيد الزمن لأحضرت لك، ليس قارورة العطر وقلادة العنق ومشبك الشعر، بل لأضفت إليها كلمة احتفاء بأنوثتك، تدفئ مشاعرك، وتوفي بحقك في الثناء على وردة تتفتح في ضوء الشمس، عذبة شفيفة كماء النبع الذي يسكن وجداني .. لكن الذي كان قد كان .. ونحن لانستعيد خسارتنا، إلا بعد أن تفعل فينا ما تفعل مكائد الزمان..»[22]. فالنبع لم يعد نبعا للماء فقط، بل هو اقتران الماء بالشعر وبالأنوثة وبالإلهام، وكلها أشياء منفلتة خانتها فروج الزمن وفجواته.
- الحوار الداخلي فضاء البوح:
قليلة هي الشخصيات في قصص محمد زهير، وقليل هو الحوار، ولكن هذه القلة متعمّدة، لأنها تفسح المجال لاكتساح غامر للحوار الداخلي، ولبوح الشخصيات ومصارحتها لذاتها. ويتخذ هذا الحوار أشكال متعددة أهمها:
- أن يتخذ السارد من ذاته شخصا مفارقا له يحكي له ويبثه أشجانه وأحزانه، وقد وردت هذه الصيغة مرفقة بالاستفهام الإنكاري الذي يفيد التحسّر والتأسف على زمن فات ولا يمكن القبض عليه؛ يقول: « .. قل لي بربك لماذا يستمر حضورها في روحي، رغم الأهواء والأنواء والإيغال في المسافات غدوا ورواحا؟. قل لي بربك لماذا تتوغل في أعماقنا علاقات ولحظات بأعيانها، فلايقوى الزمن على محوها؟.»[23]
- أن يتخذ الحوار الداخلي شكل بوح داخلي تفضي به الشخصيات إلى ذاتها خصوصا حين تتكلم بصيغة المتكلم، وبدون أن توجه الخطاب إلى شخص آخر، يظهر هذا خصوصا في “ألوان الطيف” حيث يحكي كل من البحر، وعباد الشمس، والشمس عن معاناتهم وعلاقاتهم. وتبدو المناجاة هنا مجالا لنقل وجهة نظر كل شخصية والكشف عن الرؤية الخاصة بها.
- أن يتخذ السارد من شخص غير حاضر محاورا، ثم يتوجه إليه بالحديث كما نجد في “إيكاروس”: «فاضل المطري .. كنت أنيسي في الغربة، رغم صمتك الطويل .. آتي إليك من مدرسة قرية أخرى بعيدة، لتؤنس وحدتي، فنتحادث قليلا، وتصمت وأنا أرغب في المزيد.. أخاطبك بعد أن تصمت، فأراك ساهما.. وتعود من سهومك إلى كتابك وتغيب فيه .. تحملت صمتك على مضض أول لقائنا، واحترمته بعد ذلك. احترمت انكبابك على القراءة، وكانت عزاءنا في الوحشة.. علاقاتك ككلماتك محدودة جدا، ولم أعرف عن تفاصيل حياتك سوى النزر اليسير ..»[24]. والحوار هنا يتوجه إلى فاضل الذي غادر ولن يعود، وحتى عندما كان حاضرا لم يشف غليل السارد، لأنه كان قليل الكلام. لهذا عوّض السارد صمته بالحوار الداخلي لكي يعبر عن هذه العلاقة المتمنعة.
- الشخصية
تشكل الشخصية قطب رحى العمل السردي، ومحرك الأحداث، كما أنها تبقى دائما هي الكوّة التي تفتح القصة على العالم الواقعي. والكاتب، أي كاتب، حيث يبدع نمطا معينا من الشخصيات يكتبها ويقدمها، ويقدّم من خلالها العالم الذي يفضّل الحديث عنه. ولعل هذه المعطيات تشجعنا على الزعم أن الشخصيات الرئيسية في “أصوات لم أسمعها” شخصية واحدة أو موحّدة تتخذ تشكيلات وتنويعات شتى.
وإذا كانت التحليلات السردية المهتمة بالشخصية تعتبر الشخصية عملا تأليفيا يمتزج فيه الوجود الواقعي بالبناء التخييلي[25]، فإننا نستطيع أن نضيف في هذا الصدد أن الشخصية في “أصوات لم أسمعها” تنتظم في نهاية التحليل، وفقا خاصيات عامة يمكن عرضها اعتمادا على التقسيم والمراحل التي تقترحها السيميائيات خصوصا المقترح الذي يقسّم العلامات المميزة للشخصية إلى مباشرة وغير مباشرة، حيث تركّز الخاصيات المباشرة والصريحة في المرتبة الأولى على المظاهر الجسدية والوضعية الاجتماعية والحالة النفسية.
إن الشخصية الرئيسية في قصص “أصوات لم أسمعها “هي رجل شاب غير محدد العمر، وغير محدد المعالم الجسدية، له نصيب من الثقافة، يعمل في مجال فكري لاجسدي، مرتبط بالقراءة والكتاب وعوالمهما، سواء كانت وظيفة عمومية أو وظيفة مدرسية أو خزانة عمومية. وهنا لا يدخل الغنى والفقر، ولا الإرث العائلي، كيفما كان، في تقديم الشخصيات؛ فهي كلها كائنات بدون امتداد عائلي ولا إرث ماضوي لها. كما أنها شخصيات حفرت مسارها في الحياة بمجهودها الخاص، لايحفل أحد بماضيها، ولكن الحرص كل الحرص يقع على تقديم حاضرها ومنجزها الحاضر، ولو كان غير مقنع.
ولاتعيش هذه الشخصيات في وسط عائلي، ولا تتواجد في فضاء عام، فإنها تؤثر الانفراد، عبر الحلم، عن عالم الجماعة والحشود.
وعلى الصعيد النفسي نجد الشخصية الرئيسية شخص يفضل الانغلاق والابتعاد عن العالم الخارجي ليغوص في عوالمه الخاصة، سواء الناتجة عن عنف ذاكراته أو حيوية خياله أو أحلامه. لا ينخرط في علاقات سهلة ولاعادية، ولكنه يحبذ العلاقات الشائكة المؤرقة التي تأتي نتيجة ألم ومعاناة ذاتية خصوصا.
كما أنه شخص مديني يعشق المدينة ويقبل عليها، رغم أنها فضاء طارد غير مرحب به، لا تقدم له إلا الهوامش، فضاء مقترن بالليل والخريف والضباب. ورغم كل هذا تبقى المدينة معشوقة محبوبة، وبالمقابل تعزف الشخصيات عن القرية المرحبة المانحة حيث «بهجة الربيع سابغة في الحقول، ونداوة الصباح مرهفة »[26].
ومن خاصيات هذه الشخصية أنها معطوبة تحمل طموحا وأملا لا يمكن تحقيقه، أو أن طموحاتها صعبة التحقّق، تراودها أحلام تخرجها من دائرة الواقع بدون أن ترفض أو تمانع، تحب عالما ضبابيا مفعما بالإبهام، قد يصل بها الاعتقاد في بعض اللحظات إلى أن الخروج من هذه الضبابية هو اصطدام بالجفاف، وسفر في أراضي قاحلة.
والشخصيات الرئيسية تنخرط بشكل كلي في علاقة مع المرأة، وهي علاقة يهيمن عليها الحبّ والتعاطف، وحتى في حالات تمنّع الحب أو حدوث شرخ في العلاقة فإنها تبقى دائما لينة سلسة بعيدة عن الاضطرابات.
صورة المرأة:
وبجوار هذه الشخصية المخترقة لكل النصوص نجد المرأة، وهي دائمة الحضور في أغلب القصص، وهي دائما موضوع للحب، حتى وإن اختلفت أشكاله ووضعياته. كما أنها متعددة متنوعة؛ فهي “للاحليمة” التي تفيض أمومتها على كل من يحيط بها، وهي “صفية” فتاة القرية التي راودت السارد دون أن تستطيع تخليصه من شرنقة المدينة، وتقابلها “إلهام” الفتاة الفكرة المتمنعة التي ظل يراودها السارد دون أن يتمكن من الظفر بها، وتجتمع مع إلهام “الشمس”، و”امرأة الرملي”، و”امرأة القطار”، ومريم في كونهن كلهن نساء متمنعات كن دائما موضوع رغبة لايمكن تحصيلها ويستحيل القبض عليها.
ووحدها “منى” زوجة سعيد الفرحان هي المرأة المساندة المطيعة التي واكبت الزوج في الصراء والضراء، وسايرته رغم عدم معرفتها بمصدر الأموال التي اشترى بها عناصر الوليمة؛ يقول سعيد الفرحان:
« هيأت منى فعلا الوليمة الباذخة، حمّرت الديك، وطبخت اللحم في مرق مركّز وتوّجته بلوز مقلي، ورتبت الفواكه والمشروبات، وهندمت طبق الحلوى، وعطّرت الجو، وقالت لي بصوت مغناج:
ــــــ مرحبا بك في بيتك ووليمتك يا حبيبي.
فقلت لها سعيدًا فرحًا:
ــــــ ومرحبا بك في بيتك ووليمتك يا حبيبتي.
وضحكنا حتى انكشفت نواجذنا ضاحكة، ثم شمرنا على ساعد الوليمة، وتهيأنا للحفل الفخيم .. شغّلت زوجتي شريط كاسيط ساخن ونادتني بطرف متوله: انهض. فأمسكت بها لينة مطواعة كالأملود، ورقصنا .. »[27].
والمستقصي لحضور المرأة في هذه المجموعة يستطيع تلمس مجموعة من الخاصيات المشتركة بين جميع النساء؛ فكلهن نساء شابات مثقفات لم يحدد عمرهن؛ فإلهام رسامة، وللا حليمة تغني، والمرأة في القطار تقرأ. كما أن علامات الأنوثة طافحة من شخصيتهن فإلهام لها أصابع دقيقة لينة رشيقة ترسم كما لو كانت ترقص[28]، وزوجة الحاج الصواف الحسناء الوضاءة[29].
كما أن لهن قدرة كبيرة على التأثير في العالم المحيط بهن؛ فللاحليمة هي التي كسّرت روتين حياة الطفل بعدما انشغلت عنه أمه بأختها الصغرى، يقول:
« دفقة حياة جديدة حركت سواكن الحياة، حتى بدت الأشياء كأنما اغتسلت من رتابتها، فتميز لي الزمان عن سابقه، انفتحت نفسي أكثر، وشدّتني الحياة إلى عالمها كما رأيته بعيون استيهامي .. قل لي بربك، لماذا تنفلت منا العلاقات واللحظات التي نتوهم امتلاكنا لها؟. قل لي بربك، هل تبقى الذكرى بلسما أم جرحا؟ عزاءً أم غصة تتواطأ على تفتيت العمر؟ قل لي بربك أي جاذبية سحرية للاحليمة، تشد إليها بآصرة محبة لطيفة، فتجعل الطفل الذي كنته، قريبا منها في اليقظة وفي الحلم، يحبّ أن يراها في كل لحظة ويقضي أجمل أوقاته قريبا منها، يلعب مع سعيد، أو يستمع إلى أهازيجها العذبة، التي تصدح بها حين يخرج الزوجان، وينتظر بشوق غامض المشاعر، أن تلد له عروسته، كما ولدت أمه عروسة سعيد. »[30] وغير خاف تأثير حضور المرأة في هذا المقطع على الصياغة اللغوية التي انتقلت من التقرير إلى الأسلوب الإنكاري، ومن السارد المتكلم إلى سارد غائب عن معترك الأحداث دون أن ينفلت من قوة حضور هذه المرأة في ذاكراته.
ويستمر حضور المرأة أيضا في القطار يكسّر رتابة السفر وغربته؛ يقول: « القطار يشقّ المسافة ، والليل غطى المكان. أضواء تطفو وأضواء تغور.. والصمت في المخدع ثقيل، وظل وابتسامة المرأة، هي النسمة الحقيقية التي تلطف وحشة نفسي .. »[31]. وكلما كانت المرأة جميلة بعيدة، كلما ازداد شوق السارد إليها، يقول السارد أسفا على صوت صفية الذي لم يسمعه: « ولو كان بإمكاني أن استعيد الزمن لأحضرت لك، ليس قارورة العطر وقلادة العنق ومشبك الشعر، بل لأضفت إليها كلمة احتفاء بأنوثتك. تدفئ مشاعرك، وتوفي بحقك في الثناء على وردة تتفتح في ضوء الشمس، عذبة شفيفة كماء النبع الذي يسكن وجداني .. »[32].
أسماء الشخصيات:
يولي فيليب هامون أهمية كبيرة، في إطار تحليله للشخصية، لاسم الشخصية في مسار السرد بوصفها علامة ثابتة دالة[33]. وإذا كان اسم الشخصية من العلامات المتميزة، فان انتقاء الأسماء في هذه المجموعة يضيف خاصية أخرى مميزة ليس فقط للشخصية، ولكن لشخصيات المجموعة بشكل خاص؛ فأسماء الشخصيات تسمح بإبداء ملاحظات عامة لعل أهمها؛ أن أغلبية أسماء الأعلام ذات بنية صرفية دالة، تتراوح بين المصدر (إلهام) والصفة (حليمة – صفية)، وكلها تفصح عن علاقة بين دلالة الصفة وخاصية الشخصية.
وعندما تستعمل أسماء أعلام شحنتها الوصفية فارغة أومفارقة لخاصية الشخصيات فإن الاسم يطعّم بوصف يوضّح دلالته سواء على صعيد المقام الاجتماعي، أوالوظيفة المجتمعية (خالد الكتبي، سليمان الراوي). وقد تتضاعف الشحنة الوصفية للاسم في نوع من الإطناب يعزز خاصية الاسم، ويوجّه القارئ نحو التركيز على هذه الصفة داخل حركات الشخصية، وتفاعلاتها مع ذاتها، ومع المحيط ( سعيد الفرحان، يوسف الطيفي، جمال الخطاط، محمود الشاعري، فاضل المطري).
إن هذه الخاصيات مجتمعة تلعب دورا قويا في إخراج أسماء الأعلام من كونها مجرد علامات فارغة تلصق بالشخصيات كيفما اتفق، ولاتتجاوز وظيفتها في تعيين شخصية ما وفصلها عن باقي الشخصيات. إن اسم العلم هنا عنصر دال موحي ومعبّر عن روح الشخصية وخاصياتها بشكل يخلق علاقة تلازمية بين اسم الشخصية وهويتها، ولعل هذا ناتج عن وعي بلحظة الكتابة، وعن رغبة في خلق عالم متخيّل مفكّر فيه بتؤدة وتأني. وبشكل يدفع القارئ إلى تبيّن هذه العلاقة وقراءة الشخصية على ضوءها.
إن العالم السردي، وفق هذا المعطى، يكاد يضحي باعتباطية العلاقة بين الاسم والمسمى، وهو عالم خال من الصدف، يتم بناء عناصره في قصدية تامة من أجل إيصال المتلقي إلى غاية ممتعة مقصودة.
السارد
يعد السارد الواسطة بين الحكاية والنص، وهو كذلك الواسطة بين النص والمتلقي، وتعدّد المواقع هذا يمنحه موقعا مرموقا، ومجالا كبيرا للعب والإبداع، والتحكم كذلك في مجريات الأحداث[34]. وسارد “أصوات لم أسمعها” مشارك في الحدث يعتمد في أغلب الأحيان على ضمير المتكلم، سواء للحكي عن ماضيه كما هو الحال في “شرفة على الماء”، أو عن حاضره كما هو حال “تنازع”. واختيارهذا الوضع السردي ينخرط ضمن عملية تحديث السرد القصصي الذي بدأ يخرج وينفلت من سلطة الراوي العليم، الذي يتواجد في كل مكان وفي كل زمان، ويستطيع التسرب إلى دواخل الشخصيات ليحكي، بدلا عنها، عن أفكارها وماتشعر به.
إن الصدمات المعرفية والتاريخية التي عاشها الإنسان الحديث إثر الحروب العالمية، وكذلك إثر اكتشاف أنه ليس مركز العالم، ولا مصدر الخير فيه، جعلته يتراجع إلى الوراء ويؤثرالحديث عمّا يشارك فيه أو سبق له أن عاشه، وبطريقة أيضا لاتتجاوز هذا المنظور، فلم يعد يعطي لنفس المرتبة العليا، ولا يسمح لنفسه من الاقتراب من وضع الآلهة، ولكنه يتقدم في العالم بوصفه مجرد إنسان يعيش الحدث أو يواكبه، وينقل ماعاشه وواكبه. وإذا كان لابد من الغوص في الأعماق فإنه يغوص في ذاته. ولعل هذه هي الوضعية التي تماهى معها السارد هنا، وهي الأكثر واقعية وصراحة، وهي التي تجعل المتلقي يصدق ويتواجد داخل الحكي. وفضلا عن ماذكر هي التي تضع المجموعة ضمن الكتابة الحداثية في القصة المغربية.
ومن علامات التحديث والحفر عميقا في تقنيات السرد يمكننا التوقف عند طريقتين إضافيتين آثر الأستاذ استعمالهما، حيث اعتمد في قصة “إيكاروس” وضعية سارد متكلم يحكي عن موضوع مغاير هو حكاية فاضل المطري، مما يجعله ساردا مشاركا في الحدث، ولكن الحدث الرئيس هو الآخر، فهو شاهد فقط على تجربة فاضل المطري، وخلال وصفه له بقي سرده خارجيا موضوعيا يكتفي بالمظاهر، وكأن فاضل بدون إحساس، ويضل دائما ملفوفا في غلالة الغموض. يقول: « جاذبته في ليلة مطيرة أطراف الحديث عن الشعر، فانفتحت نفسه وأخبرني أن له ديوانا سماه ” رماد الحبر” سألته قراءته فقال لي: هو طوع يدك، وأشار إلى الوعاء النحاسي الملموم على الرماد..
ـ أهذا هو ديوانك؟ !
ـ نعم .. ما الذي يدهشك ؟ !.
وليبدد تظنني، باح بعفوية باردة إلى حد الاستفزاز، بسر رماد الحبر. فلم يتبدد تظنني ولا أمكن لنومي ليلتها أن يستقر.. »[35]
ولأن السارد كان ملحا في التسرّب إلى دواخل الشخصية المتمنع فقد اعتمد الصور والأشياء المحيطة واستمد من أشكالها وهيئاتها مايوحي بما يحس به فاضل المطري؛ يقول:« كلماته مقتضبة، ومعظم زمنه الليلي يقضيه في قراءة الكتب على ضوء الشمعة الشحيح المترنح داخل غرفة ضيقة من بيت قديم، في قرية جبلية نائية، صرف فيها معظم سنوات شبابه مدرّسا في مدرسة ابتدائية فرعية، تضم حجرة واحدة هو المدرس الوحيد فيها..»[36] فكما نلاحظ الوصف خارجي موضوعي ولكن الطقس الذي تضفيه النعوت والصفات ( الشحيح، ضيقة، قديم، نائية، فرعية، واحدة، وحيد ) على الأشياء يسمح باستشفاف عمق الحزن والعزلة التي تغوص فيها الشخصية. ولعل خير صورة تجاور الشخصية وتفصح عن أحاسيسها وأشجانها صورة الشمعة؛ يقول: « هناك أكثر من علاقة تجمع بين الشموع وبين فاضل المطري: النحافة، الضوء المتلعثم، قابلية الذوبان، الانطواء على الأسرار، والحزن في الليالي الكئيبة، التي كتب في بحرها فاضل المطري شعرا كثيرا، أحرق نصوصه واحتفظ في وعاء نحاسي برمادها المتكاثر.. »[37]
هذا فيما يخص الوضعية الأولى، أما الوضعية الثانية فتتجلى في اعتماد الراوي المتعدد من خلال قصة “ألوان الطيف” حيث يحكي السارد الممثّل جزءا من القصة ويترك ما تبقى منها للشخصيات نفسها لتعبّر عن نفسها، بدون إذن ولكن فقط العناوين هي التي تؤشر على انتقال الحكي على التوالي من الراوي، إلى البحر، إلى عباد الشمس، إلى الشمس، ليعود السرد إلى الراوي باعتباره السارد الممثّل. وتنتهي القصة بتعليق الكاتب الذي لا يفصح عن نفسه، ولكنه يتعالى ويفصح لنا عن القانون المنظم لعمله؛ يقول: « في لعبه الخيالي يمزج الكاتب ألوان الطيف بألوان الرؤى. يُنَسِّبُ كل شيء، ليكتشف المناطق والعلاقات والعلامات التي تنتفي فيها القياسات والحدود بين المعاني ومعاني المعاني، فيمكن للكلام أن يتحرك في المجاهل التي تسكننا ونتوق إليها.. ومن تلك المجاهل أسمع الآن صوتا يقول إن له رؤية أخرى فيما كتب عن البحر والشمس وعباد الشمس، وإن البحر والشمس وعباد الشمس هي التي كتبت عنه وهو سيكتب عنها، وستكتب عنه كلما كتب عنها.. »[38]
ويشرف على هذه العملية بأكملها سارد غائب عن مسرح الأحداث، ولكنه يجيد توزيع الأدوار على أعضاء فرقته السيمفونية مما يعطي ألقا خاصا للقصة، خصوصا وأنها تأويل خيالي ممتع شديد التناسل حول نوعية العلاقة الغريبة بين البحر والشمس وعباد الشمس وخيال الراوي.
وتصل لعبة توزيع الأدوار قمتها مع قصة أنوار الشموس حيث تصبح هذه العملية متعمّدة من طرف السارد الممثّل “سعيد الطائي” الذي يضع القصة في طريق كل من “خالد الكتبي” و “سليمان الرواي” و طالب شاب من مدرسة “سيد الزوين” العتيقة بناحية مراكش، ليحكي كل واحد منهم القصة نفسها، ولكن بطريقة خاصة.
ولكن القراءة المتفحصة للقصة تقول لنا أن سعيد الطائي ليس إلا دمية في يد السارد الخفي الذي يحرك كل الأحداث ويدفع بسعيد الطائي للعب دور منسق عمليات الحكي في حين أنه هو أيضا خصص له دور قدّره وقرره السارد الخفي؛ يقول: « وتوقف “سليمان” الراوي عن الحكاية والدهشة ملء أبصار سامعيه..
ــــــ هكذا إذن !..
قال “سعيد الطائي” في نفسه، وهو يمسك المخطوط منطويا على سره. المخطوط الذي اشتراه من خالد الكتبي قبل قليل، وفرغ من حكايته “سليمان” الراوي قبل قليل !.. لم يعرف سعيد كيف نسج “سليمان” الحكاية ولفّ في مساربها. فقط عرف كيف أنهاها. ولكن كثافة الحضور ودهشتهم دلتا على أنه قد صال في ميدانها وجال كعادته.. »[39]
ولعل الغاية من هذه العملية بأكملها استعراض طرق الحكي التقليدية سواء منها الشفوية أوالكتابية، المحترفة أو العاشقة، وبيان الغواية التي تمارسها الحكاية على الناس بشكل لا يجعلهم يتفاعلون معها فقط، بل يضيفون إليها من ذواتهم ويحذفون مالا يناسب ذوقهم أو بصيغة أجمل يمتلكون الحكاية ويستحوذون عليها؛ يقول: « ومضى الشاب إلى شأنه.. قال كلمته ومضى.. وقد أوقعني في شرك الحكاية من جديد.. عند ذاك خطر لي “خالد” الكتبي. كنت أعرفه وأعرف ما يبتدعه خياله الذي يحتاج فقط إلى شرارة تؤججه. والشرارة هذه المرة كانت نسخة الطالب الشاب.. النسخة التي أخذتها، وأرسلتها إلى مزاد الكتب، مع من زعم لـ “خالد” أنه حفيد الرملي. فاشتراها “خالد”، ونسج عنها من خياله ما نسج، فأذيعت الحكاية كما رغب الطالب الشاب، وتناسلت منها حكايات لا حدود لمجاريها، كما رغبت أنا “سعيد الطائي” . وها هي النسخة من جديد أمامي، عائدة من سفر لاستئناف سفر آخر، تستدرج فيه الحكاية إلى الحكاية.. وللحكاية إغواء، وراكب متنها كراكب متن الريح المسكونة بالأهواء.. »[40]
وعلى سبيل الختم نقول إن تجربة الأستاذ محمد زهير القصصية تتميز بتنوعها حيث لم تتخندق في دكان صغير من الدكاكين القصصية، ولكنها اخترقت جدار التنميط والتقوقع، وأفسحت لنفسها فضاء رحبا يعانق كل التجارب دون أن تمنعه من ترك بصماته الخاصة. ولعل سرّ تألقها يكمن في قدرتها على الانضباط للنوع الأدبي، أي القصة، وفي الوقت نفسه تحقيق الرغبة الدفينة للذات في التألق وتكسير حواجز هذا النوع. وبين هذا وذاك انتصرت لموقفها من الحياة الذي يعلي من شأن التنوير والتحرير وحق الذات في أن تبدع.
…………………..
[1] ـ يحرص نقاد التجربة القصصية المغربية على التمييز في مسارها بين ثلاث مراحل مهمة هي على التوالي المرحلة التأسيسية الوطنية، والمرحلة الواقعية، المرحلة التجنيسية الذاتية. فيما يخص التصنيف انظر: نجيب العوفي، القصة القصيرة، والأسئلة الكبرى، ضمن القصة المغربية، التجنيس والمرجعية وفرادة الخطاب، سلسلة ملتقيات القصة، منشورات الشعلة، البيضاء، الطبعة الثانية، 2006.
[2] ـ نفهم الواقعية هنا ليس بوصفها تطابقا بين الواقع النصي والواقع الخارجي أو واقع الحقيقة التاريخية، ولكنه فقط اعتماد مؤشرات تماثل معطيات الواقع وتخلق لدى المتلقي وهما بالتطابق،هو وهم المرجع، أو أثر الواقع. أنظر: معجم السرديات، إشراف: محمد القاضي، الرابطة الدولية للناشرين المستقلين، تونس، الطبعة الأولى، 2010. ص: 14 و479.
[3] ـمحمد زهير، أصوات لم أسمعها، الطبعة الأولى2011. ص:79،80.
[4] ـ المرجع نفسه، ص: 89.
[5] ـ محمد زهير، أصوات لم أسمعها. ص:26.
[6] ـ المرجع نفسه، ص: 49.
[7] ـ محمد زهير، أصوات لم أسمعها ، ص: 48.
[8] ـ المرجع نفسه ، ص: 35.
[9] ـ محمد زهير، أصوات لم أسمعها. ص: 57.
[10] ـ محمد زهير، أصوات لم أسمعها. ص: 71.
[11] ـ المرجع نفسه، ص: 76،77.
[12] ـ معجم السرديات، إشراف: محمد القاضي، الرابطة الدولية للناشرين المستقلين، تونس، الطبعة الأولى، 2010. ص: 472
[13] ـ محمد زهير، أصوات لم أسمعها. ص: 30.
[14] ـ محمد زهير، أصوات لم أسمعها. ص: 80.
[15] ـ المرجع نفسه. ص: 80،81.
[16] ـ المرجع نفسه. ص: 81،82.
[17] ـ المرجع نفسه.ص: 39.
[18] ـ حول الاستعارة المهيمنة ودورها انظر: إيلينا سيمينو، الاستعارة في الخطاب،ترجمة: عماد عبد اللطيف وخالد توفيق، المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2013.
[19] ـ محمد زهير، أصوات لم أسمعها. ص: 19.
[20] ـ المرجع نفسه. ص: 87.
[21] ـ المرجع نفسه. ص: 100.
[22] ـ محمد زهير، أصوات لم أسمعها، ص: 107،108.
[23] ـ المرجع نفسه. ص: 22. وانظر كذلك ص: 25.
[24] ـ المرجع نفسه. ص: 99.
[25] ـ Hamon Philippe. Pour un statut sémiologique du personnage. In: Littérature, n°6, 1972. Littérature. Mai 1972. pp. 86-110.
[26] ـ محمد زهير، أصوات لم أسمعها، ص: 111.
[27] ـ محمد زهير، أصوات لم أسمعها، ص: 42.
[28] ـ المرجع نفسه، ص: 11.
[29] ـ المرجع نفسه، ص: 72.
[30] ـ محمد زهير، أصوات لم أسمعها. ص: 25.
[31] ـ المرجع نفسه، ص: 81.
[32] ـ المرجع نفسه، ص: 108.
[33] ـ انظر: فيليب هامون، مرجع مذكور.
[34] ـ انظر : قاموس السرديات، جيرالد برنس، ترجمة: السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، الطبعة الأولى: 2003 ص: 134.
[35] ـ محمد زهير، أصوات لم أسمعها. ص: 98.
[36] ـ المرجع نفسه، ص: 98.
[37] ـ المرجع نفسه، ص: 97.
[38] ـ المرجع نفسه، ص: 37.
[39] ـ محمد زهير، أصوات لم أسمعها. ص:65.
[40] ـ المرجع نفسه، ص: 78.