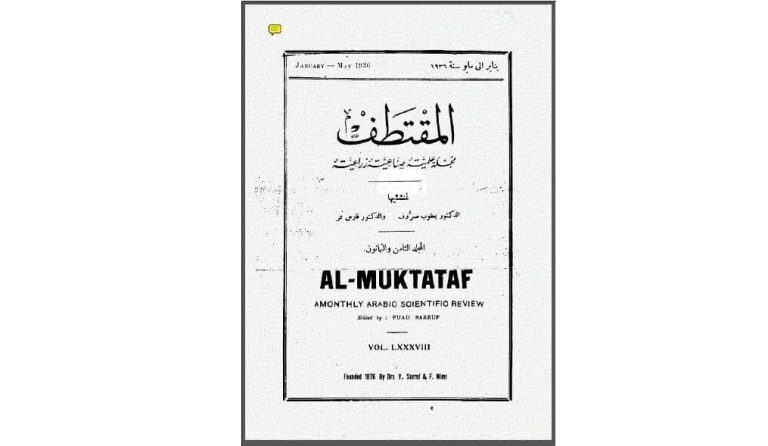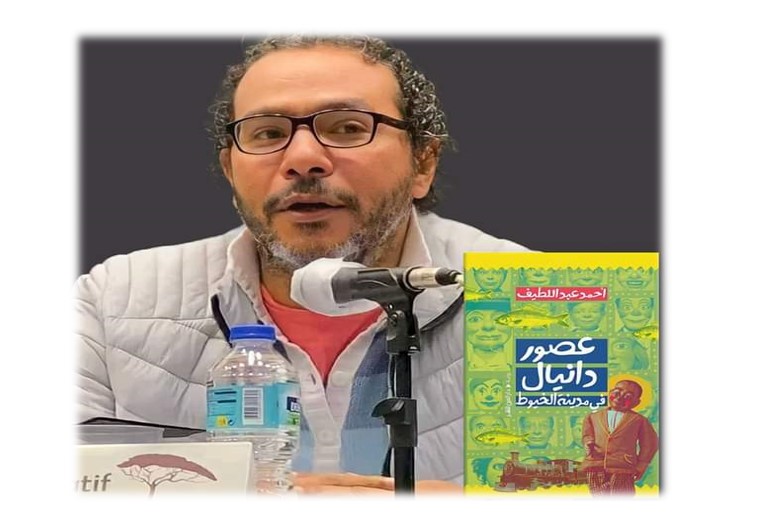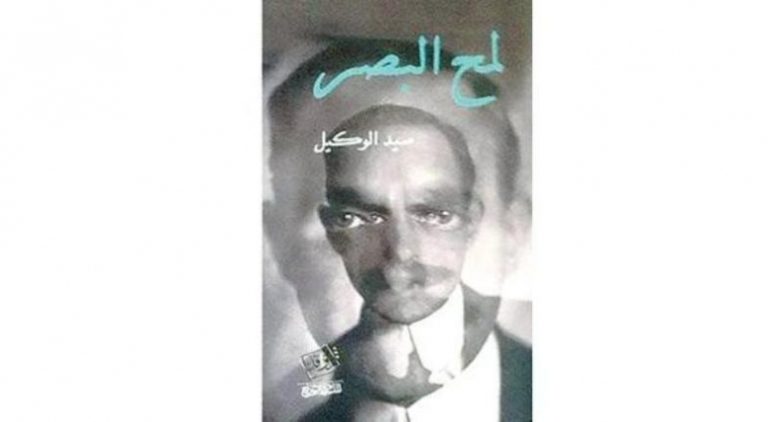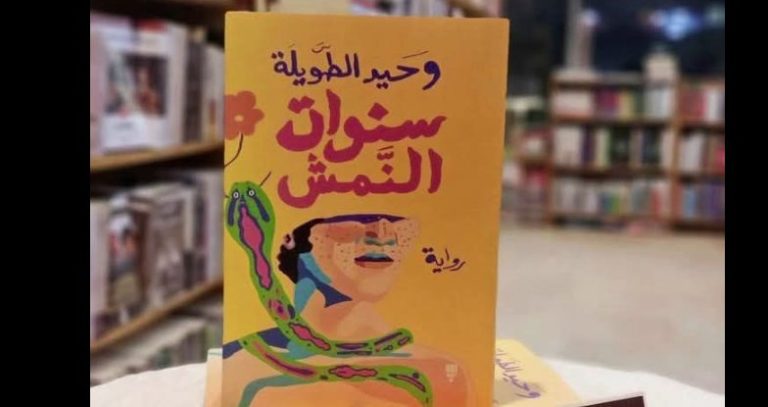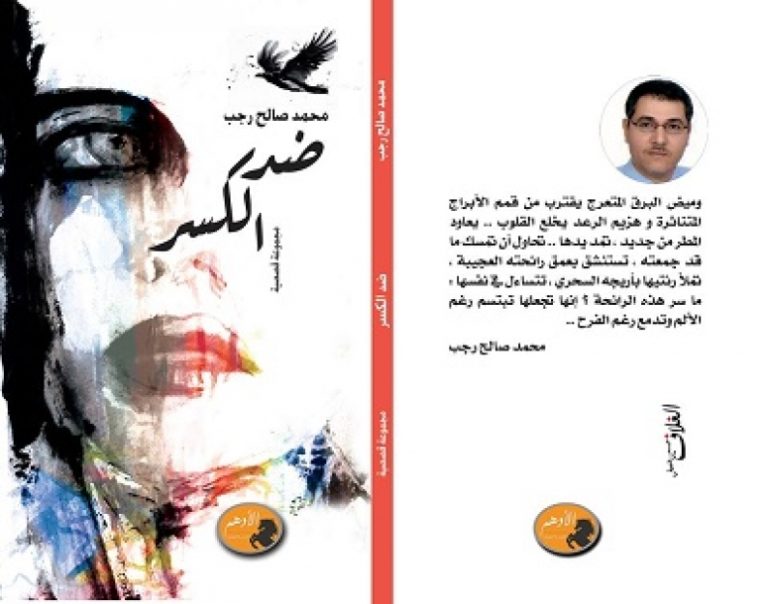أحمد جاد الكريم
تبدأ رواية “قصتي الحقيقية” للكاتب الإسباني “خوان مياس” الصادرة عن منشورات المتوسط (2021م) بترجمة أحمد عبد اللطيف بفعل القراءة وتنتهي بفعل الكتابة، وما بين الفعلين يكبر الطفل/راوي القصة الذي يُمارس والده القراءة بنهم، مستثمرًا تلك القراءات في تقديم برنامج تلفزيوني يتحدث فيه مع كُتَّاب عن الكتب التي ألفوها، وقرَّاء أيضًا، ينتزع ذلك البرنامج فخر الأم وابنها، في حين يظل ذلك الأب على مسافة من ابنه الذي يَكثر تبوله في السرير ليلًا مما يُسبب له أزمة، تُعالج الأم الموقف كل مرة دون إخبار الأب بما فعله ابنه.
تُعرض أحداث الرواية القصيرة من خلال راوٍ داخلي يُمثل الشخصية الرئيسية التي من المفترض أن تحكي “قصتها الحقيقية” بشكل خطي، يبدأ بطفولة الراوي، وينتهي به شابًا، تتصدع تلك الطفولة البريئة بحادث يخدش براءتها وسذاجتها، ففي اللحظة التي يشعر فيها الراوي/الطفل بأن أباه لا يحبه، يقرر الانتحار، يعتلي الجسر الذي يمر تحته طريق سريعة، وبدلا من أن يُلقي بنفسه لتصدمه إحدى السيارات المنطلقة، يقذف بـ”بلية” وجدها في فناء المدرسة، تصطدم بزجاج سيارة مارَّة فتجعل حركتها تضطرب، لتنقلب بعد أن تصطدم بشاحنة، ليموت أب وزوجته وابنه وتبقى الابنة عرجاء جراء الحادث، مشوهة الوجه والخِلقة.
تبدأ “القصة الحقيقية” بالتخلق منذ تلك الحادثة التي يشعر بعدها الطفل بالذنب، ويخفي عن أبويه اللذين سينفصلان أنه قاتل لعائلة بأكملها، يكتم السر فيما يبحث عن تلك الفتاة الناجية، ومنذ عثوره عليها، تبدأ حلقة أخرى جديدة من قصة الطفل، الذي رأى رواية “الأبلة” لديستوفيسكي في مكتبة أبيه فوجد عنوانها تعبيرًا عن حياته الساذجة، وعن استمرار تبوله في السرير (كدلالة عن ذلك البَله)، والرواية الأخرى رواية “الجريمة والعقاب” لديستويفسكي أيضًا مما يجعله يشعر أن الكتب هي التي تشكل حياته، وتبنيها، فهو مولود في بيت أشبه بمكتبة كبيرة، ويتأكد أن ما قام به من جريمة ينتظر العقاب الحتمي، فيُقرر ألا يقرأ تلك الرواية كما لم يقرأ رواية “الأبله” من قبل.
وبالانتقال من فعل “القراءة” إلى فعل “الكتابة” كنتيجة طبيعيةٍ، تحدث للراوي تحولات عدة: توزعه بين بيتين؛ بيت الأب الذي يرتبط بفتاة ينوي الزواج منها، وبيته الأصلي حيث تقيم معه أمُّه، في ذلك الوقت يُقرر الراوي أن يلتقي بالفتاة، كنوع من التكفير عن الذنب، وباندفاع نحو اكتمال “القصة الحقيقية” للفتى الذي يظن أن أحدًا لا يعلم بجريمته، تتطور عَلاقته بالفتاة وتتحول إلى عشق، ثم لقاء حميم في منزله تكشفه الأم بعد ذلك، وفي كل طور وتحول لشخصية الراوي يُوضع حجر جديد في “القصة” ويرتفع جدار آخر، وتصير تلك الفتاة اليتيمة في حاجة إلى ذلك المراهق الذي يكتب القصص، تفوز إحدى قصصه بالمركز الأول في مسابقة تقدَّم لها الآلاف.
إننا أمام قصة تتطور تدريجيًا وعلى مهلٍ، بصبرٍ وأناةٍ، تنضج مِثلما تنضج حياة الرَّاوي/الطفل، صاعدًا سُلم العمر عامًا وراء آخر، وكأنَّ تقدمه في العمر، وانتقاله من طورٍ إلى طورٍ ما هو إلا انعكاس لتقدُّم القصة وصعودها نحو ذُروة الاكتمال، القصة التي يُخيَّل لقارئها أن لحظة فورانها بدأت بمشهد الحادثة لكن لحظة الانطلاق هي العثور على الفتاة “الناجية” لتتحرك القصة خُطوة للإمام، وليكون هناك سبب وجيه، للإتيان مرَّة أخرى على سِيرة الأسرة “الهالكة” كان لا بُدَّ أن تنبت تلك الشخصية، أن تظهر للرَّاوي، أن يصفها، ويرى قبحها وتشوهها، يرى عرجها، ساقها الصناعية، أن يقترب منها، أن يُشفق عليها، لأنه تسبَّب فيما جرى لها، ما كان للقصة أن تكتمل أو تزحف نحو كمالها إلا بسطوع “إيريني”/الفتاة الناجية في فضاء الحكاية، فتأخذه إلى عوالم جديدة، أماكن لم يزرها، مثل الكنيسة، وحضور القداس في “الأبرشية” لأداء التمرينات الروحية، هو الذي لا يُؤمن بالرب، كما أبويه تمامًا، هناك حيث يُلقي الراهب عظته التي لا تغرس في نفسه أنياب الندم لِما فعل بِقَدر ما تُشعره بتفاهة أن يَحمل الإنسان جُرح الخطيئة الأول، الجُرح الذي لا يندمل، وعليه أن يَحمل جراحًا أُخرى، تُذكره بالجُرح القديم، ولذلك يشعر الرَّاوي مع أول إحساس بلذة القذف مع الفتاة بالندم؛ كأن جُرحًا جديدًا نبتت له أجنحةٌ، فيما لا تشعر هي الفتاة “المتدينة” بوخزات الإثم ألأنها ذاقت مرارة اليُتم والعجز، فالتأم جرح الخطيئة الأولى، وأصبحت خطاياها المستقبلية مغفورة، كتعويض لها عما فَقدتْ؟!
في مشهد اللقاء الحميمي بينهما، يقول الرَّاوي عن “إيريني”: “كلُّ قواها تبدو مركزة في جسدها، كلُّ ما فيها جسد، كأنها، على عكسي، استطاعت أن توقف وظائف عقلها مؤقتًا”، فعقله يعمل ويبدأ في تذكر مخازي حياته بدءًا من التبول في السرير ثم حادثة مقتل الأسرة ثم عدم الاندماج التام في العَلاقة معها، هنا العقل لا يكفُّ عن التفكير فيما مضى، وفيما هو حادث في تلك اللحظة، بينما تتجمع في جسدها كلُّ قوى التركيز والتفكير، يهدأ العقل أو يغفل تاركًا مساحة الجسد غير المكتمل (مبتور الساق) لتتمدَّد، ويستعيض – ولو وهمًا- جزءًا مِمَّا فَقد.
مع انكشاف تلك العلاقة من قِبل الأم تظهر كل “الأوراق المكشوفة” – بتعبير الرَّاوي- على السطح؛ فالأم تعرف أن ابنها هو مَن تسبَّب في “الحادثة”، والفتاة نفسها أيضًا تعرف، يبدأ هو بالنفور منها، وكأنه بعلمه أنها غفرت له ما سبَّبَه لعائلتها انتفت أسباب علاقته بها، يبدأ في النظر للحكاية من جهة أخرى، جهة الكتابة، فيبحث عن روايتي ديستويفسكي “الأبله” و”الجريمة والعقاب”، كتابَا سيرة حياته، يشعر أنه بانفصاله عنها رغم تمسكها به كمن يُلقي “بلية” أخرى على الفتاة الناجية الوحيدة من “الحادثة” ليقتلها – ولو مجازًا- بإبعادها عن مسرح حياته، مسرح الحكاية التي تبزغ هناك على الورق، يُعبِّر الرَّاوي عن استبعاده للفتاة من حياته بقوله: “كأنَّ الحياة ورشة كتابة أو قراءة”؛ فاللعبة هنا لعبة خاصة بالكتابة، إزاحة للحياة، بكل معانيها، من شفقة ومحبة وآلام وأحاسيس من التي يمكن أن يشعر بها البشر ما داموا على سطح الحياة، أمَا وقد دخلوا ملعب “الأدب”؛ فاللعبة لها قواعد وقوانين مختلفة، فعندما يشرع في كتابة القصة يتردد بين رغبته أن يصبح راويًا داخليًا، جزءًا من الحكاية، بطلًا وشخصية رئيسية، وبذلك يصبح “خياليًا”، ورغبة أخرى مُضادة لها أن يكون راويًا خارجيًا، كُلِّي العِلم بما يجري للشخصيات، متحكمًا في مصيرها، صانعًا حيواتها دون أن يَتورط في أي فعل تقوم به، لن يتسبَّب في قتل أيِّ أحدٍ، ولن يشعر بالندم في أي لحظة، بالعكس يفوِّض آخرين للقيام بكل تلك الأفعال التي ستحدث، تكون لهم أصواتهم، يكتفي هو بأن يَصير صاحب “زاوية الرؤية وضابطها على هواه، في هذه اللحظة سيكون شخصًا “واقعيًا”، يظل متذبذبًا، متعلقًا بين حَبْلي وضعية الرَّاوي الذي يُمكنه أن “يضع مفتاح الحكاية من الخارج” كما يُمكنه أيضًا أن “يضع مفتاح الحكاية من الداخل”.