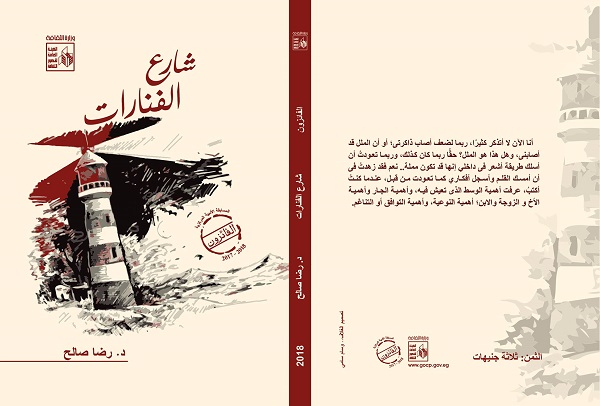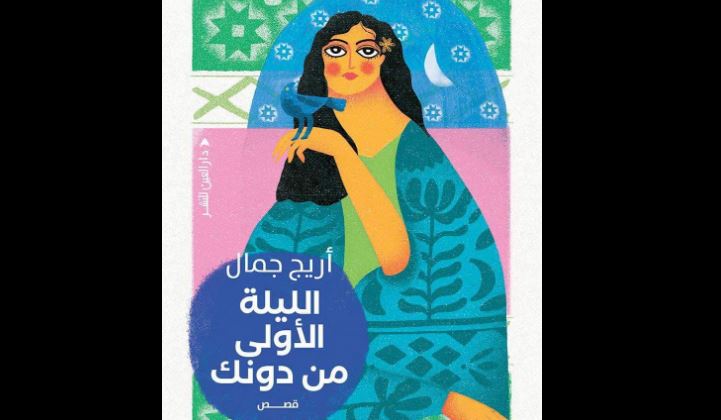حسن البقالي
– اللقاح مؤامرة
ظل جدي يردد على مسامعنا كلما تمت ملامسة موضوع اللقاح.
كانت المشاهد التي تبثها شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي مريعة وصادمة: أبهاء مستشفيات وقد استحالت إلى مهاجع للأنين وجسور إلى ممالك للموت، جثث مهملة على الأرصفة وقبور بلا حصر تنبت يوميا كما تنبت الفقاقيع وهذر كثير، تحليلات متضاربة وبرامج للتحذير والتوعية تنشر من الهلع أكثر مما تنشر من الوعي “لا تغادروا مساكنكم إلا للضرورة القصوى وبترخيص من السلطات، أهجروا عادات المصافحة والعناق، والنظافة، النظافة، النظافة…”
كانت الجائحة تستشري في أوصال الأرض تهدد بالمزيد من الفتك، في ظل لامبالاة تامة من قبائل الخفافيش* واستحسان متزايد من الحيوانات التي غادرت الغاب لتتجول في الشوارع الخالية، وفي ظل رهاب جماعي يسر على الحكومات أن تقنع شعوبها بأية خطوة أو تدبير ولو كانا باتجاه الهاوية، ولم يكن – بالمقابل- للشعوب محيد من أن تصدق أن الحكومات، وهي تفرض حالة الطوارئ، ثم وهي تزرع تحت الجلد مواد غريبة هي عبارة عن لقاح هيئ على عجل، أن تصدق أنها إنما تريد بها خيرا.
هكذا سارعنا إلى أخذ جرعات اللقاح ضدا على تحذيرات البعض ممن انبروا لمواجهة الطروحات الرسمية، وضدا على حكايات تروج عن أناس أخذوا اللقاح فماتوا أو أصيبوا بالعمى أو الشلل
وحده جدي أمعن في الرفض
-قال: “لاتعطوا جلودكم للمؤامرة، لا تعطوا دمكم”
كنا نسمع، في حمأة المعلومات التي تدحض إحداها الأخرى عن مؤامرة عظيمة تحاك للبشرية من لدن عقول جبارة تدير شؤون العالم من خلف ستار وتتحكم في الملوك والرؤساء وساسة الأرض. الأرض التي ضاقت بما تحمل، والتي وجب التخفيف عنها بتقليص أعداد الساكنة إلى حدود المليار الذهبي
– الأرض بمليار نسمة ستتمكن من غسل رئاتها والتنفس عميقا، سترتاح. هكذا قالوا، والضحايا؟ نحن العجائز والمهمشين والفئات الأكثر هشاشة والأكثر تطلبا للرعاية والأقل مردودية في نظر الشركات والمؤسسات المالية
تتقد عيناه من الغضب ويجمع قبضة يده يلكم بها الهواء. كان يشعر بأنه مستهدف بشكل شخصي، هو العجوز الهش الذي لم يعد به “نفع” سوى أن يتصدر الصالة ويتابع بامتعاض الشكل الذي اتخذته الحياة داخل المنزل
– لقد خوزقكم صاحبكم )يقصد زوكربرغ(، علقكم بين “الجيمات” والقلوب التي لا تنبض، ثم أجهزت كورونا على الباقي.
تفرس في وجوهنا قليلا، وربما لاحت بسمة ساخرة أخيرة على شفتيه، وقال:
– لا بقاء لي بينكم
هكذا حسم قراره باعتزال الأسرة، واتخاذ الغرفة على السطح مسكنا له، مع الاحتراز من كل ما يمكن أن يصيبه أو يفسد خلوته. توضع حاجياته عند باب الغرفة، وعند باب الغرفة يضع ما فضل عنه أو اتسخ. لا يرى أحدا أو يراه أحد. بهذا الشكل عاش أياما متتابعات وأسابيع كما لو أنه محض فكرة ضبابية عن جد بعيد في القدم تقدم له القرابين ويزورنا في الحلم
أحيانا
أحيانا فقط، تجتمع الأسرة حول المائدة أو أمام التلفزيون، فيلوح بشكل فجائي مثل طيف متوعد، بعد أن يكون قد تسلل من غرفته وهبط الأدراج، يجول بنظرات عجلى على سحناتنا ويصيح:
– ها.. ما زلتم أحياء يا أولاد الذين..
ثم يفر إلى غرفته قبل أن يكلمه أحد
كنت أصعد أحيانا إلى السطح بدافع من فضول لمعرفة ما عسى أن يفعله رجل عجوز ووحيد في غرفة مسدلة الستائر، معتمة ومحايدة تماما كأن لا شأن لها بما يحدث في الخارج، غرفة نائمة بعمق وصامتة.
صمت يقطعه جدي في أحيان نادرة بجمل متقطعة يرمي بها في وجه الفضاء كما لو أنها فضلات، قبل أن تعود الغرفة إلى نومها. هكذا تمكنت من التقاط بعض مما فاه به، من قبيل:
“ها أنذا أتنفسك بعمق أيها الهواء فهل تمانع؟
يقولون جدي جدي وأنا من هو جدي؟
حين تنكشف الروح للجسد يرى الجسد حقارته..”
ولم أشعر ذات يوم حتى سحب جدي الباب إليه لأجدني أمامه وجها لوجه. وجه إلي نظرة بيضاء رهيبة وخاطفة، نظرة شخص غريب عائد من موت محقق وليس في نيته التآلف مع الأشياء والأشخاص
غمغم:
– إئتني بقلم وأوراق أيها الإنسي
ثم أغلق الباب في وجهي
كان يفقد كل الصلات بنا ويتحول إلى شخص آخر. ولم نكن نعرف أي كائن سيغادر تلك الشرنقة التي صار يعيش وسطها في عزلة عن كل مؤثر خارجي
– وإذن، لم تموتوا بعد؟ ما أغباكم
وكان باديا عليه التعب حين لاح كطيف عند الباب، أطلق هذه الجملة كما تطلق الخرطوشة الفاسدة من بندقية غابت عنها الصيانة وصعد الأدراج. هل كان يوجه كلامه إلينا؟ أم أن الطيف الذي صاره يحدث أطيافا لامرئيين وظلال من عبروا ذات فترة ثم أكلهم الزمن كما يأكل العث الأثاث
فهل أصيب بالوباء رغم العزلة والتدابير الاحترازية، وكانت به حمى أم أن جنية من أهل العوالم السفلية بعثرت كيانه؟ هل كانت هلوسات أو تعويذات وأدعية أم مجرد حوار صاخب متقطع مع الذات شبيه برمي حصوات على صفحة ماء راكد أو ضرب خفيف على دف؟ ذاك ما كنت ألتقطه حين أصعد بعد العشاء لآخذ ما وضعه عند باب الغرفة من ماعون وبقايا طعام، وأنتهز الفرصة للتنصت مليا على الأصوات التي تتنفسها الغرفة. يخطر لي أن جدي قد جن، وأنه يطوف عاريا حول نار متخيلة، أو يسابق غزلانا لامرئية في وهاد بعيدة لن يرجع منها أبدا. ترى أين بلغ بك المسير أيها الجد؟
يسألني أفراد الأسرة عما حصل وإن كان ثمة جديد، هل كلمك؟ هل فتح الباب؟ هل هو مريض؟ لولا أن الأسئلة باتت متأخرة ودون معنى، فقد مات جدي على حين غرة. لم يود به المرض ولا الوحدة، بل سقط من أعلى الدرج ودق عنقه.
في ذلك اليوم، بينما نحن منشغلون بأشيائنا الصغيرة، بمشاغل العمل أو الهاتف أو المطبخ أو مجرد نميمة تمنح الذات اعتبارا ما، فتح جدي باب الغرفة، عرض أثاثه البسيط لشمس النهار، ثم نزع ثيابه عن آخرها، اغتسل وقصد الأدراج.
كان هناك صوت ارتطام جمجمة بحائط وتقصف ضلع أو أكثر وغمغمة ضعيفة وصلت بالكاد كأنها نداء او ابتهال أو تصديق على وعد “ها أنذا قادم أيها الأطياف”. الآن وأنا أسترجع ذلك، لا أعرف بالضبط أيهما أسبق: الارتطام أو الكلام، وهل نطق جدي بذلك فعلا أم أن الذهن يتكئ على الخيال أحيانا وينسب مخرجاته إلى الذاكرة؟ بدا هناك، أسفل الأدراج بجسده العاري تماما والموشوم بدم طازج مثل وليد استقبل الحياة للتو ولم تنظفه المولدة بعد من دم الولادة. ووسط البلبلة التي يحدثها الموت، وسط الضوضاء المحدثة والهرجلة والنحيب، كان لي من صفاء الذهن وسرعة البديهة ما أسعفني بالهرولة صعدا إلى الغرفة على السطح والسطو على أوراق جدي.
يبدو أنه كان يكتب بيد راعشة متلعثمة وبخط متكسر، لكنني تمكنت من فك شفرة ما كتب. لم يكن وصية ولا رسالة وداع، بل جرح انفتح وصنبور مشاعر رجل عجوز وملهم تنحدر حياته نحو الأفول مثلما تنزلق الحكاية نحو النهاية.
قرأت:
ها أنذا أتنفسك بعمق أيها الهواء فهل تمانع؟ هل تحسب أن الشمس وهي تهوي في حركتها الأخيرة نحو الغروب، تخشى ذلك؟
في سني هذا، سن السابعة والسبعين روحي مثقلة بالزمن وبالخطايا وجسدي موغل في الهشاشة، هل أعبأ بشيئ اسمه كورونا وأخشى على حياتي منه؟ في هذا العمر هل يعتبر الإنسان حيا إلا بما كان؟ في زمن سابق يبدو بعيدا جدا الآن وغابرا، كانوا يتجارون إلي: “جدي جدي احك لنا حكاية” أو أهتف بأحدهم ” تعال يا ولد حك لي ظهري” وها هي الهواتف تشغل كل أوقاتهم وتضطلع بجل المهام، هي التي تحكي هي التي تعلم وهي التي تواسي وتكسب المال وتجلب المتعة وتغني عن الجد والأسلاف جميعا.
– جدكم الآن هو الهاتف
– كم أنت متعب يا جدي
الطعم في فمي مر وروحي طائر سمان يترنح، وعلي أن أتخفف قليلا من الأشياء والأشخاص والتطلعات ومحاولات استدرار عطف الصيصان التي تنغل حولي في لامبالاة. وها كورونا تستوطن الأرض تنشر الهلع وتقدم الذريعة المثلى )هل كنت أحتاج إلى ذريعة؟( لقطع الحبل السري مع الآخرين بشكل نهائي.
اعتزلتهم
اعتزلت الأولاد والأحفاد والجيران وأصداء الجزر الجديدة التي تهديها الهواتف النقالة لأفراد الأسرة، كل بجزيرته الشخصية التي يؤثثها حسب هواه، وعالمه المختوم بالصمغ، فيما أبدو بين كل ذلك شيئا مهملا على قارعة الطريق، فائضا عن الحاجة أو أكاد، للتسلية أحيانا وللنسيان كل الوقت. يقولون” جدي جدي احك لنا حكاية” وأنا من هو جدي الآن؟ من يحكي لي ويعيد بعض الضوء إلى العينين وبعض الدفء إلى القلب، من يتدلى إلى أعمق أعماق الروح يصقل الأوتار التي شاخت ويعيد وصلها من أجل أغنية أخيرة؟ أما يزال في العمر بقية؟ وهذا الجسد هش هش والروح قلقة قلقة.. أكلما أشرقت الروح على الجسد رأى الجسد حقارته؟
– تعال يا ولد حك لي ظهري
– كم أنت متعب يا جدي
أتسلل من الغرفة وأهبط الأدراج بحذر، أرقبهم من خلل انفراجة الباب فيترسخ لدي انطباع بأنني أدك قبرا غريبا في مكان مهجور كي أسويه بالأرض، وأمعن في التيه علني أعثر في النهاية على بعض ذاتي.
أم أنني مجرد فراغ يروم امتلاء؟
الفراغ يأكل العالم، يأكل العلاقات والقيم، والتفاهة أفقه الأخير
– ها.. ما زلتم أحياء يا أولاد الذين
أتعرى تماما وأدلق جردل ماء على جسدي، وأقصد الأدراج خفيفا بعد أن أكون قد هيأت نفسي للموت كما تهيأ لقمة الكسكس جيدا قبل أن تقذف في الفم.
…………………….
* باعتبار أن إحدى الحكايات الرائجة ترجع الجائحة إلى خفاش من مقاطعة صينية تدعى “ووهان”