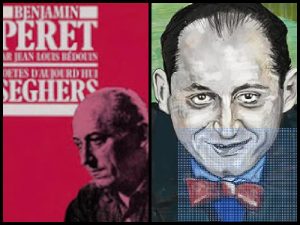|
يصعب أحيانا تحمل الشعور بالذات. تفرض الهوية نفسها كطغيان مع المسؤوليات الشخصية أو الاجتماعية أو العائلية أو المهنية التي تصاحبها. يسعى بعض الأفراد إلى محو أنفسهم، وعدم شخصنة أنفسهم، والانسحاب من شخصيتهم. كان روبير فالزير، وهو كاتب سويسري (1878- 1956) ناطق بالألمانية، واحدا من هؤلاء. كاتب لم يلتزم أبدا بوجوده. كاتب ينتمي إلى ذلك النوع الذي يمكن وصفه بالكائن السري، أو بالكائن الذي لا يريد أن يترك أثرا بعد مروره. انغمس في الكتابة وفقًا لتطلعاته وأذواقه، دون مراعاة قواعد النقد والأساليب السائدة في وقته. كاتب من ذوي المصائر الاستثنائية نال إعجاب كبار الكتاب في النصف الأول من القرن العشرين، لكنه أدار ظهره للجميع ولكل شيء. في هذه المقالة المقتطفة من المجلة الفرنسية للأخلاق التطبيقية (2 /2018 ع 6 ص 81/90) والتي أنجزتُ ترجمتها من اللغة الفرنسية إلى العربية، سنحاول أن نفهم مع دافيد لو بريطون ( 1956) أنثروبولوجي وعالم اجتماع فرنسي ومختص في تحليل السلوك المحفوف بالمخاطر، لماذا زهد روبير فالزير في الشهرة واختار الخلود إلى الصمت بمحض إرادته، وكيف جنح إلى الاختفاء والعيش في منطقة البياض منسلا من هويته، من خلال قراءة تحليلية لشخصيته وأعماله الأدبية. |
تقديم وترجمة: عثمان بن شقرون
«ألستُ في حاجة إلي سكينتي ؟ في مثل هذه الحالة، من الأفضل أن أبقى وحيدًا تمامًا. لم أكن أرغب في شيء عندما تم حجزي في المستشفى. يجب على الناس البسطاء مثلنا أن يظلوا هادئين قدر الإمكان في مثل هذه الوضعية. »
كارل سيليج، “نزهات مع روبير فالزير”
بذلُ الجُهدِ في أن يكون المرء ذاته
يصعب أحيانًا تحمل الشعور بالذات. تفرض الهوية نفسها مثل طغيان مع المسؤوليات الشخصية والاجتماعية، والعلاقات العائلية أو المهنية المرتبطة بها. في بعض الأحيان يكون الإغواء قويا للانسحاب من هذه الشبكة الصعبة من القيود التي تفرض على الفرد تمثيلا دائما على المشهد الاجتماعي دون أن يستثمر حقًا في الشخصية التي يجسدها في عيون الآخرين. وتتمثل المهمة بعد ذلك في أن ينفصل المرء بنفسه جزئيا عن ذاته، ليصير غير مرئي إلى حد ما، وأن يظل متحفظًا إلى ما لا نهاية، وأن لا يستسلم أبدا، وأن ينفك من عبء الأنا. بعض أشكال محو الذات، ما أسميته البياض، مؤلمةٌ مثل الاكتئاب أو الإرهاق على سبيل المثال، فهي مزمنة أو مؤقتة، تارة يكون الفرد هنا في بعض الأوقات، وأحيانا أخرى لا يكون هنا، أو يكون هنا فقط من خلال حضور شبحي. هكذا يتحمل البعض نوعا من «إضراب الوجود»، فهم يقفون على جانب الطريق مثل المتفرجين غير المبالين، ويرفضون السير على خطى الآخرين. إنهم لا يغادرون دون أن يتركوا عنوانا، مثل الآخرين، بعيدًا عن انقطاع الأنفاس أيضًا، لكنهم ينسحبون إلى قوتهم الداخلية للمشاركة بأقل قدر ممكن في الرابطة الاجتماعية.
لا يتعلق الأمر بالاختفاء من الذات بالمعنى الحرفي للكلمة، بل بالاختفاء وراء إحدى الشخصيات الموجودة بالقوة داخل الذات عن طريق محو الحالة المدنية التي تسجنها، مع الاستمرار في العيش ولكن في سجل لم يعد يعطي الكثير من السيطرة للآخرين. كل شخص يُعتبر قارة من الشخصيات الممكنة، و«أنا» هي ألفٌ من الآخرين. كل فرد هو ماسة بوجوه لا حصر لها، وكل وجه منها يقدم تعريفًا مختلفًا، على الرغم من أن كل واحد من الوجوه يبدو وكأنه يمنح لوحده الوصول إلى قلب الماسة. الاختفاء من الذات هو وسيلة للهروب من التعريفات الاجتماعية الضاغطة، والانسحاب من إلزامات النظام من أجل الانسحاب من العالم، كنوع من الرهبنة العلمانية الملتزمة بتجنب التورط قدر الإمكان في مسار العالم. يطلق المرء سراح انتباهه ويكف عن الشعور بكونه معنيا إلا من مسافة بعيدة. إنها ليست مسألة رفض للتعاون بقدر ما هي مسألة لامبالاة، إنها وجود بصوت منخفض، إلى أدنى حد، كما لو كان مكتومًا. هي طريقة للتموقع خارج المعنى، أو إلى جانب المعنى، دون أن يتخلى المرء عن وجوده تمامًا، ولكن دون أن يجازف به. يقول موريس بلانشو: «إن الكائن الموسوم بالحياد لا يُلاحَظُ» (1969, p. 565) لأنه لم يعد هناك أي فرصة للسيطرة عليه. ذوبان الذات في شفافيتها تجاه الأحداث، دون الاكتراث بطبع بصمتها عليها. لم يعد المرء يصبغ المواقف بأي تراتبية، فهي على مسافة متوازية وتُقدر بشكل خاص في عدم الانخراط فيها أبدًا، وتركها تتدفق دون المشاركة في أدنى جزء منها من خلال الانقياد لحركتها مما يُشبه مفهوم “وو واي” في التقليد الطاوي. يعني عدم التداخل في مسار الأحداث، والاستجابة للاستعطافات دون أخذ زمام المبادرة، والانقياد للأحداث دون تغيير اتجاهها.
أنا أسمي البياضَ هذه الحالة الواضحة من الغياب بشكل أو بآخر، في الحقيقة، إن المرء يُغيِّب نفسه بصيغة أو بأخرى بسبب صعوبة أو مشقة أن يكون ذاته. وفي جميع الحالات، فإن الرغبة هي الإفراج عن الضغط. إن البحث عن علاقة مبطنة مع الآخرين، هو مقاومة لضرورات بناء هوية في سياق الفردانية الديمقراطية لمجتمعاتنا. يستجيب البياض للشعور بالتشبع والفيض الذي يشعر به الفرد. إن عالم التمثلات الذي يعبره باستمرار متقطع أو مضطرب، ووساطة المعنى تتراخى. إنه يحافظ على وجوده كصفحة بيضاء لكي لا يضيع أو يتعرض لخطر التأثر بالعالم. إنه مرتاح من بذل الجهد ليكون ذاته، وأحيانًا لم يعد يعرف حقًا من هو أو أين هو، ولم يعد يتحمل أي مسؤولية تجاه الآخرين أو تجاه وجوده الخاص. لم يعد العالم يعنيه، فهو يتجول في أرض خلاء يحتاجها لالتقاط أنفاسه، والتخلص من التوترات التي تخصه. إنه يقف في عالم النسيان، ليس في صلب الحياة ولا في الرابطة الاجتماعية، ليس في الداخل تماما وليس في الخارج تماما. يقال أحيانا: “لدي فراغ”، للإشارة إلى نسيان أو غياب، أو نوع من الفاصل. إنها حلحة للوجود على الوضع الأدنى، تقليص للعلاقة مع العالم. وتقييد يفرض نفسه باستمرار.
إن البياض فتور، واستغناء عن الأشياء ناتج عن الصعوبة في تحويلها. إنه ينحني أمام مادية العالم التي لا رجعة فيها، وأمام المطالب الاجتماعية. في عالم السيطرة هذا الذي يفرض نفسه في أجواء مجتمعاتنا النيوليبرالية، هناك إرادة متناقضة في العجز، والاستغناء. توقف الفرد عن الرغبة في التحكم في وجوده والسماح لنفسه بالانسياب. لا يعود الفرد يرغب في التواصل، ولا التبادل، ولا إبراز نفسه في الزمن، ولا حتى المشاركة في الحاضر؛ ليس لديه مشروع، ولا رغبة، وليس لديه ما يقوله. إنه يفضل رؤية العالم من مكان آخر. إن السعي المتناقض هو السعي إلى عدم الشخصنة، والتخلص من جميع قيود الهوية من أجل الوجود في الحد الأدنى فقط.
روبير فالزير أو عدم الشخصنة
يُعَد الكاتب السويسري روبير فالزير مثالاً صارخًا لهذه الرغبة الشرسة في التكتم. كاتب كبير ولكنه مغمور مادام أثره لا يزال غير مألوف ولأنه سعى إلى حماية نفسه من الروابط الاجتماعية العادية والابتعاد عن أعماله. عندما سئل عن هذا، أجاب بسكينة: « في الواقع، هناك أشخاص يرغبون في استخلاص دروس الحياة من الكتب. بالنسبة لهذا النوع من الأشخاص المحترمين للغاية، يجب أن أقول إنني، للأسف الشديد، لا أكتب». إنه يبلور عملا عن «لا شيء» من أجل «لا شيء». إن قراءة أعماله تجربة مربكة بالفعل، حيث تزخر بالانحرافات الجميلة، والانتقالات الفجائية، والسخرية الطفولية. حتى أن فيليب فورست يتحدث عن فن «مخادع عمدًا» (2010، ص 9). وتتحدث إلفريد جيلينك عن « خطاب انفصامي […] انقسام الذات» (2007، ص 70). إنه يشعر بأنه خارج العالم ويشعر وكأنه رجل مستبعد:
« لقد كنا نرفض بازدراء كل ما لا يتوافق مع العالم الذي كنا نفتخر بأن نكون جزءًا منه. ولكن هذا العالم، لم أكن أبدا لأخاطر باقتحامه. لم أكن حتى أتحلى بالشجاعة لإلقاء نظرة عليه. لذلك عشت حياتي الخاصة على هامش الوجود البرجوازي. ألم يكن هذا جيدا؟ وإذا كان عالمي أفقر وأقل رسوخًا من عالمهم، أليس الأمر جيدا على النحو؟ ومع ذلك، فهو أيضًا لديه الحق في الوجود. » هكذا صرح لكارل سيليج في يوليوز 1941 (1992، ص 36-37).
وبعد بضعة أشهر: «هل تعلم لماذا لم أتقدم بصفتي كاتبا في الرتب؟ سأقول لك: غريزتي الاجتماعية لم تتطور بما فيه الكفاية ولم أكن أمثل بما يكفي الدور الكوميدي الذي كان ينبغي عليّ أداؤه لكي أرضي الناس» (سيليج، 1992، ص. 43).
ولد روبير فالزير في عام 1878 في بيال، سويسرا، وهو الطفل ما قبل الأخير لعائلة مكونة من ثمانية أطفال، لم يترك أي منهم ذرية. غادر المدرسة في سن مبكر. ولج التدريب المهني في سن 14 عامًا في فرع الشركة التابعة لبنك كانتون برن. ثم في Speyer and Co ، وهو بنك بازل ودار للشحن. وهو ناسخ، تميّز بخطه الجميل ونَعِم بتواضع عمله. في ذلك الوقت، أراد أن يصبح ممثلا، وانضم إلى جمعية بيال لفن الدراما. كونك ممثلاً، فهذه طريقة أخرى للتخلص من ذاتك من خلال القيام بأدوار أخرى. يضاعف من الوظائف الصغرى، والتي غالبا ما يتركها بسرعة كبيرة لتكريس نفسه للكتابة. بعد بضع سنوات التحق بمدرسة الخدم، التي تخرج منها في عام 1908، معهد بنجامينتا. لا يحيا إلا لكي يكتب في عزلة عميقة. اشتغل لفترة من الوقت خادما في شاتو دامبرو. هناك، كان عليه أن « ينظف الغرف، ويصقل الملاعق الفضية، وينفض السجاد وأداء الخدمة تحت اسم السيد روبير» (المرجع نفسه، ص. 20). في برلين، كان يتردد على الأوساط الأدبية دون أن يشعر بالراحة فيها. نشر نصوصا نثرية قصيرة، ثم رواية ” الإخوة طانير” في عام 1906، ورواية “الناسخ” 1907، ورواية “معهد بنجامينتا” في عام 1908. لاحظ فرانز كافكا هذا العمل الأخير ووصفه بأنه مضطرب، وأنه يتقدم على عصره، وأخبر ماكس برود بأن هذاالعمل هو المفضل لديه. كُتبت هذه الروايات التعليمية في غضون أسابيع قليلة، لكنها لم تفض إلى دخول مريح وسعيد إلى العالم. بيعت كتبه بشكل سيئ، وتخلى عن هذا النوع من الكتابة.
بحلول عام 1911 كان يعمل ناسخا وساعيا وماسحًا للأحذية. على الرغم من الكتب والمقالات التي ينشرها، فإنه يرفض أي تسوية في عالم يكافح فيه للتعرف على نفسه دون أن يضع نفسه في موقف الرفض الكامل له. العالم هنا، لكنه غير مهتم به لأنه إذا كان من الضروري التوقف عند هذا الحد، فسيتعين عليه تحمل اسمه وتاريخه ومسؤوليته. وهو ما كان يرفضه دائما. إنه غارق في وظائف تابعة حيث يصبح غير مرئي، دون أي اتساق آخر سوى الانتقال من مهمة إلى أخرى ودون مزيد من المساءلة. لا يستطيع المكوث ساكنا، وسرعان ما يترك وظائفه. لكنه ليس مسافرا بأي حال من الأحوال، تلخص ماري لويز أوديبيرتي الأمر بشكل مثالي (1996، ص 39): « قد يقول المرء إنه يتحرك بينما هو يمكث في مكانه».
في عام 1912، ابتكر كتابة كثيفة بخط اليد، يصعب على غيره قراءتها، باستخدام قلم رصاص مصغّر، وهي طريقة أخرى للاختفاء من خلال أن تصبح غير قابلة للفك. الخطوط الصغيرة في الوقت نفسه تخفيه وتؤكد وجوده. يلعب باللغة من خلال اللجوء إلى كتابة قديمة من الألمانية العامية، ويخلط بين الأصوات، ويختصر الكلمات، ويستخدم اللهجة والمصطلحات السويسرية الفرنكوفونية… يكتب على أوراق بأحجام مختلفة تقع بين يديه بالصدفة: ظهور الأظرفة والفواتير، وهوامش الصحف، وأوراق التقويم، إلخ. النصوص متنوعة: رواية (اللص)، وقصائد، ونصوص حوارية، وتسجيلات وصفحات مذكرات… في بعض الأحيان يقوم بنسخ بعضها من أجل نشرها، تاركا الباقي في الظل. كتابة يصعب فك تشفيرها ونشرت بعد وفاته (فالزير، 2003).
بعد فترة من الفوضى الداخلية التي كان يسمع فيها أصواتًا، لجأ إلى شقيقته، ثم إلى والده، ثم انزوى بمفرده في غرفة علوية. وحدها الكتابة جعلته يتشبث بالحياة. فيها يختفي لأن حقيقة العيش، حتى في الحد الأدنى، هي بالفعل أكثر من اللازم. بالنسبة لمارث روبير، فإن عمله هو « قصيدة في مدح الفشل الذي تم السعي إليه لذاته، بمرح بشكل ما، دون أمل في التعويض ولا حتى أقل من المكافأة» (روبير، 1960، ص 15). يمحو نفسه بمحض إرادته، ويضحي بالأثر الممكن، مقتنعا بأنه وصل إلى حدوده ويفضل التخلي. يكتب عددا لا يحصى من النصوص غير المتجانسة والقصائد والحكايات والتأملات والقصص القصيرة. يحظى بتقدير محرري الصحف والمجلات، الذين يطلبون منه بانتظام نصوصا قصيرة. « كتبتُ وكتبتُ، لم أترك طاولتي. لم أكتب أبدا بمثل هذا الحماس. لقد كان هجرا. لم أفكر في الأكل. ولا في النوم … ألم يكن تقريبا آلة كاتبة؟ » (Sauvat ، 2002 ، ص 9). كما أنه يستخدم أحيانا توقيعات مختلفة. تجزئة الكتابة تعكس قلقه على عدم الاستسلام، ورغبته في طمس المسارات.
في بداية “معهد بنجامينتا”، يبسط جاكوب الصبي الصغير برنامجًا سيكون هو البرنامج الذي طالب به فالزير: « ما أعرفه هو أنني سأكون فيما بعد صفرًا مستديرا» (1960، ص 33). لا يملك طموحا آخر سوى هجران الروابط الاجتماعية في تقدير لا حدود له. كان للمعهد أيام مجده، لكنه الآن يقع تحت طائلة الإهمال. الصفات الوحيدة المطلوبة هي الطاعة والصبر، وهما طريقتان للتخلي عن الذات. هناك نقص في طاقم التدريس، بعبارة أخرى، « إن السادة المدرسين ينامون، إما أنهم موتى أو لا وجود لهم إلا ظاهريا، أو ربما قد تحجروا، ففي كل الأحوال لا نستفيد منهم» (المرجع نفسه، ص 33). وما هو تعليم المدرسة: « هنا نتعلم الشيء القليل جدا، لدينا نقص في هيئة التدريس، ونحن الآخرين فتيان معهد بنجامينتا لن نصل إلى تحقيق شيء، بمعنى أننا سنكون لاحقا أناسا من العامة متواضعين وخاضعين. » (المرجع نفسه، ص 31). يتعلم تلاميذ المعهد التخلي عن أنفسهم، وأن لا يكونوا شيئا من أجل يذوبِّوا أنفسهم بشكل أفضل في ذهن سيدهم وخدمته بتفان كامل في غياب أي راحة شخصية.
يكمن الانضباط في التدريس المخصص لتعلم الغياب في توحيد الهيئات ومحوها الجذري، حيث يوجد خطر تأكيد التفرد والذاتية. وكل تظاهر بالأصالة يتم قمعه من خلال صرامة المواقف.
« أثناء الدرس، نمكث نحن التلاميذ ساكنين بلا حراك، نحدق إلى الأمام مباشرة. لا أعتقد أنه ليس لنا الحق حتى في مخط أنوفنا. أيدينا تستند على ركبنا وغير مرئية أثناء الدرس […]. أعيننا تحدق باستمرار في فراغ متأمل، وهذا أيضا مطلوب بموجب النظام الداخلي […].لا ينبغي على الشفاه أن تتمايل وتزدهر بشكل شهواني في وضعها الطبيعي الملائم، بل يجب أن تكون مزمومة ومشدودة كعلامة على التضحية والتوقع النشط. » (المرجع نفسه، ص 90 وما يليها).
توحيد الوجوه وتصفيفة الشعر والمظهر: «حتى الخطوط يجب أن تلتزم بالنظام الداخلي. » (المرجع نفسه، ص 92). لا ينبغي مخالفة أي شيء.
أدت الاضطرابات النفسية إلى اعتقاله في والداو عام 1929. وبعد سنوات قليلة، تم نقله إلى هيريساو. فهو لم يتوقف عن الكتابة فحسب، بل إنه لم يبال بمصير كتاباته القديمة، كما لو أن شخصًا آخر كتبها. أفكاره تثقل كاهله لأن « الإنسان الواعي بذاته يواجه دائمًا شيئًا معاديًا لضميره » (المرجع نفسه، ص 6). لم يتلق أي زيارات تقريبًا، باستثناء زيارة الكاتب السويسري كارل سيليج في عام 1936، الذي اصطحبه في نزهات طويلة حول الملجأ والتي ذكرها في كتاب مذهل: نزهات مع روبير فالزير(1992). وكان عمره آنذاك 58 عامًا. يُعد هذا اللقاء الأول نموذجيًا أيضًا، حيث يعلم سيليج من أخت فالزير أن هذا الأخير «متشكك بشكل مفرط»، لذلك ظل صامتًا: « كنت صامتا، وكان صامتا. وعلى جسر الصمت الضيق هذا التقينا » (سيليج، 1992، ص 10). لكن الأمر لم يستغرق وقتًا طويلاً حتى تحدث الرجلان وأقاما صداقة طويلة حتى وفاة فالزير.
داخل المؤسسة، يسعى فالزير أيضًا إلى الاختفاء. يضيع في ورشة العمل المقدمة للمرضى، يقضي ساعات في تقشير الخضروات، وفرز البازلاء والعدس والكستانيات، وصنع الحبال، ولصق الأكياس، ومساعدة نساء التنظيف. يقرأ المجلات القديمة أو كتبا من الماضي. يتولى الأدوار الموكلة إليه من قِبل المستشفى دون أدنى خشونة. لم يكتب أبدًا أو يرغب في القيام بنشاط فني. خلال سيرهما معا، كان يُذَكِّر سيليج برغبته في العودة إلى الملجأ في الوقت المناسب على وجه التحديد ليتم نسيانه من خلال الاختلاط مع دواليبه دون أن يزعجه شيء :
« إنها مسألة شرف. ثم إنني الآن منجذب إلى هيريسو؛ لدي فيه واجبات يومية لا أريد أن أهملها تحت أي ظرف من الظروف. على الأخص، لا تجعلني محط ملاحظة وإخلال بنظام المستشفى. لا أستطيع أن أسمح لنفسي بهذا» (المرجع نفسه، ص 71).
طوال حياته، كان روبير فالزير مشَّاءً لا يكلّ ولا يمل. يجد جوزيف، شخصية كتاب “الناسخ”، عزاءه في المشي، وعلاجًا لحزنه. إنها طريقة أخرى للاختفاء ولكنها سعيدة ومسالمة، وهي تسوية أخرى مع العالم لا تمنع المرء بأي حال من الأحوال من الوجود ضمن الرابطة الاجتماعية، لكن بعناية تجاه العزلة (لو بريتون، 2012).
يندمج فالزير مع الدور المنوط به لكي يختفي، فهو يتلاشى كممثل في وجوده ويستسلم عن طيب خاطر لجاذبية الأشياء. إنه يظل معلقًا خارج الوجود، خلف جدار غير مرئي يقوده إلى أسلوبه الغريب والساخر والصبياني والحاد والمتقطع والاستطرادي في نفس الوقت، كما لو كان منزاحا ومجردًا من الجاذبية، وهو أسلوب « يصدم، أولاً، بسبب إهماله غير المعتاد تمامًا والذي يصعب وصفه،» كما يقول بنيامين (2000، ص 157). في الواقع، يعطي انطباعا بأنه يرفض أي جهد لتغيير أسلوبه. تتحدث ماري لويز أوديبيرتي عن «مبارزة بين الثرثرة والصمت » (1996، ص 183). تتوقف قصصه عند تفاصيل لا حصر لها، وأشياء صغيرة وتأملات منزاحة وساخرة، غير ذات صلة، كما لو كان على المرء أن يتباطأ باستمرار حتى لا يجرفه الطوفان. إنها كتابة الغياب والمسافة، ونوع من الحنان المخيب للآمال، ظاهريا تبدو بلا عمق، والتي أثارت مع ذلك إعجاب فرانز كافكا، وماكس برود، وروبير موزيل، وهيرمان هيسه، وبنجامين، وتوتشولسكي. ولكن أثارت أيضا العديد من الانتقادات العدائية من معاصريه الذين لم يفهموه. بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، أشادت به صحيفة برلين تابلات، لكنها اقترحت عليه التوقف عن الكتابة لمدة ستة أشهر، الأمر الذي ألحق به ضررًا عميقًا. «سنكتفي بعد ذلك بالاعتقاد بأن الكتابة وعدم التصحيح الذاتي أبدًا هو التداخل التام بين الغياب التام للقصد وأعلى درجات الإصرار» (بنيامين، 2000، ص 157). على غراره، تبحث شخصياته عن اللامعنى، وتعزم على الاندماج في الأجواء، ليس لها أي هدف، تضيع في التفاصيل، لا عمق لها، أو بالأحرى كل عمقها يظهر على سطحها. كتب في روايته “الإخوة طانير” (1985، ص 336): «أنا دائمًا أمام باب الحياة، أطرق وأطرق مرة أخرى، دون عنف، هذا صحيح، وأرهف السمع وأصغي بفارغ الصبر إن كان شخص ما آتٍ ليسحب المزلاج ويفتح لي الباب. […].. أنا شخص يستمع وينتظر، لا شيء آخر، ولكن الأمر مثاليّ على هذا النحو، لأنه بالانتظار تعلمت أن أحلم. »
يتعلق الأمر بأن يكون موجودا وفقًا للصيغ الداخلية للغياب. حول شخصيات روبير فالزير، كتب والتر بنيامين إنها « شخصيات تغلبت على الجنون ولهذا السبب، تظهر سطحية تمزق القلب، وغير إنسانية تماما ولا تتأثر بشيء. لتسمية ما لديها من سحر وقلق بكلمة واحدة، يمكننا القول بأنها جميعًا قد شُفيت». (بنيامين، 2000، ص 160).
ست سنوات في والداو وثلاث وعشرين سنة في هيريساو، وجد فالزير في المستشفى النفسي ملاذًا، بمعنى الحماية. في الأشهر القليلة التي سبقت دخوله المستشفى، أقدم على عدة محاولات خرقاء للانتحار. وعند التراجع، أخبر كارل سيليج عن نوبات القلق التي استحوذت عليه في بعض الأحيان: « خلال سنتي الأخيرة في بِرن، عذبتني كوابيس مروعة: دوي الرعد وصراخ، وأيدي خانقة تلتف حول حنجرتي، ونوبات من الأصوات المهلوسة، بحيث كنت أستيقظ كثيرا وأنا أصرخ من الرعب. » (في Seelig ، 1992 ، ص 22).
جاء إلى والداو بمحض إرادته، برفقة شقيقته ليزا. « أمام بوابة هذا المؤسسة، سألته مرة أخرى: “هل تعتقد أن هذا هو الحل الصحيح؟” كانت إجابته الصمت. ماذا كان بوسعي أن أفعل سوى الدخول» (المرجع نفسه، الصفحة 26).
لقد جعل من مستشفى والداو منسكًا له. إن الشفافية الغامضة للشخصيات في رواياته، وعدم اكتمالها، تجعلها قريبة من العديد من شخصيات كافكا، مثل لوريدس بريج للأديب ريلكه أو تورليس تلميذ موزيل، وحتى شخصيات بيرانديللو، وهي شهادات على عالم متغير، حيث تكتسح الفردانية المجال بلا توقف ولكنه يجعل وجود أولئك غير القادرين على إعطاء معنى لوجودهم أكثر ضعفا وأكثر ترددًا.
توقف عن الكتابة عندما كان في الخامسة والخمسين من عمره. صحيح أن وصول النازيين إلى السلطة عزله عن الصحف الألمانية التي كان ينشر فيها مسلسلاته. ثم أن المحررين الذين كان يعرفهم تم طردهم أو قتلهم، أو تم القضاء على الصحف.
في محادثاته مع كارل سيليج، يشرح تهميشه على النحو التالي: لم يرغب أبدًا في بذل أدنى جهد: « لهذا السبب بقيت في أعينهم نقطة الصفر، الرجل الذي لم يكن يستحق الحبل ليشنق به. » أن تصبح عديم الأهمية، كما يقول فيليب لاكادي، بالمعنى المزدوج للمصطلح، أن تكون خاليًا من أي معنى ومن الأهمية الاجتماعية» (2010، ص 95). شيّد فالزير لنفسه ملجأً، ديرًا داخليًا حيث لا يمكن لأحد أن يطرده منه. يريد أن يمر دون أن يلاحظه أحد، رماديًا في الجدران الرمادية، لتجنب إثارة أدنى اهتمام بالآخرين:
«أصبحتِ الأرض حلمًا؛ أنا نفسي أصبحت شيئًا داخليًا… لم أعد أنا، بل شخصًا آخر، ومع ذلك، ولهذا السبب بالتحديد كنت أنا.. الإنسان الداخلي هو الوحيد الموجود حقًا. »
الشخصيات التي ينشئها فالزير لا تريد أن تكون أفرادًا، فمُهِمَّة أن يكونوا ذاتهم لا تعنيهم، فهم يعتزمون الاندماج في الخلفية. عندما أخبره سيليج، أثناء سيرهما، أنه سيتم التعرف عليه يومًا ما في صورة شاعر سويسري آخر، هو جوتفريد كيلر، الذي شهد أيضًا عبورًا طويلًا للصحراء،
« توقف، كما لو كان متجذرًا في الأرض، ونظر إليّ بأشد التعبيرات جدية وأخبرني أنني إذا كنت أقدر صداقتنا، فلن آتي إليه لأكلمه بمثل هذه المجاملات. هكذا هو روبير فالزير كان صفرًا وأراد أن يُنسى » (Robert ، 1960، ص 14).
ومع ذلك، بفضل جهود كارل سيليج ، في عام 1953 تم نشر كتبه مرة أخرى في خمسة مجلدات. صدر “معهد بنجامينتا” في عام 1950 والتقى أخيرا بقرائه في الملجأ، ظل فالزير واضحا بشأن نفسه دون التراجع عن قراره بالتخلي عن هويته.
كتب في معهد بنجامينتا (1960، ص 209): « أن أكون عديم الأهمية وأن أظل كذلك. وإذا رفعتني يد أو ظرف أو موجة وحملتني إلى مرتفعات القوة والائتمان، فسأدمر حالة الأشياء التي ستكون لصالحي، وسأرمي نفسي بنفسي في أعماق العتمة الوطيئة والعقيمة. لا أستطيع التنفس إلا في المناطق السفلى».
يعلم بوفاة شقيقه كارل بنوع من البرودة،. عندما تتجه شقيقته ليزا، المصابة بالمرض، ببطء نحو الموت، لا يشعر بأي رغبة في رؤيتها مرة أخرى. بعد تشخيصه بشلل الأمعاء، يرفض أي علاج أو عملية جراحية، لكن المرض لا يؤثر عليه كثيرًا حيث يموت بعد أحد عشر عامًا. يرفض أيضًا العلاج النفسي التحليلي الذي اقترحه أحد أطباء النفس في هيريساو. يشعر بالراحة في غيابه ولا يرغب على الإطلاق في تغيير شخصيته. يشعر بالراحة تمامًا في دور المقيم ويؤدي المهام المسندة إليه ببراعة.
بياض الثلج يطارده مثل هاجس، فالثلج يغطي تعقيد وتناقض العالم ببساطته السلمية. يجعل الأشياء موحدة. إنه يعلق كل مسؤولية عن البيئة ويود أن يلف نفسه فيها من أجل جعل نفسه غير مرئي وصامت. من خلال تغطية المساحة ببياضه، فإنه يجعلها تختفي بلطف. والصمت الذي يسود حوله يزيد من إبراز هذا الشعور بعالم معلق لم يعد يتطلب أي شيء والذي أصبح من الممكن أخيرا أن يرتاح منه. أي هروب ضيق من أي مسؤولية يتم تدميره. يكتب (2000، ص 228): «كان هناك سلام لدرجة أنه كان على المرء أن يعترف على الرغم عنه بأن كل شيء في العالم قد تم الوفاء به وتصفيته واسترضاؤه»، الثلج هو محفل ملكي للاختفاء.
في كتابه “الإخوة طانير”، تصف إحدى شخصياته اكتشافها في الغابة لـ “شاب ملقى عبر الطريق وسط الثلج”، سقط على الأرض منهكًا ومات من البرد. ويظل مندهشًا ويقول في نفسه إنه «بكل نبل اختار قبره. هناك، تحت أشجار التنوب الخضراء الرائعة التي تغطيها الثلوج» (فالزير، 1985، ص 135). قبل أيام قليلة من لقاء آخر كان مقررا مع كارل سيليج، وفي يوم عيد الميلاد عام 1956، قام روبير فالزير البالغ من العمر 78 عامًا، بمسيرته المعتادة في البادية المكسوة بالثلوج. يمشي صوب أنقاض روزنبرغ للتأمل في المناظر الطبيعية الرائعة لجبال الألب. يتسلقها بين أشجار الزان والتنوب. وفجأة يخفق قلبه، ويسقط إلى الوراء، ويستلقي على ظهره ويضع يده على صدره. مات غارقًا في البياض، وجسده مغطى جزئيًا بالثلج. في وقت لاحق، يكتشفه الأطفال ويطلبون النجدة، إنها الموت، طريقة أخرى الأكثر شيوعا لكي لا يكون المرء هناك.
البحث عن ملاذ
مثل الدير أو المعبد ، ولكن في سياق علماني، فإن مستشفى الطب النفسي (على الأقل في هذه الفترة التي لحسن الحظ لم تكن تعرف بعد فرط العلاج الكيميائي للمرضى الشائع اليوم) هو مكان للاختفاء، ملاذ حيث لم يعد الفرد لديه أي مساءلة وحيث من الواضح أنه ينزلق من مهمة إلى أخرى في جدول تحكمه المؤسسة بالكامل. لم يعد مضطرًا إلى الاهتمام بوجوده، فالآخرون من حوله موجودون لمراقبته. لم يعد لديه ممتلكات، ولم يعد لديه أي شيء يرغب فيه، ببساطة أن يكون هناك من لحظة إلى أخرى في حد أدنى من الحضور. إنه شغف اللامبالاة، أو بالأحرى العجز. الاعتماد المستمر على الآخرين لنشر الوجود الذي يسعى إلى أن يكون صغيراً. كان المستشفى في ذلك الوقت، في سويسرا، مكانًا للتخلي عن الذات، رغم الازدحام الذي كان يسوده في البداية، ولكن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل السكينة، وتجميد الوعي وإلغاء الزمن لصالح مدة لا تحتوي على مفاجآت. يجد العديد من الأفراد المأوى هناك، والحماية من الاضطرابات الاجتماعية حيث لا يمكنهم العثور على أنفسهم. إن الجهد المبذول في أن يكونوا على طبيعتهم ويحافظوا على الواقع أمر ثقيل جدًا بالنسبة لهم. ثم يقومون بعد ذلك بتفويض مسؤولياتهم إلى الآخرين، إلى أحبائهم الذين يستمرون في زيارتهم ويحافظون على حضورهم الشبحي في تواصلهم الاجتماعي، وإلى طاقم الطب النفسي الذي يراقبهم باستمرار ويريحهم من المهام اليومية. غالبًا ما تؤدي الأدوية النفسية إلى محو الإحساس بالذات وتتركها عائمة مع مرور الأيام. في هذه الظروف، يخلقون مساحة من الامتصاص حيث لا تصلهم ضوضاء العالم إلا بعد تصفيتها، ويتظاهرون بسهولة بعدم سماعها ويواصلون وجودهم بحركة بطيئة. المؤسسة عبارة عن خط فاصل، نوع من الملاذ بعيدًا عن التناقضات التي لا تطاق في العالم الخارجي. وآخرون، أكثر عددا، يقيمون مع أسرهم، محميين، محاطين، معفيين من المهام المشتركة. إنهم يعيشون بصمت، راضين ببعض المسارات البسيطة، وبعدد قليل من الأنشطة المتكتمة، أو يبقون في غرفتهم، فإن انتحال شخصياتهم يسمح لهم بالاستمرار في الوجود بطريقتهم الخاصة. وفي مواجهة الحركات في العالم التي لم يعودوا قادرين على متابعتها، فإنهم يطالبون بالحق في الامتناع عن التصويت، والصمت، والانسحاب. إن العيش على نطاق التواصل الاجتماعي المشترك يعد متطلبًا كبيرًا بالنسبة لهم. هكذا منعزلين، يخرجون بأقل قدر ممكن لتجنب أي لقاء إذا لم يشعروا بالقوة اللازمة للحفاظ عليه، ويحافظون على مواردهم الداخلية ويصبحون نساكًا داخل الحشد. يبقون في الدائرة ولكنهم كفوا عن المشاركة و يشعرون أنه لم يتبق لديهم شيء ليقدموه. إن التدخل تجاههم لمحاولة إعادتهم إلى الرابطة الاجتماعية التي يرفضونها هو سؤال أخلاقي تكون كل إجابة عليه فريدة من نوعها. لا شك أن هؤلاء الرجال أو النساء كانوا سيجدون في أوقات أخرى سكنًا في الأديرة أو الكنائس. لكنهم اليوم مهجورون ويعاد استثمارهم في مهام أخرى غير الصلاة أو الخلوة. هناك أماكن قليلة، خارج أي قيود طبية أو مؤسساتية، قادرة على الترحيب بهؤلاء المنفيين من الداخل.
البيبلوغرافيا مرتبة حسب ورودها في النص الأصلي
AUDIBERTI, M.-L. 1996. Le vagabond immobile, Paris, Gallimard.
BENJAMIN, W. 2000. Robert Walser, Œuvres II, Paris, Gallimard, coll. « Folio ».
BLANCHOT, M. 1969. L’entretien infiniment, Paris, Gallimard.
FOREST, P. 2010. « Ce que j’écris sera peut-être une préface », dans P. Lacadée (sous la direction de), Robert Walser. Le promeneur ironique, Nantes, Éditions Cécile Defaut, p. 7-14.
JELINEK, E. ; LECERF, C. 2007. L’entretien, Paris, Le Seuil.
LACADÉE, P. 2010. Robert Walser. Le promeneur ironique, Nantes, Éditions Cécile Defaut.
LE BRETON, D. 2012. Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur, Paris, Métailié.
LE BRETON, D. 2016. Disparaître de soi.
Une tentation contemporaine, Paris, Métailié.
MÉCIF, Y. 2009. Entre présence et absence, Bédarieux, Rémanences.
ROBERT, M. 1960. « Préface », dans R. Walser,
L’Institut Benjamenta, Paris, Gallimard, p. 7-29.
SAUVAT, C. 2002. Robert Walser, Monaco, Le Rocher.
SEELIG, C. 1992. Promenades avec Robert Walser, Paris, Rivages.
UTZ, P. 1999. Robert Walser : danser dans les marges, Carrouges, Zoé.
WALSER, R. 1960. L’Institut Benjamenta, Paris, Gallimard.
WALSER, R. 1985. Les enfants Tanner, Paris, Gallimard, coll. « Folio ».
WALSER, R. 2000. L’homme à tout faire, Lausanne, L’âge d’homme.
WALSER, R. 2003. Le territoire du crayon. Microgrammes, Carrouges, Zoé.