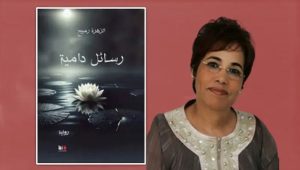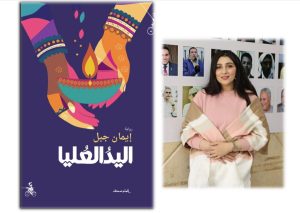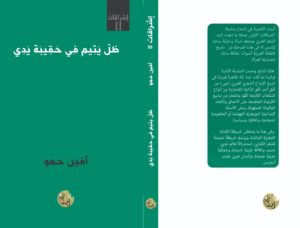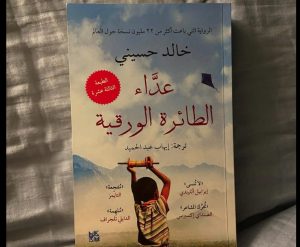أمل سالم
في افتتاحية مجلة (المجلة)، عدد مارس 1969م، وعبر باب بعنوان (في إحدى الزوايا) كتب يحيى حقي، رئيس التحرير، مقالا من صفحتين بعنوان (هذا الشعر)، تناول فيه جزءا من مقال -داخل نفس العدد من المجلة- للدكتور عبد الغفار مكاوي، عن جوته والشعر العربي وكتابه (الديوان الشرقي للمؤلف الغربي)، واختار منه القصيدة المنسوبة لتأبط شرا، التي مطلعها:
إن بالشعب الذي دون سلع *** لقتيلا دمه ما يُطَلُّ
خلّف العبء علي وولى *** أنا بالعبء له مستَقَلُّ
هذا المقال راجعه فيه الشيخ محمود شاكر بسفر كبير، هو: (نمط صعب ونمط مخيف). وكان الشيخ شاكر مدافعا باستماتة عن العربية، ووجه نقدا لاذعا لصديقه يحيى حقي على مقاله عن جوته، فهل غضب يحيى حقي وخسر صداقة الشيخ شاكر تلقاء ذلك؟
أبدا! نشر حقي كتاب شاكر على مدار سبعة أعداد، وفي نفس المجلة، وكانت افتتاحية العدد التالي ليحيى حقي بعنوان (هؤلاء الراحلون) ويليها مباشرة مقال شاكر، وفيه طبق شاكر منهجه الخاص “التذوق”، واستيقن نسب القصيدة السابقة لابن أخت تأبط شرا، وخاض في فقه النغم مثبتا جاهليتها. وهذا هو اختلاف الكبار، واختلاف الكبار بحق لا يؤدي لقطيعة، أو بالضبط كما قال نجيب محفوظ في حواره عن يحيى حقي: “قد نختلف في الآراء ووجهات النظر، ولكنه اختلاف بين اثنين لديهما استعداد للاختلاف، مثلما لديهما استعداد للاتفاق”.
وعليه لا يمكن التحدث عن يحيى حقي دون المرور على رأي نجيب محفوظ، فعندما سأله إبراهيم عبد العزيز، وهو تلميذ ليحيى حقي، في حوار أجراه معه عام 1994م، قال، نجيب محفوظ: “إن قنديل أم هاشم والثلاث قصص الملحقة بها في هذه المجموعة القصصية القصيرة “خيشت” في عقلي”. وكان يقصد قصص: “السلحفاة تطير”، “كنا ثلاثة أيتام”، “كن.. كان”، ويكمل محفوظ: “وعشقت كاتبها على غير معرفة أو اتصال به”، وتواصل الحوار بيننا في المكتب و”الأوتومبيل” في كافة شئون الأدب والحياة”.
أما عن الأوتومبيل الذي ذكره نجيب محفوظ؛ فإننا نعرف أن محفوظ عمل مديرا لمكتب يحيى حقي في مصلحة الفنون؛ المصلحة التي أنشأها وزير الإرشاد فتحي رضوان في الفترة من 1955م إلى 1959م، حيث كان يحيى حقي أول وآخر مدير لها، وأثناء ذلك وضع مشروعا للمعهد العالي للسينما وأنشأ فرقة للفنون الشعبية، وكان يحيى حقي يقطن في مصر الجديدة، فكان يصطحب نجيب محفوظ معه لينزله في العباسية حيث سكنه،. وهذا هو جزء من الجانب الإنساني الذي أشار إليه نجيب محفوظ فيما يخص يحيى حقي. وليس بخفي عن المتابع أن إنسانيات يحيى حقي فائقة، فهو رجل خلوق، رقيق الحس، مهذب المشاعر، وجميل الطبع، كما وصفه كل من تعامل معه.
في برنامج تليفزيوني بعنوان (ساعة مع)، كانت تقدمه الإعلامية القديرة ليلى رستم، استضافت يحيى حقي وتركت له اختيار رفاق البرنامج، فاستضاف أعضاء جمعية الرفق بالحيوان، وتحدث عن دور المرأة، ودافع عن الضعفاء والمساكين،…ألخ، مما يدلل بشدة على اتساق الكاتب الكبير مع ما يقدمه عبر انتاجه الإدبي من قصص تتناول المهمشين، والضعفاء، وتغوص في أعماق المجتمع.
أما عن القصص التي ذكرها نجيب محفوظ، التي من خلالها حكم محفوظ أن يحيى حقي من مؤسسي القصة القصيرة في مصر كما قال في نفس الحوار، فقد كانت هذه المجموعة القصصية قد صدرت عام 1945م، برغم من أن يحيى حقى قد بدأ الكتابة في سن مبكرة، قبل ذلك بحوالي عشرين عاما تماما، إلا أن صدور مجموعة قصصية مكتملة تأخر كثيرا، لكن ذلك لم يقلل من شأنه في شيء؛ فالقصص التي كان يكتبها لها خصوصيتها الشديدة، فهي من عالم الإبداع لا الاتباع، وهي أدب جديد، قائم بذاته، له أسلوبه الخاص والمتفرد، وله معجم لغوي متميز، يستخدمه في كتابة خالية من البلاغة اللفظية، وكتابة لا زيادة فيها ولا فائض كتابي يؤخذ عليه، يجاوز فيه بين العامية والفصحى. وكما قلت فإن تأخره في نشر كتاب لا يقلل من الأمر في شيء، فكانط -الفيلسوف الألماني الكبير-نشر باكورة أعماله، وهو كتابه (نقد العقل المحض)، وهو في السابعة والخمسين، فالمهم في الإبداع والكتابة المحتوى وليس التوقيت ولا الكم.
يقول محفوظ في نفس الحوار: “وعلى قلة ما أبدع الأستاذ يحيى حقي فإن كل آثاره تبقى مرشحة للبقاء والخلود، فمجموعاته القصصية القصيرة -على قلتها- كانت كلها “نقاوة” تبقى ما بقي الأدب يُقرأ، وحين يؤرخ لتاريخ الأدب، وكتابته خلال الفترة التي عاشها الأستاذ يحيى حقي، سيكتب عنه ضمن من أبدعوا وفي أكثر من مجال؛ فهو سوف يذكر بين كتاب المقالة، كما سوف يذكر بين كتاب النقد، وفي القصة القصيرة سيذكر أجمل ذكر”.
احتراز المقالة في أعمال يحيى حقي
فأما من جهة المقالة: فعندما نتابع مقالات عديدة صدرت له، في مجلات واصدارات قديمة، نجد مقالته حصيفة، لا لبس فيها، صافية من التوهم. فمقالته مثلا في نقد مسرح الريحاني في مجلة الأديب عام 1954م، وكيف أنه حلل مسرح الريحاني مثبتا أنه غش تجاري رخيص، مرور بالكسار، وما بينهما من منافسة، رابطا كل ذلك بدنلوب، (Douglas Dunlop)، ودوجلاس دنلوب ذاك هو مبشر اسكتلندي، حاصل على درجة الماجستير في الآداب، ودرجة الدكتوراه في القانون، من جامعة غلاسكو، ووضع في مصر نظاما للتعليم يخدم أهداف الاحتلال البريطاني أنذاك، كلفه به اللورد كرومر حينما عينه مستشارا لوزارة المعارف، وعدّ الوطنيون والمثقفون المصريون نظام دنلوب التعليمي معرقلا لتقدم التعليم في البلاد، وقد أطيح بدنلوب عام 1920م، وهذه الإطاحة تعدّ من مكاسب ثورة 1919م، على الرغم من سوء أحوال التعليم إلى هذه اللحظة.
وفي سنة 1930م يكتب حقي مقالا في المجلة الجديدة عن تطور القصة يشير فيه إلى تشابك الفنون وإلى أهمية الإلمام بالفنون من أجل كتابة القصة القصيرة عللى وجه أجمل وأميز، وأشار إلى العينة الدالة من القراءة وأهميتها في اختيار ما ينبغي قراءته. ولقد كان للكاتب العظيم المقدرة على استشراف المستقبل في مقالاته، فها هو يتنبأ بإفلاس الغرب وأن قيادة الحضارة توشك ان تفلت من يده. وكتاب (كناسة الدكان) –وكان اسمه في الأصل (كُنَّاشة الدكان)، والكُنَّاشة: هي إحدى الطرق لتجميع العلوم وتصنيفها، التي عادة ما تكون بكتابة المعلومات عن الكتب. وقد غيَّر الناشر على غير قصد عنوان الكتاب- بأبوابه الثلاثة؛ عالم الطفولة، وذكريات الحجاز، ودروب الحياة، الذي يحتوي على عدد من المقالات الأدبية راقية المستوى، خير دليل على تداخل الأنواع الأدبية، فالمزاوجة بين القصة والمقال -عند يحيى حقي- في حاجة إلى إعمال النقد الأكاديمي عليها ودراستها جيدا.
يحيى حقي وذائقة النقد
وعلى مستوى النقد فإن مقالات يحيى حقي كانت مقالات نقدية حصيفة؛ وخير دليل على ذلك مقالات عديدة؛ كنقده قصة تمارا لخليل تقي الدين، وكذلك نقده مسرحية شهريار لعزيز أباظة، وكذلك نقده الوسادة الخالية لإحسان عبد القدوس. وفي ذلك كله يظهر الذائقة النقدية الحصيقة التي يتميز بها، والقائمة على الثقافة الرفيعة المرتكزة على قراءة واعية وإلمام متميز بالنصوص الأدبية ومقاربتها ببعضها البعض.
إبداع القصة القصيرة لدى يحيى حقي
أما من جهة القصة فقد كانت القصص لدي يحيى حقي ليست مجرد كتابة؛ وإنما كائنات حية يتفاعل معها وتتآلف معه؛ يقول في مقدمة مجموعته (أم العواجز)، الصادرة في يوليو 1955م: “هذه مجموعة قصص ترجع لعهود مختلفة من حياتي، يتضمن بعضها ذكريات الصبا والشباب، ظلت تسألني، وأنا أتشاغل عنها، أن أجمعها في كتاب، لنعيش معا من جديد كأفراد الأسرة يجتمعون بعد تفرق تحت سقف واحد، لا فرق عندي بين صغيرها وكبيرها، جميلها ودميمها، فلست أنا، بل الناس –كدأبهم- هم الذين يحكمون”.
وعندما سُئل عن اتجاه الشباب لكتابة القصة القصيرة أجاب: “لأنها تُخرج ما عندهم، وتعبر عن دواخلهم بسهولة، وتشبع رغبتهم في الإفضاء السريع لحالة القلق التي في نفوسهم”.
وعن (قنديل أم هاشم) التي ذكرها محفوظ فإنها تعد من قصص الرواية القصيرة (Mini-Novel Story) حيث جاءت الحبكة معتمدة على الحدث، وقد حققت في صفحات قليلة ماتحققه الرواية في عدد أكثر كثيرا من الصفحات.
أما عن مجموعة (أم العواجز)، التي احتوت على سبع عشرة قصة، فقد أثرت في الأجيال التالية تأثيرا كبيرا، أذكر منها قصة (احتجاج) –وقد نشرت لأول مرة، في المجلة الجديدة 1934م- ونجد أن روح هذه القصة يظهر في قصة (نظرة) ليوسف إدريس، من مجموعته (أرخص ليالي)، 1956م؛ فكلاهما يحكي عن الخادمة المقهورة، فبمبة في احتجاج هي الخادمة المقهورة، التي تحتج لمطالبتها بالزواج من الأسطى حسن المنجد. بينما حاملة الصواني مجهولة الاسم، في نظرة يوسف إدريس، تنظر للأطفال في الشارع وهم يلعبون وتحسدهم، وقد حرمت من حقها في اللعب وهي طفلة وأُلقت في ساحة العمل بلا هوادة، خادمة مقهورة. كما أننا نجد في خاتمة القصة أن بمبة الخادمة بعد انتهاء أسيادها من الأكل: “دارت حول المائدة؛ تجمع اللقم المتبقية لعشائها، ثم حشت فمها بلقمة كبيرة، وأخذت تمضغ وتبلع”. وتكمل الحياة دون انتظار نتيجة احتجاجها الذي أبدته، وطفلة يوسف إدريس تنظر في صمت ثم: “ابتلعتها الحارة” دون ترك فرصة واحدة لمراجعة نتيجة احتجاجها المكنون عبر نظرتها. ولا يغيب عنا أن كلتا القصتين تناولتا القهر الذي تتعرض له الأنثى، ومن المعروف أن الأنثى في البلاد المستعمرة ودول ما بعد الكولينيالية مستعمرة مرتين؛ مرة من الاستعمار الخارجي، وأخرى من قبل المجتمع الذكوري. وعلى القارئ في كلتا القصتين أن يكمل هو ما تجود عليه به قريحته من خيال فيما يخص ما بعد المشهد.
رواية أم مجموعة؟
تقع (صح النوم)؛ المختلف على تصنيفها في هذه الإشكالية، وقد صنفها طه حسين، في كتابه الرائع (نقد وإصلاح) 1956م، بإنها قصة رمزية، ووصف يحيى حقي بالقاص الشاعر، وأظن أن هذه المرة الأولي في تاريخ الأدب العربي أن يستخدم هذا المصطلح، وعاب عليها فقال: “واضح آخر الأمر الكاتب يريد أن يرضينا عما تم في مصر من الإصلاح، ويعزينا عما لا يزال فيها من آثار الضعف وبقايا الفساد؛ لأن باريس لم تُبْنَ في يوم واحد كما يقول الفرنسيون. ولكني لا أكتم الكاتب الأديب أني أوثر حلمه الرائع الجميل على برنامجه في فلسفة الإصلاح؛ لأني أجد في حلمه أدبا رفيعا بارعا، ولا أجد في برنامجه إلا كلاما نقرؤه في كل يوم، وتعليل ذلك هين يسير، فلم يَئِنْ للثورة المصرية بعد أن تكون موضوعا للقصص الأدبي الرفيع، لأنها ما زالت قائمة لم تبلغ غايتها بعد؛ فنحن نشهدها ولا نحلم بها، ونحن إذا تحدثنا عنها آثرنا النصح الصادق والمشورة الخالصة، وأخذنا أنفسنا بألوان من القصد قد لا يألفها الخيال.”
وقد يكون طه حسين جار في مقاله ذلك على يحيى حقي؛ فقد تكون علاقة يحيى حقي بالشيخ محمود شاكر هي العامل المؤثر في ذلك، فما بين شاكر وطه حسين كان كثيرا من خلاف؛ فذلك الخلاف بدأ بعيدا قبل صدور الكتاب المشكل؛ (الشعر الجاهلي) لطه حسين، ذلك عندما كان يلقيه على مسامع الطلاب كمحاضرات في الجامعة، ولم يرق ذلك للشيخ شاكر، الذي كان طالبا أنذاك، وترك الجامعة ولم يكمل دراسته.