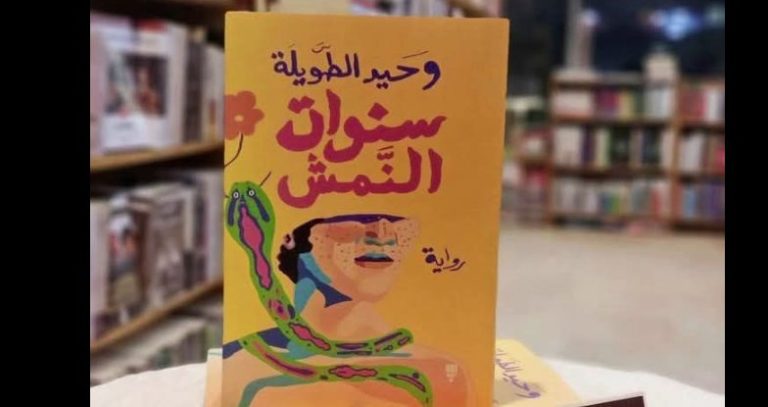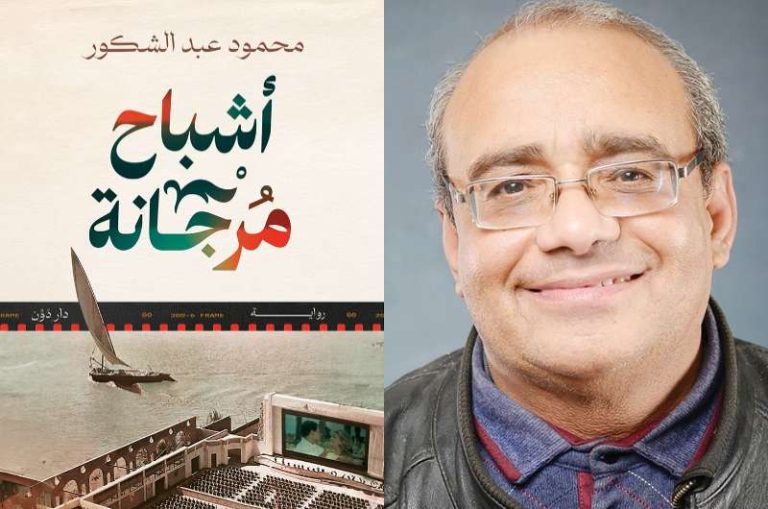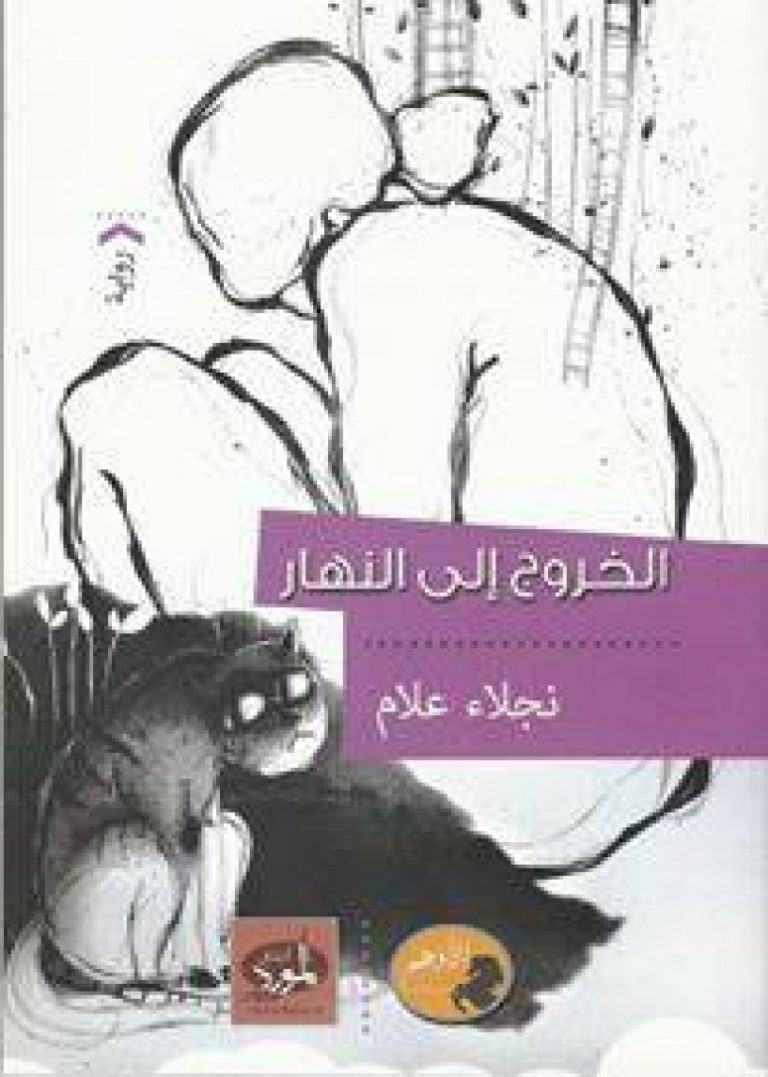عبد الله السفر
لا يزال صدى وأثر قصيدة النثرفي مصر يتوسع، وتكاد تشكل هذه القصيدة الآن الجانب الأبرز في المشهد الشعري المصري، يؤكد ذلك توالي الإصدارات ورسوخ بعضها فنياً (لا ننسى أن أحد كتابها فاز بجائزة يوسف الخال للشعر عام 1992عنينا محمد متولي بعد حدث ذات مرة أن..) “نحو إمبراطورية الحوائط” لأحمد طه، و “ناس وأحجار” لياسر عبد اللطيف، وسواهما، مما جعل البعض يطعن على هذه القصيدة ويعدد مثالبها (انظر ما كتبه جمال القصاص في جريدة الشرق الأوسط، عدد 6083 ر 6084 في 25/26-7-1995) أو في الأهون يجد أنها تستنسخ القصيدة التي يكتبها شعراء المشرق العربي (عبد الله السمطي، الحياة، عدد 11171، 24 سبتمبر 1993م) أو يتحدث من موقع “المَعلمة” التي لا تخلو من التوبيخ والتهكم (أحمد عبد المعطي حجازي في مقابلة مع مجلة الوسط، عدد 182، 24/30 يوليو 1995). غير أن هذه مجرد إشارات إلى الزلزلة التي تحدثها هذه القصيدة في بعض المواقع التي تعتقد أن الإبداع حكرعليها. وإذا كان فإنه بنفس الطريقة التي هم عليها.. وضمن هذا الجدل تأتي قصائد إيمان مرسال في “ممر معتم يصلح لتعلم الرقص” الصادر حديثاً عن دار شرقيات القاهرية، يأتي هذا الكتاب كنقلة كبيرة ومفارقة عن كتابها الأول “اتصافات” الذي طوبه ادوار الخراط واجداً فيه “إنجازاً حقيقياً وليس فقط ما ينم عن موهبة حقيقية بل ما يومئ، بإبلاغ إلى شاعرة حقيقية” الحياة، عدد 10435، غرة سبتمبر 1991). تتخلى إيمان مرسال عن إنجاز “اتصافات”: لغة ورؤيا ومناخات لصالح القصيدة الحياة: الطازجة الخارجية عن يبوسة المعجم واهتراء خرقة مدّعي الصوفية.
تفتتح إيمان مرسال كتابها بنص “أتلفت”: “في يقظة كائن ينتظر انهياراً ما/ عادة ما أتلفت حولي/ ربما لهذا../ لعنقي قوة لا تناسب جسدي، والمدهش/ أنني لا أتوقع رصاصاً حياً/ من الشوارع الجانبية الخالية/ ولا مقصات- كوسيلة صامتة للقتل-/ بل انتباه خاطف/ على عيون أكاد أعرفها/ ولكنها قادرةعلى القيام بالمهمة” (ص9)، وكأن هذا النص بيان، لما يليه من نصوص أو فاتحتها المعبرة عن كتابها بالكامل. يتعاون مع هذا التوجيه الافتتاحي، تلك العبارة التي ذيل بها الكتاب منسوبة إلى ريجيس دوبريه: “…، فقد أصبحت أكثر تواضعاً بما فيه الكفاية لتنتظر بهدوء، وبغير استفزاز، دورك يوم يحدث لك ذلك. إن الطبيعة تصنع الأمور خيراً منك، أو أعداؤك، فلا تستعجل، إن لديك متسعاً من الوقت” وما ذلك المنتظر بهدوء سوى الموت، يتأكد ذلك عندما نعود للفقرة التي استل منها التذييل حيث نقرأ: “كنت تريد أن تمنح نفسك للحياة، فكان عليك إذن أن تمنح نفسك الموت (..) وعلى الموت كذلك أن يكون متواضعاً، فلا ينبغي تجنبه ولا السعي إليه طواعية، وإنما ينبغي أن تتلقاه حيث هو، وكما هو، حيث يأتي بلا تعقيدات. وأن أمامك الآن حظوظاً قوية في ألا تكون مضطراً للجوء إلى تصرفات تطوعية، فقد أصبحت أكثر تواضعاً..- ريجيس دوبريه، مذكرات بورجوازي صغير بين نارين وأربعة جدران، دار الآداب، بيروت، ط2، 1981م، صفحة 96.
إذن بين انتظارين “تتلفت” إيمان مرسال بما يعنيه التلفّت من نظرة عجلي، تخطف الخطفة الأولى بما فيها من زخم وحرائق وندوب، وخدوش المروق الاختطافي، نظرة كافية أن ترسم المشهد في وضوح ونصاعة لا تخطئ في معاينة الموت المتربص بما يلقيه من ارتباك/ تخلخل قبالة أقرب الأشياء وأشدها حميمية وخصوصية، عنيت الاسم/ الجسد، ففي نص “لي اسم موسيقي” ينهض اسم “إيمان مرسال” على وثوقية بتميزه عما سواه، وتعاليه بحيث يستحق أن يعطي لمدرسة فتتشرف به، وأن يسمى به الشارع، غيرأن هذه الوثوقية يحتويها العطب من داخلها وتوقع بها في الارتباك حينما يغرق الاسم في “الالتباسية”، فلا يدل على فكر محدد ولا على وطن بعينه، ويبلغ الارتباك ذروته عندما تشعر أن هذا الاسم قد لا يخصها فهي مجرد جسد/ معدة: “للأسف، شيء ما حدث/ فعندما يناديني أحد يعرفني/ ارتبك،/ وأتلفّت حولي،/ هل يمكن أن يكون لجسد كجسدي/ ولصدر تزداد خشونته في التنفس/ يوماً بعد يوم، اسم كهذا؟”(ص15)
كذلك يخالسنا ارتباط الشاعرة إزاء الصديقة “أمينة” (عنوان ص24) مشاركتها غرفة الفندق، فتحاول أن تخفي انفراط اطمئنانها وارتباكها بالتمثيل وإدعاء “السوقية” و”الخشونة” و “الثقة في النفس” وتحرض صديقتها على الخروج بعيداً عن الغرفة، عنها، لكن كل هذا كما قلت ينطوي على الارتباك والخذلان فهاهي تطلب من صديقتها الخروج فيما تبكي غيابها وتلتفت إلى فرشاة أسنان الصديقة المعباة بحضورها: “صديقتي الكاملة تماماً/ لماذا لا تخرجين الآن/ (…)/ لماذا لا تخرجين/ تاركة كل هذا الأكسجين لي/ قد يدفعني الفراغ الذي خلفك/ لأن أعضّ شفتي ندماً/ وأنا أرى فرشاة أسنانك أليفة ومبللة.” (ص27)
وتحاول الشاعرة القيام بعملية اتزان/ توازن: المقاومة، مع هذا الارتباط/ التذبذب، فتعمد إلى الالتجاء إلى السخرية السوداء ذات النبض الصارخ بالمفارقة وإلى ملء كيانها الهش بـ “التبجح” وإدعاء الحقد والكراهية. هاتان الآليتان نجدهما منبثقين في أكثر من نص، فالسخرية السوداء نلحظها في آخر نص “فاتتني أشياء” العامر بالارتباكات المفارقة: “هذا البيت، كان لسنوات بيتي/ لم يكن معسكراً طلابياً/ حتى أترك فستان الحفلات/ على مسمار خلف الباب،/ وألصق صوري القديمة بصمغ مؤقت./ أظن أنّ الجمل العاطفية/ التي أخرجتُها من “الحب في زمن الكوليرا”/ قد اختلطت هناك/ وأصبحت نصاً بالغ الكوميديا”(ص21). وفي نص “الصالحون لصداقتي” فبعد أن تعدد النظراء الأشباه بأقزع الصفات المهينة المثيرة للضحك، تنبري قائلة: “أشباهي،/ الصالحون لصدقاتي،/ الذين تخلقهم من أجلي/ وفيرون هذا العام/ يا إلهي/ ارفع عطاياك عني/ ولا تخلف وعدك لي/ بأعداد جدد”(ص32). ومثل ذلك نقرؤه في “هذا جيد” (ص42)، و “أصف الصداع” (ص65)، أما آلية إدعاء الحقد والكراهية فتأتي- كما قلنا- كمحاولة لتجاوزوردم ارتباكها وارتباطها الشديد بالآخرين حيث يتمثل الموت- حقيقة أو تمثيلاً- مسافة مرعبة حيث الوحدة والاستيحاش والنزيف في مقابل الألفة والأمان والاستقرارعلى النحو الذي يوضحه بصورة أكبر نص “في كامل فرحهم” إذ يبدو الحقد متنفساً لاستمرار الحياة: “سأتأكد/ أنهم موجودون بالفعل/ في كامل فرحهم/ وأنني وحدي/ وأن الصباح ممكن/ طالما هناك أحقاد جديدة”(ص81).
قلنا إن الموت يحاصر الكتاب من قصيدة الافتتاح “اتلفت” حتى كلمة التذييل لريجيس دوبريه، ولن نخطئ إذا قلنا أن الشاعرة هي الخيط الذي يتبلور عنده/ حوله: الموتى.. الجثث: الأب، الأم/ والأصدقاء، أحياء وأمواتاً، وتلح فكرة أن تكون الشاعرة الخيط الذي ينتظم الموتى- تلح على الظهور والتمرئي في أكثر من موقع ففي نص “يبدو أنني أرث الموتى” يترسخ حضور الموت عبر أكثر من وسيط: (الأم- أسامة الذي تهرأت كليتاه، ص36)، فأني تلتفت تجد نفسها مسورة بالموت، يتخللها، فهي مليئة بالموتى موشومة بهم: “يبدو أنني أرث الموتى/ ويوما ما/ سأجلس وحدي على المقهى/ بعد موت جميع من أحبهم/ دون أي شعور بالفقد/ حيث جسدي سلة كبيرة/ ترك فيها الراحلون/ ما يدل عليهم”(ص30). ونعثر في نص “على الحافة” ما يدعم هذا الامتلاء بالموتى وإن كان على شاكلة “ذكريات” مرصوصة في علب تتأملها في حياد (لا أظنه إلا حياداً مدعياً رغم المسافة الخالية): “عندما تدخل علبة على مقاسك/ سيكون بإمكاني إخراجكم جميعاً/ إلى إضاءة غرفتي الخاصة/ لأسهر مع هذه الثروة وحدي/ فرحة باتساع روحي/ لكل هذه المفقودات”(ص71).
ونرى الشاعرة في نص “سقوط عادي” كيف تقاوم الوحدة: “كيف أسمح لنفسي/ أن أكون وحيدة قبل الثلاثين” وكيف تقاوم التآمر: من البلاط الذي لم يكن رحيماً، ومن الحواف التي غيرت أماكنها في العتمة، وذلك بأن تستحضر الجثث (الأحياء/ الأموات: جميعاً) بمساعدة الكراهية التي درّبت أسنانها على مضغها حتى باتت جزءاً منها (وذلك كما تقول في نص سابق : فاتتني أشياء، ص20)، فتحظى بالراحة العميقة من خلال الجثث التي تملأ الغرفة وتفشل في عدّها: “لماذا لا أفتح للكراهية كي تخرج/ وتملأ الغرفة بجثث/- أخطئ في عدّها فابدأ من جديد-/ هل لأن السقوط للحظة كان حاسماً/ وللحظة/ لم تكن هناك غير الراحة/ كأن كل من أحبهم معي/ أو كأنني تلقيت خبر موتهم/ في حادث جماعي” (ص77).
ينبغي الإشارة إلى أن سفور الكراهية والحقد- هكذا تكتب الشاعرة بالتعيين دون مواربة – في التعبير عن تجاوز ما يدك الحياة ويجعلها تتقلب في قفص الوحدة والارتباك مرتبط، بـ “الصراحة” وتقنية الإفشاء/ الإفضاء التي جعلته معادل “القمامة”.. نقرأ في نص “الصالحون لصداقتي”: “الصرحاء كالقمامة” (ص31)، باستخدام كاف التشببيه، لكن في نص “تمارين الوحدة” تستغني عن الكاف وتُجسد الآخر فيها: “سأقول له أن رجلاً ينام في غرفة مجاورة بلا كوابيس،/ لم تكن رأسه في مستوى رأسي/ فشل في أن يكون صندوق قمامة لي،/ ولو لمرة واحدة،/ وترك كل شيء يتسرب إلى الشوارع العمومية”(ص 91). ولعلّ التلازم بين الصورتين، بين الصراحة/ الإفشاء والقمامة هو ذلكم البارز حيث القمامة التي لا تخفي دمامتها ونتانتها: مكشوفة في قمة وإيلام، وتصور لو بقيت محتوياتها مطمورة في الداخل، تنغل ولا تخرج، غير أن هناك من يتخفف: “سأمسك بأصابعك/ وأتأمل دقة تليق بجراح، ليس بحاجة لمشرط طبيّ/ لنزع البؤر الصديدية من جسد يتآكل ذاتياً/ وأضعها في وعاء الثلج، وحيث لا رجفة هناك…/ أخرج من هنا…/ متشحة بالفقد وخفيفة”(ص94).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة اليوم ع 8116، 4 سبتمبر1995