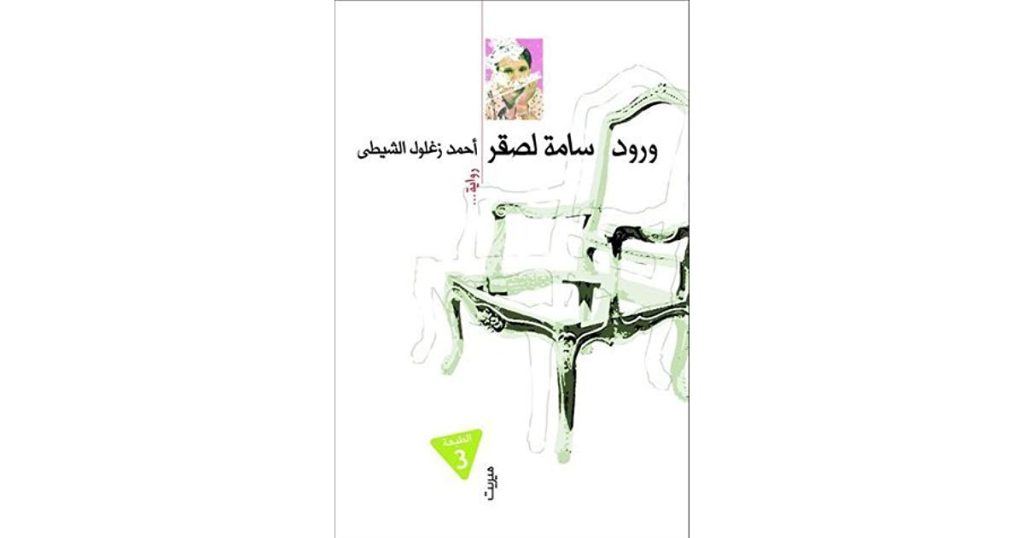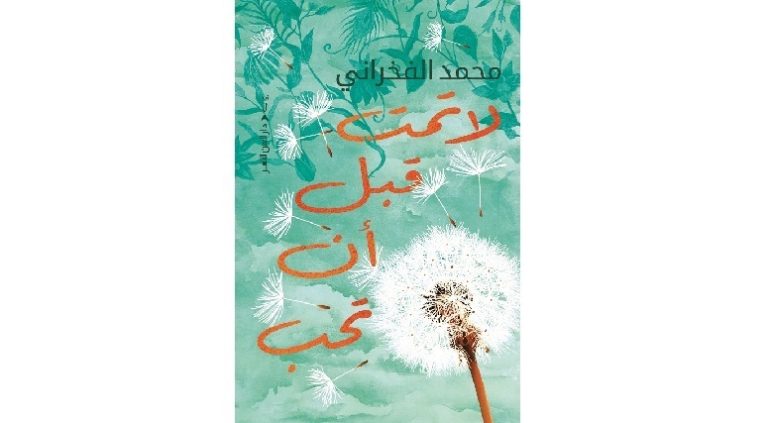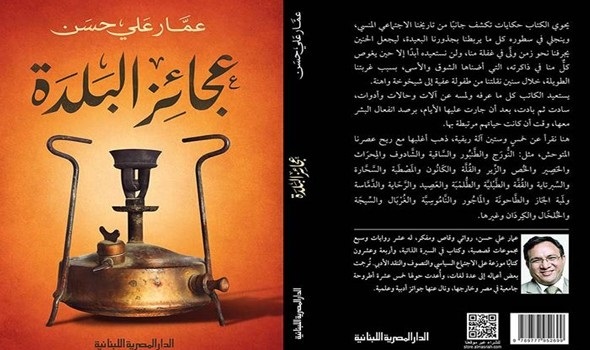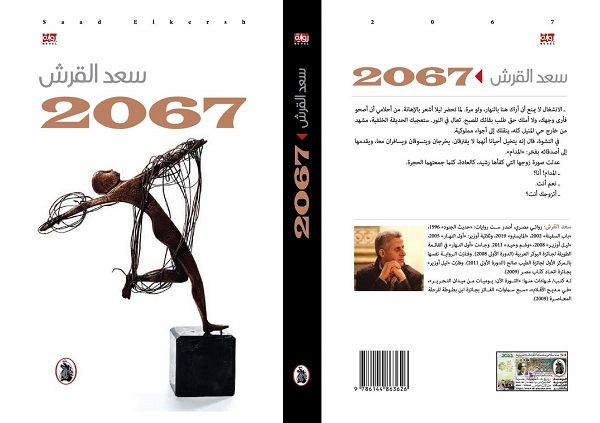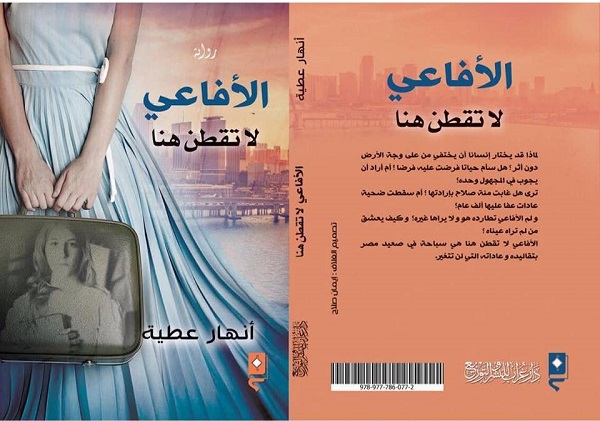ممدوح فرّاج النّابي
قصة موت صقر الحالم بحب البرجوازيات
عندما صدرت رواية “ورود سامّة لصقر” لأحمد زغلول الشيطي، في أوائل التسعينيات استقبلها الوسط الثقافي استقبالاً حافلاً، وإن كان ثمّة تخوُّف وحذر من قبل المؤسّسة الرَّسميّة، وقد جاء التخوُّف في صيغة تحفّظ على ما جاء في الرواية من ألفاظ أرتأت الرقابة وقتها، أنها لا تستقيم مع أخلاقيات المجتمع، ولم تسمح بتمريرها، وهو ما آل إلى عدم صدورها بين دفتي كتاب كما أراد لها مؤلفها الشّاب وقتها، وتأجّل هذا إلى عام 1993. وهو ما عاد إلى الأذهان سيناريو المذبحة، الذي تعرضتْ له رواية “تلك الرائحة” لصنع الله إبراهيم، في زمن متقدّم نسبيًّا.
رواية التأسيس
صدرت الرواية – على غير العادة – ضمن صفحات مجلة أدب ونقد (العدد 54 يناير – فبراير 1990، على صفحات 59 إلى 88)، و قد سبقتها رواية تلك الرائحة لصنع الله إبراهيم التي نشرتها مجلة شعر اللبنانية في عدد يوليو 1968، بعد أن منع نشرها في مصر عقب صدورها، وقد أشارت المجلة في تصديرها بأنها الرواية التي منعت في مصر. وقد شغلت الرواية صفحات 8- 111، في 3 صفحة من قطع المجلة.
الجدير بالذكر أن الرواية كتبت عام 1986، ونشرت عام 1990. أما نشرها في كتاب جاء بعدما عرضت الناقدة إعتدال عثمان على المؤلف نشر الرواية ضمن النشر العام، وبالفعل صدرت عام 1993 بغلاف من تصميم الفنان التشكيلي جميل شفيق، وإن كان حُذفت العبارة التي كان عليها الخلاف من قبل ووضع بدلاً منها نقاط. وهي العبارة التي أعيدت مرّة أخرى في الطبعة الثالثة، وأيضًا موجودة في الطبعة الرابعة الصّادرة مؤخرًا.
إبّان صدور الرواية احتفت بها مجلة “أدب ونقد”، حيث أعدت ملفًا نقديًّا شارك فيه عدد من النقاد البارزين؛ سيد البحراوي وصبري حافظ، والسوري خليل الخليل الذي وصفها بأنها “نقطة من أولى نقاط إضاءة رواية عقد التسعينيات في مصر”، كما قال عنها الدكتور سيد البحراوي إنها “فتحت الباب لرواية ما بعد نجيب محفوظ”، وقالت الناقدة فريدة النقاش إن رواية (ورود سامة لصقر) تدشن ميلاد روائي كبير في عمله الأول”. هكذا اعتبرها النقاد “اللبنة الأولى في رواية التسعينيات“، أو إنها “رواية مؤسسة لكتابة جيل التسعينيات، وتبشير بنموذج لرواية ما بعد نجيب محفوظ وأدب جيل الستينيات” على نحو ما ذكر سيد البحراوي. كما أشاد إبراهيم أصلان بالرواية في تصرح له في إحدى الصحف قائلاً “إن أفضل عملين قرأهما مؤخّرًا هما (الحبّ فى زمن الكوليرا) لماركيز ومخطوطة لشاب بعنوان (ورود سامّة لصقر)”.
واقع أحداث الرواية لم ينفصل عن مؤلفها الذي وصفه سيد البحراوي بأنه “وعمله أسطورة” إلا أنه كان يقول عن نفسه ” كنت أسطورة مُفلسة وبلا مأوى، كان همُّ العديدين معرفة مَن أكون، وما هي هويتي السياسية، وهل أنا صقر أم يحيى، وكنت أنا نفسي لا أمتلك أي يقين، تركتُ كل شيء وغادرت القاهرة والحياة الثقافية ووسائل الإعلام، تركتُ النص يعيش حياته وعدتُ إلى مسقط رأسي دمياط، لم يكن عندي شيء آخر لأقوله، تخلّصْتُ من كل النسخ وعكفتُ على اكتساب مهنة لآكل منها عيشًا، لم أكن أدري وقتها أنني والنص قد وقعنا في بؤرة لحظة تحوّل عنيفة، لحظة تحوّل لن تترك أي شىء ما بين السّماء والأرض، وكنت أنا أضعف من أن أجيب على كل الأسئلة، كانت أخباري تواتيني من آن لآخر، كسبتِ الرواية أرضًا جديدة كل يوم، وبسبب غيابي الطويل عن الحياة الثقافية، التي تعتمد على التواجد الجسدي والعلاقات، خسرت الترجمة والجوائز والسّفر الى الخارج، وخسرت التواجد في عصر وسائل الإعلام الذي انفجر أواسط التسعينيات، كنت تمامًا كمن عَمِلَ وقَبض غيره”.
الموت المُلغز
ومع مرور ما يقرب من 30 عامًا على صدور الرواية الأولى، إلّا أنّها ما زالتْ مُتحقِّقة، وتأثيرها لا يزالُ ممتدًا حتى اللّحظة الراهنة، كما هو واضح في توالى طبعاتها، حيث صدرت لها مؤخرًا طبعة جديدة عن دار المرايا، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما تمّ تحويلها مؤخّرًا إلى نص سينمائي بعنوان “ورد مسموم” للمخرج أحمد فوزي صالح، وقد حاز على ثلاث جوائز في الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي. لكن لم يأخذ صاحب الرؤية السينمائية من الفيلم سوى اسمي الشخصيتين تحية وصقر، ما عدا ذلك، فرؤية الفيلم مغايرة لتلك الرؤية التي مرّرها المؤلف عبر مرويته.
تنبع أهمية الرواية من أزمة بطلها الرئيسي صقر عبد الواحد، لم تكن شخصية، بل كانت أزمة وطن أنهكه الفساد، واتّساع الهوّة بين الطبقات الاجتماعيّة، وتخبُّط السياسيين، ومن ثمّ كان متمردًا وناقمًا، وانتهى به إلى الهروب ثمّ الموت. كانت أزمته كما وصفها صديقه “في عزلته المقيتة، وزمنه الدائري. في الحصار الذي أوقع نفسه فيه، في الهروب المبكّر إلى كهوفه الداخليّة”. لكن مِن أين جاءت هذه الأزمة، إنها انعكاس لواقعه المزري، لزمن أصبحت “فيه كل الأشياء ليست حقيقية، وكل الكائنات مسوخ… زمن تكون فيه كل الورود سامة، وكل الحبّ مستحيل” كما كتبَ هو بنفسه في ورقة لا أحد يعرف لمن كتبها.
عدّ النقاد صقر عبد الواحد بطل الرواية نموذجَ “البطل الجديد المأزوم الذي سأم النصائح والشعارات البرّاقة ونزل إلى حضيض الواقع يُعاني من تناقضاته“. فالرواية المصرية كانت وقتها تبحث عن مخرج ينقلها إلى ما بعد الستينيات، بعد تحولات عالميّة جذريّة تمثّلت في انهيار الاتّحاد السوفيتي، وزعزعة اليقين إزاء الإيديولوجيات الكبرى، والمرويات الكبرى، على حدّ تعبير المؤلف نفسه. فجاءت “ورود سامّة لصقر“، بآلياتها الكتابية والأسلوبيّة، لتكون بمثابة الانتقال من مرحلة إلى أخرى.
جاءت أحداث الرواية في أشدّ فترات الوطن من تاريخ مصر اضطرابًا، حقبة السبعينيات والثمانينيات، والتحوّل الصادم من الاشتراكية إلى الرأسماليّة؛ حيث بدايات الانتفاح الاقتصادي، وتأثيرات المنطقة الحرة، حتى بدت “بورسعيد فسدت الدنيا”، وهو على حدّ تعبير صقر”إننا نعيش عصرًا كاملاً من الخيانة، أو قل الوضاعة”. تبدأ الرواية بخبر وفاة صقر عبد الواحد، الذي وقع في مساء الثامن من أغسطس 1984، أو صباح التاسع منه، فما أن فتحت أمه الباب حتى وجدوه “أزرقَ وصلبًا، ورغوة تسيل من فمه، وفوق صدره باقة ورود، انطبقت عليها يداه”. وقد كان قبلها هاجمته: “كوابيسه ووروده السّامة، هاجمته الفلقة، والخشب فوق ذراعيه، هاجمه كل شيء في دوامة واسعة بغيضة”. حتى صار يتساءل في عجبٍ: “لماذا تفرُّ كل الأشياء الجميلة من بين يدي؟”.
هذا الموت الملغز، الذي لا نعرف سببه: هل هو انتحار؟ أم قتل؟ أم موت طبيعي؟ وإن كانت أم صقر أرجعت سببه: “لأن الدنيا لم تُعجبه”، في حين صديقه يحيى خلف، اعتبر ناهد بدر “هي قاتلة صقر” بعد أن رأها في الجنازة. ومع هذه البداية الملغزة، وقصة الموت المبهم، إلا أن الأحداث تأخذ مجرى أخر، غير الكشف عن أسباب موت صقر، أو قاتله.
تذهب الرواية إلى تجسيد أزمة بطل، هو نموذج لأزمة جيل بأكمله، سقط ضحية لزمن سقوط الأحلام، وتوالي الهزائم، بدءًا من هزائم الفقر الذي جعله يجمع الجرائد لا ليقرأها وإنما ليبيع فيها أبوه العنب، وبسبب الفقر صرخ في وجه يحيى صديقه في المقهى القديم بسوق الخضار، وقد وضع فوق المنضدة رواية “صورة الفنان” قائلاً :”إننا فقراء أكثر مما ينبغي، أخشى أن يشوّهني الفقر، وضع كفه فوق وجهه، صرخ بصوت مبحوح: صرتُ أكتب أشياء مزعجة، هل أفسدتني الكتب”. مرورًا بهزائم موت الحلم؛ حلم عبد الناصر، إلى فجيعة الهزيمة كما تجسّدت في صورة فتحي الذي رجع من الحرب مبتور السّاق، في حين أنهم “كانوا باعوا كل السيقان المبتورة، والأذرع والعيون والأحلام”. وصولاً إلى هزائم الحب، الذي أضحى مستحيلاً، وأمره “متروك للأيدي الخشبيّة”.
فقد ساد زمن الموت والخسّة الذي لم يكتفِ رجاله ببتر ساق فتحي، بل تعمدوا موته والتعجيل به فأعلنوا أنهم سيوظفونه عاملاً في مرحاض، وهو ما جعل فتحي ينكفئ في صدر أمه يضرب قبضته في الزجاج، صائحًا: “عامل في مرحاض“، ثم أشعل النار في الكتب والمجلات، وأشعل النار في صوره مع خطيبته”. كان فتحي ليحيى “أعظم الناس أجمل الناس”، مثلما كان صقر لتحية “أكبر وأجمل رجل”. بشاعة هذا الزمن لم تقف عند شيء، حتى الأحلام البسيطة أُجضت، فيفشل حلم تحية بأن يرتب معها يحيى كتب صقر، فقد جاءه عقد عمل وذهب إلى قطر.
بؤس العالم
تنتمي الرواية إلى رواية الأصوات، حيث كل شخصية من شخصيات الرواية القليلة، صقر عبد الواحد، وتحية أخت صقر، ويحيى صديقه، وناهد بدر حبيبته وسبب أزمته، تحكى جزءًا من حكاية صقر، وجانبًا من مأساته، التي انتهت بموته. كل شخصية تتناول سيرة صقر من منظورها الخاص، بحكم علاقتها به، فصورة صقر من جانب يحيى وتحية، تختلف عن صورة ناهد التي شغفت به وبجسمه الطويل إلا أنها عندما سألت نفسها: “هل تحبّه أم تكرهه؟” أجابت: “لا، لا أحبّه ولا أكرهه“، وفي نفس الوقت تعترف بدورانها المحموم حوله وكأنّه “إله وثني” وهي الحيلة التي اعتمدها المؤلف، ليظهر لنا الصّراع الذي كان سبب َالأزمة بين الشخصيات.
تتكوّن الرواية من ستّ فقرات؛ فقرتا البداية والنهاية، وهما بعنوان “موت صقر” تحكيان وقائع الموت ولكن بوجهتي نظر مختلفة تارة من منظور يحيى وتارة من منظور تحيّة. يرصد الرواي في فقرة البداية وفاة صقر منذ لحظة اكتشاف أنّه ميت، وإذاعة الخبر. وهي عبارة عن ستّة مقاطع قصيرة ما بين سرد غائب، وحوار، وإن كانت هذه المقاطع لخصت العالم الذي ينتمي إليه صقر. ومع أن شخصية صقر كما ستظهر من خلال السرد، شخصية معدمة (أو عدمية بالفكر النيتشوي)، إلا أنّ التركيز على سبب وفاته، والطقسيّة التي تمت بها جنازته، منذ إعلان الوفاة بميكروفون، يحمله يحيى وهو يجلس على عربة حنطور، تسير في الشوارع الضيقة، ثم إخبار ناهد بالخبر من خلال يحيى، مرورًا بحالة الأسرة أثناء مراسم الجنازة فالأم “شقت جلبابها، وتمرغت في التراب “وتحية تبكي في صمت، ثم تعود تردد “أخويا .. يا أخويا“، مرورًا بمشهد النعش والمشيعين يسيرون وراءه في موكب، وصولاً إلى ناهد التي جاءت ترتدي “طقمًا أسود أحدث موديل ضيقًا ومشوقًا من أسفل، وكان برفانها يفوح على البعد”، يكشفُ هذا العالم بتناقضاته وزخمه، فداحة الواقع الذي ينتمي إليه صقر، وبؤسه المقيت. أما فقرة النهاية فتعيد تصوّر مشهد موت صقر من جديد، ولكن من منظور تحية، وإن كانت تبدأ هذه من تاريخ 8 أغسطس أي قبل موته بيوم، وصولاً إلى يوم وفاته.
أما الفقرات الأربع ما بين البداية والنهاية، فتقدّم جوهر الحكاية عبر أربعة أصوات هي يحيى خلف، وصقر نفسه، وأخته تحية، وناهد حبيبته، باستثناء أمه. لا يحكي يحيى خلف عن صديقه، وإنما يحكي عن إنسان مأزوم قهره واقعه الذي حاول كثيرًا أن يغيره لكنه فشل. يحكي من موقعه بالقرب من صقر الذي رافقه في غرفة حقيرة في باب البحر، فيأتي سرده أشبه باستعادة لحياة صديقة المأزومة، مازجًا بين لحظتيْن، لحظة وفاته وكيف استدعته أمه، ولحظة حياة صقر، وأوّل لقاء بينهما تحت البنك “في ذلك الصيف البعيد”، وقد عُلِّقا في الفلقة من الأسطى، وقتها جمعهما حلم “الهروب في السّفن الشراعية المبحرة نحو البلاد البعيدة، حيث كان كل شيء جميل كالتصاوير”، ودراستهما معًا، وعملهما في الورشة، ثم دراستهما في الجامعة، بل كان شاهدًا على الفصل الدرامي في حياة صقر، أي علاقته بناهد، وكيف أنّه كان يُحذّرها من جنون صقر، وفي المقابل كان يرفض استمرار علاقة صقر بناهد، لأنه كان يعلم بأطوار صديقه. لا أريد أن أقول أن عالمي يحيى وصقر نقيضان، فيحيى وصقر شريكان في الطفولة والسّكن والشقاء، والإحساس بالظلم، إلا أن طريقهما اختلفت من الخروج منه، صقر مات، ويحيى حصل على عقد عمل في قطر.
تتأى حكاية صقر التي يرويها المقرّبون منه، عبر زمن استرجاعي (زمن كرنولوجي) تصاعدي، وإن كان ثمّة تقاطعات زمانية بين الماضي والحاضر، وأحيانًا بين الحاضر والماضي البعيد الذي يعود إلى طفولة صقر وعلاقته بوالده الحديّة والمتوترة . حالات القطع والوصل في الزمن أو لعبة الكولاج السرديّ، يوظّفها الرّاوي في الوحدات السّردية جميعها، فالشخصيات وهي تروي عن شخصية صقر، باعتباره مرويًّا، وحدثًا مُستعادًا، تنطلق من لحظتها الحاضرة، التي هي بعد موته ولم تتجاوز عشرة أيّام كما في حالة ناهد بدر. ثمّ تأخذ مسارًا استرجاعيًّا، وإن كانت تعود إلى لحظتها الآنية.
في الوحدة السّردية الخاصّة بحيى، ثمّة تداخلات زمنية، فتأتي الاستعادة مرتبة، كما هو الحال في الوحدة السردية الخاصة بناهد، حيث نستشعر ثمة تصاعدًا على مستوى الزمن المتصاعد منذ بداية التعرّف، إلى نقطة الفراق، وأيضًا على مستوى العلاقة، التي لم تأخذ صيغة ثابتة، وإنما كانت قائمة على التوتر بين الشغف والحب، والحب واللاحب، والرغبة في الامتلاك والكراهية ومن ثم إعلان الحرب.
بيت الموت
تبدأ هذه اللحظة الحديّة منذ أن طلبت ناهد من أخيها سامي أن يذهب بها إلى بيت صقر، أو بيت الموت كما وصفته، لتصفية مسألة عالقة بعد موته بعشرة أيام. ففي المسافة ما بين ركوبها السيارة مع أخيها إلى بيت صقر، الذي لم تصله حيث طلبت في منتصف الطريق من أخيها أن يعود، تستعيد ناهد بدر حكايتها مع صقر، وبمعنى أدق حكايات جنون صقر معها، وأوجزها صقر في عبارة شديدة التهديد “بيننا حرب لا تنتهي… حرب عمرها آلاف السنين بين أولاد الفقراء وأولاد الأغنياء”، والتي يلخصها صراع الحالم المجنون والبرجوازية، منذ أوّل لقاء بينهما في الجامعة الأمريكيّة، في حفل أوركسترا برلين.
وهو اللّقاء الذي ظهرت فيه بوادر نوبات جنونه معها، ثم ما تلاها من نوبات صراع ومطاردة لها، وجره لها من شعرها، وطلبه أن ينام بين فخذيها ليلة بطولها، وفضحه لها في الجامعة بقصائده، وسرقة ملابسها الداخلية وعرضها على أصدقائه في المقاهي. السؤال لمن يتابع الصّراع بين الطرفين: لماذا طاردها، ولماذا أراد محوها، وفي ذات الوقت كان يطالبها بحبه؟ ببساطة، كان صقر يريد أن يقتلها لأنها لم تحبه. لنتأمل كيف بدأت الحكاية بشغف وانتهت بموت ليس موتًا حقيقيًّا، وإنما موت معنوي بدأ بمرضه الذي زارته فيه، عندها، رأت الموت في فراشه، وكان لحظتها كل شيء انتهى كما قالت له: “فقد كل أسلحته، كل سحره سألني: انتهى، قلت انتهى، جاءني عريس معيد ويعمل في شركة سياحية، ورجل أعمال صغير، قال: أريدك، قلت انتهى. قال: جئت لنصفي خلافاتنا، قال: أحبك يا ناهد: قلت: انتهى؟
كان صقر انتهىى، فصقر الذي كانت ذاهبة إليه لتصفية حسابها، ثم عدلت “لم يعد منه شيء. فقط أربعة عيون صقرية… متحفزة في بيته المظلم …بيت عنكبوت”. ومع حالة الصدام بينهما إلا أنها كانت مشدودة إليه بخيط، لم تعرف كنهته، هذا الخيط كان هو الدافع لأن تستلقي فوق صدره، وتتركه يفعل ما يشاء، بل أدخلها إلى عالم “آخر تحكمه قوانين سرية لا يعرفها سواه”.
في حوار النهاية بين صقر وناهد، يتجردان أمام بعضهما البعض هكذا عبر حوار طويل، يكشف أول ما يكشف عن الخلل بين الشخصيتْين ولماذا لم يتوافقا، هكذا جاء الحوار:
- (ماذا تريد. لا أعرف، تحبني؟ أكرهك وأحبك. مشكلتي في نظركَ أنني غنية، مُشكلتُكِ أنني صقر). ثم تأتي حرب صقر التي كانت ضد البرجوزاية في صورة ناهد وعائلتها، حتى في جولاته معها في الأحياء المتداعية، في السيدة والقلعة وباب الشعرية وباب البحر، كان يتجول بها ويجلس معها على مقاهي وينادي الناس، وفجأة يقول لها: “عليك أن تسألي نَفسكِ مَن سرق هؤلاء في الحياة، ويشير إلى الأطفال العراة وهم يتبولون ويتبرزون في وسط الشارع: يقول كانت طفولتي”.
لم تكن أهمية الرواية القصيرة التي تندرج تحت النوفيلا، في موضوعها وفقط أو حتى القضية النبيلة التي دافع عنها بطلها المأزوم، وإنما في جمالياتها التي دشنّت لكتابة جديدة، تمثّلها جيل التسعينيات، ترفض بطبيعة الحال الشكل التقليدي أو الكلاسيكي المتوارث، مُستعينة بتعدّد الأصوات، كشكل يستطيع أن يُجسّد الصّراع على مستوى الشخصيات فيما بينها، وأيضًا على مستوى صراع البطل مع نفسه، حتى في استعادة ناهد لعلاقتها بصقر، كانت في صراع بين شغفها وعدم حبها، وهو ما يعكس انتمائها إلى طبقتها، فهي ابنة مستشار وتاجر، وستتزوج معيد وصاحب شركة. وكأنها لا تريد أن تخسر، وهي السياسة التي رفضها صقر وحارب ضدها، بل أشعل الملابس التي جلبتها أخته من بورسعيد، بعدما صارت منطقة حرّة، في تأكيد لرفضه هذه السياسة.
كما أن الرواية أعادت الاهتمام بالقصة الطويلة، التي كانت سائدة في الثلاثينيات والأربعينيات، وإن كان النقاد أدرجوها تحت بنية رواية في تعنُّتٍ شديدٍ. إضافة إلى أن الرواية كسرت النمطية المألوفة في الوصف، والتعبير عن الشخصيات. فمن المشاهد العجيبة في الرواية التي تُضاف لجماليات القبح، وصف الفتاة وهي تتغوط، والأدهى أن الراوي يُمارس الجنس مع الفتاة وهي في هذه الحالة. علاوة على اللغة المرتبكة، والمختزلة إلى حدّ التقتير الشديد، والتي كانت لا تتوسّل ببلاغة في تقديم إفادتها، بقدر الاعتماد على دلالة اللغة المجردة، بعيدًا عن فخامة اللغة وانحرافات المجاز، وتهويمات الخيال. لغة مجردة محايثة للشخصيات، ولواقعها التحتي.