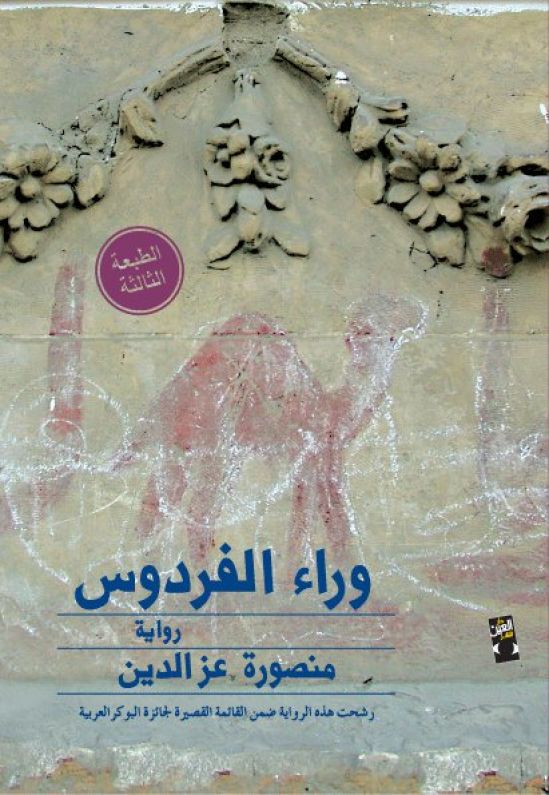كانت كالموجهة من قِبل قوة داخلية تؤجج غضبها لهدف غير معلوم. بصعوبة فتحتْ الصندوق، وأخرجتْ ما فى جوفه من أوراق، نظرتْ فيها لبعض الوقت، ثم أرجعتها مكانها. سكبتْ قليلاً من الكيروسين على الصندوق، وأضرمتْ فيه النيران دون ذرة من تردد.
بشعرها المجعد المضموم للخلف، ونظرتها الحادة، وشفتيها المزمومتين على كثير من الغضب، بانتْ كأنما تمارس طقسًا وثنيًا غامضًا، خاصة أنها أخذتْ تُقرِّب يديها من النار حتى ليخيل لمن يراها أنها على وشك شيهما. لم تفهمْ “ثريا” التى كانت تراقبها خلسة من خلف زجاج النافذة طبيعة ما تفعله ابنتها، لكنها بدت مرتاحة لخروجها أخيرًا من غرفتها التى حبست نفسها فيها منذ عادت إلى البيت.
حين لسعتْها النيران سحبتْ سلمى يديها بسرعة، وجلستْ فوق الجذع الضخم لشجرة الصفصاف التى قطعها رشيد منذ سنوات وبقى جذعها كمقعد غير متناسق وكرسالة تخبر زائرين مجهولين عن وجود الشجرة هنا ذات يوم، وعن حياة مفعمة بالأحداث والتفاصيل الصغيرة غادرت بلا رجعة.
كانت تراقبْ الصندوق وهو يتآكل كأن حياتها هي معلقة بفنائه وتآكله.. يتآكل أمامها رشيد، سميح، جابر، رحمة، ثريا، جميلة، هشام، ولولاّ ويحترقون. تحترق هي معهم كى تبدأ من جديد بروح شابة وذكريات أقل ألمًا.
عاد الثعبان الأسود الغليظ مرة أخرى، خرج من كومة القش متجهًا نحو شق أسفل الجدار المقابل تاركًا أثرًا أسطوانيًا محفورًا فى التراب الناعم. لم تبصره سلمى هذه المرة أيضًا، وحتى لو رأته ربما لما حركت ساكنًا لاستغراقها التام فى مراقبة النيران والدخان الثقيل المتصاعد منها للأعلى.
بعد قليل قامت بتثاقل، نفضتْ ترابًا وهميًا عن ملابسها، سارتْ ببطء فى أنحاء الحديقة غير المعتنى بها قبل أن تستديرْ متجهة نحو سلالم البيت التى صعدتها بسرعة.
منذ طفولتها تعتقد أن درجات السلم يجب صعودها عدوًا ورغم تخطيها الثلاثين بسنتين ما تزال متمسكة بهذا الاعتقاد بشكل غير واعٍ.
سحبتْ أحد كراسى البامبو للخلف وجلست بجوار عمتها نظله المستغرقة في قراءة القرآن بصوت خفيض. جالت بعينيها في الفراندة الواسعة التي نسج العنكبوت خيوطه في أركان سقفها وأخذت نفسًا عميقًا تنهدت بعده. كانت هذه أول مرة تخرج فيها من غرفتها علي الرغم من وجودها في البيت منذ شهر.
كانت عيناها غائرتين أكثر من المعتاد، ومطرزتين بالكثير من الشعيرات الدموية الرفيعة، وذهنها كان سابحًا في مكان آخر أكثر قدمًا وحيوية.. مكان توسطته طفلة صغيرة باكية لها عينا بقرة مذعورة.
***
عادت سلمى إلى بيت أبيها مدفوعة بحلم!
حلمها كان يشبهها إلا قليلًا، كان عنيفًا، وإن ليس ذلك العنف المكتوم الذي يظهر فقط عبر نفاد الصبر والملل الشديد والاحتداد غير المبرر، إنما العنف الحقيقي الموشى بالقتل والدماء وطقوس الدفن.
تلبسها شعور مخيف بالذنب، عايشت ما يعانيه المجرمون الذين وصلت حالتهم حد الشعور بأنهم ملعونون إلى الأبد ولا أمل إطلاقًا في محو تلك اللعنة.. ذلك الشعور الذي يصل بهم أحيانا حد الرغبة فى التلاشي والميلاد من جديد بروح بريئة غير ملوثة.
كانت متأكدة من كونها قتلت شخصًا ما ودفنته بيديها العاريتين ثم نجت بفعلتها، وقفت بدم بارد ترقب دماءه تنزف ثم تتخثر، قطّعت جثته ثم جمعت أشلاءه ووارتها التراب، دفنتها وسوت الأرض بقدميها، ثم جلست على التربة الرطبة من دون أن تعبأ باتساخ ملابسها الأنيقة.
قالت لنفسها “أنا قتلت جميلة“.
كأنها تستعيد مشهدًا من الماضي السحيق جاءتها أحداث الحلم، شعور عميق بالذنب سيطر عليها، ليس شعور المجرم الذي انكشف أمره، وتعرض لنظرات التأنيب والاحتقار من الآخرين بسبب جريمته النكراء، فأمدته هذه النظرات ببعض القوة والجرأة على التحدي: تحديهم والبصق عليهم بلا مبالاة، ومداراة شعاع الندم -الذي بدأ ينبثق في داخله- عنهم.
إنما شعور السفّاح الذي ارتكب جرمًا بشعًا بإتقان ودون أن يعلم به أحد، وظن أنه قوي لدرجة لن يشعر معها أبدًا بوخز الضمير، لكن قوته خانته، وتحول لا وعيه إلى عدوه اللدود.
كانت تشعر أنها أفسدت حياتها كلها بجريمة القتل تلك، ورغم أن أحدًا لم يرها، إلا أنها كانت تفكر فى وسيلة للتكفير ولغسل هذه الدماء عن يديها.
في لحظة معينة انفصلت عن حلمها، أصبحت خارجه، ووقفت تتفرج عليه مرتعبة من شعورها بأنها قاتلة خبأت أمر جريمتها لعقود، ثم عليها الآن – بعد أن خانتها قوتها- أن تقر بها.
لحظة الانفصال عن الحلم عادة ما تكون معبرها إلى أرض الواقع، بعدها بلحظات تستيقظ دون أن تفيق تمامًا من تأثير أحلامها. تبقى تفاصيل حياتها الحقيقية مشوشة في ذهنها لبعض الوقت، تتداخل الأوهام مع الحقائق، والوساوس مع مشاعرها الدفينة.
مغمضة العينين ظلت لفترة تفرز أحداث حياتها، فلم تعثر على أية جريمة تُذكر، حمدت الله على أنها لن تعيش مشاعر الذنب المريرة تلك في الحقيقة، وإن ظلت تشعر بالثقل والتشوش الشديدين. مرات عديدة تسيطر أحلامها على حياتها الواقعية، تجعلها تنفصل عنها، وتغرق في هلاوس الحلم وتشوشاته لدرجة يختلط معها الوهم بالواقع.
كانت واهمة حين تصورت أنها سوف تتخلص من هذا الإحساس بالذنب، صحيح أنه خف كثيرًا عنه فى الحلم إلا أنها لم تطرده كليةً، بقى ملازمًا لها وحاولت أن تجد له تفسيرًا.
فكرت أن مغزى الحلم كان في سرية الجريمة المرتكبة، في أن أحدًا لم يعرف بها، وبالتالى لم تنل عقابها عليها. السرية إذن هي مربط الفرس. ترى ما السر الذي تخفيه ويطاردها في مناماتها؟ تساءلت بينها وبين نفسها دون أن تصل لإجابة تريحها.
في الليلة التالية رأت حلمًا آخر كأنه امتداد لحلمها السابق. في هذا الحلم بدت التفاصيل أكثر وضوحًا وارعابًا:
فيما كانت جثة جميلة ترقد بسلام على الفراش الذي نقلتها إليه سلمى بصعوبة؛ كانت هي تعدّل من هندامها أمام مرآة الحمام، جددت حمرة شفتيها، ورسمت خطًا طويلًا من الكحل فوق الجفنين العلويين، وأنساها اللون المتورد لوجنتيها أن تضيف أية مساحيق أخرى.
صوت جميلة المتحشرج المبحوح وهي تنطق بكلماتها الأخيرة كاد يوقفها، لكنها كانت قد وصلت إلى نقطة يصعب التراجع عنها، فواصلت طعناتها القوية في صدرها. كان دم جميلة القانى ينبثق ساخنًا بينما أخذت سلمى ترتعش وعيناها مثبتتان على الوجه الذى كانت الحياة تنفلت منه إلى الأبد.
فكرت أن من الحماقة أن تنشغل بتنظيف المكان، ونظرت إلى سترة وردية بلا أكمام وتنورة سوداء قصيرة كانت ترتديهما لتتأكد من نظافتهما. لحسن الحظ السترة لم يمسسها الدم، وإن كانت ذراعها اليسرى قد رٌسمت عليها بقعة دم طولية بدت أشبه بزهرة جلاديولس حمراء بفرعها الطويل وما يقرب من أربع زهرات متراصة فوق بعضها البعض. راقها هذا التشابه، فضحكت ضحكة تردد صداها في الشقة المغلقة. كانت قد نسيت تلك التي ترقد في الداخل ولا شيء فيها يشبه الحياة.
جلست على الفوتيه، وضعت حقيبتها السوداء الكبيرة على الأرض بين قدميها، أخرجت علبة سجائرها، وبدأت تدخن بهدوء. كانت تشعر بأنها انفصلت نهائيًا عن حياتها السابقة بكل صخبها وخيباتها. لم تعد المرأة الشابة التي كانتها منذ أيام، ولا البنت التي اعتادت أن تكونها في ما مضى. لم يساورها أى شعور بالندم، بل على العكس داخلتها لذة خفية صُعقت منها، وإن كانت لم تتنكر لها.. شعور آسر لم تخبره من قبل استحوذ عليها.
مخدرة تمامًا شرعت في تدخين سيجارة أخرى، وحين أنهتها، حملت حقيبتها ودخلت حجرة النوم حيث ترقد جثة صديقة طفولتها. بدت لها قامتها أطول مما كانت عليه. نظرتْ إلى وجهها الأزرق الجامد، ولم تجرؤ على لمسه. هالها التطابق بينه وبين الوجه الذي تحمله هي.
عادت إلى الحمام، فتحت صنبور المياه، وغسلت ذراعها أكثر من عشر مرات. لاحظت هذه المرة الهالات الزرقاء حول عينيها في المرآة، كما خُيل لها لوهلة أنها رأت وجه أبيها في المرآة، غير أنها عندما أمعنت النظر مرة أخرى كان وجهه قد تلاشى.
خرجتْ من الشقة بهدوء، وأغلقتْ الباب خلفها. كان السلم معتمًا بعض الشىء، فاستغرقت وقتًا أطول من المعتاد كي تصل إلى الشارع شبه الخالي الذي خطت فيه ببطء. لم تجد ما تفكر فيه فتشاغلت بعد خطواتها لكنها كانت تخطئ كلما وصلت إلى الخطوة العاشرة فتعاود العد من جديد، وعندما ملّت هذه اللعبة اتجهت إلى مقهى قريب وجلست في ركن مهمل. كان المجهود الذي بذلته قد أنهك قواها، وأفسد كي ملابسها، مما أعطاها إحساسًا طاغيًا بالقذارة حاولت تجاهله قدر الإمكان.. أشعلت سيجارة جديدة، وارتشفت رشفة من فنجان القهوة الذي وضعه النادل أمامها قبل أن ينسحب بسرعة.. شربت القهوة بتلذذ، ثم قلبت الفنجان في الطبق، وأمسكته لترى فيه ما يشبه الخريطة الداكنة، كان وجه جميلة أمامها بكل الشحوب والرعب الذي سيطر عليها في لحظاتها الأخيرة. لم تستطع أن تسيطر على القشعريرة التي اعترتها فجأة، فوجه جميلة سينطبع في ذهنها، سيلتصق بها وتلتصق به، طعنات سكينها قربتها منها كما لم تكونا من قبل.
تذكرتها بحنو وهي تحاول التشبث بأي شىء، فيما دمها يتفجر غزيرًا. تمنت لو استطاعت تثبيت هذه اللحظة إلى ما لا نهاية، فلم تكن قريبة من أي إنسان كما كانت معها في لحظتهما تلك، كانت قريبة منها للدرجة التي حلمت بها دومًا وحرمتها جميلة من الوصول إليها.
نظرتْ إلى ذراعها، فإذا بزهرة الجلاديولس الدموية ترتسم من جديد، قامت بحكها فلم تنمح، كانت تتسع كوحش بطئ. ركضتْ خارجة من المقهى.. ركضتْ طويلاً دون أن تحسب المسافة، وعندما أحست بالتعب توقفتْ مستندة إلى عامود نور في شارع مزدحم، كانت الزهرة ما تزال تتسع، وعينان لواحدة تشبهها تنغرزان فيها. مشت بخطوات متثاقلة وهي تردد: واحد.. اثنان.. ثلاثة.
فكرت أنها كان ينبغى لها أن تلقي نظرة أخيرة عليها. تساءلت كيف خلّفتها وراءها بهذه السرعة؟ بدأت تشعر كمن تخلى عن اسمه، عن هويته أو على الأقل عن جزء كبير منها. لم يعد اسم “سلمى رشيد” يعنى لها ما كان يعنيه قبلها بلحظات، صار بعيدًا عنها، وصارت بعيدة عنه بالمقدار نفسه، لم يعد أحدهما يدل على الآخر.
أما جميلة فبدا حضورها كأنما سيتضاعف بفعل الغياب، سيسيطر عليها ويقصيها عن نفسها، جميلة صابر اللعنة التي سوف تسكنها من الآن إلى ما لا نهاية، أناها الأخرى التي انفصلت عنها، وقطعت علاقتها بها دون ذرة من تردد.
استيقظت سلمى من نومها وهي تشعر بضيق فظيع، أحست هذه المرة أن ما رأته لم يكن حلمًا إنما واقع اختبرته وترك طابعه الدموى على روحها. عادة ما تكون أحلامها مجرد شذرات غير مترابطة، وتفتقد لهذا التسلسل المنطقى.
جلست في فراشها لبعض الوقت وهي تتساءل بينها وبين نفسها عن السبب الذي دفع بجميلة فجأة إلى حياتها من جديد ولو عبر باب الأحلام. غادرت الفراش ودخلت الحمام حافية القدمين، غسلت وجهها، ثم اتجهت للمطبخ، أعدت “نسكافيه”، وحملت الكوب معها إلى حجرة المكتب في شقتها الصغيرة. جلست أمام الكمبيوتر الذي نسيت أن تغلقه قبل نومها. لم يكن ثمة رسائل إلكترونية لها، كالعادة لم يرد “ظيا” على رسائلها العديدة له. أغلقت جهاز الكمبيوتر، تناولت إفطارًا خفيفًا، جهزت حقيبة ملابسها، وضعت أوراق “الرواية” التي تكتبها في حقيبة يدها، وخرجت متجهة إلى بيت أبيها في القرية، ذلك البيت الذي أصبح مهجورًا بعد وفاة والدها إلا من أمها وعمتها العجوز، وأحيانا شقيقتها هيام التي تمكث معهما من وقت لآخر.
بعد شهر تقريبًا كانت سلمى تنزل درجات سلالم بيتهم الثمانى كنمرة هائجة، يتبعها الخادم بصندوقه الخشبي الضخم، وقفت في المنطقة الجرداء بالفناء الخلفي للبيت غير مهتمة بالحر القائظ أو منتبهة للثعبان الأسود الزاحف بهدوء من كومة القش إلى الشق أسفل الجدار.
كانت عيناها غائرتين أكثر من المعتاد، ومطرزتين بشعيرات دموية عديدة، وذهنها كان سابحًا في مكان آخر قديم تتوسطه طفلة لها عينا بقرة مذعورة:
في الخارج تزهر أشجار الخوخ، يتسابق الأطفال لشراء الحلوى، تجلس الفلاحات أمام عتبات بيوتهن مثرثرات مع بعضهن البعض، فيما نسوة البيت ذهبن لزيارة المقابر في الصباح الباكر وعدن بغنيمة. وجدتها حكمت تبكى في الطريق إلى هناك. جئن بها بينما يتناول الأطفال والرجال طعام الإفطار على “طبلية” بالفراندة الواسعة للبيت ومعهم الخادم صابر وزوجته بشرى وابنته جميلة.
وقفت الغنيمة في وسط الفراندة تبكي بفستان قصير من الشيفون جورجيت بلون وريقات الفول الأخضر، شعرها الأسود مقصوص “ألا جارسون”، لونها خمرى، وعيناها متسعتان كعينى بقرة صغيرة.
كانت فى مثل عمر جميلة وسلمى تقريبًا، نظرت إليها الطفلتان بفضول مشوب بالغيرة، فانطلقت البنت فى دورة أخرى من البكاء أكثر صخبًا من ذي قبل، كأنما أحست أن وجودها صار مهددًا مع هذه العيون الفضولية المحدقة فيها.
اقتربت منها ثريا وربتت على كتفها بحنو وهي تمسح دموعها، سحبتها لتجلس على الكنبة التركى المفروشة بقماش الكريتون اللبني، وسألتها عن اسمها، فأجابت البنت بصوت مرتعش: سماح.
ثم أردفت من بين دموعها: سماح أحمد عبد الهادي.
طوال ساعتين حاولوا الوصول إلى اسم عائلتها دون جدوى، بالنسبة لهم العائلة هي كل شىء، أحمد عبد الهادى اسم غُفل لا يمكن الاستدلال عليه في أحراش هذا العالم دون لقب عائلته.
لم تشف البنت غليلهم، ولم تستطع حتى أن تخبرهم باسم القرية التي جاءت منها إلى عزبتهم الصغيرة الموحشة في حضن النيل، فكفوا عن استجوابها.
أحضروا لها طعامًا لم تقربه، وكوبًا من اللبن شربت نصفه فقط. جلست منزوية ويداها الصغيرتان تعبثان بالكرانيش الكثيرة لفستانها الأخضر القصير.
يداها ذات الأصابع الطويلة الرشيقة والأظافر النظيفة المقلمة المزين بنصرها الأيسر بخاتم ذهب يتوسطه فص من الياقوت المقلد كانت محور اهتمام جميلة بسنواتها القليلة، شعرت بالغريزة وحدها أن هاتين اليدين هما أكثر ما يبعد هذه الغريبة عن عالمهم، ويجعل وجودها فيه وجودًا طارئًا سرعان ما يٌنسى.
نظرتْ جميلة إلى يديها هي وإلى أصابعها ذات الأظافر غير المهذبة التي تحتفظ بالأوساخ تحتها وصممت بينها وبين نفسها أن يكون لها هذا المظهر الأنيق المهندم في يوم من الأيام: شعر قصير ممشط جيدًا، أظافر جميلة، فستان بلون وريقات الفول، وقبل كل شىء رائحة ذكية ونظرة أسيانة.