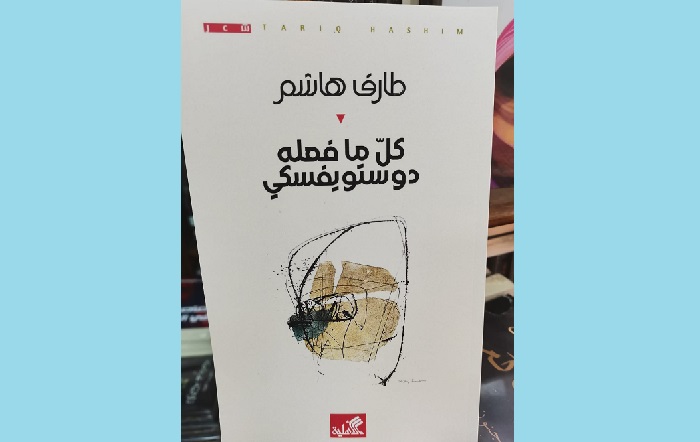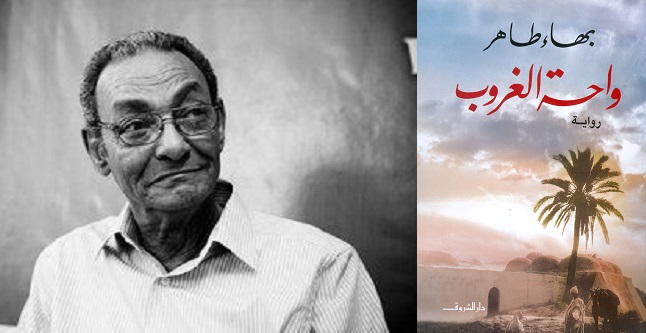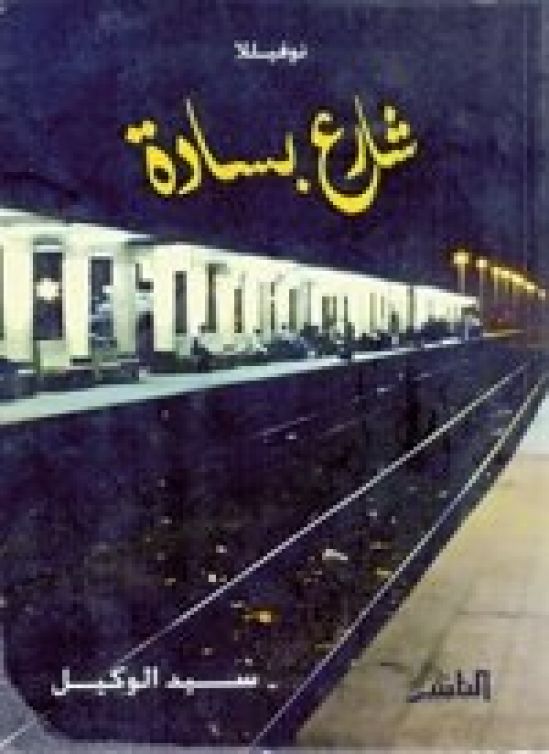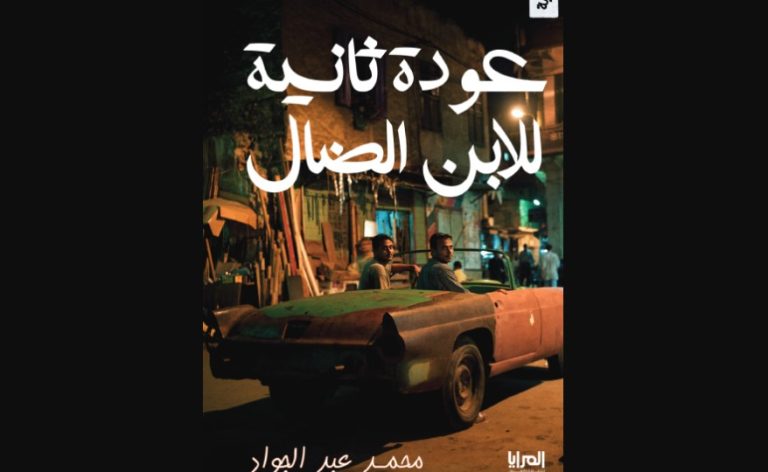حاتم السروي
الشعر باعتباره نوعًا أدبيًا عريقًا وملهمًا، هو ذلك الفن الذى يقوم على ترقية الإنسان وتهذيبه من داخله بإكسابه القدرة على تذوق الجمال والإحساس به؛ بل على تذوق الحياة ورؤية ما وراء الأشياء، والعروج إلى سماوات الحكمة.
والشعر لا ينمى الإحساس فقط؛ وإنما – وبالقدر ذاته- يثرى وعى الإنسان بذاته وعالمه فى صياغة جمالية إذا فُقِدَت لم يعد القول المنظوم شعرًا؛ فالشعر هو الجمال، وإن بعض عناصر الجمال تكمن فى الرقى النفسى والعاطفى، ورقى الفهم للأخلاقيات الإنسانية والحقائق الكلية للحياة، ولعل هذا ما يربط الشعر بالفلسفة فى علاقة لا انفصام لها، فالشاعر الحق يستبطن فيلسوفًا بداخله.
ورغم كل ما يقال عن توارى فن الشعر عن المشهد الثقافى وأنه أصبح بلا جمهور؛ إلا أن الحاجة إلى الشعر كنوع أدبى هى حاجة إنسانية قديمة متجددة؛ فالإنسان بحاجة إلى التعبير المكثف المختصر، المُوَقَّع، الذى يتسم بالتوازن والتناغم والانتظام البنائى وتشكيل الأنساق الدلالية، فالشعر فن موسيقى مؤثر، وأحد أوجه جاذبيته هى القدرة على اكتناز الكثير من المعانى فى عبارات قصيرة، وهذا ما يجعل من الشعر أدبًا سهل الحفظ والاستعادة، ومن هنا يتردد الشعر على ألسنة الكثيرين من حيث أنه ينبوع الحكمة ومُلهم المربين، ففى الشعر تبدو لنا دروس الحياة وعصارة التجارب البشرية، وذلك فى إطار كلمات قليلة العدد جَمَّة المعانى.
ومن حقنا أن نتساءل: كيف يمكن للشعر أن يموت وهو أقدم الأنواع الأدبية على الإطلاق؟ وقد عرفته الحضارات الإنسانية القديمة جميعها دون استثناء، وكتب عنه أرسطو منذ ما يزيد على الألفيْ عام «فى الشعر» وهو الكتاب الذى قسم فيه الشعر إلى ثلاثة أنواع: الشعر الغنائى، الشعر الملحمى، والشعر المسرحى، فهى ثلاثة أنواع من الشعر يميز بينها أرسطو بالضمائر الثلاثة، فالضمير «أنا» يرمز به للشعر الغنائى.. والضمير «هو» يرمز به للملحمة.. أما الضمير «أنت» فهو عند أرسطو رمز للدراما.
ويعتقد بعض الباحثين أن الإنسان عندما تحدث للمرة الأولى فى تاريخه الحافل قال شعرًا؛ ويعنى هذا على مذهبهم أن اللغة الإنسانية الأولى كانت ضربًا من ضروب الشعر، ودليلهم على هذا أن اللغة الأولى كانت تحتوى على خصائص الشعر الجوهرية، وهي: «الإيجاز- الكثافة- الإيقاع- الانفعال العاطفى» فقد كانت هذه اللغة البدائية فقيرة وقليلة الكلمات، ومع ذلك فقد كانت لغةً بكرًا أصيلة، وقد أراد بها الإنسان القديم أن تعبر عن الكثير من المعانى، وبهذا اجتمع فيها الإيجاز مع الوفرة الدلالية مما أدى إلى الاكتناز، والاكتناز أحد خصائص الشعر المحورية، وبهذا يكون الشعر هو بداية الكلام.
يضاف إلى ما سبق أن اللغة الإنسانية الأولى كانت إيقاعية الأداء، بما يعنى أنها تقترب من الموسيقى أو أنها لغة موسيقية قريبة من الغناء، ويأتى هذا بالطبع من حيث أن اللعب كان أحد سمات هذا العصر البدائى الذى شهد ملامح طفولة الإنسانية وبراءة الإنسان القديم، ذلك الإنسان الذى كان يلعب ليعيش أو يعيش ليلعب، وحتى فى صيده وبحثه عن الطعام كان يلعب، والغناء صديق اللعب، ومن هنا كانت لغة هذا الإنسان لغة مُغنَّاة؛ وبالتالى كانت لغة شاعرية.
ونظرًا لغياب المعارف العلمية والرؤى الفلسفية عن الإنسان البدائى الذى اكتشف اللغة؛ فقد كانت لغته مفعمة بالانفعالات النفسية والأحاسيس العاطفية، وهذا أيضًا دليل يضاف إلى ما مر بنا من أدلة يرتكن إليها القائلون بأن الإنسان الأول عندما تكلم للمرة الأولى كان كلامه شعرًا.
ورغم وجاهة كل ما سبق من أدلة؛ إلا أن هذا الفريق من الباحثين فاته أمرٌ فى غاية الأهمية؛ ألا وهو أن هدف تلك اللغة البدائية لم يكن إنتاج الجمال؛ وإنما كانت غايتها نفعية بالطبع، فهى لغة تواصل وتعبير وليست لغة فن أو إبداع، وما كانت خصائص الشعر التى ظهرت لنا فى تلك اللغة مقصودة لذاتها، فليس هناك عمد ولا قصدية، وإنما كانت هذه الخصائص نتاجًا لطبيعة المرحلة المعرفية، وبالتالى تعطل عنها معنى الإبداع، ومن ثم يكون من الشطط والمغالاة أن نقول عن الإنسان أنه نطق شعرًا حينما أتته الرغبة فى الكلام..
ويذهب فريق آخر إلى أن مصدر الشعر هو: «تراتيل الكهان» والتعاويذ والرُّقى التى كانت تُكتَب وتُقرأ لتحقق أثرًا سحريًا فى الإنسان والحيوان والأشجار، أو للتأثير على نتيجة الحرب فتكون فى صالح قارئ التعويذة، أو لتحقيق اليسر والتوفيق فى مهمة الصيد، وكذلك لعلاج الأمراض، واستنزال المطر – فى اعتقاد الإنسان البدائي- فهى تراتيل مكتوبة تقوم على الإيمان القاطع بتأثير الكلمة ذات الطبيعة الخاصة، ونحن نرى الآن وفى كل زمان أن للكلمة الشاعرة تأثير على السامع أو القارئ بما يجعلنا نقول أن الشعر فن مؤثر جدًا.
اقرأ ايضاً| مديح آخر للقراءة
وهو خير ما يشعل فينا الحماسة والحب والرحمة والحكمة، فالشعر وإن كان قد انفصل عن هذا المنزع البدائى الذى رأى فيه ضربًا من السحر؛ غير أنه لا زال حتى تلك اللحظة يسحرنا ويأسرنا ويحقق ما يبتغيه الشاعر الفذ من التأثير فى الناس..
وقد يدعم ما ذهب إليه فريق الباحثين الذين رأوا فى التراتيل الكهنوتية أصلًا لفن الشعر، أن ثمة تصوراً عاماً شاع لدى العرب الأقدمين بوجود قوى خفية تلهم الشاعر ليخرج للناس قصيدته فتأسر ألبابهم، وقد اصطلح العرب على تسمية هذه القوة الخفية بـ «شيطان الشعر» ذلك أن الشعر– عند العرب- ليس قولًا بشريًا عاديًا؛ بل هو قولٌ خارق جاء من عالم غير محسوس، ومن هنا رأينا الشاعر «رؤبة بن العَجَّاج» يقول فى أرجوزته متفاخرًا:
إنى وإن كنتُ صغير السنِّ.. وكان فى العين نُبُوٌّ عنى
فإن شيطانى أمير الجِنِّ.. يذهبُ بى فى الشعر كلَّ فَنِّ
والواضح لدينا هنا بما لا يحتاج إلى بيان أن «رؤبة» يصرح بأن ما يقوله ليس من اختراعه المحض؛ وإنما هو «وحيٌ وإلهام» ثم يتفاخر بأن مُلْهِمَهُ ليس مجرد شيطان عادي؛ بل هو «أمير الجن»! ومؤدى البيتين أن قصائد رؤبة هى فنون ممتازة تأتى من مصدرٍ عظيم، مصدر أميرى فى عالم الجن والقوى الخفية!
ثم لم يكتفِ العرب بالقول أن للشعر شيطانًا؛ بل قسموا الجن إلى قبائل وشعوب، وغدا كل شاعر يقول بأن شيطانه ينتمى إلى قبيلة جنية معينة؛ فحسان بن ثابت رضى الله عنه – على سبيل المثال- كان يعتقد بأن شيطانه ينتمى إلى قبيلة «بنى الشيصبان»..
وظل القول بأن للشعر شيطانًا قائمًا حتى عصرنا الحديث، فعندما مدح حافظ إبراهيم صديقه أمير الشعراء أحمد شوقى مرحبًا به بعد عودته من المنفى بأسبانيا وجدناه يقول:
إن قال شعرًا أو تَسَنَّمَ منبرًا.. فتعوذوا بالله من شيطانِهِ!
وحين جاء الإسلام والعرب على هذا النحو من الاحتفاء بالشعر والوُلوع به، كان من المناسب أن يتناول هذا الفن ويحدد فى وضوح ما إذا كان الشعر له شياطين يلهمون الشعراء أم لا، ولهذا قسَّم الشعر إلى نوعين؛ فما كان من الشعر غزلًا فاحشًا أو إثارة للعصبية والحقد بين القبائل أو هجاءً مقذعًا، فهذا من نفث الشيطان، وأما الشعر الذى تبرز فيه الحكمة والحث على الفضائل، أوالتعبير عن العواطف الإنسانية النبيلة، فهذا شعر جيدٌ مستساغ وخصوصًا لو كان جزلًا فصيحًا، وكان الرسول يسمع الشعر ويثيب عليه، وقد أنشد كعب بن زهير بين يديه قصيدته التى مطلعها «بانت سعاد» وبدأها بالنسيب – أو الغزل- كما نعرف ولم ينكر عليه، وبعد أن فرغ كعب من إنشادها عفا عنه وألقى عليه بردته..
والقول بعُلوية القول الشعرى وكونه إلهامًا قول لا تعوزه الدقة فى الحقيقة؛ بل إن فيه بعض الصحة، فالقرآن الكريم يقول عن الرسول «وما علمناه الشعر» فالشعر إذن موهبة من الخالق بنص هذه الآية وهو علمٌ كذلك، ولحكمةٍ معلومة لم يأتِ النبى الكريم شاعرًا، وذلك ليتبين للعرب ولكافة البشر أن القرآن وحى إلهى منزل وليس من جنس قول البشر ولا يمكن أن يُعد شعرًا، وليس فيه ما فى الشعر من خيال وحالٍميَّة بل هو القول الحق المبين من لدن الحكيم العليم سبحانه..
والشعر ليس مجرد ممارسة جمالية فحسب؛ بل يمكن أن يكون داعية إلى الفضائل بالشكل الذى لا يجعله نوعًا من الوعظ أو الخطابة، وكما يقول أمير الشعراء «أحمد شوقى»:
والشعر إنجيلٌ إذا استعملتَهُ.. فى نشر مَكْرُمَةٍ وستر عَوَارِ
ونقول فى النهاية إن الشعر لا يموت بل يتجدد،لأن مادته هو الشعور الإنسانى وكل حب وشوق وحماسة وحزن وخوف ورغبة وأمل وذكرى، كل هذه الأحاسيس والرؤى هى شعر، ولا تخلو حياة الإنسان أبدًا من عاطفة ومن رغبةٍ فى البوح والتعبير عن هذه العاطفة؛ فنحن إذن بحاجة إلى من يتحدث عنا، عما يعتمِل فى ذواتنا من آمال وآلام، ومن هنا كان الشاعر ضرورة، فكيف يموت من لولاه لمُتنا من الكبت، كيف لا يشدو المغني؟ كيف لا تبدو روح الحقيقة؟ لاشك أن الشعر سوف يبقى طالما بقى الإنسان، لأن الشعر هو الإنسان.