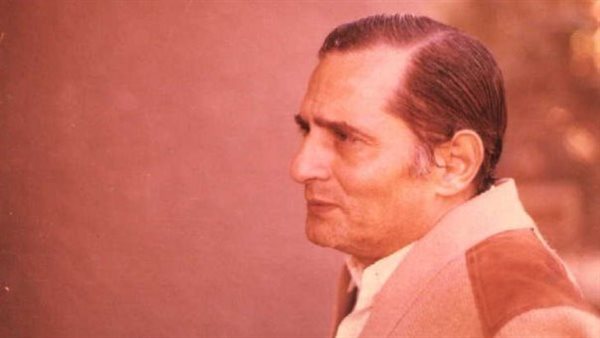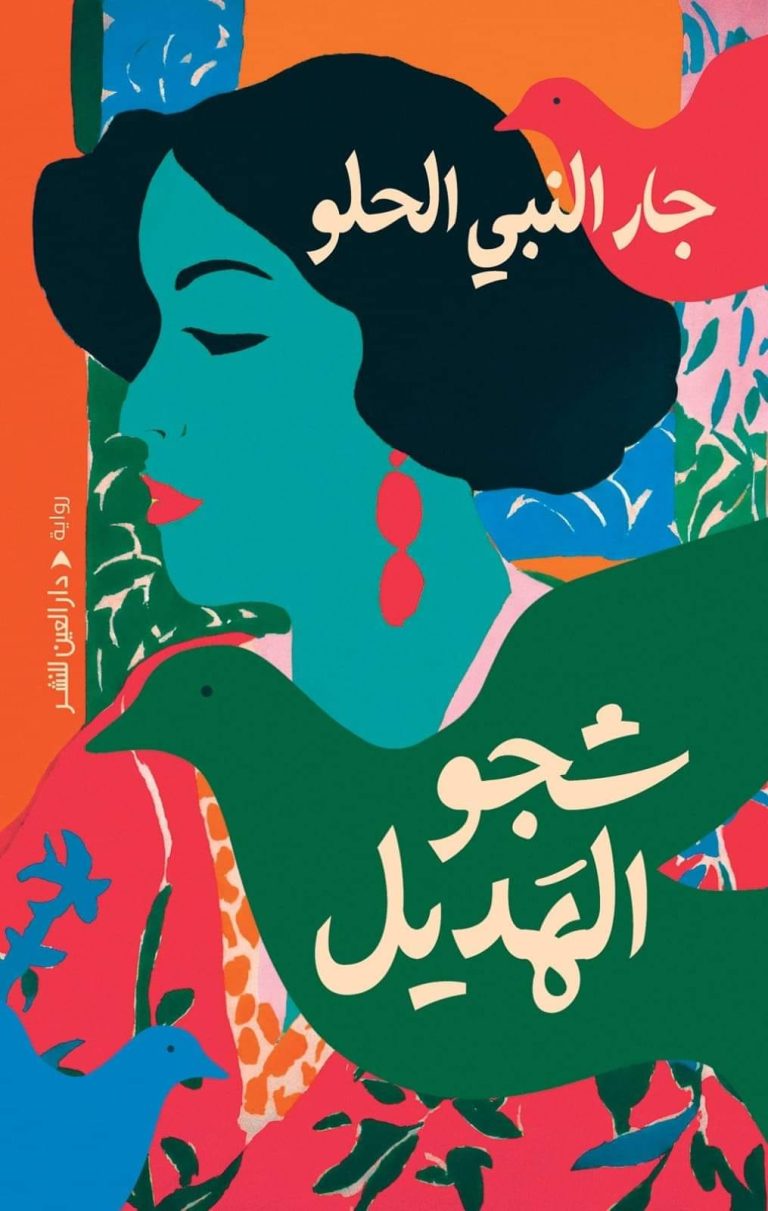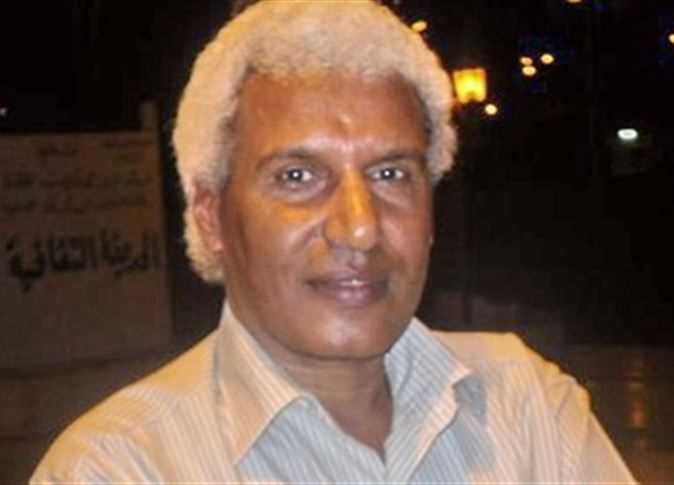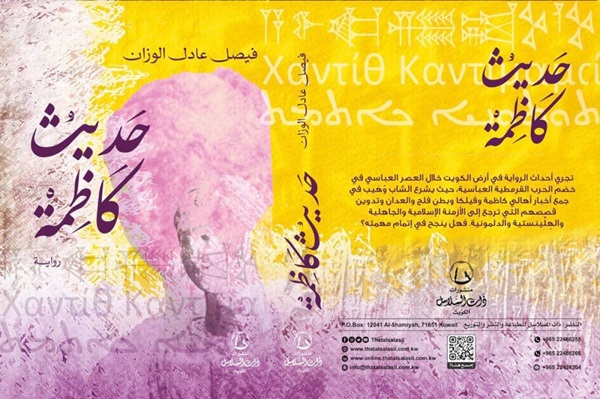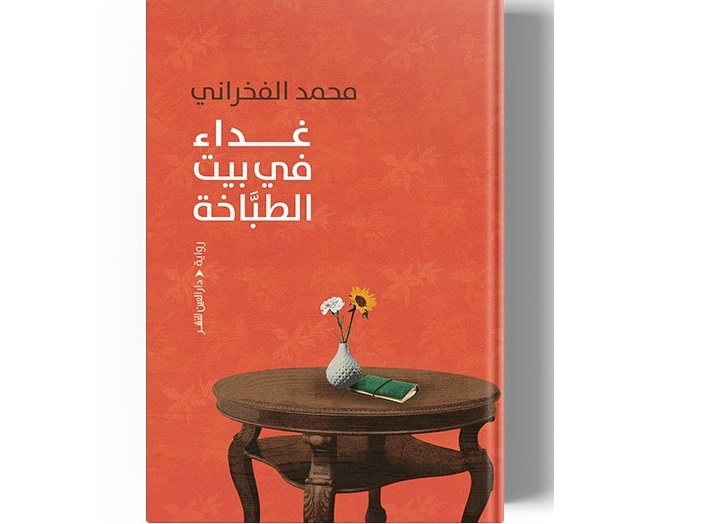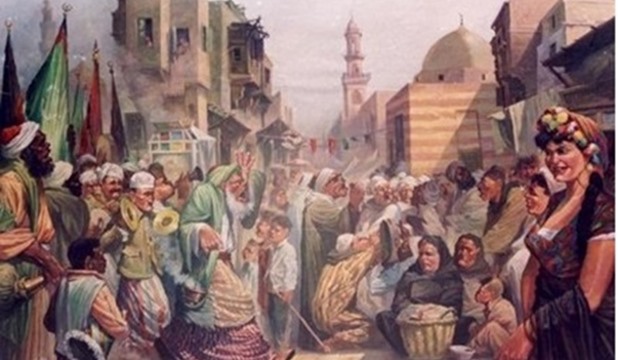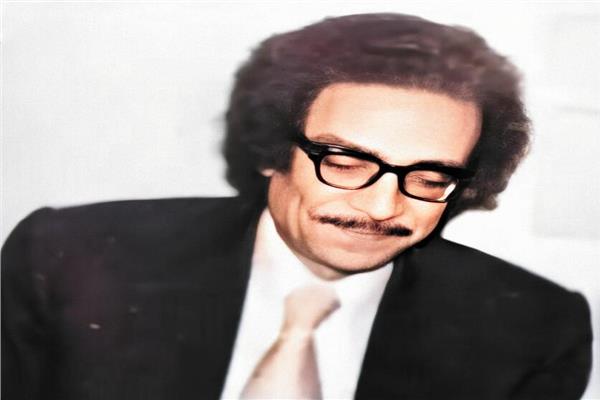د.سيد ضيف الله
أعترف بداية أنني كنت على مدى سنوات مريدًا لفؤاد حداد وأن مولانا الشاعر منحني درجة الدكتوراه في شعره ولم يمنحني سره! مررت بلحظات عصيبة مع بعض نصوصه حتى أنني كدت أومن بأن هذا الشاعر يبدع من منطقة يسكنها وحده، بل من منطقة يصعب أن تفتح أبوابها للعقلاء!
العقل هنا تقييدٌ للخيال، وفؤاد حداد خيال جامح لا مُخضع له ولا موِّجه له سوى سلطة الصوت. الصوت والخيال متنافران بطبيعة الحال، لأن لكل منهما سلطته التي لا يتخلى عنها للآخر، فأن تنقاد لسلطة الخيال يعني أن تتحرر كلية من محددات تصنع للصوت إيقاعاته الطربية، وإذا انقدت لسلطة الصوت واتحدت بإيقاعاتها انتقلت بها من لغة العقول إلى لغة الأجساد وهي تفارق العالم المعقول لتنتشي بعالم هارب من أعراف الثقافة ونظام العقل. أكاد أومن أن من أسرار فؤاد حداد الشعرية قدرته على إخضاع سلطتي الخيال والصوت لسلطته الشعرية الفردية ليكون نتاج ذلك شعرًا قد نفهمه حين يكون تمرده خاضعًا لأعراف التمرد التي تضعها الثقافة للراغبين في التمرد عليها، لكنني أرتاح الآن لإرضاء نفسي حين لا أفهم بعض أجزاء من شعر فؤاد حداد أو علاقة أجزاء بأجزاء داخل القصيدة الواحدة- أقول قد أرتاح للقول بان تمرداته لم تتم وفقًا لأعراف التمرد التي تجعل من كل تمرد أو خروج على الأعراف خروجًا لديه قابلية للفهم والتفاعل معه؛ أي خروج مقنن على القانون!
بعض خروجات فؤاد حداد على أعراف الخيال في ثقافتنا السائدة يمكن فهمها أحيانًا على أنها صور شعرية مبتكرة، لكن هناك الكثير من الصور الشعرية التي يصعب فهم سر وجودها في قصيدة ما سوى على انها بنت الصوت الذي انقاد له فؤاد حداد فجعله إمامًا للخيال الشعري. وقد لا يمكن للقارئ أن يصل لهذا السر حين يكون قارئا لا يحسن استقبال الصوت والدخول في حالته الإيقاعية، وقد يصعب الوصول لسر العلاقات بين أجزاء قصيدة لأن الرابط بين هذه الأجزاء لا رابط بينها سوى أمر شديد الخصوصية داخل نفس الشاعر أو في أحوال أخرى يكون هناك من رفاقه من يحكي لك عن تفسير للربط بين تلك الأجزاء مستند لمعرفته الشخصية بالحالة النفسية للشاعر وقت دخوله في حالة الإبداع أو بأسرار حياته الاجتماعية محدودة النطاق. ويبدو أن الافتقار لهذه الأسباب التي كانت رابطة بين أجزاء قصيدة ما لفؤاد حداد في ذهنه أو في أذهان مريديه ورفاقه هو ما يجعل التأويل ضرورة من ضرورات التعامل مع شعر فؤاد حداد، مع الوضع في الاعتبار ان هذا التأويل لا يقوده سوى قدرة المؤول على الانتقال وراء صوت فؤاد حداد المسموع والمتخيل من مقام إلى مقام.
إن التعامل مع شعر فؤاد حداد بهدف إخضاعه لأعراف القراءة النقدية الشائعة للشعر العربي التي تمزق جسد القصيدة للغة وإيقاع وصور شعرية ودلالة أو رؤية للعالم لا يفضي سوى لمزيد من الفجوة بين قارئ يستجيب وفق أعراف تلقٍ وشاعر يتمرد على أعراف الإبداع الشعري. بل إن التعامل مع شعر فؤاد حداد بهدف استخراج معنى مبنى من علاقات سببية بين أجزائه المتعاقبة داخل القصيدة قد لا يظفر صاحبه بمراده في بعض الأجزاء؛ فمثلا في ديوان التسالي نجد فؤاد حداد مشغولاً بصنعة الصوت وصنعة الصور الشعرية المبتكرة على نحو يجعل الإمساك بمعنى محدد لمقطع شعري في قصيدة “شرع التسالي” ليس سهل المنال.
من صغر سنّي كنت شيخ فلكي
أبصّ للنجم اللي زيّي قليل
بتسكنه زيّي أمم زغاليل
باب الحديد في الدمع ما بيغرقش
حلفت اثبت قلبي زيّ النقش
وان طربقوا فوقه زواج ملكي
ربوا القمر والشمس بالبقاليل
تسالي
إن السؤال البسيط لمن يريد أن يربط بين أجزاء المعني المفترض انه ينمو داخل المقطع الشعري هو ما سبب وجود “باب الحديد” هنا؟
فهذه القصيدة -إن كان يجوز أن نقول للقصيدة غرض- غرضها اعتزاز الشاعر بنفسه، وهو ما يظهر واضحًا في مطلع القصيدة
أنا والد الشعراء فؤاد حداد
أيوه أنا الوالد وياما ولاد قبْلسَّه ربيتهم بكل وداد
بعدسَّه تلميذ أولى وإعداد
ومن ثم يمكن توقع الصور الشعرية المتواترة في سياق الاعتزاز بالنفس، ومنها تلك الصورة المبتكرة التي أنتجها فؤاد حداد حين نقل الصورة التقليدية (الأنا- النجم) نقلة نوعية بجعله النجم والذات الشاعرة تسكنهما أمم زغاليل!
أي ذات تلك التي تشتمل على أمم زغاليل؟ وأي خيال ذلك الذي جعل تلك الذات الشاعرة ترى في النجم -المستهلك استعاريًا في الثقافة العربية- مسكنًا لأمم من الزغاليل؟! وكيف كان له أن يربط بين مفردة ارتبطت بمجال دلالي يخص الطيور بمجال النجوم ليعتز بذاته؟!
ورغم عدم وجود إجابات على تلك الأسئلة لا يمكنني سوى أن أستجيب لابتكاره الاستعاري مستمتعًا بصحبة الخيال والصوت. وتتكرر الاستجابة نفسها مع الصورة التالية رغم عدم ابتكاريتها بل إنها نقل استعاري لمشهد متواتر في الثقافة الشعبية يساق للدلالة على رجاء الناس للشمس أو للقمر أن تظهر حين يختفي اي منهما لبعض الوقت، ويكون سر الدهشة هنا استخدام متفرد لمفردة البقاليل التي تضرب بها القمر والشمس؛ حيث يتحول المشهد المتوارث لاستعطاف الشمس أو القمر للظهور بالضرب بالعصى على الصفيح وهو المناسب لغرض الاعتزاز بالنفس والتشبه بالنجم، إلى ضرب للشمس نفسها أو للقمر نفسه بالبقاليل/ الفقاقيع.
إن الخروج الاستعاري هنا قد لا يستطيع الكثيرون تقبله باعتباره خروجًا لم يلتزم بأعراف الخروج الاستعاري المقنن في ذاكرتنا الشعرية. لكنهم لا يملكون سوى تأمل هذا الخروج والاندهاش له ومحاولة الإمساك به وشده بالتاويل لأعراف القراءة النقدية التي يميلون لها.
ويبقى في هذا المقطع الشعري الصغير ما يخفى عني حتى هذه اللحظة ؛ وهو ما الذي أتى بباب الحديد(رمسيس حاليًا) في ذهن فؤاد حداد لينفي عنه الغرق في الدمع بينما سياق القصيدة وغرضها الاعتزاز بالنفس؟!
باب الحديد في الدمع ما بيغرقش
لكن في المقطع التالي نجد فؤاد حداد يعيد استثمار استعارته السابقة عن (الأمم الزغاليل) لتكون الذات الشاعر طيرًا طار من قلب الوالد لكن دون أن يعلمه ضرورة أن يختار بين ظلم النفس وظلم الغير، وهو ربط بين أجزاء لمعنى يتشكل في خدمة غرض الاعتزاز بالذات، وما أن نستريح للإمساك بمعنى يتشكل من جزئياته نجدنا أمام شفتشي المعروف لدينا أنه لون بهجة وقد صار عند حداد مرتبط بأيوب أيقونة الصبر في الثقافة الشعبية، ونجدنا أمام مياه تذوب بينما الذوبان للثلوج ثم نجدنا مرة أخرى أمام استحالة أن يكون فؤاد حداد جامعًا بين نقيضين (مفتري ومجذوب) مع أنه لم يقدم لنا سوى صور شعرية نموذجية في التدليل على الجمع بين المتناقضات للخروج على أعراف التخييل الشعري!
الشفتشي نازل على أيوب
مش كل أوهام اللي ماتوا عيوب
كان قلب والدي وقلبي ماله جدار
الميّة دايبه يا مناويشي
مش لسه رايحة تدوب
مااقدرشي أبقى مفتري ومجذوب
لا تتوقف صور فؤاد حداد الشعرية التي تؤرق القارئ الباحث عن علل للربط بينها لبلورة معنى واحد متسقة أجزاؤه، فالذات الشاعرة التي كانت نجمًا تسكنه ” أمم زغاليل” ثم صارت طيرا يطير من قلب الوالد دون أن يعلم ضرورة أن يختار بين ظلم النفس وظل الغير، تصير نفسها جرسون يقدم الينسون بحسب طلب(هم) لكن الاختلاف بين ما يستطيعون رؤيته ويشكلون به ميراثهم وبين ما تراه الذات الشاعرة وتسطيع به أن تشكل صورها الشعرية – هذا الاختلاف هو ما يمكن أن يعيدنا للصورة التي لم نفهمها سابقا ولم نعرف سر وجودها في قصيدة غرضها اعتزاز الذات الشاعرة بنفسها، أعني صورة “باب الحديد في الدمع ما بيغرقش”!
فباب الحديد ليس باب الحديد المعروف بمحطة مصر أو ميدان رمسيس لاحقًا، والينسون ليس مشروبنا المعروف فحسب، حيث نعود لاستثمار الحديد دون بابه في صورة شعرية جديدة حيث يصبح مقدم الينسون مبصرًا ما لا تبصره العيون الستائر الوارثة للبؤس
طلبوني قالوا تقدم الينسون
بصيت لهم مش قصدي ماذا رأيت
عيون ستائر بئس ما يرثون
وهنا يأخذ الشاعر في تقطير الندى لهم وسقيتهم بل ويأخذ في السرقة من قلبه ومن السجن ومن الحديد ليعمل لهم شجر وغصون فيبصرهم بما عجزت العيون الستائر عن رؤيته، وبهذا التجاور بين القلب والسجن والحديد نجد رؤية تتشكل مع إعمال التأويل، فتجاور الحديد مع السجن لصناعة أغصان الشجر والغصون حرفة شاعر يرفض أن يكون دوره جعل الناس ينسون أو لا يبصرون وإنما أن يبصر ما لا يبصرون. هذه الروابط الصوتية بين الصور الشعرية يمكن بجهد تأويلي الوصول لخريطة تقريبية لحركة الصور في ذهن فؤاد حداد التخييلي ، فباب حديده ليس ميدان رمسيس وإنما باب السجن باب حديد لا تغرقه الدموع لكنه شاعر يمكنه أن يعمل منه “شجر وغصون” عوضًا عن السجن المبني من قلوب السجانين الذي تمنع قضبانه النور والشجر في ديوانه الأول أحرار وراء القضبان.
في سجن مبني من حجر
في سجن مبني من قلوب السجانين
قضبان بتمنع عنك النور والشجر
زي العبيد مترصصين
من هذه المنطقة الخاصة به يأتي بصوره الشعرية المثيرة للدهشة بسبب قدرته على الخروج على أعراف التخييل الشعري فنرى معه الضحك طالع سلم الترماي ثم نكتشف أن الضحك مريض يكشف عليه الحكيمباشي ثم تأتي المفارقة من طلب الحكيمباشي من الضحك أن يقول نقيضه (آه ، أيوه، آي) ليتمكن الحكيمباشي من تشخيص مرضه؛
الضحك طالع سلم الترماي
جاله حكيماباشي وقال له يازول
حاكشف عليك قول آه وأيوه وآي
عايزين نشوف هم التلاته دول
باشوا في قلبك والا لسّه قواى
تسالي
إن واحدة من خصائص شعر فؤاد حداد-كما رأينا- هي تلك الطاقة الصوتية التي لا تلعب فقط دورًا موسيقيًا فحسب وإنما تحفز طاقة الخيال عند فؤاد حداد بحيث يمكن في كثير من القصائد أن يكون زمام قيادة خيال الشاعر بيد الصوت وهذا لا يتعارض مع تأكيد الشاعر على سيطرته على كلامه وأنه لا يوجد حرف زائد عن الحاجة، وإنما تأكيده هذا هو في حد ذاته وعى بوجود ما يدعو للشك، ليس شكًا في غياب إرادة الشاعر، وإنما في الاعتقاد بوجود صراع داخلي بين عقل الشاعر الفرد الذي هو عقل مفارق لأعراف التخييل الشعري الشائعة والمتوارثة، وعقل الأمة الذي هو أعراف صياغة المعاني صوتيًا، ويبدو ان حرص حداد على نفي هذا الصراع أقوى دليل على وجوده في داخله على الأقل ووعيه بضرورة تجاوزه لتتآلف داخلة سلطة الخيال مع سلطة الصوت ويقودهما لإثبات تآلف فرديته المتميزة وتحقيق تمرده وفق أعراف الثقافة في الخروج على نماذجها الجمالية.
“وانا في انسجامي/ ما انساش لجامي/ تحكم كلامي/ إرادتي/ وباقول يا قافيه/ المعنى أفيد/ ولا حرف أزيد عن حاجتي”.
إن للشاعر لجامًا بحسب فؤاد حداد، وإذا تأملنا القصيدة ذاتها التي يؤكد فيها إرادته الفردية في الإمساك بلجام الشعر؛ “صاحب مزيّه واستاذيه”، سوف نجد أنه قد يحق له أن يقول: إنه لا يوجد حرف زائد عن حاجته هو كشاعر، لكن ذلك لا يعني أن خيال الشاعر هو من يمسك بلجام نغم ألفاظه ورنينها. ذلك أن الانتقالات داخل القصيدة تشكل فجوات في بنيان الخيال أو مساراته السردية، لا تملأها إلا جلبة الصوت، بما يتسق وسياق التلقي الشفاهي، وبما يعكس امتدادًا لنموذج الشاعر الأصلى المرتبط بالسياق الشفاهي. ويصبح السؤال عن هذه الفجوات من منظور قارئ فرد في سياق كتابي كاشفًا عن مدى دور الصوت في قيادة الخيال.
مسحراتي/ منقراتي/ ياسيداتي/ وسادتي/ بعد التماسي/ انا التماسي/ يدوم حماسي/ وعادتي/ أنا قلب أخضر/ بفروع تجرجر/ من الشجرجر/ مودتي/ من غير أذيه/ صاحب مزيه/ واستاذيه/ في مادتي/ وانا في انسجامي/ تحكم كلامي/ إرادتي/ وبا قول يا قافيه/ المعنى أفيد/ ولا حرف ازيد/ عن حاجتي.
إن المسار السردي للخيال في هذه القصيدة يمكن رسمه على النحو التالي:
- تحية المتلقي،”بعد التماسي”.
- تحديد موضوع الرسالة الموجهة للمتلقي،”انا التماسي يدوم حماسي وعادتي”.
- وصف الذات الإنسانية، “انا قلب اخضر، بفروع تجرجر، من الشجرجر، مودتي، من غير أذيه”.
- وصف الذات الشعرية، ” صاحب مزيه، وأستاذيه، في مادتي…إلخ.
عند تأمل هذا المسار السردي سوف نتوقف عند الفجوة الأولى إذا ما تساءلنا ما علاقة موضوع الرسالة “الالتماس بدوام الحماس والعاده”، بما تلاها من وصف للذات الإنسانية؟! لكن هذا السؤال لا يُطرح تحت تأثير التجانس الصوتي “التماسي/التماسي/ حماسي”، وكأنه تجانس قادر على تحقيق قدر من التجنيس للمتلقين في السياق الشفاهي، أو هو تماثل صوتي هادف لدفع المتلقين للامتثال في السياق الشفاهي. نأتي للفجوة الثانية إذا ما تساءلنا عن الدافع للانتقال من وصف الذات الإنسانية إلى الانتقال لوصف الذات الشعرية؟ ولا نجد إجابة على هذا السؤال إلا في ذلك الحافز الصوتي للخيال والمتمثل في “أذيه، مزيه، استاذيه”؛ ذلك أن ختام وصف الذات الإنسانية ينتهي بتأكيد طبيعتها الودودة، ونفى صفة الإيذاء عنها، بينما بدء وصف الذات الشعرية يبدأ بتأكيد اعتزازاها بنفسها لدرجة المدح والتفاخر، فما الداعي للانتقال لمدح الذات الشعرية لنفسها؟ ألا يكون ذلك تراثًا عبّر عن نفسه من خلال دفع الشاعر دفعًا لإعلان امتلاكه للحس التاريخي بماهية الشعر في عقل الأمة، ومن ثم تمثيله لذاته الشعرية باعتبارها امتدادً للنموذج الأصلي للشاعر الذي أنتجه السياق الشفاهي لإنتاج الشعر وتلقيه؟!
إن كون الصوت محفزًا للخيال يقوده حيثما يريد، لا يعني أن الخيال فردي والصوت جمعي، وإنما يعني أن الخيال يتشكل أيضًا بشكل متسق مع طريقة تشكيل الصوت.