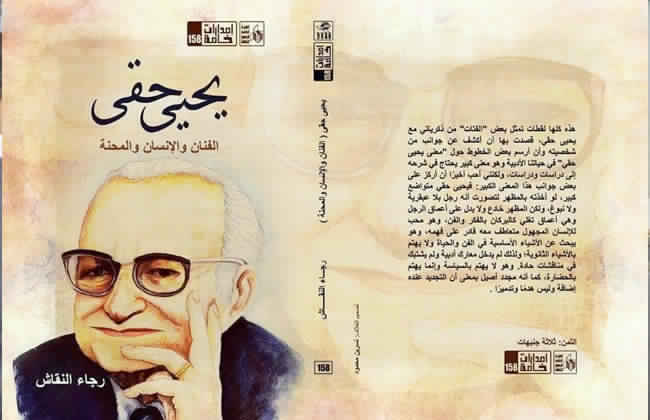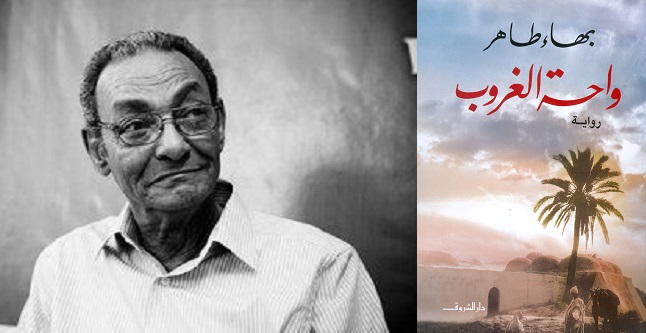محمود عبد الدايم
«كتاب مين ده؟!».. سؤال مباغت ألقاه ابني «إياد» على طاولة حوارنا الممتد ونحن في طريق عودتنا من «تمرين اليد» شبه اليومي، يستغل «إياد» الدقائق التي تمر علينا ونحن في مترو الأنفاق في طريقنا إلى البيت في التحايل عليّ بشتى الطرق لأسمح له بـ «اللعب على الهاتف»، مستفيدًا من غياب أمه وانزعاجي السريع من «تكرار الطلب»، غير أني _ ودون أي ترتيبات مسبقة_ ربحت، ولأول مرة، في جذب انتباهه بعدما أخرجت من شنطة الكتف التي أحملها دائما رواية «هذه ليست رصاصة»، سريعًا التفت ناحيتي، وباغتني بالسؤال السابق، وكأنني وجدتها فرصة لأحكي له عن الأستاذ عبد الله ناصر، الذي أحببته دونما أن أراه، بعدما أزاح صديقي القاص والروائي محمد البُرمي الستار عن كتاباته.
ولأنه «البُرمي»، فحديثه الشيق، منذ سنوات عدة، عن «عبد الله»، مع حفظ الألقاب والمقامات، جعلني أستكشف عالم هذا الكاتب الذي يحبه صديقي ويحترمه ويقدره، فكان لقاؤنا الأول مع مجموعته «فن التخلي»، والتي أدخلتني في موجة سعادة منذ اللحظة التي طالعت فيها الإهداء الذي كتبه «ناصر» إلى «ماريو بينيديتي» صاحب «بقايا القهوة» و«الهدنة»، الذي دخلت عالمه هو الآخر من بوابة القصة القصيرة بعدما طالعت مجموعته المُدهشة «عشيقات الماضي البعيد».
سريعًا.. أُغرمت بما يكتبه «عبد الله»، وفهمت لماذا اختار «بينيديتي»، ليقدم له إهداء «فن التخلي»، ومرت الأيام سريعًا وكان لنا لقاء ثانِ بعنوان «العالق في يوم أحد»، والذي لم يكن أقل جودة ودهشة من «فن التخلي»، وكان سببًا في أن أتخلى عن خجلي المزمن وأبحث عن صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مكتفيًا بالضغط على «زر المتابعة» لأكون على موعد بين الحين والآخر مع «منشورات» هي أقرب إلى نصوص عذبة تدهشني لغتها وإحساسها المرهف.
قراءة ومتابعة صاحب «فن التخلي»، كشفت ليّ أنه إنسان بقدر ما يعشق البساطة إلا أنه دقيق الملاحظة، لديه حس خاص مع التفاصيل، وقدرة عجيبة على صناعة عالم من تفصيلة صغيرة جدًا قد لا ينتبه إليها غالبيتنا، لكن «ناصر» المغرم بكل ما هو دقيق، يدرك جيدًا الزاوية التي ينظر بها إلى تفاصيل العالم، ويتقن أيضا اختيار التفصيلة المناسبة ليقدمها لنفسه أولا، ثم لنا، في أجمل صورة.
بعدما أنهيت حديثي مع «إياد» عن صاحب «فن التخلي»، وجدتني سعيدًا، فابني الصغير لم تسحبه «لعبته الإلكترونية» بعيدًا عن عالمي، وامتد بينا حديث شيق عن واحد من كتابي الذين أحبهم، ووصلنا إلى محطتنا دون تكبد عناء مشقة أن تظل واقفًا في مترو مزدحم طوال تسع محطات.
«نحن محاطون بالستائر»، مقولة قدّمها «عبد الله» في بداية الرواية لصاحبها رينيه ماغريت، وستكشف التفاصيل بعد ذلك لماذا «ماغريت» وليس أحد غيره، وذلك قبل أن يضعك في بؤرة التفاصيل مباشرة مسددًا رصاصة في منتصف جبهة انتباهك، على طريقة ألبير كامو، في روايته «الغريب»، التي بدأها بجملة «اليوم ماتت أمي.. أو ربما أمس.. لست أدري»، حيث كتب «عبد الله»: «كانت لأبي ثلاثة مسدسات، وبندقية صيد، وترخيص قديم للسلاح»، لتبدأ من هنا أحداث «هذه ليست رصاصة».
هنا.. لستُ في معرض النقد أو الحديث عن أسلوب الكاتب و«تكنيك الكتابة»، ورؤيتي لـ «تجربته الروائية الأولى»، بقدر ما سأحاول نقل دهشتي من «العادي» الذي استطاع المبدع عبد الله ناصر أن يجعله مدهشًا ومختلفًا في آن معًا، فمن الطبيعي أن يمتلك أي منا حكايته الخاصة، لكن من المدهش أن تتحول الحكاية إلى قطعة فنية يقدمها صاحبها في أبهى صورة، فالطفل الذي قضى سنواته يبحث عن «سر أبيه» يأخذك من يديك إلى عالمه الخاص ويجعلك شريكًا معه في رحلة بحثه الممتدة التي دفعت «فياض» لأن يطلق رصاصات خمس في جسد «أبو نعير»، وإلحاحه المتواصل على كل من حوله لمعرفة التفاصيل.
وكعادته، كانت الجملة المكثفة حاضرة في فصول الرواية الصادرة عن دار الكرمة، وهي مهمة ليست باليسيرة بالمناسبة، غير أنه إلى جانب هذا منحنى الكاتب – وبشكل شخصي – عدة هدايا، منها حديثه عن رينيه ماغريت، الذي يبدو أن ولع «ناصر» بالفنون جعله خبيرًا في تقديم أصحابها خير تقديم، وهو ما جعلني أستمتع كثيرًا بقراءة فصل «الناجي» الذي يحدثنا فيه عن «ماغريت» ولوحته التي تحمل اسم الفصل، قبل أن ينقلني بهدوء وسلاسة إلى فصل أكثر رقة ورحابة عنوانه «تهريب الأب» مقدمًا في وجع هادئ رحلة الأم مع الحياة و«فياض» والمرض، ولأنني من الذين يمسكون بقلم رصاص حينما يقرأون، وجدتني أضع الخط تلو الآخر تحت أسطر الفقرة التي قال فيها على لسان الراوي: «على أنني أتذكر ليلة بعينها بكيت فيها أنا وأختي طويلًا قبل النوم حتى أبكينا أمي. سرعان ما مسحت دموعها، وكما غلت الأم الفقيرة الماء في القدر لتنوم أطفالها الجياع قالت أمي إن أبي سيعود غدًا. توسدنا وعدها ونمنا. وعندما طلع الصبح سألناها فقالت إنه جاء في الليل واضطر إلى أن يسافر مرة أخرى. قالت إنه قبَّلنا ونحن نيام وجاء لنا ببعض الألعاب. العجيب أننا صدقنا ذلك. كانت الألعاب حقيقية أما القُبلات فلا. لقد فعلت الذاكرة فِعلتها، وعشتُ سنوات أتذكر تلك القُبلة الخيالية. سألتُ أختي ذات يوم عن تلك الزيارة الليلية القصيرة فضحكت وأقسمت أنها أيضا تتذكرها، بل تتذكر أبي عندما فتحت عينيها فرأته ينحني ليقبلها. صارت أمي تُهرب أبي بالحكايات من السجن. كلما حان موعد نومنا عاد أبي إلى البيت حتى نغمض أعيننا وننام.
أخيرًا.. «هذه ليست رصاصة» رواية من النوع الذي يشبه العطر، كلما أيقظ حاسة الشم لديك أعاد إليك ذكرى خاصة تُسعدك، رواية من تلك الأعمال التي ستجدها تُناديك كل فترة، تأخذك لفترة من الزمن قبل أن تُعيدك وقد منحتك جرعة مكتملة من الروعة والدهشة.. ويقين بأن «العادي» من الطبيعى أن يصبح مدهشًا عندما يكتبه عبد الله ناصر.