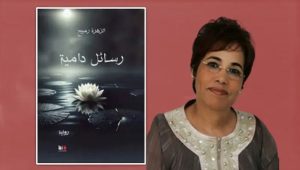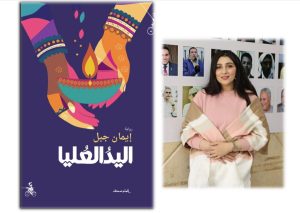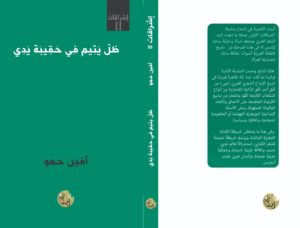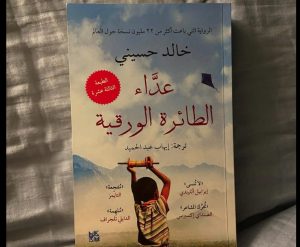د. مصطفى عطية جمعة
في التعريف الأساسي لنقد النقد، تشير نجوى القسطنطيني إلى أنه : “خطاب يبحث في مبادئ النقد و لغته الاصطلاحية و آلياته الإجرائية و أدواته التحليلية([1])، فهو قراءة على قراءة، فالناقد يقدم قراءة نقدية للنص الأدبي موضع التطبيق، ومن ثم ينتج خطابًا عليه، ويأتي نقد النقد مناقشا لهذا الخطاب. وبذلك نخرج من الفهم المغلوط الذي نجده لدى البعض، بمثابة تعديل أو تصحيح لخطاب الناقد، أو إعادة إنتاجه بالشرح والتفسير والتوصيف، أو حتى النقيض من هذا أو ذاك، وهو الهجوم الكاسح، الناتج عن موقف رافض، مثلما رأينا عند رافضي النقد الحداثي، الذين رفضوه بناء على قناعات إيديولوجية أو بالتلقي السلبي الذي يضع حاجزا نفسيا أمام الجديد، دون أدنى استعداد لفهمه بشكل إيجابي، ينظر إلى الفائدة والإفادة والجدة والرؤية وطبيعة النهج العلمي بآلياته وطروحاته. فهناك من قرأوا المناهج الغربية الحداثية ورفضوها وهم يقرؤونها دون محاولة النظر إلى مقدار ما أضافته للدرس النقدي الحديث في الأدب العربي. وهناك من رفضوها لدواعٍ خاصة بغموض الخطاب النقدي العربي الذي قام بنقدها، حيث أمعن بعض النقاد الحداثيين في نخبوية الخطاب إلى درجة الإلغاز، أو من بالغ في التنظير، وأضفى على المنهج الكثير من المديح والحفاوة، ولكن وجدنا قصورا واضحا عندما جنح إلى التطبيق. وكانت الآفة أشد، عندما رأينا نقادا نقلوا النظريات النقدية الغربية في مؤلفات لهم، لمجرد مواكبة موجة النقد الحداثي التي انتشرت مؤخرا، ولكن ممارساتهم التطبيقية نأت بهم عما نقلوه، وتمسّكوا بما ألفوه من طرائق نقدية تقليدية.
ومن المهم التنبيه على أن عملية نقد النقد تتجاوز النقاش العلمي الذي نجده في عروض الكتب، أو مناقشة الرسائل العلمية، أو التعليق على بحث أو كتاب، والمراجعات العلمية من المختصين. فنقد النقد نشاط علمي مستقل له منهجية، تتجاوز الإطار التعليمي والإرشادي إلى الاشتغال على خطاب الناقد نفسه: المفاهيم، الأفكار، المرجعيات، الآليات، الممارسات التطبيقية. وهذا من شأنه أن يكسب نقد النقد أهمية كبرى، فلن يتعامل الناقد الثاني مع الناقد الأول من باب المراجعة العلمية فهذا مستوى أولي، وإنما يشتغل على الفكر والنظرية والتطبيق.
أما كون نقد النقد خطابا، لأنه بمثابة قراءة ثانية أو ثالثة للدراسات النقدية، ولكن على صعيد دراستنا، والمعنية بتجربة المتنبي، فإن المنهجية هنا تنحصر في نطاق بعينه، وهو التجربة الشعرية للمتنبي، وهذا يتقاطع مع مفهوم الحقل الخطابي Champ Discursif، والمقصود به مجموع الخطابات المتفاعلة حول ظرف أو تجربة أو نص بعينه، بما ينتج فضاء خطابيا، يشتمل على روابط بين الرؤى والدراسات حول هذا الفضاء، وتكون بينهما علاقة تنافسية بالمعنى الواسع، والحقل الخطابي ليس بنية ساكنة، بل هو لعبة توازن غير قارّ، وأيضا هو ليس متجانسا حيث توجد تموقعات مسيطرة، وأخرى مسيطر عليها، وتموقعات مركزية، وأخرى أطرافية([2]).
بما يعني أن الخطابات في الحقل الواحد، تتنافس في تسليط الضوء على ما في التجربة الإبداعية من جوانب وأبعاد ورؤى. وأيا كان الحقل الواحد (إبداعا أو قضية أو فكرة أو موقفا) فلاشك بأن هناك خطابات تحيط به، وبالطبع ستكون متراوحة بين التجانس والتعارض والتناقض، وهو ما يجب رصده والوقوف عنده، مع التمييز بين ما هو مركزي وما هو فرعي، فالأول يعني بما هو مشترك في الخطابات، أما الفرعي فهو ما يتفرع عنها، وقد تكون رؤى متناثرة لا علاقة لها، ولكنها تكمل الحقل الواحد، وتملأ ثغرة في الفضاء الخطابي، أو تنبه إلى ما غفل عنه المركزي.
إن من أهداف نقد النقد – بوصفه نشاطا وتلقيا للنقد الأول- إيجاد خطاب نقدي، ينتج جدلية مثمرة، من أجل دراسة الجهد النقدي المبذول في قراءة النص الإبداعي في ضوء المنهجية المطروحة، ومن ثم النظر في مدى توفيقها في استنباط معاني النص، وكشف خصوصياته. وكذلك السعي إلى كشف جوهر الممارسة النقدية ذاتها، وتفكيك منطقها، وفحص آلياتها و إجراءاتها و مرجعيات أصحابها الفكرية والنظرية والجمالية([3]). ومن هنا، فإن نقد النقد جهد علمي، يسير في دروب عدة، منها النظر إلى التطبيق في ضوء الطرح النظري، ومناقشة التأسيس النظري ومرجعياته الفلسفية والعلمية، والنظر في جهد الناقد نفسه وسعيه في التطبيق على الإبداعات، من حيث توفيقه في الرصد والإجراء والتحليل والاستنباط والتأويل.
فالوعي بنقد النقد، يأتي على مستويات عديدة، تشكل مدخلا للقراءة والتحليل، بمعنى أننا في دراستنا لأعمال ناقد أدبي، لابد من الولوج لأعماله من زوايا متنوعة، أولها: مفاهيمه النقدية التي تشكل رؤاه التنظيرية، فالكارثة تتحقق عندما نكتشف أن هناك من يرغي ويزبد في تحليل النصوص الإبداعية، وهو بلا مرجعية نظرية، فالذوق والانطباع والخبرة المكتسبة هي الأساس في تقييمه، وهذا شأن كثير من نقاد الصحافة والمجلات والمنتديات الأدبية، ونرى أن هؤلاء في أفضل الأحوال متذوقون أكثر من كونهم نقادا، شارحون للنصوص الجيدة، يقفون عند الدرجات الأولى من السلم، وهي الإرشاد المحدود للمبدع في أخطاء وثغرات.
على صعيد آخر، لابد من التنبيه على قضية الموهبة فيما يتعلق بالنقد ونقد النقد، فالموهبة النقدية تعني أن الناقد لديه القدرة، والكفاءة، والهمة، والرؤية، والذائقة، التي تجعله يقرأ النص ويقيمه، ويتجادل معه، ويطبق عليه مفاهيمه النقدية وافتراضاته. وبالتالي، تسقط المقولة الشهيرة أن الناقد مبدع فاشل، فهي مأخوذة بلاشك من عالم الحرف اليدوية، وليس من أجواء الإبداع والنقد، فالصانع الفاشل يعرف أسرار الصنعة، ولكنه يفتقد الإجادة، فيستطيع أن يقيم منتج الصانع الماهر أو نصف الماهر بما عرف، وتلك مهمة لا تتماشى مع عالم الإبداع.
وأيضا، من الخطأ التصور أن النقد محصور في ذكر الجيد والرديء، فهذا عمل أولي مع النصوص الأولى للمبدع، أما مستويات النقد فهي تلتقي مع مهارات التفكير، فهناك مستويات ثلاثة دنيا : الفهم والتذكر والتطبيق، وهناك مستويات أربعة عليا تشمل : التحليل والتركيب والنقد والتقويم. ومن خلال هذه المستويات يتم تطبيق الخبرة الجمالية، والمناهج النقدية، وعمليات الشرح والتأويل.
نقد النقد استراتيجية تكاملية:
إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ونحن بصدد طرح رؤية مختلفة حول نقد النقد هو: هل يمكن أن تكون منهجية نقد النقد آلية كاشفة لفهم متكامل للتجربة الإبداعية؟
ونسعى من خلال الإجابة عن هذا السؤال إلى اتخاذ منهجية نقد النقد كوسيلة لفهم أعمق للمنجزات النقدية حول مبدع ما. بما يكشف عن عمق تجربته وتميزها، وأيضا كيف أن تعدّد المناهج النقدية، وتنوع المقاربات يساهم في كشف المزيد من أبعاد التجربة الإبداعية؛ وبذلك نتخطى النقاش التقليدي لنقد النقد، والتي تركز عادة على تقويم القراءات النقدية، على صعيد المنهج والإجراءات والنتائج، والتقويم هنا ذو وجهين: إثرائي وتقويمي. فالوجه الإثرائي يركّز على الإضافة التي قدمتها قراءةٌ ما أو دراسةٌ ما لنص إبداعي أو موضوع ما، ويتم البناء عليها، والتنبيه على ما فيها من تميز، وبذلك يراكم في الإنجاز النقدي، ويسلط الضوء على الجهود المبذولة، ويقلّب التربة عما لم يستوفِ حقه في النقاش النقدي، وغابت عنه الأضواء.
أما الوجه التقويمي فهو معني بمناقشة مدى قصور القراءة النقدية لإبداع ما، على مستوى المنهج أو التطبيق أو الخلاصة. وكلا الوجهين يساهم في تطوير الخطاب النقدي بشكل عام، عبر قراءة نقدية ثانية تنظر في الفرضيات العلمية التي صاغها الناقد، وجعلها ركيزة في قراءته التطبيقية للإبداع، ولا يعني ذلك نسف الجهد المبذول، بقدر ما يساهم في ضبط المسار، وإعادة تموضع العين الناقدة بشكل صحيح.
وبالعودة إلى السؤال المطروح أعلاه، فإن جوهره النظر في كيفية أن يكون نقد النقد سبيلا لتكوين رؤية تكاملية لمبدع ما، أو أية ظاهرة إبداعية، وفق الدراسات والأبحاث النقدية التي تناولته، على فرضية منّا؛ بأن التراكم النقدي حول مبدعٍ ما يساهم في كشف جوانب عديدة من إبداعه، على المستوى الجمالي والرؤيوي واللغوي، وغيرها من الأبعاد الثقافية والسوسيولوجية، وأيضا الإشارات الثقافية والفكرية والنفسية.
فإذا كان الناقد قديمًا -كان أو حديثًا- يسعى إلى تسليط الضوء على إبداع ما، فإنه حتما وبلاشك لن يستوفي كل جوانب التجربة الإبداعية، وإنما يتوقف عند ظاهرة أو بُعد ما، أو يدرسها ضمن منهجية نقدية، بما يعني أن كل دراسة نقدية هي بمثابة مصباح كاشف عن بعض أو جزء من جماليات النص، وطروحاته ورؤاه، وإشاراته.
على صعيد آخر، فإن النقاش لأي منجز نقدي لابد أن ينطلق من مفهوم قوامه أننا نناقش خطابا نقديا أنتجه الناقد الأدبي في عصر بعينه، وضمن سياقات ثقافية وأدبية ونقدية وفكرية محددة بالعصر والشخص والمنهج والتطبيق والممارسة.
فلا نغض من شأن نقاد اجتهدوا في ضوء المتوافر في عصرهم، وإن جاء نقدهم مباشرا يقف عند الدرجات الدنيا من العملية النقدية باقتصاره على ذكر الإيجابي والسلبي في النص. فلاشك أن هؤلاء امتلكوا الموهبة النقدية، وامتاحوا من خبراتهم النصية والذائقية، ولا نُعلي في المقابل منهجيات أو مقاربات نقدية، نرى أنها قد فاقت ما سبق، وإنما تكون استراتيجية نقد النقد ناظرة في جوهر الإضافة العلمية والمعرفية للتجربة الإبداعية محلَّ الدراسة، وكيف أنها تضافرت مع غيرها في إيضاح التجربة وتعميق الرؤى حولها، وأيضا تبصير المتلقي بالجديد في النصوص الإبداعية.
نقول هذا، ونحن بصدد دراسة التجربة الإبداعية لشاعر العربية الأكبر أبي الطيّب المتنبي (303هـ – 354هـ)، وما أكثر الدراسات النقدية حوله، وقد أثير الكثير من الجدل حول شاعريته، وما تثيره من قضايا لغوية وبلاغية، ولكن لا خلاف على رقي إبداعه، وتميز شاعريته، وعِظَم قريحته، وقوة شخصيته.
وقد رأينا أن ننطلق من نقد النقد بوصفه استراتيجية منهجية، تتيح رؤية متكاملة تستند إلى عينين: عين على التجربة الإبداعية، وعين على المنجز النقدي، فالتجربة الإبداعية أساس النقد، مثلما أن النقد هو تلقٍ نوعي وعلمي للإبداع.
إن النقد الأدبي يشتمل على دراسة الأعمال الأدبية: جماليات وتلقيا وفكرا، أما مجال نقد النقد فسنجده يتضمن عنصرين مختلفين: أولهما النقد الأدبي في مستوييه النظري والتطبيقي، وثانيهما الأعمال الأدبية، مما يعني أن موضوع نقد النقد أوسع من موضوع النقد الأدبي، لأن النقد الأدبي نفسه يقع ضمن موضوع نقد النقد([4]).
كما يستلزم الفرق الجوهري بين مجال النقد الأدبي، ومجال نقد النقد، ذلك أن الضرورة العلمية تقتضي تعزيز استقلال نقد النقد عن النقد الأدبي، بما يجعل نقد النقد مختلفا في المنهجية، بهذه الدرجة أو تلك عن النقد الأدبي في كل من آلياته ومصطلحاته و أهدافه التي يتغياها، من منطلق أن نقد النقد ينطوي بالضرورة على النقد والتقويم، بما يشتمل عليه من نقد الأفكار والأسس والمناهج معا([5]).
فلابد للناقد من وجود أطر نظرية يستند إليها: منهجيات، نظريات، مدارس، رؤى، ليكون النقاش معه وفق مرجعية، وإلا ستكون الانطباعية مرجعية وحكما، وهذا يخرج بنا عن دائرة النقد بمفهومه العلمي. فمن المشكلات المطروحة في هذا الصدد، وجود نقاد تطبيقيون، ونقاد منظرون، وندر من يجمع بين الاثنين، فالتنظيري يكتفي بالترجمة والنقل، ويظن أن النظرية هادية مرشدة لمن أراد التطبيق. والتطبيقي يرى العبرة في التطبيق، ومقاربة النص، والغوص فيه، ولكن بلا شك فإن استراتيجية نقد النقد لابد أن تقرأ ما وراء التطبيق، إن غاب التنظير، وتنظر في جدوى التنظير إن عزّ التطبيق، فكلاهما متلازم في النقد، فمثلا في النقد العربي القديم غاب التنظير، بل استند كثير من النقاد القدامى على ذائقتهم ودُرْبتهم وخبرتهم مع الإبداع، ولذا يستوجب استقراء ما وراء الإشارات النقدية، للوقوف على البعد التنظيري. أما إذا وُجِدَت دراسة جامعة التأسيس النظري والتطبيق، فإن استراتيجية نقد النقد ينصب على مناقشة أسسه المنهجية، ومنطلقاته الفكرية، وانسجام نتائجه مع حقائق النص الأدبي المنقود من جهة، ومع تنظير الناقد نفسه من جهة أخرى.
المستوى الثاني هو قراءة التطبيق النقدي لمن لديه تنظير مؤسس، مع الربط بين التطبيق والتنظير ومدى تحققه. أما المستوى الثالث: فهو نقد النقد ذاته، بمعنى النظر إلى النظرية الأصلية، والمقارنة بينها وبين تلقي الناقد لها، وفهمه وتطبيقه إزاءها، ونفس الأمر مع الإبداع، ننظر في النص الإبداعي ومن ثم ننظر في نقده، ونمارس نقدا على نقده، فيكون رؤيتنا للنص من خلال وسيط نقدي.
ومن هنا، تتحدد مهمة نقد النقد بأنه فعل تحقيق، واختبار، وإعادة تنظيم المادة النقدية بعيدا عن أي ادعاء بممارسة النقد الأدبي، انه يقوم فعلا بنقد آخر و صلته بالأدب غير مباشرة([6]). وهذا عمل مطلوب لأنه يجمع الجهود المشتتة، ويؤلّف بينها، وينسقها، ليخرج بتصور في النهاية، يفيد من يحمل الراية بعده.
وإذا نظرنا إلى النص الإبداعي وعلاقته بالنقد ونقد النقد، سنجد أن العلاقة الأولى تتمثل في النص النقدي المنتج الذي يحاور ويناقش النص الإبداعي مباشرة، فهي قراءة أولية للنص الإبداعي، وفق رؤية نقدية من قبل الناقد، أو عدد من النقاد. وهناك علاقة ثانية، تأتي في مرحلة ” نقد النقد ” فيكون النص الإبداعي هنا مذكورا عبر وسيط نقدي يمثل وجهة نظر الناقد الذي تناوله.
وقد أسهمت مجمل المعطيات سابقة الذكر في خلق حركة نقدية جدلية دفعت البعض الى دراسة الظاهرة التأويلية في ضوء علاقتها بالنص الإبداعي و مدى توفيقها في استنباط معاني النص، و كشف خصوصياته. و دفعت البعض الآخر الى الاهتمام بجوهر الممارسة النقدية ذاتها، وتفكيك منطقها، وفحص آلياتها وإجراءاتها ومرجعيات أصحابها الفكرية و النظرية و الجمالية.
وفي هذه الحالة، لابد من الاطلاع على النص الإبداعي، وعدم الاتكاء على الوسيط النقدي، فذلك حجاب فاصل في تقييم النص وتقييم نقد النص أيضا، مما يفقده حميمية تواصله مع الإبداع، وتصبح علاقته بالنص النقدي القارئ للنص الإبداعي علاقة رضوخ لافتراضاته النقدية، أي هيمنة النص النقدي ومقولاته على النص الإبداعي، وسقوط ناقد النقد في إسار تلك الهيمنة.
فلاشك أن النقد في إحدى مهامه هو وساطة بين القارىء والنص الإبداعي، ما يجعله ينبض بروحانية الإبداع وجماله، أما نقد النقد فهو يمركز نفسه وسيطًا بين النص النقدي وقارئه، ليسلب النقد مرتبته تلك، وإن كان هذا ما سيجعلنا أمام سلسلة تكاد لا تنتهي من النقود، لاسيما إذا كان الفاصل بين النص النقدي الأول، والجديد، متمركزاً على دراسات عديدة، كل منها يخرج بإضافة معينة على الدراسة السابقة([7]).
ومن هنا، يتوجب على ناقد النقد في تقييمه للدراسات التطبيقية أن يطلع على النص الإبداعي الأساس أولا، ويتفاعل معه، ومن ثم ينظر في المحاورات والنصوص النقدية التي تناولته، ليأتي حكمه مستقلا، غير منحاز أو تحت قراءة مسبقة.
وأخيرا، هناك مستوى عال، يتمثل في تنظير نقد النقد، ويعني أن يخرج الناقد للنقد من اطلاعه ونقاشه لعدد من المنجزات النقدية المتنوعة بنظرية ورؤية كلية. أي أنه يبني تنظيرا على إبداع وتطبيق ونقد ونقد النقد، فيأخذ خلاصة الأبحاث والرؤى، ويستند إليها في صياغة نظريته النقدية أو الأدبية، فعمله أشبه بعمل النحلة التي امتصت رحيق زهورا عديدة في حقل واحد، ومن ثم أنتجت شهدا.
………………………………….
[1] ) في الوعي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهوره، د.نجوى الرياحي القسطنطيني، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد1، المجلد 38، يوليو ـ سبتمبر 2009، ص35.
[2]) معجم تحليل الخطاب، باتريك شارودو، دومينيك منغنو، ترجمة: عبد القادر المهيري، حمادي صمّود، المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا، سلسلة اللسان، تونس، 2008، ص98.
[3] ) في الوعي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهوره، ص35.
[4]) نقد النقد أم الميتانقد، محاولة في تأصيل المفهوم، باقر جاسم محمد، مجلة عالم الفكر، العدد ٣، المجلد ٣٧، مارس ٢٠٠٩، ص 118.
[5]) المرجع السابق، ص118.
[6]) نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، محمد الدغمومي، منشورات كلية الآداب، الرباط، 1999، ص166.
[7]) نقد النقد في أسئلته الجديدة، إبراهيم اليوسف، الحوار المتمدن، العدد: 3537، 5/11/2011م.