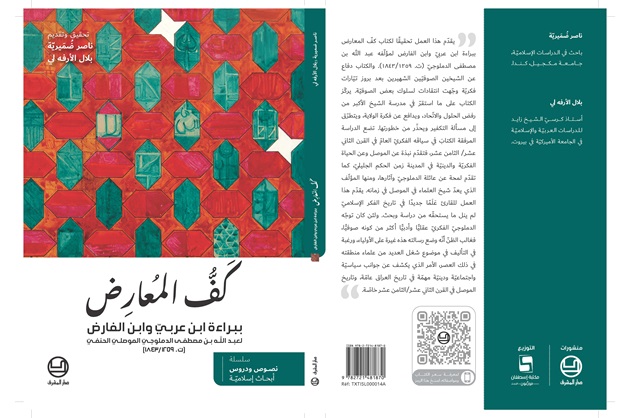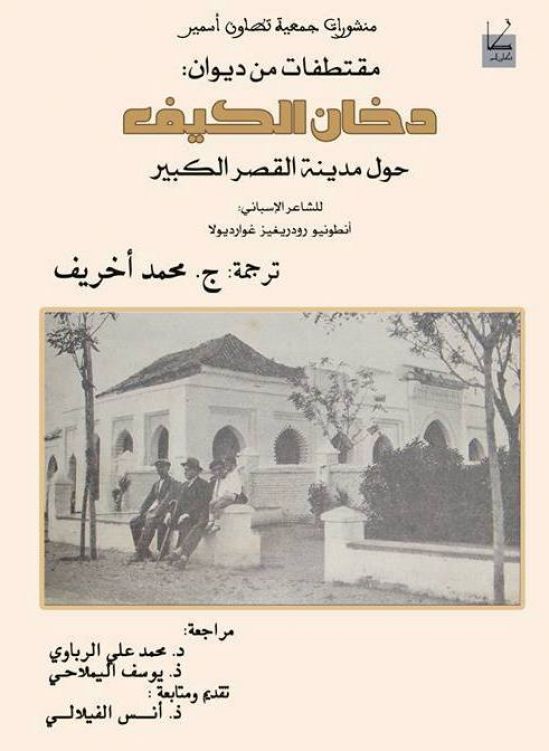عن دار العين للنشر في القاهرة صدر كتاب “سبع سماوات، رحلات في الجزائر والعراق والهند والمغرب وهولندا ومصر” للروائي المصري سعد القرش، هو الكتاب الحائز على جائزة ابن بطوطة للرحلة المعاصرة من المركز العربي للأدب الجغرافي. فيما يلي مقدمة الكتاب.
المصادفة وحدها صنعت هذا الكتاب.
عقب بعض الأسفار، كتبت فصولا عنوانها التلقائية. ولو كنت أعرف أنها ستجد طريقها لتستقر في كتاب، لأعطيتها اهتماما لائقا يتجاوز فكرة رد جميل.. إلى أماكن أو بشر شاءت المصادفة أن يكونوا رفاقا أو أصدقاء دائمين.
لست مولعا بالسفر، ليس خوفا من خطر الموت المرتبط بالحوادث؛ ففي مصر أصبحت النجاة، من موت متربص بمواطنين زائدين على حاجة النظام الحاكم، أعجوبة نفوز بها كل مساء، حين نعود إلى بيوتنا سالمين. الطرق في مصر شباك لاصطياد الأرواح بيد ملاك الموت. وقد عودت نفسي كل يوم على توقع الموت.. قبل النوم، قبل الذهاب إلى العمل، قبل الانتقال من القاهرة إلى أي مدينة أخرى، قبل السفر إلى الخارج. أستعد للموت وأنا في سلام مع النفس، ومع الآخرين، حتى الأعداء أو الذين يتصورون أنهم كذلك. لا أكره أعدائي، وإنما أستبعدهم من مجال الرؤية، كأنهم غير موجودين، لا محبة ولا كراهية.
لكنني قبيل كل سفر أتمنى إلغاءه. أشعر بالانقباض. حدث مرتين أن عدت من المطار وأنا في طريقي إلى بلد خليجي، وكنت سعيدا، لم يكن مصدر السعادة فوزا بحياة أو استبقاء لبعضها أو رهبة من الموت، لكنه إحساس غامض لا أعرف له تفسيرا. قبل ثلاثة أيام من سفري إلى الهند للمرة الثانية (2008)، اشتريت لأولادي سيارة. ظللت أستبعد فكرة اقتناء سيارة أو قيادتها، لشغفي بالنظر إلى ما حولي وأنا راكب بحرية لا تتاح لسائق. فاجأت أولادي بالسيارة، يقودها أخي أيوب. لم أخبرهم ـ حتى بعد رجوعي من نيودلهي ـ أنني شعرت بملاك الموت ينتظرني في بلاد غاندي، وأردت إعفاءهم من عناء شوارع القاهرة. في تلك المرة، أخطأني الملاك.
لا أدري هل يمثل جواز السفر وثيقة انتقال إلى دولة أخرى، أم استقبال موت ينتظر خلف الحدود. الموت نفسه لا يعرف حدودا سياسية، هو أكثر جرأة، فلماذا لا نواجهه ونكون أكثر شجاعة لكي يرتدع ويتأخر قليلا.
أول جواز سفر انتهت مدته (سبع سنوات) من دون أن أستخدمه. وقد مزقته عام 2000 حين استخرجت جواز سفر جديدا.
في عهد الجواز الأول دعيت عام 1995 لحضور مهرجان المربد في بغداد، ورفض رئيس التحرير. ومن المفارقات أن أستخرج جواز السفر الجديد تحت إلحاح دعوة ثانية إلى العراق عام 2000، ولمهرجان المربد الشعري السادس عشر (15 ـ 21 نوفمبر 2000). تضمن خطاب الدعوة أن إدارة المهرجان تذكر بأنه «بسبب الحصار الظالم المفروض على العراق تتحمل نفقات النقل من عمان إلى بغداد وبالعكس»، على أن يتحمل الضيف نفقات السفر إلى عمان. كانت حماستي كبيرة، ولاأزال أحتفظ بإيصال بثمن تذكرة الطائرة إلى الأردن (712.5 جنيه مصري/ يوم 14 ـ 11 ـ 2000). في حين سبقني أصدقاء مصريون بالطريق البري.
في بغداد التقطنا شاعر من جيلنا، نحيل بلا ظل، أجهد نفسه كثيرا في تذكر نكات مصرية قديمة ليضحكنا بها، ولازمنا في جولات اقترح أن نقوم بها، إلى معالم ومطاعم وملاجئ. لم يكن يفارقنا إلا آخر الليل، وأحيانا يبيت في غرفة أحدنا بالفندق. حدثنا عن تعرضه للسجن وشقائه وقلة حيلته وهوانه على الناس، واضطراره لبيع أثاث بيته، وأنه لا يجد حتى ثمن السيجارة، ونبادر إلى تقديم السجائر، إلى جانب دعوات إلى الطعام والشراب في أي مكان، فالغريب يملك الكثير في بلد مثل العراق في نهاية عهد صدام حسين.
ذات ليلة، وقد أثقل الشراب رؤوسنا في غرفة أحدنا بالفندق، بدا الشاعر عدميا غير مبال، وظننته حر الخيال، في حياته كما في القصيدة، وتكلمت عن غزو الكويت، فنهاني عن الخوض في هذا الأمر، قائلا بوعي شديد:
ـ لا تقل: الغزو. قل: الاستعادة.
وتساءلت ببراءة، وأنا أنحي بعض الصحف الحافلة بصور صدام:
ـ أمركم عجيب يا أخي؟ كيف تحتملون مثل الرجل؟
فانتفض من ظننته غائبا عنا، منتشيا بشراب مجاني، وقال بعربية فصحى:
ـ أرجوك، لا تقل: هذا الرجل. قل: السيد الرئيس.
فتدخل الأصدقاء المصريون مقترحين أن نتجنب الكلام عن «الزعيم المفدى»، لكن الموقف كان فاصلا بين التلقائية والرعب.
فيما بعد، وحين اختلطت المفاهيم، وحمل أحد أحياء بغداد اسم «9 نيسان» ـ تاريخ الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003 ـ عنوانا للاحتلال تحت راية التحرير الوهمي، سمعت أن هذا الشاعر ودع مرحلة بأكملها، وانضم إلى صف المنددين بدكتاتورية صدام، وازداد امتلاء، في زمن صار فيه امتلاك سيارة ضرورة شخصية وواجبا مرحليا.
أيامي في العراق كانت كابوسا. كانت صور صدام في شبابه، بنظرته الواثقة المتحدية، تطارد الناس، مواطنين وزائرين، يضطرون لإثقال جيوبهم بصوره المطبوعة على عملات ورقية توزن بالكيلوجرام. صورة الرئيس في عشرينيات عمره. ليت أحدا نصحه بأن صوره الغزيرة في تلك السن نذير شؤم، إذ تحوله إلى شخص تأكد لأهله أنه أصبح في حكم الميت أو الغائب، فأرادوا أن يحنطوا تلك اللحظة الغاربة من حياته، ويثبتوا الزمن الذي يتحرك من حولهم وهم غافلون.
في السفر أبحث عن مصر التي أحلم بها. من حق أي إنسان أن يرى بلده الأجمل. لا أبالغ إذ قلت إن مصر هي الأبهى. دائما أقول لأصدقائي من غير المصريين إن القاهرة، بصرف النظر عن أي اسم تحمله عبر العصور، خلقها الله على مهل، في هذا المكان، ثم خلق مصر بحدودها التي لم تتغير منذ عام 3100 قبل الميلاد، ثم خلق الدنيا. أقسو على مصر لأنني أغار عليها، وقسوة المحب واجبة دائما. أكاد أتشاجر مع عبد الرحمن الكواكبي (1854 ـ 1902)، وأصرخ فيه: نحن شعب طيب، راق، فمن أين يأتي الجهلاء المستبدون إلى سدة الحكم؟ أستحلفك بكل غال عشت وقتلت من أجله، أن تراجع بعض أفكارك، خصوصا ما ذكرته في كتابك (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) إذ تقول:
“وإذا سأل سائل، لماذا يبتلي الله عباده بالمستبدين؟ فأبلغ جواب مسكت هو: إن الله عادل مطلق لا يظلم أحدا، فلا يولي المستبد إلا على المستبدين. ولو نظر السائل نظرة الحكيم المدقق لوجد كل فرد من أسراء المستبدين مستبدا في نفسه، ولو قدر لجعل زوجته وعائلته وعشيرته وقومه والبشر كلهم، حتى ربه الذي خلقه تابعين لرأيه. فالمستبدون يتولاهم مستبد، والأحرار يتولاهم الأحرار، وهذا صريح معنى: كما تكونون يولى عليكم”.
لا أشغل نفسي كثيرا بتأمل غرائب الأماكن، ولا تبهرني البنايات الفخمة، إلا بقدر ما تحمل من الملامح النفسية لمن شيدوها، كأنني أراقبهم، أردد غناءهم، وأحنو عليهم فأحتمل بعض شقائهم، وأمسح عرقا يتصبب منهم، ويتشكل حجارة لها رائحة البشر. يروي محمد البخاري أنه دعا الشاعر التركي ناظم حكمت، حين زار مصر عام 1962، إلى دخول مسجد السلطان قلاوون بالقاهرة، لكنه «أمسك بيدي ليخرجني متعجلا، وهو يقول لي: معذرة يا أخي إن تركيا مليئة بمئات من هذه المساجد، والأبنية هي الأبنية في كل العالم، إن ما أريده هو أن أستمع إلى نبضات الناس، إلى كلماتهم، أن أتبين وميض بسماتهم، وهنا لمح طفلين يتهامسان إلى جنب زوجته الشقراء الروسية، فتورد وجهه وانحنى يحدثهما متوسلا أن أترجم له كل ما يقولان». (ناظم حكمت: أغنيات المنفى. ترجمة وتقديم محمد البخاري. ط 2 القاهرة 2002).
أتأمل ذلك الطفل الذي كنته، وهو يقبض على عصا يقود بها الحمار، وتتيبس يده من شدة البرد، وينفخ فيها ليدفئها، لكي يتمكن من القبض على الشقرف (المنجل) لحش البرسيم للبهائم، ويؤخره شغل الغيط عن حضور طابور المدرسة، وكيف تعلم مصادفة، من دون أن يبالي به أحد، رغم حرص أمه، التي لا تقرأ، على أن يستمر في الدراسة. أتذكره في بداية المرحلة الثانوية، وكان الحضور إلى معرض القاهرة للكتاب حلما يتحقق بجنيه واحد، وتأجل الحلم. أتأمل ذلك الطفل، وأنظر ورائي وأتنهد بعمق، كأنني عشت مئة عام، ولا أصدق أن ذلك الطفل الذي عاش حياة كالدراما، سيكون له عبر القارات أصدقاء من الأماكن والبشر.
أدب الرحلة هو فائض محبة. لم أضبط نفسي مضطرا لقول ما لا أريد. أستبق الزمن ناظرا إلى الأمام مئة عام، وأضع نفسي مكان قارئ لم يولد بعد، سيكون قاسيا في حكمه، وأتفادى أن يصفني بالكذب حين يقرأ لي شيئا عن بلد لم أحبه بقدر كاف يحملني إلى الكتابة عنه. زرت بلادا جميلة، أو تبدو كذلك، ولم تلتقط نفسي الإشارة، تلك الذبذبة الخاصة بروح المكان، وتأجلت الكتابة، إلى حين أو إلى الأبد. كما تكررت زيارتي لبلاد لم تتجاوز العين إلى قلب يجب أن يفيض بمحبتها أولا.
أكرر إذن أن هذه الفصول كتبت بتلقائية عقب كل رحلة. فكرت في إعادة كتابتها تمهيدا لنشرها في هذا الكتاب، ثم تراجعت؛ ففي إعادة النظر في الكتابة الطازجة لا تكون الرحلة هي الرحلة، ولا أنا أنا، بل شخصا آخر يكتب عن رحلة الرحلة والذات بعقل منهجي بارد، وبطبعي لا أحب البرود، في البشر أو الكتابة التي أحبها متوهجة حية نابضة بالدماء. لن أعيد كتابة الفصول، حتى لا أحذف منها الكثير، أو أنسف فكرة الكتاب أصلا، وحسبي ما ذكره العماد الأصفهاني: “إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو غُير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العِبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جُملة البشر”.