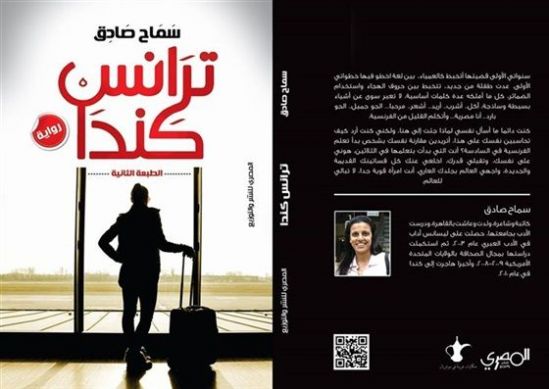أفتح عينيّ، فأجد المنبه المزعج مستمراً في الدق، وشوارع المدينة يغطيها المطر، أمطار الربيع التي تعيد الحياة لكل شيء.
“لا تأمن لامرأة ولدت في الربيع”
هكذا قلت له بالأمس، ولم يصدقني كعادته، لذلك اتخذت قراري بهجرته، فلم أعد أحتمل البقاء في هذا المكان أكثر من ذلك.
في الصباح الباكر، خرج إلى العمل كعادته. مع إغلاقه لباب البيت، قمت من سريري، وبدأت في ترتيب أشيائي للرحيل، تمر بمخيلتي قصة قرأتها ذات يوم، حول امرأة دائمة التشاجر مع زوجها، تقرر بشكل يومي تقريبا أن تهجره، ولكنها وبعد أن تقضي نهارها في إعداد حقيبتها، سرعان ما تخبئها عندما تسمعه يدير مفتاحه في الباب، وتظل على هذا الحال تدور في دائرة مفرغة[1].
ولكني لست مثلها، فلقد عشت عدة سنوات بهذا البيت، أرى في نظراته وتصرفاته توقعه لهروبي، ولم أفعل! لم يكن في نيتي الهرب أبدا. كنت أتوقع منذ يومي الأول فراقا محترما، نجلس فيه معا على مائدة متواجهين، ونتفق سويا -ربما لأول مرة في تاريخ حياتنا الزوجية- على شيء.. ألا وهو الفراق.
ولكن يبدو أن عدة سنوات كانت كافية لـ “أتأمرك[2]” واتخذ هذا القرار وحدي، بل وأنفذه حيث لا يتوقع أحد، ليكون هديتي لنفسي يوم ميلادي. فتحت الدولاب، فتذكرت أني بحاجة إلى بعض الصناديق، أحتاج أيضا إلى قهوتي الصباحية. ارتديت ملابسي، ونزلت إلى أقرب “ديبا- نار”[3]اشتريت القهوة وبعض الشيكولاتة، وفوقهما منحني الرجل عدة صناديق كرتون مطوية. حملت أشيائي، وعدت للمنزل أهرول تحت المطر.
“لأبدأ الآن.. لا وقت لدي”
فتحت الصناديق وقويتها بالشريط اللاصق العريض، ثم درت بعينيّ في كل زوايا البيت، “من أين أبدأ؟! “..
“الكتب.. كتبي هي الأهم”
مجموعة صغيرة، ولم يكن من الصعب جمعها، فهي مكومة سويًا في خزانة مع أوراقي الهامة، وبعض الاسطوانات والأدوات المكتبية. بعدها ملابسي، الكاميرا، الكمبيوتر، كل الأسلاك الخاصة بهذه الأشياء، ثم أحذيتي الصيفية والشتوية، “بشكير” صنع في مصر، ولوحة من اليابان، وإطار به صورة جماعية تضم أصدقائي المقربين – أتذكر أنني يجب أن أتصل بهم لاحقًا وأخبرهم عن هروبي.. فأضحك- وإطار آخر لصورتي مع زوجي، وتمثال نصفي لنفرتيتي.
“ماذا أيضا؟” مستحضرات التجميل، فرش الأسنان والشامبو، من يصدق أني أستطيع أن أعيش بدون زوج، ولا يمكنني الاستغناء عن هذه الأشياء البسيطة! فكرت في التخلص منها بالمرة والخروج دونها، ولكني شعرت أن شراءها من جديد سيكون مكلفًا، خصوصا في الأيام القادمة، والتي لا أعرف كيف ستكون، صعبة أم سهلة.. لقد اتخذت قراري، وانتهى الأمر.
“ماذا أيضا.. ماذااا؟” لاشئ.. هل يعقل؟ كل هذه السنوات في هذا البيت، وليس لي فيه سوى هذه الكراكيب، التي لم تملأ سوى صندوقين وشنطتي سفر؟!”
لقد تغيرت كثيرا منذ وصلت إلى هنا.. ربما لم أكن لأتغير بهذا الشكل لو تزوجت عربيا، ولكن معاشرتي لرجل غربي جعلت هناك فجوة واسعة بين ما كنته وبين ما أنا عليه الآن، وتعلمي للغة مختلفة تماما، خلق مني إنسانة جديدة، حتى أن أفكاري نفسها أصبحت بلغة مختلفة، همسي بيني وبين نفسي لم يعد عربيًا.
ليت هناك صور فوتوغرافية للعقل، لأستطيع أن أرى كم التغير الذي طرأ على أفكاري، وإن كانت صوري الجديدة تشي بالكثير، ومعظم تصرفاتي أيضا. لم أعد تلك البنت التي وصلت إلى مونتريـال تجر شنطتي سفر، تاركة وراءها كل شيء، وهي مدركة تماما احتمالية عدم عودتها إلى مصر أبدا.. شنطتا سفر ليس بهما أشيائي الحبيبة، أو حتى كل ملابسي، ليس بهما سوى ما خف وزنه وغلا ثمنه مما مضى من حياتي.
أتذكر، وكأنه اليوم، نظرات المارة المندهشة للفتاة القوية التي تجر حقيبتين تبدوان ثقيلتين جدا، صاعدة منحدر شارع “سان ديني”، متجهة إلى شارع “شيربروك”، باحثة عن “بارك سان لوي”.
لا أحد ممن استوقفتهم عرف العنوان الذي أبحث عنه، فالعنوان المفترض في شارع “برنس آرثر”، ولكنه تحول مع فرنسية المدينة إلى “بغنس آغثووغ”. وبعد أن أضعت فترة لا بأس بها، وصلت إلى باب الفندق، لتفتح لي ديان بابتسامتها الجميلة وإنجليزيتها الرقيقة، لتشعرني بأنها خالتي أو عمتي التي حللت عليها في زيارة مرتبة سابقا، فتندفع في الحديث وتصطحبني إلى غرفتي الصغيرة الجميلة ذات الذوق الراقي، المطبخ والحمام والحمام الاحتياطي، والكمبيوتر وصالة الطعام وغرفة المعيشة.. كان الفندق في الحقيقة عبارة عن بيت صغير لطيف ونظيف وحميمي للغاية، كان أول بيت أسكنه في هذه المدينة المزدوجة الشخصية، وسببًا لوقوعي في حبها. ولكنه حب ككل حب مر بحياتي، لم يقف عائقا بيني وبين الفراق يوما ما.
“سأترك الستائر.. ستائري، نعم، أنا من اخترتها وأحضرتها ولم تعجبه على أي حال، كان يعيب على لونها الوردي، فهل آخذها؟! لا.. مجرد مجهود ضائع، سأتركها هنا، علامة على مروري يوما”
كانت ستائري أول وآخر مساهمة لي في هذا البيت. بعد أن اختلفنا حولهما، أيقنت تماما عدة حقائق رسمت علاقتي معه من البداية وحتى هذه النهاية، ومنها أن ذوقنا ليس واحدًا، وأن هذا البيت ليس بيتي، وأنني لن أستطيع أن أعلق لوحة أو أفرش سجادة، وبالتالي… لن أستطيع أن أعيش هنا لفترة طويلة.. ليس لأني أهتم كثيرا لوجود هذه الأشياء، ولكن لسبب آخر أهم، هو أنني ليس لديّ حرية اقتنائها أو عدم اقتنائها طالما كنا معا! لذلك، ظل هذا البيت بحوائطه العارية وأثاثه البسيط أقرب لمخزن منه إلى بيت.
أشيائي اكتملت تقريبا، نظرة أخيرة في كل الجوانب، كدت أن أنسى قواميسي، القواميس التي جئت بها من مصر، وكنت سعيدة بفكرة أنني سأبدأ بتعلم لغة جديدة، ولم أعرف أن هذه الفكرة صعبة للغاية وستعذبني كثيرا ولسنوات، حتى أستطيع التحدث بالفرنسية، فلقد اكتشفت بعد وصولي أن مستواي في اللغتين متدني للغاية، وأنني أبدو هنا كإمرأة قروية ساذجة لا تستطيع التعبير عن نفسها.
بالتحديد في يومي الثاني، وبعد 6 ساعات من التسكع المتواصل في شارع سانت كاثرين، سعيدة بفستاني الملون القصير، لا أنوي على شيء غير مشاهدة المحلات والأسعار، كانت أهم معلومة توصلت لها في ذلك اليوم هي أنني فعلا.. من المستحيل أن أعيش هنا بدون إجادة الفرنسية. وفي الحقيقة، مهما كان قرب مونتريـال من نيويورك، أو قوة العلاقات الأمريكية – الكندية، أو استخدام جميع مدن كندا الأخرى للإنجليزية، إلا أن حظي قد رماني في “كيبيك[4]” وما أدراك ما كيبيك؟ المقاطعة الكندية الفرنسية!
في البداية، لم أدرك حتى الفرق بين كندا وأمريكا، ففي عقلي -وكما كنت أرى في الخرائط- أنهما تقريبا شيء واحد، وأنه لا فرق بين الأمريكان والكنديين، ولكني تدراكت هذا الخطأ الشائع بعد أن تفوهت به أمام أحد الكنديين، الذي رد بحساسية شديدة:
“لكن نحن لسنا أمريكيين”
كان يبدو غاضبا جدا عندما وصفته بالأمريكي، فأردت أن أخفف الموقف، فسألته:
“في ظنك ما هو الاختلاف الأكبر بين الكنديين والأمريكيين؟” أجاب بسرعة:
“نحن شعب مؤدب” ثم أضاف: “كما أن الأمريكان لديهم ثقافة السلاح، كل شخص يحمل سلاحا في بيته؛ نحن لا، نحن شعب مسالم”، الحقيقة شجعني على مجادلته، فقلت: “ولكني أشعر أنهم أكثر طموحا وشغفا بما يقومون به عن الكنديين!”
فأجاب بسرعة يدافع:
“غير صحيح. هم فقط شديدو المهارة في استعراض نقاط القوة، بمجرد أن يقوم أمريكي بفعل أي شيء جيد، يبدأ في إظهاره والاستعراض به، يعلن عنه لكي يرى كل العالم ما قام به”
صدقت على كلامه قائلة:
“لديك ألف حق.. هم فعلا أساتذة في الدعاية”
ابتسم لشعوره بانتصار وجهة نظره، وأكمل:
“كما أننا أكثر اخلاصا لجذورنا منهم، من الظلم تشبيه الشعب الكندي بالشعب الأمريكي”.
أردت أن أجيبه بأن “كلنا ولاد تسعة”، ولكني لم أعرف كيف أترجمها، فضحكت والتزمت الصمت.
كنت أتساءل دائما: التمييز والتصنيف والقومية، هل هي قيم حقًا؟ أم أمراض وفيروسات تأكل الشعوب وتقضي عليها، تجعلها تتقاتل حتى يفني بعضها البعض؟.. فهذا الكندي المعتز بوطنه، يقابله كندي آخر يعتز بانتمائه لـ “كيبيك”، ويصف انفصالها عن كندا بالتحرر. هناك كندي لا يرى نفسه كنديا، ولكن ذو هوية أخرى، تعود بجذورها إلى فرنسا، ففي مونتريـال حرب حضارية تدور رحاها منذ عقود طويلة بين أصحاب الثقافة الفرنسية “الفرانكوفون” وأصحاب الثقافة الإنجليزية “الأنجلوفون”، ورغم انتهاء حرب السنوات السبع فعليا عام 1763 بانتصار الإنجليز، وتنازل فرنسا عن مستعمراتها في أمريكا الشمالية لهم، إلا أن هذه الحرب، رغم مرور قرنين من الزمان، لا زالت مستعرة، فحتى اليوم تقف “جبهة تحرير كيبيك الانفصالية” كما يحبون تسمية أنفسهم، إلى جانب فكرة الانفصال عن كندا، ولا تتوقف محاولاتهم عن تحقيقها، بل والمدهش أن حوالي نصف من يعيشون في هذه المنطقة من العالم مؤيدين لفكرة الانفصال والتمسك بالثقافة الفرنسية، وهذا ما أثبتته الاستفتاءات التي قاموا بها عامي 80 و95.
عندما أدركت سيطرة الثقافة الفرنسية على المدينة، فكرت في حصيلتي من اللغة الفرنسية، ووجدت أنها كلمة واحدة فقط….!!!!!
Bonjour
في صباحي الثاني في مونتريـال، تعلمت أن أقول صباح الخير على الطريقة الفرنسية أو المونتريـالية، الراء خفيفة وأقرب الي الغين “بونجوغ”، فالفرنسية لغة مختلفة تماما عن الانجليزية، فالإنجليزية لغة حروف قد تسمح لك أحيانا أن تنطقها على طريقتك الخاصة، فيظهر لك ما يسمى بـ “الأكسنت” أو اللكنة، ولكنك ستكون مفهوما على أي حال، أما الفرنسية فلغة مقاطع صوتية، وإما أن تقولها كما هي، أو لن تستطيع نطق كلماتها أبدا، وإن نطقت بشكل خاطئ فلن تكون مفهوما من الأساس، وبالطبع فوق كل هذا سيبقى “الأكسنت”.
تبادلت الحديث مع “ديان” حول مصر وكندا والعديد من الأشياء، واندهشت كثيرا لمعرفة المرأة بأحوال مصر وزيارتها لها، ولكن سرعان ما زالت دهشتي عندما قابلت زوجها الشاب المصري “هاني”.
شعرت في البداية مع ديان وزوجها أنه من السهل للغاية الحصول على أصدقاء في مونتريـال، ولكني كنت واهمة، فقد عذبني الكيبكوا[5] المتشددين لدرجة التطرف بخصوص لغتهم، وعذبتني دروس اللغة الفرنسية، وعذبني البرد، ولكني كنت أكرر لنفسي دائما “أن أصعب مشكلة تواجهني هنا أسهل كثيرا من ركوب ميكروباص في مصر”
ماهذه الأفكار، وما هذا الهدوء الذي حل بي؟ لماذا لا أبدو كامرأة هاربة من زوجها؟ من أين جاءني كل هذا البرود؟! أنا حتى غير قلقة لعودته قبل أن أنتهي، وأعرف أنني سأرحل على أي حال، حتى لو لم أكن أعرف إلى أين أذهب، وما الذي سأفعله، وماذا سأقول لأصدقائي. كل هذا غير مهم، وكأن من كانت تهتم في السابق هي شخص غيري!
أنزلت الصندوقين الثقيليين -بسبب الكتب- أولا، ثم أتبعتهما بالشنط. وضعت كل شيء في شنطة السيارة، ونظرت لها بامتنان، فالسيارة هي بيتي الآن، هي كل ما بقي لي من هذه العلاقة. أظن أنه كان يعرف جيدا ما الذي سيحدث في النهاية، لذلك اقترح أن تكون السيارة ملكي. ربما لأنه كان يرتب في وقت الفراق أن يأخذ البيت ويترك لي السيارة. لم أستطع أبدا أن أتعامل مع حقيقة حسابه الدقيق لكل شيء، ولكن بدا أن هذا هو أسلوب الحياة في الغرب، وليس مجرد طبع من طباع زوجي التي لا تتغير.
طبقا للقوانين الكندية، يجب أن يتم اتفاق مادي بين الزوجين قبل الطلاق، يضمن لكل واحد منهما حقه في حياة كريمة بعد الفراق، كل شيء يملكه الاثنان، يتم تقسيمه أو التراضي بينهما عليه، أو يترك الفصل فيه للمحكمة، بحيث تعطي لكل ذي حق حقه، وهذا أحد أسباب هروب الكثير من الزوجات والأزواج في كندا، فالبعض يريد الاحتفاظ بمدخراته، والبدء بحياة جديدة دون أن يدخل في مشاكل الطلاق المكلفة على كل المستويات، بل إن هذا هو أحد أسباب قلة الزواج هنا، حتى أن بعض الاحصائيات قد اشارت أن نسبة كبيرة من الأطفال في كيبيك هم نتاج علاقات غير مقيدة كزيجات.
أغلقت السيارة وصعدت إلى البيت مرة أخرى، ألقيت نظرة أخيرة على كل شيء، فاكتشفت أني نسيت سماعات الكمبيوتر الخاصة بي، وربما أحتاج أيضا إلى بعض الملاءات والأغطية، أخذت واحدة من كل نوع، تفاحة، وزجاجة ماء.
وأغلقت هذا الباب ورائي للمرة الأخيرة.
بهذه البساطة!!
جلست في السيارة أفكر “أين أذهب؟” فجأة خطر ببالي أبعد مكان في كندا.. أخرجت “الجي بي إس[6]” وكتبت “وسط البلد – فانكوفر[7]“. بعد أن حسب حسبته، أخبرني الجهاز أن رحلتي ستمتد ليومين وساعتين وعدة دقائق من القيادة المتواصلة على “ترانس كندا”[8]، وأن هناك طرقا أخرى أقصر ولكنها ستمر بالحدود الأمريكية، فاخترت “ترانس كندا”.
[1] قصة “روتين ” من مجموعة “انطباعات مجمدة وطوارئ ” للكاتبة / دنيا ماهر
[2] كلمة شائعة بمعنى يتشبع بالثقافة الأمريكية
[3] كلمة فرنسية كندية تعني محلات البقالة الصغيرة التي تفتح لأوقات متأخرة، وتبيع القهوة وتذاكر االلوتو والسجائر والجرائد وبعض الأطعمة السريعة
[4] كيبيك: أكبر المقاطعات الكندية من حيث المساحة، عرفت عند اكتشافها بـ فرنسا الجديدة، ولا زالت تتمسك بثقافتها الفرنسية، وتعتبر اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية لها، وبها حركة كبيرة تدعو للانفصال عن كندا وتكوين دولة منفصلة.
[5] النطق الفرنسي لكلمة الكيبيكين، وهم سكان مفاطعة كيبيك
[6] جهازالكتروني به خرائط للعالم كله، وظيفته توضيح الأماكن والمسارات خلال القيادة أو السير
[7] مدينة شهيرة بمقاطعة بريتش كولومبيا أو كولومبيا البريطانية وهي في أقصى الجنوب الغربي لكندا
[8] TransCanadaهو اسم مجموعة الطرق السريعة (هاي واي،اوتوروت) التي تربط كل المدن الكندية