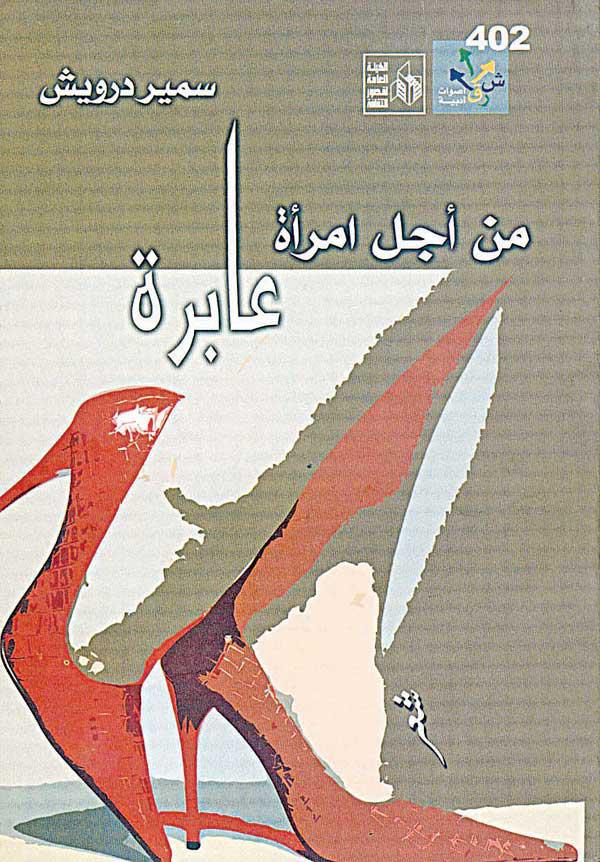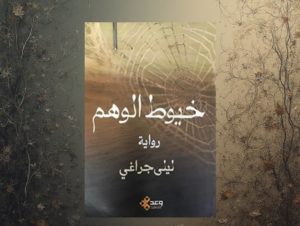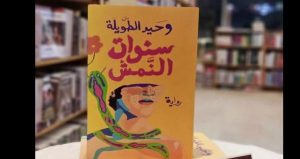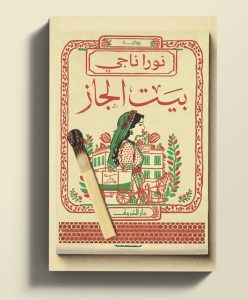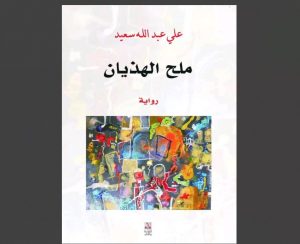د.محمد السيد اسماعيل
الانشغال بمقولة الجسد -عند سمير درويش- انشغال حقيقى ومتميز ليس فى هذا الديوان فحسب بل فى العديد من الدواوين السابقة واللاحقة، الأمر الذى يدفعنا إلى ضرورة التعامل مع هذه المقولة بوصفها مدخلًا أساسيًّا لعالمه الشعرى. وارتباط الجسد بالإبداع سمة مستقرة فى الوعى العربي والإنساني، فكثيرًا ما حدث التماهي بين الجسد الانثوي والقصيدة، وبين متعة الإبداع ومتعة التواصل الحسي، ولعل أشهر شاهد على ذلك قول أبى تمام: “والشعر فرج ليست خصيصته/ طول الليالي إلا لمفترعه”، وكثيرًا ما دار الحديث حول المعاني البكر وفحولة الشعراء وصولًا إلى “لذة النص” عند رولان بارت حديثًا.
ورغم هذا ينبغى التفريق بين الجسد خارج النص والجسد الذى يصنعه النص، فالجسد -فى الواقع- جسد عضوي/ اجتماعي، أما داخل النص فهو جسد لغوي/ متخيل وإن كان هذا لا يعني انفصاله عن الجسد الحقيقي. وما دام الجسد في النص جسدًا لغويًّا فإن تعاملنا معه لا بد أن يستفيد من السيمياء أو علم العلامات الذى يتجاوز اللغة، واللافت أن تراثنا النقدي قد عرف هذا التوسع فى فهم العلامة حين يقول الجاحظ مثلًا فى تعريف البلاغة: إنها كل ما أوصلك إلى المعنى. يستوى فى ذلك الدال اللغوى واللون وإيماءة الوجه وحركة اليدين وشكل الثياب ورشاقة الجسد أو ترهله، وهذا كله يستثمره الشاعر المبدع سمير درويش فى ديوانه بصورة إبداعية لافتة.
الجسد هو المدخل الرئيسي الذي نرى من خلاله العالم، نرى: الحياة والموت، القدرة والعجز، جذوة الشهوة وانطفاءها. وهذا ما يجعلنى أقول إن سمير درويش قد عبر من الجسد إلى الكينونة، أو جعل الجسد مرادفًا لكينونة الإنسان وحقيقته، بعد أن ظل هذا الجسد مرادفًا للأرضى وكل ما هو أدنى وأقل سموًا، باعتباره -فقط- غلاف الروح السامية وحامل العقل الهادي، يقول زهير: “وما المرء إلا عقله ولسانه/ فلم تبق إلا صورة اللحم والدم”.
سمير درويش يعيد الاعتبار لهذا اللحم والدم تأثرًا بالفلسفة الحديثة وبنيتشه تحديدًا حين يقول: “لا أحب من الكتابات كلها إلا تلك المغموسة بالدم”، أو: “كل الحقائق هى بالنسبة لى حقائق الدم”. وعبارة “الدم روح” تسقط ثنائية الجسد والروح التى ظلت مسيطرة على العصور القديمة والوسيطة، ووجد الكثير من تجلياتها في الأدب الرومانسي، كما تسقط ثنائية الحسي والعقلي، وهكذا تتداخل الإدراكات الإنسانية الثلاثة: الحسي والعقلي والروحي التى درجنا على تمايزها، وصولًا إلى الكينونة الجامعة لهذه الإدراكات كلها. ونيتشة هو القائل بمركزة الجسد على أنقاض مركزة الفكر عند ديكارت طبقًا لشعاره الشهير: “انا أفكر إذن أنا موجود”، وعمومًا فإن “الفلسفة المعاصرة هى التى حاولت أن تفلت من قبضة الحداثة، فاعتبرت -وبجرأة نادرة- “أن النفس ليست إلَّا جزءًا من الجسد” (د.علي حرب نقلًا عن “الجسد والسلطة”، أمينة ماسك عبد الله، مجلة القاهرة ص17، العدد 128، يوليو 1993).
***
فى ديوان “من أجل امرأة عابرة” لا نجد هذه الحمولات الأسطورية أو الرمزية التى نجدها فى الأدب الحديث شعرًا وسردًا، أو الصور النمطية للمرأة التى نجدها فى الشعر القديم. فى هذه الحالات كلها -قديمًا وحديثًا- يبدو الجسد علامة على بعد آخر أسطوري أو رمزي أو اجتماعي. لكننا هنا مع سمير درويش نواجه الجسد الفرد المتعين المعروف بالاسم أحيانًا. حتى صيغة التنكير التي جاءت فى العنوان تأتي موصوفة مما يقربها من صيغة المعرفة.
وتأكيدا لهذا التعيين تأتي عناوين القصائد التي يغلب عليها أسماء أماكن محددة: رأس البر، الأقصر، ميدان التحرير. والحق أن الأماكن تأخذ -على مدار الديوان- تنويعات كثيرة طبقًا لصفات الثبات والحركة والإقامة والانطلاق والاتساع والضيق، ومن المعروف أن اختيار المكان ليس عملًا مجانيًّا لكنه مشحون بالدلالة، ولنتخذ نموذجًا لذلك قصيدة “البدروم” بضيقه ومستواه الأدنى من مستوى الأرض وشباكيه الموازيين لحركة أحذية السائرين، والقصيدة مهداة إلى أمل دنقل مما يعطي هذه الصفات دلالات تتجاوز واقعها إلى أبعاد اجتماعية وسياسية، باعتبار أمل دنقل أمير شعراء الرفض كما أطلق عليه.
تبدأ القصيدة هكذا: “تقوسوا/ تقوسوا/ تلك رسالتى” (من أجل امرأة عابرة، سمير درويش ص43، الهيئة العامة لقصور الثقافة 2009). هذه الدعوة إلى التقوس تذكرنا بدعوة دنقل الساخرة إلى الانحناء فى قصيدة “كلمات سبرتاكوس الاخيرة”، لكن أزمة القصيدة عند أمل ترجع إلى الانفصال بين عالم السادة القاهر وعالم العبيد المقهور، هذه الأزمة التي تبدو -وهى ليست كذلك- حقيقة قدرية تكررها دورات التاريخ دائمًا، بينما أزمة القصيدة عند سمير درويش اجتماعية تحمل سمات وجودية دالة على العبث واللاجدوى والاغتراب:
“سأصعد إلى الدور العلوي الآن
أعد فنجان قهوة ثقيلة
بملعقة سكر واحدة فقط
لأن كوب الشاى فارغ
ولأن إيقاعات الأحذية أرهقتنى
ولأن عينىَّ تعبتا من ألعاب الكمبيوتر
والتحديق فى الفراغ”.
وهى أفعال اعتيادية يومية متكررة لا رغبة فى شيء ولا دوافع حقيقية وراء حركة الذات، فهي تصعد لتعد فنجان قهوة لا لشيء إلا لأن كوب الشاى فارغ، والفراغ كما يوحى التكرار هو السمة المهيمنة، فراغ الأشياء وفراغ الحياة. ووسط كل هذا تنتظر الذات شخصًا مختلفًا -هل هو أمل دنقل؟- شخصًا يبدو على النقيض، يتمرد على عوامل الاستلاب والفراغ، حيث: “يسطح صفحة وجهه/ يحاول ألا ينظر للشاشة/ بطريقة مباشرة”.
عند هذا الإحساس تظهر صورة سيزيف، أو يظهر امتداده المعاصر: “هل أحمل الصخرة إلى قمة الجبل/ أعادي الاتجاه الطبيعي للحياة؟”.
قصيدة “البدروم” نص ثقافى -وهى سمة غالبة على أغلب القصائد- بمعنى أنه يستدعى غيره، ليس بصيغة التناص القديمة، بل بفعل المثاقفة. ما يطرحه الشاعر هو صورة الرق المعاصر، رق الضرورات الحياتية التى تحاصر الإنسان المعاصر، ولأن التشييء يعد سمة الحياة المعاصرة، تتبع حركة الأحذية -وليس الأقدام- التي تحدد كل شيء: القوة والضعف، الثورة والحكمة، الشباب والشيخوخة. وعند هذه المرحلة من تطور القصيدة يصبح تحاور الجسد مع المهملات وتآلفه مع الأسقف الواطئة متوقعًا وطبيعيًّا، وتصبح أمنية الشاعر هى أن يرى الوجوه التى لا تميز الأحذية بينها.
إن ما سبق يطرح ذلك الحضور المراقب للآخرين، والذى يمارس على حركة الذات فى علاقاتها الخاصة كما يبدو فى “العيون المختبئة خلف خصاص الشبابيك”. والحقيقة أن الآخرين لا يأخذون دائمًا صفة الحصار أو التلصص، ففى قصيدة “الطريق السريع” نجد تنوُّعًا لافتًا يجمع أنماطًا مختلفة من الآخرين، والتى يبدو فيها تلك العلاقات الجدلية بين الأنا والآخر سلبًا وايجابًا وحضورًا وغيابًا، ولنتأمل -فقط- المقطع 13 من هذه القصيدة:
“قبل نحو ساعة كانوا هنا
غرسوا شمعة وسط تورتة صغيرة
أطفأوا الأنوار
وساروا على أطراف أصابعهم
/../
وضعوا على ملامحهم بهجة مألوفة
ولصقوا قُبَلَهُم على خديَّ وشفتيَّ
ولكنني كنت هناك
حيث ثوبك الكاكاوي من القطيفة
الذي التصق بي
فى المقعد الخلفي” (ص78)
يمكن تفسير السطور السابقة على أكثر من مستوى: مستوى المسافة المكانية والمسافة الوجدانية التى تبدو فى مشاعر الذات نحو هذه الأنثى البعيدة، وانفصالها عمن يحيطون بها، ومن المهم تأمل طبيعة الفعلين “وضعوا” و”لصقوا” اللذين يوحيان بالتكلف وافتقاد الحميمية، وهي الدلالات نفسها التى تؤكدها الضمائر المستخدمة: ضمير الغائب فى الحديث عن الآخرين، وضمير المخاطب الذي يوحي بالقرب الوجداني من هذه الانثى البعيدة مكانيًّا فقط.
***
ذكرت أن الجسد هو المدخل الرئيسي لهذا الديوان بمفهومه الذي يعبر عن الكينونة، بحيث يغدو أى حديث عن تمايز الجسد والروح منتميًا إلى الماضي: “تتململين كأنما تقرئين من كتاب تراثى/ تتحدثين وعيناك نصف مقفولتين/ عن عشق الجسد الذى يفنى/ وعشق الروح الخالد”. وفي شواهد أخرى يتداخل التواصل الحسي وفعل الكتابة، ويتبادل النص والنثر موقعيهما، وامتدادًا لهذا الوعي الحسي نجد الكثير من الكنايات والاستعارات التي تمزج بين الطبيعة والمرأة، ويصبح الموت نفسه دافعًا للتواصل الحسي، المرادف بدوره للحياة، فموت الأخت نجده حافزًا للرغبة الشبقية فى قصيدة “استشفاء”.
يبقى أن أشير إلى إحدى الظواهر اللافتة، وهى تضمين نصوص مختلفة داخل القصائد، من قبيل: الأغنيات العامية والنصوص المترجمة وأبيات الشعر الفصيح، ووضع بعضها فى سياقات مناقضة لدلالتها الأولى، مما يصنع تحاورًا فنيًّا بين الدلالة الأولى والمكتسبة.
وأخيرًا فإن هذا الديوان للشاعر المبدع سمير درويش يدل على وعى شديد بطبيعة الكتابة الشعرية التى يتداخل فيها الجمالي والثقافي في صيغة فنية متميزة.