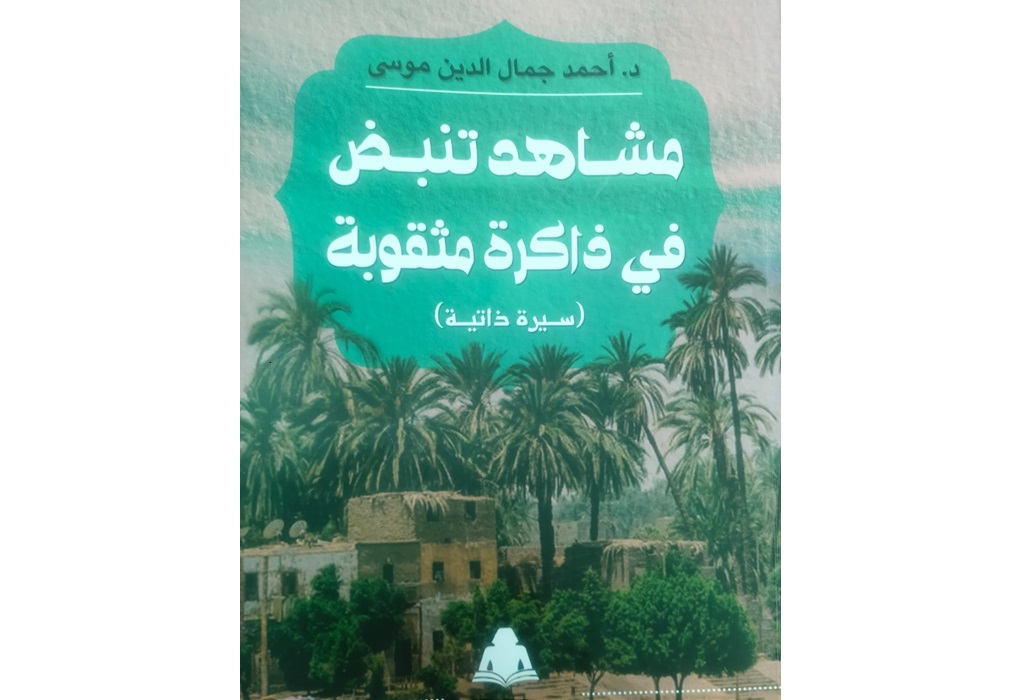محمد الكفراوي
كتابة السيرة الذاتية لا شك تواجه تحديات عدة، فهل تكون كتابة انتقائية نوعية؟ أم كتابة توثيقية منظمة ومرتبة؟ أم كتابة صريحة مباشرة أقرب لأدب الاعتراف أو الكتابة التطهرية؟
في حالة المذكرات التي بين أيدينا يبدو أننا أمام الخيار التوثيقي المرتب المنظم الذي يحشد التفصيل بجوار بعضها البعض ليخلق حالة من الزخم البشري تكاد تضع القارئ في مكان وزمان الراوي نفسه.
يقدم لنا الدكتور أحمد جمال الدين موسى في مذكراته الصادرة حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب تحت هذا العنوان “مشاهد تنبض في ذاكرة مثقوبة” قطعة من جسد مصر، ممثلة في تاريخ طويل وأحداث عدة يقترب منها ويعايشها ويختبرها ويراها رؤية العين وينقلها لنا محملة بمشاعر وأحساسيس زمنها.
منذ بداية السيرة الذاتية استوقفني الوصف المبدئي لمشهد يكاد يكون فانتازياً، فالكاتب لا يريد أن يبدأ من وقت وعيه الفعلي، بل يتخيل أنه رأى حفل زفاف والديه، ويصف الحفل بالتفاصيل الدقيقة، وهو ما أعتبره وفق معايير الكتابة الشائقة براعة في الاستهلال.
وإن كان الأمر يتكشف بعد ذلك ليدرك القارئ أن الكاتب يصف حدثا عاشه بالفعل حين أقام جده احتفالية لزيارة أحد مشايخ الطرق الصوفية لقريتهم.
في الفصل الأول من المذكرات يصف الكاتب القرية، بكل تفاصيلها الدقيقة، ببيوتها الطينية، والأحواش والأراضي والأجران ومستلزمات الزراعة والحيوانات، هل يريد أن يدخل القارئ في أجواء القرية بهذه التفاصيل؟ في تصوري أن هذا ليس الهدف بالضبط من الوصف الدقيق المسهب الطويل لكل تفصيلة صغيرة كانت أم كبيرة في القرية، أتصور أنه يفعل ذلك ليحفر حفرة عميقة في الأرض يضع فيها أساس الحكاية، إنه يصنع أرضية أصيلة موغلة في العمق والقدم، محتشدة بالتفاصيل الصغيرة الكثيرة، يمهد الأرض ليبني الحكاية أو يسردها على أساس متين أصيل حميم.
تبرز في الفصل الأول ملامح العصامية التي يبدأ بها الطفل أحمد جمال الدين موسى حياته مساعدا لوالده في محل البقالة وفي الوقت نفسه ساعيا لبناء تجارته الخاصة بالتوافق مع أبيه.
بعد ذلك يتطور الأمر حين يذهب الطفل إلى المدسة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية ليفاجأ بمجتمع آخر وعالم مختلف هو عالم منظمة الشباب الذي انضم إليه، وأصبح عضوا فاعلا فيه، فهذه المنظمة التي ربّت أشبال الاتحاد الاشتراكي في ستينات القرن الماضي كانت في ذهن الكثيرين مجرد كلام في كتب التاريخ، إلا أنها هنا تتجسد على أرض الواقع بفعالياتها وتفاصيلها وأهدافها وأعضائها.
الغريب أن الشاب حين انتقل من بلدته إلى المدرسة الثانوية في السنبلاوين، ظل محتفظا أيضا بالتفاصيل الصغيرة، من بينها أسماء سائقي سيارات الأجرة الثلاثة الذين يعملون على هذا الخط بين بلدته “المقاطعة” ومدينة السنبلاوين، لقد ذكرهم بالاسم وكأنه يمنحهم هدية امتنان سرية لما قدموه له من خدمات بتوصيل عامود الطعام من أهله إليه في منتصف الأسبوع.
الأحداث السياسية الكبرى التي عايشها الشاب أحمد جمال الدين في غاية الثراء، وتقدم صورة حية من لحم ودم لأحداث سمعنا عنها ولم نشاهدها أو نختبرها عن قرب، هزيمة 67 ، تنحي عبد الناصر، فنجد نصا مفعما بالمشاعر يقول “كابدت إحساسا طاغيا بالعجز والخواء، بقيت ساعات طويلة وحيدا في حجرتي، أبحلق في الظلام وأمتنع عن تناول الطعام، أعاني ثقلا خانقا يجثم على صدري ويشل تفكيري”.
وهناك أيضا المشهد المهيب لجنازة عبد الناصر، وإصرار الكاتب وأقاربه على حضور الجنازة التي تقريبا احتشدت فيها مصر كلها.
ينتقل السرد تباعا إلى حركة الطلبة في السبعينات، الحركة التي استهدفت الضغط على الحكومة لمحاربة إسرائيل واسترداد الأرض من اللصوص والرعاع، بحسب ما وصفهم السادات في رسالة ذكية مبطنة حين سأله كيسنجر منذ متى وسيناء مصرية، فأجابه السادات سأرسل لك صورة من رسالة مكتوبة على ورقة بردي أرسلها جندي لزوجته يخبرها أنه في العريش حيث يحمي حدود الوطن من اللصوص والرعاع.
الحركة الطلابية في السبعينات والنشاط المميز لأحمد عبد الله رزة وأحمد بهاء الدين شعبان وغيرهما من قيادات حركة الطلبة، وصولا إلى قرار العبور وانتصار أكتوبر، وما كابده الجندي المقاتل أو ضابط الاحتياط أحمد جمال الدين على الجبهة، كل ذلك ينفذ من غربال الحكايات الذي يعده الكاتب ويحركه ببراعة.
التفاصيل الصغيرة والدقيقة هي سر الجمال الكامن في هذا العمل، فرغم المشاهد المأساوية على الجبهة لا نعدم أن نقرأ مشاهد إنسانية بين الجنود، ووصفاً دقيقاً لساحة المعركة ومسارات الحرب، وكشف مهم لكيفية تكوّن ثغرة الدفرسوار وقرار وقف إطلاق النار.
الكثير من التفاصيل المشحونة في الذاكرة تكاد تضعنا أمام مخاتلة في العنوان، فالذاكرة ليست مثقوبة كما يبدو وإنما تنز بالتفاصيل والحكايات البسيطة والحميمة التي تمنح تلك السيرة طابعا مميزا يجعلها كأنها تضع أمامنا قطعة نابضة من جسد مصر ممثل في أحد أبنائها الذين اجتهدوا حتى وصلوا إلى ما تمنوه من تحصيل أكاديمي وعلمي حتى سافر إلى باريس ليجد نفسه محميا من الصدمة الحضارية بقراءات سابقة عن هذا العالم الجديد.
وتكاد تكون القراءة والإبداع ملجأ للكاتب في أوقات كثيرة كما يقول، وربما تكون علاقة الصداقة التي جمعته بعدد من الكتاب من بينهم منصور مكاوي وأحمد صبري أبو الفتوح وغيرهما من العلامات المهمة التي شكلت جزءا من هاجسه الإبداعي، كما أن الكتب التي يذكرها كل عام كحصيلة قرائية تشير أيضا إلى الشغف بهذا العالم المدهش، عالم الإبداع، الذي ربما انشغل عنه بالتحقق في الحياة العملية والأكاديمية لفترة، إلا أن هذا العالم ظل كامنا في ضميره كجزء أصيل من مكوناته الشخصية.