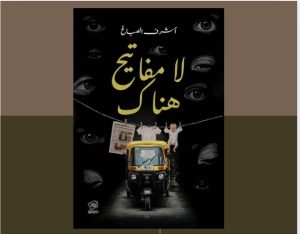ما يقدمه لنا مصطفى ذكري في (مرآة 202) هو كتاب نصفه الأول عبارة عن قصص قصيرة أما النصف الثاني فعبارة عن قصتين طويلتين. الطريف أن القصتين الطويلتين ما هما إلا تجميع حاذق للقصص القصيرة في النصف الأول, و تضمينهما في نصين طويلين. هو الانعكاس غير الملتزم للمرآة, التي تقع – افتراضاً- في منتصف الكتاب. لم يتعلم مصطفى ذكري هذه التقنية الآن, بل ربما منذ كتابه الأول (هراء متاهة قوطية) و الذي كان في أجزاء كثير منه تجميعاً لومضات و نصوص قصيرة من مجموعته و كتابه الأول (تدريبات على الجملة الاعتراضية), فهل كان الكتابان الأولان جانبين لمرآة تمر بينهما كحد السيف؟ يدرك الراوي في (مرآة 202), و أعتقد أن مصطفى ذكري يوافقه في هذا, أنه رجل البدايات الأول. يقول الراوي في أول (مرآة 202): (لطالما قطعت البدايات بعزم و أمل مهملاً تنظيم الطاقة التي تنفد بعد وقت قصير). هذا سطح واحد من المرآة, أما السطح الآخر, الذي يجيء في نهاية الكتاب فيقول فيه الرواي متناولاً نفس المشكلة التي تناولها في النصف الأول من الكتاب(عدم تمكنه من إكمال عملية نقل أرقام أجندة تليفونات قديمة إلى أجندة أخرى حديثة). يقول الراوي: (يقولون عني أنني منجز بدايات عظيم. آه بدايات فقط). هذه البدايات, الومضات أو القصص التي يبرع في صياغتها مصطفى ذكري إلى هذا الحد, هي ما تغريه بتجميعها في نصوص طويلة. أي تغريه بكتابة نص عبارة عن بدايات فقط, و لا يتواصل ابداً. من هنا تأتي حيوية النص الفائقة و انفتاحه الدائم. و من هنا أيضاً يأتي التشظي الفاتن له. ليس هذا فقط, بل تأتي كذلك إشكالية عدم الجزم إن كان من داخل المرآة هو الحقيقة أم الانعكاس. هل يجوز القول مثلاً أن النص الطويل في منتصف الكتاب الثاني هو عبارة عن تجميع للقصص القصيرة في النصف الأول أم القول أن القصص القصيرة في النصف الأول هي مقتطفات من القصة الطويلة في النصف الثاني. ليس هناك من يقين بأي الجانبين هو “الأصل” و أيهما هو “الانعكاس”. نرى الرواي في قصة قصيرة و في مشهد متضمن في القصة الطويلة يتفحص إحدى كتفيه فيجد الكتف اليمنى أعلى قليلاً من الكتف اليسرى. و لأجل مواجهة هذه المشكلة يقرر رفع اليسرى قليلاً فيجدها قد صارت أعلى من اليمنى. من هنا يستخلص استنتاجه “أنني في اللحظة التي فكرت فيها برفع الكتف اليسرى لتستوي مع الكتف اليمنى كانت الكتفان مستويتين متزنتين”. ليس هناك من أصل ثابت, فالأصل يتراوح موقعه بين الطرفين, من بداخل المرآة و من بخارجها, بسهولة و نعومة. هكذا يثأر مصطفى ذكري للحلم من الواقع, عبر سؤال بسيط “ما الفرق في أن يطمس النسيان حلماً واقعيا أو حلماً؟” فالزمن يمحو دون تميز صفات الواقع والحلم, يمحو منطقية و صلابة الواقع , كما يمحو كثافة و تشويش الحلم. عبر هذا ينتقل ثقل الكتابة في أحيان كثيرة كذلك إلى الأحلام, و إلى حلم مصطفى ذكري المفضل: الأسطورة الشعبية عن العفاريت ذوات سيقان الماعز و الرجل الذي يفر منها فلما يجد رجلاً آخر يحدثه عن المكان المسكون بالعفاريت و كونه عرفهم من سيقانهم المشعرة كسيقان الماعز.. و عندئذ يرفع الآخر جلبابه عن ساقيه المشعرة كساقي المعيز و يقول له.. مثل هذه؟ هنا, و ثانية, تعاودنا المرآة. فكأن الرجل الجاري من العفاريت هو سطح المرآة و كأن العفاريت ذوي سيقان الماعز هم جانب المرآة و كأن الرجل الذي كشف عن ساقيه التين تشابهان ساقي الماعز هو الجانب الآخر من المرآة. و ليس هناك فارق بين من داخل المرآة و من خارجها, فالكل عفاريت. ليس هناك من فارق بينهما سوى في الوعي السابق بأن ثم جانباً أصلياً (بشرياً) و الآخر انعكاساً (عفاريت), هذا الوعي الذي تكذبه المرآة بكل شراستها, حيث ينتقل ثقل الواقع إلى الحلم كما تنتقل هشاشة (تكثيف و تشويش) الحلم إلى الواقع.
ليس هذا هو السبب الوحيد فقط لإعجاب مصطفى ذكري بهذه القصة الشعبية, فالأسطورة تكشف عن تصور بديع في الثقافة الشعبية و في التخيل الشعبي لعالم الجن و العفريت. إذ ما أن يكشف الرجل عن ساقيه المشعرتين حتى يفر الآخر هارباً فيطلق العفريت المتنكر ضحكاته الجنونية الساخرة من عجز البشر و ضعفهم. أي أن العفريت لم يؤذ الإنسان. أخافه فقط. هذا هو الخوف الذي ينقله مصطفى ذكري بحرفية عالية. فلا أذى مادياً قد تحقق هنا ولا أذى مادياً قد تحقق من مدام نانا في رواية (الخوف يأكل الروح) إذ كانت تحتفظ في بيتها بالراوي و تمارس عليه كل قدراتها الشبحية و افتتانها الملغز بالفن, الافتتان الذي يقرب حد قتل زوجها لكي تحاكي فيلما سينمائياً (اي تنقل ثقل الفن إلى الواقع.. أي تمحي التمييز بين من بداخل المرآة و من بخارجها). ليس في قصص مصطفى ذكري عنف أو أن العنف لايقع على الرواة أبداً. ما يقع عليهم هو شعورهم المقبض بأنهم ملك لأشباح و أنه ليس لهذه الأشباح من مهمة سوى إخافتهم و تعذيبهم بغموضها و بغيريتها و ببرودها, بإشعارهم بأنهم قد وقعوا في عالم كامنة فيه احتمالات بلا عدد. الكمون هو الرعب, حيث لا احتمال واحد من هذه الاحتمالات يتحقق. فقط يظل الخوف مفتوحاً بلا مسبب مادي أمام أعيننا .. مثلما أن الأب يؤدي عبارة واحدة (هيه.. كدا.. يا دنيا). يقول العبارة الحزينة و المرهقة بنشاط و حيوية و هو يعد واجباته الصباحية. أي: بمعزل عن الأسباب الكئيبة التي دفعته لقولها قديماً و لاتخاذها لازمة له. و هذا يدفع لأم لتردد العبارة بعد رحيل الأب, أي بعد رحيل مسبب العبارة و قائلها كذلك. فلا يتبقى إلا أثر الأثر. أثر و لمسات العالم الغريب الذي جاءت منه شخصيات مصطفى ذكري و الذي ستذهب إليه. و ما بين طرفي المرآة, العالمين الغريبين, عالم الأصل و عالم المآل, تقع الشخصيات. تواجه رعبها في عالمها الذي هو دائماً بين بين.