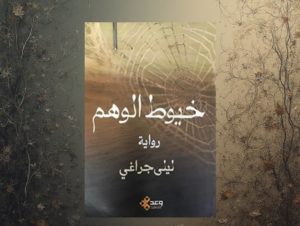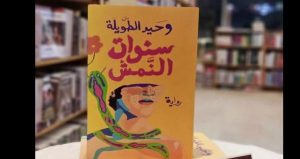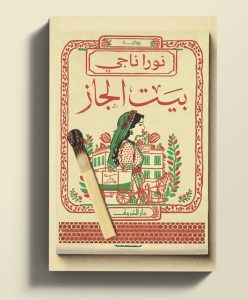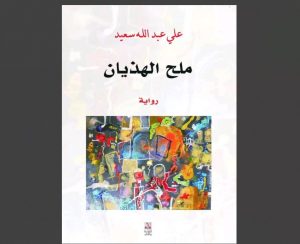عاطف عبد العزيز
لا بد أن أكونَ خوان ميرو
لتكونَ امرأتي خطوطًا متعرجةً وبقعَ لونٍ
وقلوبًا، ونجومًا، وكراتٍ صغيرةً هائمةً،
وأطفالًا،
وطيورًا متمردةً على دوائرها الأزلية،
ودمًا يلطخ الساقين في الليلة الأولى!
…
لا بد أن أكونَه:
لتنمحي المسافةُ بين عقلي
(الذي لستُ متأكدًا من مكانه بالتحديد(
والكائناتِ التي تطير في الحلم اليوميِّ
ترتدي ريشًا بالألوان الأساسيةِ
وتفرزُ مطرًا أزرقَ ببقعٍ صفراءَ
وتمطرُ موسيقى الرحبانيةِ
وقصائدَ عشقٍ لم أكتبها بعد!
هل يمكننا الدخولُ من هذا الممر الضيق إلى عالم ديوان (الرصيف الذي يحاذي البحر)؟! هل يمكن أن ننتظر سمير درويش حيثما شاء لنا انتظارَه، أي على رصيف خوان ميرو؟!
شيء كبير من ذلك يبدو صحيحًا، إذا ما رصدنا تلك المسافةَ التي تزحزحتْ فيها حساسيةُ سمير درويش في ديوانه هذا عن موضعها السابق، فخوان ميرو يترك لنا تراثًا معتبرًا كواحد من التجريديين الخُلَّص، يعضد هذا أنه أحدُ الموقعين علي بيان السوريالية الشهير في القرن الماضي.
ينزع شاعرنا في غالبيةِ نصوصه إلى تخليص المشهد الحياتي من زوائده الضالة والمضلة، بل إلى كشف بنيته التحتية، مضحيًا في ذلك بالراحة التي يتيحها لنا الفهم، ويمنحنا إياها إشباعُ التوقع، إنه يفعل بنصه فعلَ الجراد حين يمر بحديقة غنَّاء، فيذهب بخضارها النضر، لكي تنكشفَ بنيتُها الخبيئةُ من جذوعٍ وأشواك وأغصان ناشفة، يذهب بالسكرة ويُبقي لنا الفكرة، إننا أمام مدرسة القسوة التي تقايضنا دومًا، حقيقةً ببهجة.
في قصيدة بعنوان “عين الشمس” نقرأ:
ستحملُ لي البحرَ على شفتيْنِ ماجنتينِ
ترسو سفنٌ على نتوءاتِهما
وتلهو قورابُ صيدٍ في انفراجتِهما
وتصطفُّ الأصدافُ خلفهما كبناتِ المدارس
…
تُزيلُ رافعةَ صدرِها النيئ
ترفعُ بطنَها عن الرمل كي تدخلَ الشمسُ
وأسئلةٌ تُنبتُ زهراتِ ياسمين
وموسيقى “الدانوبُ الأزرق”.
…
ستحمل لي ماءها في كأسٍ بللوريًّ
مالحًا كاللعاب، وشفافًا كقَدَرٍ،
وتقول: أنتَ شمسٌ واحدةٌ وأنا كوكبٌ دريٌّ
يوقدُ من شجرة مباركةٍ
وتغنِّي.
ينفتح قوس التأويل في هذا المقطع الصغير على آخره، كأن التأويلَ هنا إعادةُ بناءٍ للمشهد الذي كان قد تم تجريدُه، أو كأنه محاولةٌ لكساء هيكلٍ عظميٍّ آدميٍّ باللحم والإهاب والملامح، من أجل استعادته إلى عالم الأحياء، تُرى عن أيِّ شيء يتكلم شاعرنا في هذا النص الصغير؟! المؤكد، أننا لا نعرف إن كان يتكلم عن الحبيبة التي بات حضنُها العامرُ بالدفء واللذة مرفأه، أم أنه يتكلم عن جغرافيا ما تخايله وتداعب أحلامَه، أم أنه يتكلم عن أشياء غير ذلك؟!
نحن إذن حيال نص يصبو إلى جعل متلقيه مبدعًا، حيث لا نستطيع أن نحصر الأشكالَ المحتملة التي يمكن أن يُبتعث هذا الكائنُ/ النصُّ عليها، إذ يظل هذا وقفًا على التاريخ النفسي والمعرفي الذي يكمن خلف كل مخيلة تتلقاه. في قصيدة بعنوان “لوحة” يُحدِّث الشاعرُ امرأةً ما، وكأنه يحدث الذاتَ التي تتلقى لوحتَه، ليعطيها وصفةَ الولوج إلى عالمه، إذ يقول:
اللوحة موهومةٌ،
فاخرجي من رجفة القماش والثميها.
لا تفرِّقُ اللوحةُ بين قصيدةٍ والهوامِ
تفتحُ فخذيّْ ألوانِها لمشيئة الجنائزِ
وتضمُّهما على عنق نبتةٍ بازغةٍ.
اللوحةُ لا تلمسُ خدَّ النارِ كما يليق بمهرٍ،
تغطيها بطبقاتٍ فوق أخرى
كأنما البحر ليس سوى زبدٍ فوق زبد.
نعم.. قراءة النص هنا، تعني ردَّ الطبقاتِ التي سبق أن جرَّفها الشاعرُ إلى مكانها، طبقةً فوق طبقةٍ فوق طبقة، تمامًا كالبحر الذي يكوِّنه الرسام في اللوحة زبدًا فوق زبد.
***
ولعلنا كنا على صواب حين احترزنا في البداية ونحن نجتاز باب الديوان من عتبة “خوان ميرو”، حين قلنا إنه مدخل (يبدو) صحيحًا، ذلك أن “ميرو” لم يكن القطبَ الأوحد الذي تتمركز حوله جزيئات التجربة، ثمة قطبٌ مناقضٌ آخر، لكنه لا يقل قوةً عن صاحبه، كأن شاعرَنا آثر أن يجعل التجربةَ أكثر إشكالية ومدعاة للتأمل، هذا القطب كان “رينوار” الانطباعيَّ العتيد، الذي اعتمد -من وجهة نظري- على منجز التأثيرية الفاتن، المنجز الذي حرص -كما يرى الكثيرون- على انتخاب المشاهد السعيدة من الحياة ليصنعَ منها لوحاتٍ خالدة، أو لنقل -إذا شئنا الدقة- إنه المنجزُ الذي حاول أن يحقن الحياةَ بالسعادة دون التورط في خيانة الحقيقة، كان ذلك مبنيًّا عند التأثيريين على فكرة رئيسة، وهي الالتزام باستخدام ألوان الطيف الأساسية فقط في اللوحة، والحصول من خلالها على الألوان البينية لا عن طريق خلطها على الباليتة، بل عن طريق تجاور البقع متناهية الصغر من الألوان الأساسية على اللوحة ذاتها لإعطاء التأثير اللوني المطلوب.. (هل يذكرنا هذا الكلام بـ”الألوان الأساسية” التي تحدث عنها سمير درويش في قصيدة “خوان ميرو”؟!).
كأن التأثيريين إذن بهذه التقنية أرادوا أن يخبرونا بأن الحقيقة موجودة على اللوحة، غير أن إدراكها لن يكون إلا بالتحديق، لن يكون إلا بالتأمل العميق، إنهم يعلِّموننا باختصار، أن السطحيين وحدهم، هم الذين سيكونون في هذا العالم على موعد مع السعادة.
تعالوا معنا نقرأ قصيدة بعنوان “مغرور”:
لا تستكينُ على مقعدها الذي يواجهني
ربما لتصبغَ جسدَها بحيويةٍ
وترسلُ أعضاؤها إشاراتٍ
لجسدي الذي انكمش وراء الطاولةِ
ولعينيَّ اللتين تفتشان خلف بلوزتِها الحمراء
ذات الأزرار السريعةِ،
عن سبب يجعلني أعيد البهجةَ الزائلةَ
لجسدٍ ثقل على ساقين نحيلتين.
انظروا! القارئ هنا أمام منظر رينواريٍّ بامتياز، إننا نوشك أن نضيِّق أحداقنا من أثر أشعة الشمس الصباحية، تلك الأشعة التي لم يرد لها ذكر في النص من الأساس، لكنها تصلنا عبر هذا الاحتفال بالوصف الدقيق لمكونات المشهد من شخوص وملابس وأشياء، وعبر حضور الألوان الصريحة الساخنة كاللون الأحمر، وكذلك عبر هيمنة المكان.
شيء مثل هذا نراه في قصيدة “تجاعيد” التي يكاد يشير فيها الشاعر إلى عقيدته الفنية في بناء المشاهد، العقيدة التي تعتمد على تداخل الألوان لا خلطها، ولا يفوته أن يلفتنا لخبراته الانطباعية كمصور (يعرف شكل البهجة)، نعم شكلها فقط، فيقول:
سأجعل الألوانَ المتداخلةَ تنساب خلفي:
الأحمرُ الجريء في الأصفرِ المهادنِ
والأخضرُ البريُّ على عكازين
والبلابلُ على خيوطٍ افتراضيةٍ من هواءٍ ثقيل
والطائراتُ الورقيةُ في أغنيات فيروز.
سأزور مصورًا يعرف شكلَ البهجة
***
هذه تجربة جادة، وهي مثلُ كلِّ تجربة جادة، تعترضها تحدياتٌ شتى، ولي عليها ملاحظاتُ قارئ،.. وأكررها: ملاحظات قارئ، أي أنني لا أملكُ دليلًا واحدًا على وجاهة تلك الملاحظات، لأنها نسبيةٌ وذوقيةٌ بامتياز، أولى تلك الملاحظات، هي ذلك القدر من الوفرة اللغوية التي كنت أحسها في العديد من المواضع، فبعض المشاهد التي رسمها الشاعر كانت تكتمل في مخيلتي قبل انتهاء النص، وعلى الرغم من هذه الملاحظة، فلا أحب أن يفوتني الثناءُ على لغة سمير درويش النضرة المليئة بالحياة فضلًا عن دقتها، الملاحظة الثانية برقت في ذهني نتيجة التفات شاعرنا الواضح للفن التشكيلي في هذه التجربة، لقد استدعى هذا الالتفات لديَّ ضرورةَ إعادة النظر إلى التشكيل البصري على الصفحة، وهو أمر لم يلقَ في ظني العنايةَ الكافيةَ من الشاعر، فمعظم صفحات الديوان جاءت ممتلئةً من أولها إلى آخرها، دون أن تُتركَ الفراغات التي تحتاج إليها الكلماتُ كي تتنفس، أيضًا لم أسترح لبعض النعوتِ التي وردت في بعضِ المواضع، وعلى سبيل المثال، ما جاء في قصيدة “نوم” حين قال:
والوجوه تنفثُ دخانًا غبيًّا
لقد خالجني إحساس بأن ثمة خللًا ينجم عن وصف الحسي بمعنوي، فالحسية عند سمير درويش -ولا سيما في تجاربه الأخيرة- لا يمكن النظر إليها باعتبارها حلية، أو مزاجًا عابرًا، بل هي في الواقع إستراتيجية أساسية، يحاول من خلالها إعادة الاعتبار للحواس.
***
أعترف بأن قراءتي تلك ليست أمينةً على نحو مطلق، فلقد كنت مأخوذًا بفكرة طرأت على بالي وأنا أطالع ديوان سمير درويش، مفادها: أن الأمانة المطلقة في النقد، قد تساوي الخيبة المطلقة، فلقد وددتُ دفعَ طرائق النظرِ إلى هذا الشاعر في اتجاه جديد، يكشف عن مناهلِه الثقافية بشكلٍ أكثرَ عمقًا، أيضًا وددتُ الانتباهَ لضرورة كشف شبكة العلاقات التحتية المعقدة التي دائمًا ما تنمو داخلنا ببطء، كي تشكلَ وعيَنا بالعالم، تلك الشبكة لا يروق لها أن تنمو إلا بمعزلٍ عن الوعي ذاتِه.