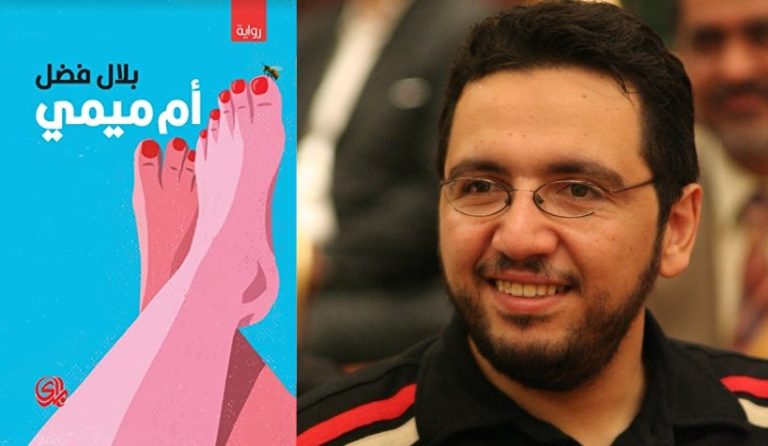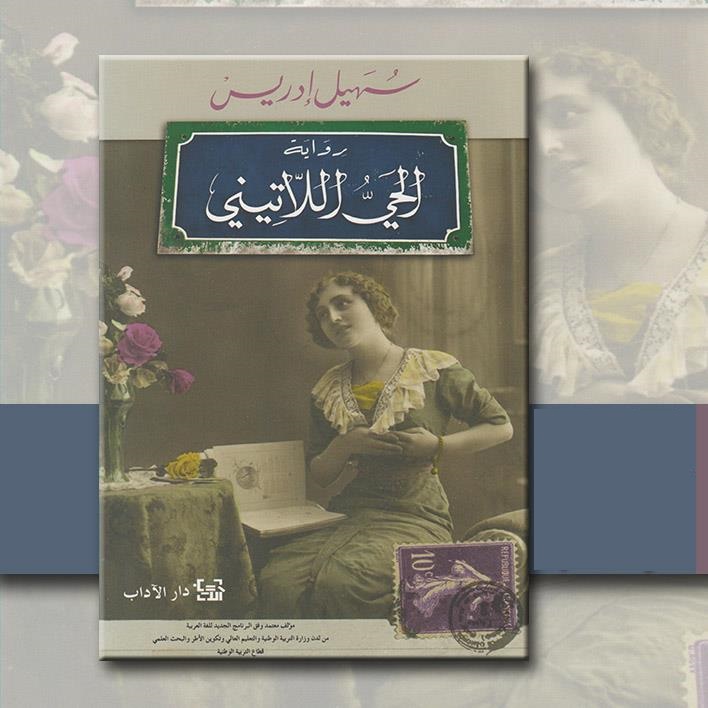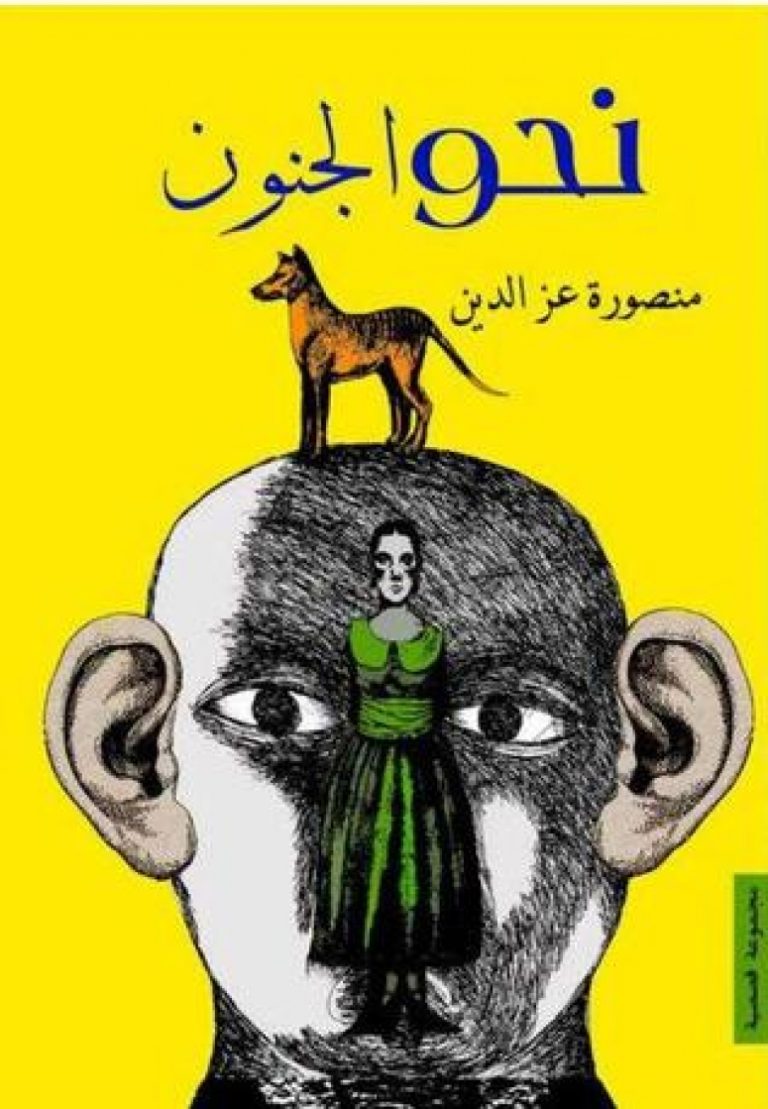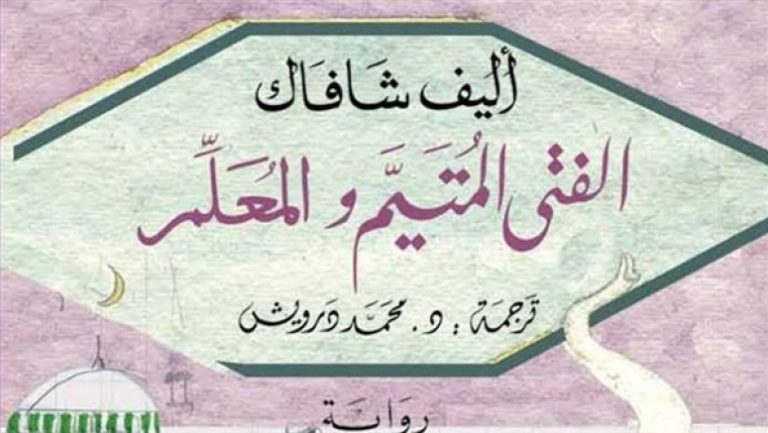مينا ناجي
ظهر الأدب الحداثي (إليوت، جويس، لورنس، إلخ..) ومثله الفن الحداثي (بيكاسو، دوشامب، هارب.. إلخ) ضد البرجوازية -الطبقة الوسطى- وقيمها: الحياة الأسرية، المُقدسَّات، التابوهات الأخلاقيّة، إلخ.. لصالح مضامين تقدميّة وأكثر فرديّة. لكن، عمليًا، حدث تواطؤ بين الفن الحداثي والبرجوازيّة (رأس المال) التي موَّلت وشملت برعايتها الشكل الجديد من التعبير الجمالي، يمكننا القول، ضد شعوبية ما.
حين قُلِّمت أظافر الحداثي، وأضفيت الألفة عليه من قِبل البرجوازيّة ومؤسساتها (السوق، المدرسة، الجامعة، المتحف، إلخ..)، بزغت ما بعد الحداثة كتيار، مثيرة نفس العواطف المُضادة للطبقات الوسطى، بصفتها فن تجريبي وتقدمي. لكن لأنها استعادة أخلاقيّة لنفس الموقع ضد البرجوازية وقيمها، فهي أيضًا تكرار، بلا نهاية، للإنجازات الجماليّة في النصف الأول من القرن العشرين.
انعدام الأصالة هذا جعل الفن الما بعد حداثي يلجأ غريزيًا إلى حيلة البارودي (المحاكاة الساخرة) ويتخفى وراءها، ليظهر ذكيًا وبفعالية نقديّة في ذات الوقت. الأهم أنه ظهر لا بصيغة تدفع الفردية الحديثة إلى مدى أبعد، لكن بصيغة شعبويّة تأخذ موضوعها الأساسي من المنتجات الجمعيّة الشَعبية (بمعنييها ‘الشائع’ و‘المتعلق بالطبقات الشَعبيّة’).
هذا المكوَّن سيلتقطه السوق ويوسعه ليصبح “التجريبي” بطاقاته التمرديّة، مع الوقت، امتثاليًا، وقابلاً للاستهلاك من الطبقات الوسطى التي قام ضدها. ويُعمَّم النموذج في أنحاء العالم: من كان يتصور مثلاً، عند ظهورها، أن أغاني المهرجانات -وفروعها المُستحدَثة- ستكتسح آذان كل الطبقات الأخرى وتهيمن على المشهد الموسيقي، بل يصبح راعيها الأساسي هو البرجوازية الكبيرة، أي الشركات الإلكترونية العالميّة العملاقة؟ أو أن طليعة الموجات السينمائيّة الجديدة هي أفلام كانت تعتبر فيما سبق أفلاماً مخصَّصة لاستهلاك الطبقات الشعبيّة بالأساس؟
في هذا السياق المُعَولَم، سيتحول ما يسمى بـ”الكتابة الجادة” في الأدب المحلي مما كان يُطلق عليه “الأدب المُلتزم” بكل تسييسه ودعائيته، إلى وجِهة ما بعد الحداثة، التي أتت بالأساس لتنقد (وتنقض) المشروع الحداثي، بالرغم من تعثره وتأزمه الكبير عندنا. الأمر الذي جعل استخدام مرجعيّة ما بعد الحداثة في هذا السياق الجديد -سياقنا- عدميّة منزوعة القيّمة. ولأنها، في كثير منها، كتابات فقيرة معرفيًا، فهي أيضًا منزوعة الطاقة النقديّة، فتستعيض عن ذلك بأن تصدر إيماءات مُعارضة أو متمردة، سطحيّة وشكليّة، ممايزة نفسها بلاغيًا عن الخطاب الأدبي العام، المُحافظ أو الشعبوي، في أداء أسماه أحد النقاد بذكاء “إجرائيًا”.
فعبر مجموعة من الإجراءات الخطابيّة والفنيّة والكتابيّة، تموضع “الكتابات الجادة” نفسها في تصنيف أدبي-اجتماعي داخل ثقافة بالأساس مُفرَّغة المضمون، تحتاج إلى ملء هذا التصنيف بنيويًا. صاحب ذلك، في الجلسات الخاصة، أو وراء الستار، انتقاد دائم لهذه الكتابات بأنها ضعيفة أو مدعيّة، وذلك لأنها في النهاية، ليس لديها شيء جديد لتقوله. مما يجعل “الكُتّاب الجادين” في احتياج دائم لتأكيد قيمتهم الأدبيّة (والاجتماعيّة)، من قِبَل الأقران والقرّاء والجوائز الأدبيّة وإعلام مواقع التواصل. ليصبح نشاطهم الرئيسي، داخل وخارج الأدب، أن يرسلوا “إشارات” و”علامات” يتم عبرها تثبيت مواقعهم. تلك الحالة خلقت شكلاً من التواطؤ بين الكتاب/النقاد. فكّرْ: ما نسبة النقد أو إبداء الرأي الحقيقي في الأعمال الأدبية في المجال العام حاليًا؟
هذا الاحتياج جعل “الكتابات الجادة” والتي تتخذ شكليًا ثوب ما بعد حداثة، تقترب مضمونًا وقيميّة من الكتابات التي تمتثل من البداية لأعراف السوق والمحافظة أخلاقيًا (فكّر في أي بيست-سيلر). لأنه حتى سُلطة اعتراف الجوائز، التي كانت محجوزة لهم في توزيع الأدوار، قطعت شوطًا كبيرًا على طريق إلغاء الفروق، كونها تعتمد بالأساس على الدور المؤسسي لمنظومات رأسماليّة داعمة للثقافة. الأمر الذي جعل – في دلالة واضحة- لجان التحكيم يرأسها كتّاب شعبويون قادمون من قوائم الأعلى مبيعًا، في مسابقات أدبيّة من المُفترَض أن تشجِّع وتبرِز التجريب والمغامرة والاختلاف الذين لا يلقوا بطبيعتهم التقدير التجاري.