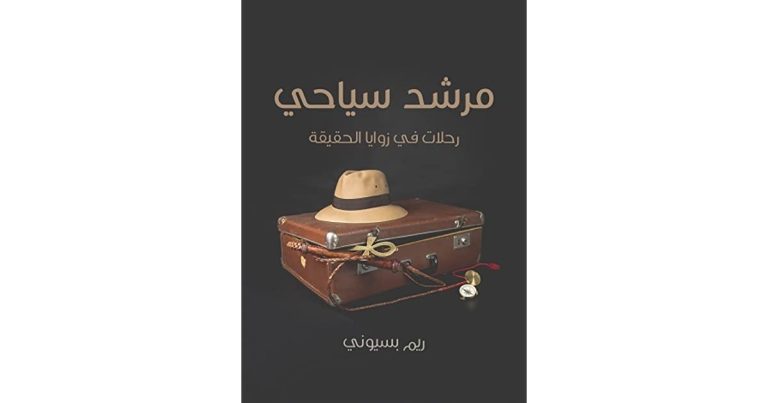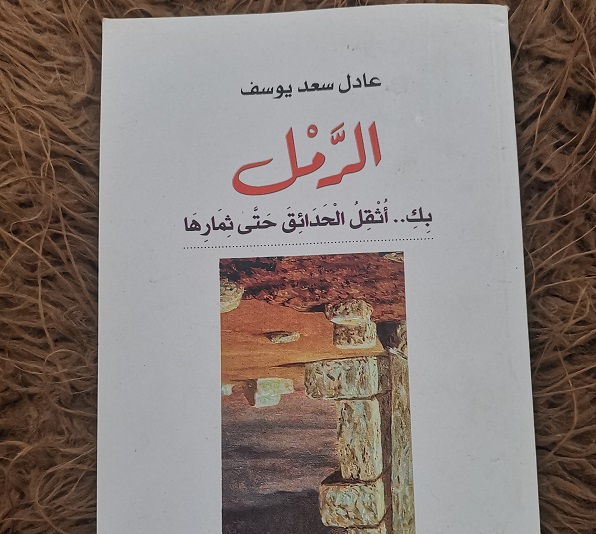حاتم حافظ
ورد في القرآن أن الشعراء يتبعهم الغاوون. وفي التفاسير أن الشعر غواية كأي غواية، وأن الشعراء مغويون لأنهم يكذبون. وردت إذا الآية في سياق التفريق بين الشعر وبين الوحي. قال معاصرو النبي إنه شاعر، ما يعني أن كلامه/كلام القرآن كذبا. يقصد المعاصرون بذلك أولا الاعتراف بجدارة ما يسمعون من كلام النبي، فهم أهل صنعة ولذلك فهم يقدرون الصنعة فيما يسمعون من كلامه، لكنهم يقصدون ثانيا أن الصنعة في كلام النبي دليل على عدم نبوته لأن الشعر – بالضرورة – خيال، أي كذب. لهذا قيل ضمن ما قيل أصدق الشعر أكذبه. العبارة الأخيرة لا تعني فحسب أن الشعر كذب، لكنها تعني أيضا أن أصدق الشعر أو أكثره إيغالا في الكذب، أو أبعده عن الواقع، هو عين الصدق.
يدعي الشاعر أنه ينشد الحقيقة، ينشد قول الحقيقة، لكنه ـ كشاعر ـ لا يقول الحقيقة إلا عبر المجاز والمجاز ليس صدقا.
يقول صلاح عبد الصبور في قصيدته ذات شتاء
نبئني شتاء هذا العام
أن ما ظننته شفاىَ كان سُمِّي
و أن هذا الشِعر حين هزَّني أسقطني
و لستُ أدري منذ كم من السنين قد جُرحت
لكنني من يومها ينزف رأسي
الشعر زلَّتي التي من أجلها هدمتُ ما بنيت
من أجلها خرجت
من أجلها صُلبت
و حينما عُلِّقتُ كان البرد و الظلمة و الرعدُ
ترجُّني خوفا
و حينما ناديته لم يستجب
عرفتُ أنني ضيَّعتُ ما أضعت
ينبئني شتاء هذا العام أننا لكي نعيش في الشتاء
لابد أن نخزُنَ من حرارة الصيف و ذكرياتهِ
دفئا
لكنني بعثرتُ في مطالع الخريف
كل غلالي
كل حنطتي, و حَبِّي
كان جزائى أن يقول لى الشتاء انني
ذات شتاء مثله
أموت وحدي
ذات شتاء مثله أموتُ وحدي .
المجاز هنا، والقصيدة كلها مجاز ممتد، يجعل من الشعر نزيف الشاعر كما لو كان النزيف يجفف دم الشاعر ويلغي الدفء من جسده فيذوي ويموت ذات شتاء. على القصيدة يصلب الشاعر كمسيح. هذا مجاز، ومن أجل هذا فهو كذب، أو لأنه كذب فهو مجاز.
لهذا فإن التمييز بين الحقيقة والخيال هو تمييز غير مفيد في التعريف بالأدب، لأنه سواء كان المصدر الذي يكتب عنه الشاعر أو الروائي حقيقة أم لا فإن النتيجة النهائية والتي نسميها بالعمل الأدبي أو النص الأدبي هو خيال في كل الأحوال.
لهذا يكون من المفيد هنا الحديث عن مرسل الرسالة ومتلقيها.
لا يكتب الكاتب لكل الناس. هذه واحدة من الأساطير. يكتب الكاتب لقارئ متخيل. ليس هذا فحسب بل إني أدعي أن الكاتب لا يكون هو نفسه أثناء الكتابة، أو على الأقل لا يكون هو نفسه في نصه. ما يميز الفنان عن غيره أن الأخير يشتغل عبر وسيط، أي عبر الانسلال داخل كائن ما، كالممثل الذي يتخفي خلف قناع. الأديب أيضا حين يكتب فإنه يتخفى خلف قناع. لكل رواية راو، أو سارد، لا يكون هو نفسه الروائي، حتى ولو كانت الرواية مكتوبة بضمير الفاعل. ما يعني أن ثمّ كاتب متخيل دائما يتخفى خلفه الكاتب الحقيقي. هذا الكاتب المتخيل حين يكتب نصه (أو رسالته) إنما يوجهها لقارئ متخيل أيضا، فمن البديهي أن شرط وصول الرسالة هو التزام الطرفين (المرسل والمستقبل) بشفرة ما. الشفرة تلك هي شفرة ضمنية بين كاتب متخيل وقارئ متخيل. شكسبير مثلا. ثمّ كاتب متخيل في نصوص شكسبير كلها تقريبا. كاتب ملكي أكثر من الملك يقف موقفا معارضا لأي تعدي على سلطة الملك المقدسة. كاتب بوق للسلطة الملكية إن جاز القول. لكنه كاتب حرفي لأقصى درجة. وهو أيضا فيلسوف. يعرف كيف يلغي التاريخ من رسالته التاريخية، بمعنى كيف يُظهر الرسالة كما لو كانت غير تاريخية لكن بعد أن يطمئن أن رسالته التاريخية قد وصلت. لهذا الكاتب المتخيل قارئه المتخيل. قارئ بالضرورة إنجليزي حتى النخاع وملكي أيضا. وما تجدد شكسبير إلا نتيجة توالي القراء من خارج تلك الدائرة. يكتب الكاتب المتخيل لقارئ متخيل لكنه لا يعدم أبدا قارئ عابر، فقدره أن يصادف قراء غير افتراضيين. فإذا كان القارئ الافتراضي الحقيقي هو من تصله الرسالة كاملة فإن القارئ غير الافتراضي هو الذي يضمن إعادة قراءة النص أو قتله. تخيل رواية من روايات نجيب محفوظ تقع أمام عيني قارئ أوروبي مدرب، أو أمام قارئ لروايات الجيب! لنتخيل أيضا نصا مقدسا كالتوارة أو كالأنجيل أو كالقرآن.. ولنتخيل أن ثم قارئ يفترض أنه يقرأ الحقيقة بينما يقرأها الآخر كشعر!
في القرآن: والفجر/وليال عشر/ والشفع والوتر/ هل في ذلك قسم لذي حجر. هل يمكن أن ينفصل النص هنا عن القارئ؟.. من الذي يمكن أن يجزم بصدق أو بكذب النص؟.. لا شك أن الرهبة التي يشعر بها المؤمنون من منبع غير المنبع الذي تصدر عنه الرهبة التي يقف بها شعر رأس الشخص غير المصدق للقرآن لكنه يعرف من أين تأتي الموسيقى في أي نص شعري.
التمييز إذن بين الحقيقي أو الواقعي والخيالي لا يفيد كثيرا في تعريف الأدب، خصوصا وأن النقاد الأدبيين في كثير من الأحيان يستبعدون الروايات البوليسية من الحديث عن الأدب رغم أن الروايات البوليسية محض خيال. لكن إن شئنا الإنصاف فإن الروايات البوليسية رغم خياليتها فإنها تفتقر للمجاز، حتى ولو أمكن اكتشاف دلالة ما خلف النص، فما أقصده هنا هو ضحالة المجاز المحتمل. وربما أيضا يكون استبعادها هو استبعاد معتمد على القيمة وليس على النوع.
لهذا أميل إلى اعتبار الأدب هو استعمال مميز للغة. يفرط ياكبسون مثلا في التعبير عن ذلك حين يقول إن الأدب يمثل عنفا منتظما يرتكب في حق اللغة العادية، فالأدب يكثف اللغة العادية، يحولها لمجاز. في رواية اللص والكلاب مجاز محيط بالحدث الروائي كله وأقصد بها مجاز العنوان الذي يجمع بين اللص والكلاب كمفردتين عاديتين، لكنه حين يبطش بالدلالة الأولية للعلاقة بين المفردتين في السياق العادي اليومي باعتبار أن الكلاب هي أداة الإمساك باللصوص ليحول العلاقة ويبدلها بما يجعل الكلاب هم من يصنعون اللصوص فإنه يصنع مجازا.
في رواية كونديرا “الجهل” ثم شخص لا يتعرف على زوجته فيكتشف أننا لا نعرف بعضنا البعض بما يكفي، لكنه يكتشف الاكتشاف الأكثر عنفا: إننا متشابهون بدرجة مرعبة، لا شيء يميزنا. هنا انتهاك للحياة اليومية التي توهمنا بالتمايز. فإن كان الحدث السردي هنا في مجمله انتهاك للحياة اليومية فإن اللغة التي يستخدمها كونديرا هي أيضا لغة مفارقة أي لغة تنتهك اللغة اليومية لأنها تعتمد لغة المجاز. حتى النصوص التي تكتب على النحو الشفهي كرواية بيكيت مثلا الحب الأول فإن ما تفعله هو الكشف عن خواء تلك اللغة اليومية على عكس ما توحي به في الحياة اليومية، أي أننا حين نقرأها في سياق فني فإننا نكتشف خواءها، مثلما نرى أنفسنا في المرآة مثلا في مسرحيات تشيخوف التي لا تفعل فيها الشخصيات غير الكلام وشرب الشاي والنبيذ.
لهذا فإننا نصف بعض التعبيرات خارج سياق الأدب بأنها تعبيرات أدبية. مثلا صك المعلق الرياضي ميمي الشربيني عددا من التعبيرات التي صارت شائعة اليوم مثل الساحرة المستديرة. هذا تعبير أدبي لأنه يستخدم لغة المجاز غير المعتادة للإشارة إلى الواقع. ليس هذا فحسب بل إن تعبيرات الغزل مثلا مثل “هو القمر بيمشي في الشارع كدة عادي” هو تعبير أدبي بامتياز ليس فحسب لأنه يستخدم المجاز لكن أيضا لأنه يستخدم حيل اللغة الأدبية في جذب الانتباه مثلا. لهذا فإن اللغة التقريرية مثلا التي سوف تكتب بها شكوى لن تكون هي نفسها التي سوف تكتب بها رسالة غرامية، فإن كانت الأولى سوف تهدف إلى التأثير الواقعي عبر المباشرة والتقليل من مساحات المجاز والبلاغة فإن الثانية سوف تهدف إلى التأثير الجمالي عبر زيادة مساحات المجاز والبلاغة، حتى ولو كان الغرض في النهاية هو كسب التعاطف في الرسالتين، ويمكننا القول إن الأولى تخاطب العقل بينما الثانية تخاطب القلب والوجدان لهذا يكون للتأثير الجمالي في الرسالة الثانية أهمية كبيرة.
ولكن ما الذي يجعل من تلك الأدبية غير الأدب؟.. الحقيقة أن السبب يرجع لكون الأدب هو انحراف دائم عن اللغة اليومية فيما أن تلك التعبيرات الأدبية أو حتى الرسائل الغرامية بسبب تكرارها الدائم تظل مجرد أدبيات غير أدبية إن جاز القول. فالتكرار هو نقيض السياق الأدبي، بمعنى أن الجريمة والعقاب مثلا ليست أبدا الحب في زمن الكوليرا فيما أن الرسائل الغرامية تظل هي نفسها حتى ولو كان كتابها متعددون، لهذا أمكن نشر كتب بها رسائل غرامية للاستخدام اليومي. وهو ما يجعلنا نميز أيضا بين ما هو أدبي وما هو غير أدبي في أن الأول هو نص غير نفعي، فهو كالرسالة الغرامية بالنسبة للشكوى الرسمية. لهذا فإننا حين نقرأ جملة في رواية (حتى ولو كانت جملة غير أدبية) فإننا نميل لقراءتها كجملة أدبية بسبب السياق. عبارة كـ “لا شيء يهم” رغم أنها قيلت أمامنا آلاف المرات فإننا نميل فقط لاعتبارها عبارة أدبية حين نقرأها في صدر رواية إحسان عبد القدوس المعروفة بالعنوان ذاته. لأنه فضلا عن السياق وأهميته فإن الفارق بين الشكوى الرسمية والرسالة الغرامية أيضا هو فارق بين أهمية ما يقال وبين أهمية الطريقة التي قيلت بها الأشياء، فالبديهي أن الطريقة التي قيلت بها الرسالة الغرامية هو جزء أصيل من الرسالة نفسها، فكلما كانت أجمل كلما ضمنت تحقيق التأثير الجمالي المطلوب، فما بالك بالرواية أو بالقصيدة.