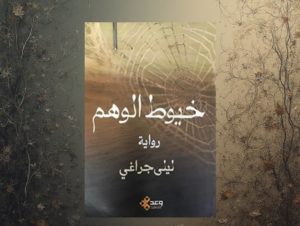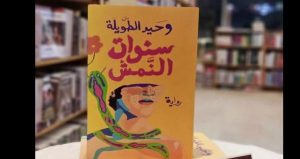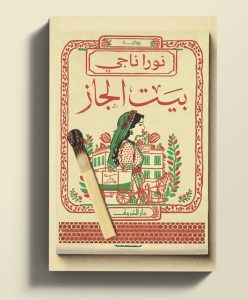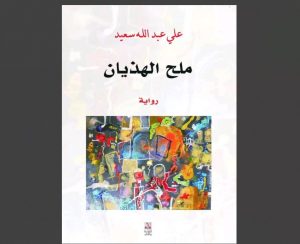رضوى الأسود
إدراك الوجود من خلال الآخر: مفتاح الرواية
تؤمن فلسفة “أوبونتو” الأفريقية بأن الفرد موجود فقط من خلال الآخرين، ولا يمكن أن يكون له وجود بمعزلٍ عنهم”، مشيرة إلى أن الإنسان يتشكَّل وجوده ممَّن حوله، وكأن البشر في مُجملهم وعلى تنوعهم يشكلون وحدة واحدة، مؤثِّرون ومتأثِّرون ببعضهم البعض، يكوِّنون جميعًا شبكة روحية عملاقة غير مرئية، لكنها مؤثِّرة وفعالة في تكوين وشخصية وصيرورة كل واحد منهم.
في روايته الأخيرة “ليس بعيدًا عن رأس الرجل” الصادرة هذا العام عن دار بتانة، والتي اختيرت مؤخرًا ضمن القائمة الطويلة لجائزة كتارا، يؤكد الشاعر والروائي سمير درويش على تلك الفكرة من خلال بطله “يونس” الذي تتشكَّل حياته وتتطور شخصيته ويتمحور وجوده من خلال أخريات، نساء، متباينات الخلفيَّة والفكر والتكوين والطموح، مر بهن ومررن به خلال سنوات حياته التي لم تتعد الخمسين.
من ثقب الرأس تنسال الحياة: الموت بوصفه بداية
مفتتح الرواية المكوَّن من اقتباس لميلان كونديرا يقول: “لا يمكن للإنسان أبدًا أن يدرك ماذا عليه أن يفعل، لأنه لا يملك إلا حياة واحدة، لا يسعه مقارنتها بحيوات سابقة، ولا إصلاحها في حيوات لاحقة”، ثم مشهد أوليّ لموت البطل برصاصة قنَّاص محترف، اخترقت رأسه في ما يُسمَّى بـ”موقعة الجمل” عام 2011 أثناء ثورة يناير، قد تكون ملخصًا لروح الرواية وفكرتها الأصيلة، القائمة على أزمة الإنسان الوجودية وفخ ظهوره في حياة لا يدري عنها شيئًا ولا كيفية التعامل معها، ومدى عجزه عن إمكانية إصلاح ما مضى واتقاء ما سيأتي.
أيضًا للعنوان دلالة كبرى، كما أنه يشكل أحد أهم الرموز في الرواية؛ فالرأس مستودع الذكريات، ومنبع التعاسة والهناءة. الرأس موضع العقل المنوط به التفكير، وعلى الرغم من ذلك، فهو مأمور بالتعطَّل في بلداننا، “من تمنطق، فقد تزندق”. إنها رأس “يونس” التي ستنسل منها مشاهد حياته منذ الطفولة وحتى النهاية، وكأن الثقب الذي أحدثته الرصاصة في رأسه هو الباب الذي ستنسرب منه سيرته كاملة ليفندها وربما يتمكن من تفكيكها في محاولة أخيرة لفهمها، وهي أيضًا رأس الرجل العجوز التي دعستها عجلات العربة الكارو، في دلالة على ضرورة دعس كل ما تربينا عليه، وكل ما تم تلقيننا إياه، والبدء من جديد بعقل يتدبَّر وفكر نقدي حر، يرفض أكثر مما يقبل، ويعترض أكثر مما يُذعِن.
سرد يبدأ من النهاية: استدعاء الحياة بعد الفناء
بالرغم من أن المفتتح هو مشهد موت، وليس أي موت، بل موت البطل الأساسيّ! إلا أنه بداية سرد مطوَّل عن حياته، بكل ما جرى فيها، استعادة كاملة لتاريخة وسيرته، وكأن النهاية صحوة بعد غفوة، استقرار بعد تيه، ترتيب الروح بعد تبعثرها، وربما إجابات على تساؤلات طالما أرَّقته.
النساء بوصفهن أمكنة
النساء في هذه الرواية كنَّ مُعادلًا للمكان، يتماهين مع طبيعته، جزء مخلص له؛ تلك الأماكن التي انتقل إليها “يونس” في رحلة حياته القصيرة، التي انسلت سنواتها – دون أن يشعر – في اكتشاف نفسه والآخرين، وفي طرح أسئلة بحجم الكون دون إجابات شافية.
ارتحل البطل من قريته النائية المحكومة بقصص الجن والعفاريت والموروث، حيث طفولته ومراهقته، مرورًا بالقاهرة في بدايات الشباب، وأخيرًا نيويورك.
على تعدد أشكال علاقات البطل بنسائه؛ سواء كانت جيرة أو زمالة، أو حتى علاقات عملية أو عاطفية أو جنسية، فهي لم تكن مجرد علاقات عادية، بل عملية تسجيل دقيقة لتبلور شخصيته وأفكاره ورغباته، وقوف على مدى تبدُّل سُلَّم إحتياجاته، ومدى تطور منظوره للحياة ولنفسه. كانت النساء مرآته الكاشفة، دون وعي منهن يكشفن له الحقائق المخفية عنه: حقائق جسده، وروحه، ونفسه. لم تكن علاقات عابرة، دون أثر، حتى تلك التي كان الطرف الآخر فيها يريدها كذلك، بل علاقات مُستهلِكة، مؤثِّرة، اخترقت روحه حتى نزفت عن آخرها.
بورتريهات النساء: تنوع التجربة وكثافتها
التجربة الأولى كانت في قريته، عزيزة عبد الفتاح، الريفية، التي رسمت لهما بيتًا بالطباشير وقال له “أنت الرجل”، وهو بعد طفل يبول على نفسه لا إراديًّا، حلمه الأول الموءود، ورغبته غير المُلَبَّاة، وهي تَجسُّد للفقر، والتقاليد، والموروث.
في المدينة سيقابل أربعة من النساء يجسِّدن تنوع وتناقض ثقافاتها المتراوحة بين التخلف والحداثة، والإنحطاط والرقي، وكذلك وجهها القبيح المتمثِّل في قسوتها وعدم رأفتها بالغريب؛ الأولى، وئام سلطان، الفتاة الشعبية الفقيرة التي تمتلىء بكلام الأغاني وتقتنع بأن “عشق الروح مالوش آخِر، لكن عشق الجسد فاني”، لذلك حين رأته يتوق إلى جسدها، قررت أن تنتقم منه بهذا الجسد نفسه، تقربه منه كثيرًا دون أن يأخذ ما يريد، وقبل اللحظة القصوى تنسحب فجأة، وتحرمه منه للأبد، لأنه قصير النظر لا يرى روحها. والثانية، ماهيتاب، ابنة الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى، المحجبة الممتلئة قليلًا، الوحيدة التي دخلت شقته ونامت على سريره وجلست تحت رجليه كزوجة بدائية، التي كانت تغفو في حضنه ليلة زفافها، وسحبت نفسها منه لتتجه مباشرة إلى مراسم عُرسها، وأصبحت زوجة مخلصة لا تتصل ولا تتواصل مع الغرباء. والثالثة، نجوان سيف الدين، الأرستقراطية التي تبحث عن المكان الذي سيدفعها لأعلى كي تقف فيه، دون أن تنتبه للأشياء التي دهستها بحذائها، أو تسمع لتأوهات الذين اصطدمت بهم في إندفاعها. والرابعة، آية عبد الرحمن، التي تنتمي لطبقة متوسطة، والتي ترتدي ما يشبه الحجاب لمداهنة المجتمع، الناشطة السياسية، التي تؤمن بضرورة التغيير، وترى أنها امتداد لنساء حضارتها القديمة، ترى أن جيل يونس جيل متخاذل قَبِلَ الإهانة لعقود، بينما هى وجيلها من قاموا بتحريره.
أما في المهجر، فسيقابل مليكة عمراني، الفتاة الناضجة، العملية، المحايدة، التي تحب بعقلها ووفق حساباتها الخاصة، وهي تجسيد للغربة وتمزق الفرد فيها بين نشأته وأحلامه، وبين ما يثقله من موروث، وما يتوق إليه من حرية.
نموذج واحد فقط من النساء كان مثالًا للتوازن النفسيّ والعقليّ، بالإضافة إلى الرقي في التعامل، والدعم دون انتظار مقابل، الأستاذة الجامعية الأمريكية “ألكسندرا فرانكلين”، وكأن الروائي يرغب بالتأكيد على أن المجتمعات التي تحترم الفرد وتؤمِّن استقلاليته وحريته الشخصية والفكرية والعقائدية، المجتمعات غير المثقلة بإرث رجعي، هي التي تُنتِج فردًا سويًّا.
المرأة كرمز للحياة والوعي
في تأويل أعمق، تبدو لنا المرأة في هذالرواية وكأنها الحياة بكل مباهجها وآلامها، بكل عنفواتها وقوتها، والتي برغم كل تناقضاتها لا يملك المرء سوى أن يهيم بها عشقًا، خاصة أن كل النماذج التي قدمها الروائي كانت لنساء قويات، لديهن طموح ما يسعين إليه حتى لو كان مجرد مشروع زواج، يعرفن ما يردن من الحياة، بينما كان هو دومًا ريشة في مهب ريحهن، لكن لأنهنَّ خَلَقوا في النهاية ما هو عليه الآن، فهو “ممتن لكل الصور السلبية والإبجابية على السواء، وممتن لسميحة النجار وألكسندرا فرانكلين، أستاذتيه اللتين أوصلتاه إلى هنا (أمريكا)، وممتن أكثر لعزيزة عبد الفتاح، حلمه الموءود ولوئام سلطان التي فتحت الباب لتدخل الشياطين ثم اختفت، أيقظت مناطق اللذة في جسده، وزرعت الملمح الأول لمشروعه الفني في روحه”.
سؤال الهوية: الغربة كقدر داخلي
تطرح الرواية سؤال الهوية، فـشعور “يونس” بالاغتراب واللا انتماء ظلَّ ملازمًا له بداية من قريته، مرورًا بالقاهرة، ونهاية بنيويورك، وإن كان في الأخيرة قد عانى بشكل قد يبدو أقل حدة، نظرًا لوجوده في مكان وظروف أفضل، ممارسًا لحريته، يعيش حياة يرضيه، لكن ظل شعوره بالغربة متجسدًا بطول الرواية، متمثلًا في كرهه لفقر الريف المدقع في قريته، وضياعه في القاهرة، مدينة التناقضات الصارخة، الرحاية التي تطحن ساكنيها بلا رحمة، وأخيرًا نيويورك، التي برغم استقراره الظاهر وسعادته فيها، لكن تظل مشاعره فيها مشعثة، يمزقه حنين غامر للقاهرة وتحديدًا لمنطقة وسط البلد، وبالمثل حنين لطفولته وذكرياته ومشاعره البكر في قريته.
لحظة اكتمال لم تكتمل: رقم خمسة ومغزى الرصاصة
بطل الرواية كان يقترب من عامه الخمسين، حين استقر أخيرًا على ما يريده من الحياة، حين قرر أن يعود إلى مهجره لأنه المكان الأنسب والأفضل والمستقبل الأنجح والأسلم، لكن لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن، فقد عاجلته رصاصة غادرة قبل إقلاع طائرته بأيام، وخمسون في علم الأرقام والطاقة، هو الرقم خمسة الذي يرمز إلى الحرية، والتغيير، وتحقيق الأمنيات، وتقدير الحياة الشخصية، والسلوك المعتدل مع الآخرين. إنه تمام الإستواء ووقت حصاد الثمار، لكن يبدو أن لا شيء يكتمل في هذه الرقعة على الخريطة، إذ ينتهي الأمل في اللحظة التي لا تفصلنا عن تحقيقة سوى مسافة ضئيلة، وهو ما حدث بالفعل بعد ثورة يناير، إنه الحلم المغدور والمستقبل الضائع على المستوى الشخصي (يونس)، وعلى المستوى العام (الشعب).
تقنيات السرد: الزمن، واللغة، والتشكيل البصري
برع الروائي في بنية السرد وكذلك في اللعب بالزمن، فلم يتبع خطًّا مستقيمًا، بل زمن يستمتع بتقطيعه، يقدمه ويؤخره كيفما يشاء، ما أعطى حيوية للنص، دون تشتيت للقارىء. كما أن السرد تراوح بالتناوب بين استخدام ضمير المتكلم، وضمير الغائب، وأحيانًا كانا يتداخلان معًا في الفصل الواحد. كما أن الواقعي تقاطع بالملحمي وكذلك بالواقعية السحرية. وقد جاءت اللغة حيَّة، شاعرية، استعارت من الشِعر تكثيفه ورمزيته، بمفردات قليلة، يُقال الكثير. وقد تم استخدام المفردات العاميَّة في الفصول الخاصة بالسيرة الهلالية.
رواية مشهدية بصرية: شادي عبد السلام حاضر في المشهد
نجح درويش في تقديم رواية مشهدية، تشبه تلك البورتريهات واللوحات التي كان يرسمها المخرج الراحل شادي عبد السلام، ثم يراها المُشاهِد مجسَّدة بشكل حرفي في المَشاهد المُصوَّرة، فجاء – على سبيل المثال وليس الحصر – مشهد سير الثنائيات والمجموعات بعد حادث موت الرجل تحت عجلات العربة الكارو وكأنه مشهد المجاميع في بداية فيلم المومياء.
لقد كتب الرواية بتلك الروح التي تخص رسامًا متمكنًا من موهبته، مبدع ينثر ألوانه باحترافية فوق قماش الكانافا، كما كان يفعل بطله “يونس”، “الفنان التشكيليّ البارع، خليط الجنون والالتزام، الفلاح الأسمر الخشن الذي يعيش ويرسم بفوضوية متناهية، الذي يحب الجمال والشعر، ويعشق النساء”.
الرصاصة الأخيرة: ذاكرة مثقلة وإرث لا يرحل
الرصاصة التي اخترقت رأس البطل، لم تكت موجهة لشخصه فقط، بل نحو ذاكرة جمعية تحمل من الهزائم أكثر مما تحمل من الانتصارات، لأناس قُدِّرَ لهم أن يعيشوا في “بلدان قديمة، متعددة الطبقات، مجرد الوجود فيها يفرض على المرء قوانين الماضي، والعادات، والتقاليد، والثقافة الشعبية، والتدين الشعبي كذلك” .. فهل ستتحرر بالفعل تلك الذاكرة الجمعية من ذلك الإرث الذي يُثقلها، أم ستظل – حتى وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة – تستدعيه وتسترجعه كما فعل “يونس”؟!
إن موت “يونس” هو دلالة على موت حُلم المرء في تغيير الواقع، ووعد ببقاء الأوضاع على ما هي عليه، لكن ربما سيرته التي حرص على روايتها لنا، قد تجنِّبنا الفخاخ التي تعثَّر بها .. ربما!
“ليس بعيدًا عن رأس الرجل” رواية ليست بريئة على الإطلاق، ليست وديعة، بل تتحرش برأسك، تتآمر على ما استقر في وعيك، تفتح أسئلة وتضعك أمام مرآة في مواجهة مع الذات، رواية مفتوحة على دهشة متسعة بحجم الكون، لكاتب ذكي، مهموم بالتفاصيل الدقيقة، والإشكاليات الفلسفية، والأسئلة الوجودية، رواية لن تخرج منها كما دخلت. نص بديع يضع سمير درويش – عن جدارة واستحقاق – في مقدمة كُتَّاب الرواية المصرية والعربية المعاصرين.