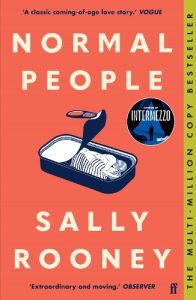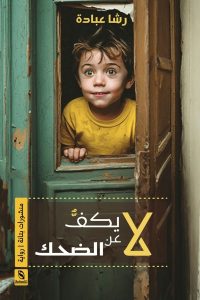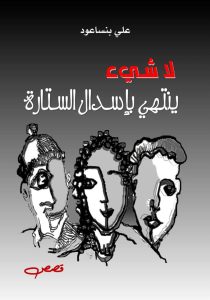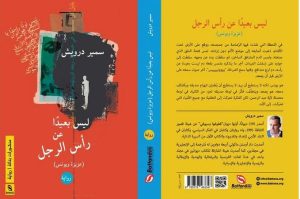حسن عبد الموجود
لا يحتاج القارئ لكثير من الوقت، بعد أن يبدأ فى قراءة رواية أشرف الصباغ “كائنات الليل والنهار” حتى يدرك أنه إزاء رواية عن مدينة القاهرة، المدينة التى شاخت وتحللت وبدأت تتداعى فوق رؤوس سكانها، وسيكتشف كذلك، ولكن متأخراً نوعاً ما، أنها تفعل ذلك متعمدة، إذ تجدد من نفسها، أو تغير جلدها إن جاز التعبير كل فترة، غير آبهة بالأحلام، ولا حتى بالحياة نفسها.
“كائنات الليل والنهار” فى تلك المدينة يبدون كـ”الكومبارس” فى شوارعها، يتحركون لإكمال صورتها، صورة المدينة العابسة، التى لا تعبِّر عن نفسها إلا بالضجيج والأصوات المرتفعة المتداخلة والدخان والغبار والسباب، صورة المدينة التى تعادى نفسها وتكره سكانها بقدر كراهيتهم وإهاناتهم المتواصلة لها، المدينة الجبارة القاسية. إنها كذلك رواية عن علاقة المدينة بناسها، حيث يدرك بطلها عاشور متأخراً للغاية أن “الناس يشبهون المدن على نحو ما، والمدن تشبه ناسها بدرجة أو بأخرى”، وهكذا فى الصراع لا يمكن لوم المدينة، على جبروتها، لأنها استمدته منهم، كما أن ذلك الخنوع العظيم لها، منحها سلطة عاتية.
يبدو مدخل الرواية مثل صورة بانورامية لـ”بلاتوه” متسع، يشمل كثيراً من المناطق، حيث ستدور أحداث الرواية، فمن الوايلى الكبير، إلى بولاق أبوالعلا، إلى رملة بولاق، إلى مثلث ماسبيرو، إلى الزمالك، إلى أسوار الكومباوندات والمدن الجديدة التى بدأت تنشأ على أطراف العاصمة، عازلة سكانها بأسوار عالية، عن ذلك الموت القريب الذى يدور فى شوارعها كل لحظة. فى ذلك البلاتوه أو المكان المتسع لا يمكن لشخص إلا أن يدور فى فلك حياة تحددها له المدينة، فالانتقال من منطقة إلى أخرى يحتاج إلى أكواد خاصة، حتى ولو كان ذلك الانتقال يتم من مجتمع فقير إلى آخر فقير، كما انتقل عاشور، بطل الرواية الرئيسى من الوايلى الكبير إلى بولاق أبوالعلا، حيث كان عليه أن يتزوج من صفاء ابنة المعلمة فريدة، ولكنه لم يقم بالأمر، وكان عليه أن يتحمل كراهية ستطارده إلى الأبد فى تلك المنطقة، كراهية أجبرته على نسيان حياة دافئة، كانت صاحبة المنزل، المعلمة فريدة، تعدُ بها، وجعلته محطة لسهام زوج صفاء “فرغلي ابن الحاج محمود العربجى”.
فى تلك المجتمعات الدنيا، يمكن إيجاد تلك الأكواد التي تجعل باستطاعة شخص ما الانتقال من منطقة إلى أخرى بسهولة، ولكنها تصبح مستحيلة في بعض المناطق الأخرى كالزمالك، على سبيل المثال. عاشور أدرك “أن هذا الحي ليس كما تصوره وسائل الإعلام والشعراء وكتاب القصص والروايات، وليس إطلاقاً ذلك الحي الأرستقراطي الذي تستعدى الحكومة عليه ليس فقط وسائل الإعلام، بل وأيضاً هواة الثورية والكلام عن الطبقات والفقراء والأغنياء. إنه حي الشريحة العليا من الطبقة الوسطى التي تعيش على رواتبها من وظائفها المختلفة، أو من ريع ميراث بسيط. تلك الشريحة التي تمارس الأعمال الذهنية والتربوية في المدارس والجامعات والأعمال المتوسطة، وفقدت الأمل في الحكومة ومشاريعها، فاستغنت بقدر الإمكان عن خدماتها اللعينة، وباتت تصرف من دخلها على علاج أفرادها وتعليمهم تعليماً جيداً، وتحرص على نظافة الشوارع والبنايات السكنية والسلالم ومداخل العمارات”.
من خلال خالته “زينب” يشق عاشور طريقه إلى عالم “الزمالك”، حيث يلتحق للعمل فى صالون للسيدات، ويشعر أن ذلك العالم العظيم يفتح له أبوابه. صار بإمكانه أن يرى سيدات المجتمع الراقى، ويستمع إلى نميمتهم، صار بإمكانه أن يحلم بحل مشاكله على أيديهن، فبعضهن زوجات وقريبات ومعارف لكثير من المسؤولين، ثم إن ما يطلبه بسيط جداً، كان حلمه أن يحول الدكان الذى حصل عليه فى “مثلث ماسبيرو” إلى صالون يشبه ذلك الصالون الذى أفنى عليه سنوات حياته فى الزمالك، لكن الحكومة كانت تطالبه طوال الوقت بفواتير للكهرباء، رغم أنه لم يستلم الدكان أصلاً، كما كانت تطالبه بسداد ثمن مخالفات فى شوارع لم يدخلها بسيارته أبداً، لكنه فى إحدى اللحظات وأمام قسوة إحداهن المفرطة فى صده يدرك أنه لن يحصل أبداً على الكود الذى سيجعله جزءاً من هذا المجتمع. لقد صار بإمكانه أن يشعر فوراً بأنه مجرد ضيف، وكان يجب أن ينتبه منذ البداية إلى ذلك، فكثير من حيتان السوق العائدين من الخليج حاولوا فيما مضى، اشتروا بنايات كاملة وشققاً وكافيهات حتى يحصلوا على الكود، ولكنهم أدركوا أن المسألة لا تتعلق بالمال، وإنما بطبيعة السكان أنفسهم، الذين يعرفون الغريب ولا يرحبون به، وهكذا هربوا من الزمالك، مكتفين فقط بالحصول على ثمن الإيجارات عن عقاراتهم.
تتحرك الرواية بذكاء كبير بين المناطق، فلا توجد قفزة مفاجئة، ولا إشارات سطحية إلى وجود فلاش باك. خبرة الكاتب مكَّنته أن ينتقل بسهولة مع شخصياته فى هذه الرقعة المتسعة، وأن يرتد في حركة بندولية بين الماضي والحاضر، الماضي حيث يمكن أن نتعرف على ذلك العالم الغامض الذى جاء منه عاشور وخالته زينب، أو السيدة التي جمعتها بأمه علاقة عظيمة. في عالم “الوايلي الكبير” يبدو المكان بعكس تسميته، صغيراً للغاية، وخانقاً، وضاغطاً على سكانه. استطاع أشرف الصباغ أن يحشرنا عنوة في قلب “علبة السردين”، أو في “جحر الفئران”، حيث تعيش أعداد هائلة في بنايات تشبه “علب الكبريت”، لا مكان فيها لخصوصية، وحيث لا تستطيع الستائر حجب ما يدور خلفها، فالجميع يتداخل مع الجميع، ولا مجال للهروب من المصائر المرسومة سلفاً. المرأة تتعرض لقهر بالغ، ولإذلال، ولاعتداء بدنى وجنسى، إنها أيضاً ليست ذلك الملاك الذي يمكن أن تشي به هذه الكلمات، فهي أيضاً تدير المعارك، ويمكنها أن تستخدم جسدها كوسيلة للتهدئة بين الذئاب المتصارعين، فى هذه الغابة التى يحاول فيها كل رجل أن يثبت أنه الأقوى. فى تلك المساحة الخانقة تدور الحرب بين الجميع، إنهم لا يلتفتون إطلاقاً إلى أن السلطة أدارت لهم ظهرها منذ زمن بعيد، إنها كذلك تبدو غير مشغولة بجرائم القتل التى تجرى، والسيناريوهات الساذجة التى يضعها السكان لسقوط قتلى يمكن تمريرها ببساطة، كما جرى عند مقتل أيمن على يد حسن، ابن المعلم فهيم، ويبدو أن عاشور وحده قادر على تقديم ذلك النموذج المذهل لابن المدينة، الذى يتحالف الجميع على سحقه ببطء، السلطة ورجال الأعمال، والمدينة التى تركت الأثرياء يشيِّدون بروجهم خلف أسوار عالية، ويعيشون فى جزر رخائهم بعيداً عن “كائنات القاع” التى تعيش على ما يبدو فوق سطح أملس ومائل يطل على الجحيم مباشرة.
الرواية تتبع مصائر تلك الشخصيات، فى رحلتها الطويلة المقدرة سلفاً، فساكن الجحيم لا يمكن أن ينجو إلا بمعجزة، فى زمن لا توجد فيه معجزات، كما أن أسماء الشخصيات ذاتها تبدو بلا معنى وغير دالة على شىء، خاصة إذا كنا نتحدث عن “الوايلى الكبير”، ففى صفحات قليلة تنهمر علينا أسماء الشخصيات كالمطر، ربما للإيحاء بذلك الضيق الخانق للعالم، حيث يمارس الجميع الجنس مع الجميع، وحيث زنا المحارم، وحيث تلك الشخصيات ممسوسة بالخرافة، وحيث إحدى البطلات تحاول تبرير حملها من أحدهم بأنها ربما تكون قد ارتدت سروال خالها، وحيث تدور حوارات عادية بين الرجال عن ممارستهم الجنس مع زوجات بعضهم البعض.
يخرج عاشور، الذي كان طالباً بقسم التاريخ، فى كلية الآداب، من هذا الجحيم بحثاً عن نفسه، محاولا تحقيق حلمه، وبرغم ما عاناه، إلا أنه يظل نموذجاً لذلك الشخص الذى تربى على التصالح مع جلاده، فهو منذ فترة الجامعة كان يرفض المظاهرات التى يقوم بها الطلاب، سواء داخل أسوار الجامعة، أو فى الخارج أمام نقابتى الصحفيين والمحامين. إنه مواطن صالح بالنسبة للسلطة، ومع هذا تمارس عليه قهراً أكبر، حيث تطالبه بضرائب ليست من حقها، إنه مواطن صالح لأنه قد يشعر بالضيق، ولكنه لا يُعبِّر أبداً عن هذا الضيق، ولا يسمح له بالخروج من مخبئه ولو على شكل تعبير غاضب أو حزين على وجهه، إنه مواطن صالح يعيش أحداث الثورة، ومع هذا يبدو كما لو أنه يشاهد فيلماً غريباً أو كابوساً، فهؤلاء الذين تجمَّعوا من كل مكان يريدون إحراق البلد بالنسبة له، وهو لن يشارك أبداً فى ذلك، لأنه يحب وطنه ويعيش لأجله. كان مندهشاً طوال الوقت وهو يصارع الأمواج العالية التى تريد رفعه والإطاحة به إلى الجحيم مرة أخرى، أن كثيراً من الصحفيين والمحامين يعيشون ويعملون ويكسبون، ومع هذا يريدون جر البلاد إلى الفوضى. إنه مواطن لم تصنعه السلطة ولم يربه الجوع أو الخوف فحسب، وإنما تلك المدينة التى تشعره بالحنو فى لحظة، ثم ما تلبث أن تُدخله كابوساً محكماً، كابوساً تتداعى فيه البنايات، وتنسحق، كما لو أنها بيوت رملية هشة على شاطئ داستها قدم شخص بالغ. نجا عاشور من فخ العدمية، ليس لأنه يمتلك أفقاً عظيماً، ولا مقاومة هائلة، ولكن فى الأغلب، بسبب تلك الفطرة التى تسم شخصيته، الفطرة التى لم ينجح الجميع فى تلويثها بالكامل، رغم تحالفهم الرهيب.
استطاع أشرف الصباغ، وبحرفية شديدة، الإلمام بتلك الرقعة الجغرافية الممتدة، بين عدة مناطق، فى القاهرة، وإشعارنا، مثل عاشور، بضيق تلك الرقعة، حيث أُجهِضتْ أحلامه قبل أن تبدأ، لم يكن فاراً من الجحيم، بقدر ما حاول التجريب فى مكان آخر، غير أن الجميع وقف فى وجه ذلك الحلم، السلطة التى تعتصره بهدوء وبالقانون، ورجال الأعمال الذين لم يمهلوه طويلاً فى “مثلث ماسبيرو” كما لم يمهلوا غيره فى “رملة بولاق”. لقد بدا كما لو أن رجال الأعمال قادرون كذلك على شراء القدر نفسه، فمن لم يمت بالإزالة مات بغيرها. بدأت الأرض تهتز والبيوت تتداعى، والموت يختطف أقرب الناس إليه، سواء أمه أو أبوه أو حتى خالته زينب.. كما أن “الزمالك” أغلقت فى وجهه الباب الكبير، وأشعرته مرة أخرى بالغربة. أدرك أنه “لا ذاكرة لدى البيوت والعشش فى العشوائيات، ولا حب أيضاً”، وربما آمن بمقولة إن “المدينة لا بد وأن تجدد جلدها، وإن الواقع أقوى من الذاكرة والحب، أقوى من الناس عندما يفقدون أحلامهم وأموالهم والأسقف التى تسترهم”. صاحب الصالون تنكر له رغم السنوات الطويلة التى أفناها فى خدمته وخدمة الزبائن. أدرك الحكمة البسيطة التى تقول إن الحياة تستمر ولا تقف على أحد. رأس المال لا يعترف إلا بمن يظل يدور فى الساقية بدون أن يبدى اعتراضاً أو ألماً، كما أن الجمال يذوى كذلك، عادت إليه حبيبته نبيلة، لكنه لم يجد فيها تلك الأنثى اللدنة، ولكن المرأة التى تحمل جبلاً من الهم فوق رأسها، ويدفع جمالها للانزواء تاركاً مساحته لحزن مقيم.
لقد انتظر عاشور طويلاً ليدرك تلك الحقيقة “أن المهزومين يدفعون ثمن هزيمتهم بكتابة التاريخ من أجل تمجيد المنتصرين، والمنتصرون يستأجرون بعض المهزومين، إنهم ينتقون الأكثر هزيمة، والأشد إحساساً بها ليصبحوا طليعة الكتبة والمؤرخين، أما بقية المهزومين فيواصلون دفع الثمن بالعمل مدى الحياة لدى المنتصرين، ويورثون أبناءهم الحرفة والصنعة والوظيفة والديون”، لم يحكم عاشور على نفسه بأى النوعين هو، لكن المؤكد أنه من النوع الثانى الذى يظل يدور كترس صغير ضمن الآف التروس فى ماكينات الأغنياء، وربما تلك الحقيقة هى ما ساعدته فى النهاية على الانعتاق.
والمدهش أن عاشور، رغم وصوله إلى تلك الحقيقة، إلا أنه رفض الحكم على رجال الأعمال، ففى رملة بولاق ينظر إلى الأبراج الشاهقة ويتذكر أنه قرأ فى إحدى الصحف أن نفس رجل الأعمال الذى انتزع الأرض من سكانها وبنى عليها كل هذه الأبراج هو نفسه الذى يرعى الثقافة والمثقفين، وأن الصحف ربما تكون متجنية على هذا الرجل، الذى “ربما يكون هو قد وصل إلى المرحلة التى يجعل فيها الجميع يرحبون بما فعله فيهم ومعهم”، لا يهم، إنه لا يستطيع الجزم، وكل ما يفكر فيه هو الانعتاق، لقد آمن أنه من حق الجميع التصرف كيفما يشاؤون، حتى بمن فيهم سكان المدن الجديدة على أطراف القاهرة “أدرك أن كل شخص يحاول الحفاظ على إنسانيته بطريقته وبقدر ما يملك من أموال وعلاقات وحظوة، الأسوار باتت تحقق الحرية وتلبى مطالب البشر، وتحافظ على آدميتهم وآدمية أولادهم وأحفادهم”، كما أدرك كذلك أنه “لا مساومات فى هذه المدن المعزولة ولا فصال فى الأسعار، لا معارك ولا خناقات. إنها سجون ومدن فاضلة وراقية لا يعتدى فيها أحد على أحد، تستقبل النازحين من الأثرياء الجدد الذين راكموا رأس المال فى البلاد فى أيدى طبقة واحدة كانت تعيش فى وسط القاهرة أو على أطرافها من دون حراسة أو رعاية تتناسب مع قيمتها المالية”. ترك كل شىء وراء ظهره وقرر الهرب إلى أرض بعيدة، لكن الرواية لا تخبرنا صراحة بذلك، لقد جعلتنا نسقط فى فخ التوهم بأنه سينضم إلى صفوف المتظاهرين أمام نقابتى الصحفيين والمحامين، لكنه لم يلبث أن غادر إلى اتجاه لا يعلمه أحد، ولا تجزم به “كائنات الليل والنهار”، التى تنتهى مثل رواية أشرف السابقة “شَرْطى هو الفرح” نهاية خيالية، أقرب إلى الخرافة: “قال صبى إنه رآه يقفز وسط العصافير البيضاء ويحلِّق معها فوق صفحة المياه”، و”قالت امرأة مسنة إنها رأته بعينيها اللتين سيأكلهما الدود يصعد من المياه إلى الجزيرة”، و”صاح طفل صغير، مؤكداً أنه رآه يسبح وسط الأسماك الصغيرة، بينما أكدت امرأة أنهم لم يطلقوا عليه النار، وأنها رأته وهو يصعد من المياه إلى طرف الجزيرة، ويختفى داخل تلك الشجرة الضخمة التى تقف منذ سنوات طويلة على حافتها مباشرة”، تلك الشجرة التى لا نعرف يقيناً فى النهاية إن كانت ابتلعت حبيبته نبيلة أم لا، لكننا نعلم يقيناً أنها تحولت إلى شجرة أسطورية لا تستطيع مناشير الأغنياء قطعها، ولا بلطاتهم.. اقتطاعها من مكانها.
تلك الرواية ليست مرثية عن المدينة ولا عن شخوصها، فالطرفان مشاركان فى العلاقة وإن كانت المدينة أكبر من الجميع، أكبر من الفقراء ورجال الأعمال، أكبر حتى من السلطة، التى تدرك ذلك بدورها، وتقف على مسافة بعيدة من الفقراء، وأقل منها عن الأغنياء، السلطة التى لا تهتم سوى بمراكمة الأموال فى خزائنها، أموال الجميع، الفقراء والأغنياء، السلطة التى تشاهد من خلال كاميراتها المزروعة فى كل مكان ما يجرى، كيف تُغيِّر المدينة جلدها كل فترة، وكيف تبتلع البيوت والناس والعلاقات والأحلام، السلطة التى تنتظر بصبر كبير نتيجة الصراع، لتبدأ فى التعامل مع الكائنات الناجية من الحرب، الكائنات تحصل على وعد بالحياة فى نهار جديد، سيتبعه بكل تأكيد كابوس طويل.