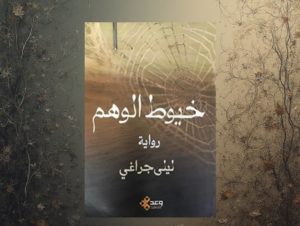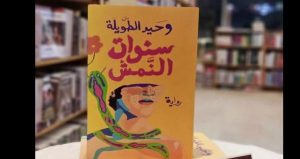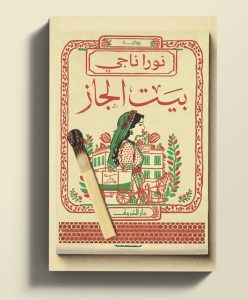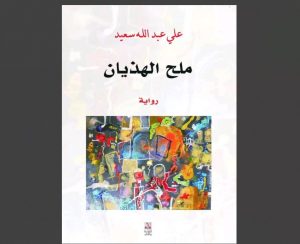د.عادل ضرغام
دائما يؤرقني سؤال لغة الكتابة النقدية، والمراوحة بين كونها عملية تؤدي وظيفة دلالية، وجمالها المشدود إلى الفن، ولدي شبه قناعة أن اللغة النقدية إذا فشلت في التقاط رهافة اللغة الشعرية تصبح هشة مخذولة، وأنها إن لم تفلح في تشييد بناء مواز للغة الشعرية مجال الاشتغال، تصبح داجنة غير فاعلة، وغير قادرة على التجاوز.
ربما كان تأمل الشعرية العربية في العقود الأخيرة، سببًا أساسيًّا في إثارة مثل هذه الأسئلة، فكثيرًا ما نشعر حين نقرأ بعض الكتابات النقدية، أن النقد المكتوب بلغته المستندة إلى إرث محنط ليس لديه قدرة على الاشتباك مع النص. والسبب الرئيس في ذلك -في ظل وجود أسباب أخرى بالضرورة- يعود إلى أن اللغة النقدية فقدت بريقها، هذه اللغة التي يمكن أن تتوزع إلى لغة متعالية باحثة عن دور معرفي سابق على النص -ربما هروبًا من إظهار العجز على المواجهة- أو إلى لغة لاهثة تستر عوارها بالاستناد إلى بلاغة قديمة، وتصر على مشروعية استخدامها، ومشروعية قدرتها على مقاربة نمط شعري لم يعد يستند إلى مثل هذه الجماليات البالية، ولم يعد يستند إلى تلك المناحي الفكرية القديمة، فقد أصبح وثيق الصلة بالجماليات خافتة الإيقاع، مشدودًا في ذلك السياق إلى ذوق فني يهتم بالبساطة، وقدرتها على صناعة كون شعري مملوء بالحياة.
وحدة الكائن وتوحده مع الإنسان
نشعر عند قراءة ديوان “أبيض شفاف” أن هناك إصرارًا على إسدال إيقاع الوحدة، فهناك ثمة نمط لا يغيره، هناك ثمة حياة جديرة بالاستعادة، والنسج على منوالها كل يوم دون تعب أو كلل، ولا يهشم ذلك النمط أو تلك الوتيرة من الحياة أي شيء يشعر المتلقي بوجود نتوء، كارتباط خاص بإنسان أو حيوان، أو تلهف لانتظار شيء أخضر قادم، أو منغصات مثل ذكرى تلح فجأة، فهي حياة أشبه بالوجود الطبيعي، مثلها في عاديتها واستمرارها على حالها مثل الظواهر الكونية التي تنبثق كالضوء الذي ينير صباحًا من فتحات الشبابيك:
ليس ثمة امرأة أهديها شيئًا
أغنية مثلًا
أو لوحةً تجريديةً
وليس في نيتي أن أفعل شيئًا ما في الصباح
سوى أن أكون ما أنا عليه
ضوءًا يتسلل من النوافذ المغلقه!
فالضوء الذي يتسلل كل صباح من النوافذ المغلقة يكشف عن ملامح ذات خصوصية لتلك الوحدة، فهي ليست الوحدة المفروضة، وليست الوحدة المختارة، وإنما هي وحدة الانعتاق من التعلق بالأشياء والآمال، وربما يكشف عن طبيعتها غير المبررة قوله في القصيدة ذاتها:
ولا أعرف، فعلًا
لماذا أنام هكذا على حافة السرير
بينما أستطيع التقلب على مساحته كلها؟
الديوان كله -أبيض شفاف- كاشف عن ذات تكتب تشظيها الصامت بصدق، وهي ذات غريبة كغرابة الكائن الخرافي الذي أسلم قيادة ذاته إليه، حيث يتسبب في وجود أسئلة عجيبة لا إجابة عنها يمكن أن تكون حاضرة، كما تجلى في السؤال السابق، وأدى إلى قمع الإنسان المشدود إلى مواضعات اجتماعية، وإلى نشوء منطلقات تدعو للغرابة والدهشة كما تجلى في بعض نصوص الديوان.
والكتابة الشعرية في ظل ذلك التصور حاضرة دائمًا، فقد حوَّل ذلك الكائن الحياة إلى كون شعري، يسدل عليه دهشة من نوع خاص في طريقة المقاربة، ليس لعجائبية يمكن أن تكون متوقعة، وإنما لعاديتها التي تصنع لها المغايرة والاختلاف. وهذا قد يبرِّر الشعور غير الصحيح الذي يمكن أن يلح على ذهن القارئ في كون الفروق الفنية بين الدواوين والقصائد الخاصة بالشاعر ليست كبيرة، وهي نصوص ثابتة، يتم تقديمها بآليات وكيفيات مختلفة.
السبب في ميلاد هذا الشعور يتمثل في فعل العادة والثبات وحالة الوحدة المستمرة، بالإضافة إلى حالة التماهي التام بين الإنسان والشاعر/ الكائن الخرافي، فليس هناك حالة من حالات الصراع بينهما، وإنما هناك حالة من التوحد والاندماج، والحياة في ظل ذلك التصور ليست مقابلًا أو قسيمًا للشعر، وإنما تتحول هي بذاتها إلى شعر، فتصبح الحياة نفسها أقرب إلى نمط شعر يضيق دائرة الانفتاح على الآخر البشري، ولا يرتبط به إلَّا في حدود ضيقة، تكفل له الاستمرار. فهو لا يتواصل مع الحياة مثلما يتواصل الآخرون، وإنما يصنع طريقة اتصاله بالحياة، بداية من الأصوات التي يحفظها وتطل برتابة محددة ونمط شبه ثابت، وانتهاء بالشياطين، ويؤسس لها بشكل مغاير، يقول الشاعر في قصيدة (كائناتي):
سيمرُّ الوقت.. حتما
وتتبدّل الأصوات بتراتب أحفظه
حتى إذا لم يتبقَّ غير النباح
أنامُ دون غياب كامل
وفي الصباح أسلِّم جثتي للضجيج
وللشياطين التي تتقافزُ
وأصوات الشقق المتلاصقة.
فالوحدة في الديوان هي الإيقاع الأساسي الممتد، وليس الفرعي أو الجزئي كما هو معهود ومعروف، وفي ظل هذا التصور، يبقى التواصل والارتباط بالآخرين هو الخروج الجزئي عن النمط الأساسي، فتتجلى الوحدة كأنها جرح منفتح، يسهم التواصل مع الآخرين في وضع قشرة رهيفة على الجرح المنفتح، ولكنه سرعان بعد العودة إلى الذات أن تطل الوحدة برأسها، وتطفر الدماء:
سأكون واقفًا عند المستشفى الجامعي
أصافح أصدقائي وحبيباتهن
اللواتي يكتبن قصائدهن السرية لي
وفي النهاية سأصير وحيدًا..
سأسير وحيدًا
يبدو الارتباط بالعالم في نصوص الديوان أشبه بموسيقى نسمعها بوصفها خلفية، ولكنها ليست فاعلة في تحريك زاوية الرؤية بعيدًا عن الذات، فهذه الذات تعيش في الوجود بوصفه إطارًا لا يملك له دفعًا، ولكنه يملك أن يحدد ملامح عالمه، ويختار جزئياته، وإن كانت جزئيات لا ترتبط بمنطق واقعي محسوس، لأنه يخلقها ويجهزها خيالًا، يتجلى ذلك كثيرًا في قصائد الديوان، فهو لا يحفل بالعالم الذي يعيش فيه، ولا يحفل بإقامة تواصل ممتد وقوي، وإنما تواصله مرتبط بجزئيات عالمه التي يخلقها، كما في قصيدة (المترو)، فتأمل الأصناف العديدة، ليس مقصودًا لذاته، ولكن المقصود منه تأسيس فكرة المقابلة بين عالمين، عالم مادي محسوس يحتوينا بمحطاته القدرية الجبرية، وعالم آخر مملوء بالوجوه والهواجس والشياطين، وكائن خرافي يشكلها، ويعطيها سمتها الرابض على حد تعبير النص الشعري (وأصعد السلم إلى قبر مكيَّف يخصني).
وهذا قد يشدنا إلى ملمح آخر من ملامح شعرية الديوان، في تجذير وتشكيل فاعلية الكائن الخرافي/ الشعر/ الظل، واستناده إلى المعرفة بما يحيل إليها من خلال الكتب، ففي قصيدة (فساد فطري) تتشكل ملامح المغايرة المشدودة إلى المعرفة من جانب، وإلى الكائن الخرافي من جانب آخر، فهو صاحب الدور الأساس في إسدال المغايرة والاختلاف، لأن لديه القدرة على النفاذ إلى جوهر الأشياء، ومن هنا تلح في بداية النص، جزئيات كاشفة عن عدم القدرة على الاستمرار في هذا العالم بمنطقه، وتتجلى نتيجة لذلك فكرة التحلل البطيء لفقدان المشاركة مع شبيه أو نظير. ويكشف النص الشعري عن انحيازه للعالم الذي اختاره مشيرًا إلى المعرفة والكتب بوصفهما وسيلتي تأسيس للمغايرة، وللكائن الخرافي، وذلك في قوله:
الساعة العاشرة مساء، الآن
وأنا ممدد على أريكتي لا أفكر فيما يتخطاها
ولا أحن إلى أحد
فقط، أكره الكتب المرصوصة بعناد
لأنها جعلتني يائسًا من قدرتكم
على رؤيتي
تأتي ملامح المغايرة واضحة، واضحة من خلال التسليم والامتثال للثبات، وعدم التعلق بشيء خارج حدود العالم الذاتي المحدد بنسق متوال، سواء أكان الأمر متعلقًا بتخطي حدود المكان، أو مرتبطًا بالحنين لغياب تتعدد أشكاله وأنماطه. وربما تدفعنا تلك الحال الخاصة بالقناعة والانعتاق من سلطة القادم المنتظر أو المتخيل إلى التوقف لقراءة إشارات لافتة تكررت كثيرًا في نصوص الديوان.
رماد الرجل الخمسيني
الإنسان بشكل عام -فضلًا عن الشاعر الأكثر حساسية وتأثرًا- في نزاله مع العالم في بداية الوعي المعرفي والإدراك يتأسس فكره على الصراع، وعلى مراقبة الآمال المطروحة للتحقيق على البعد، وتتشكل الآمال طبقًا للمرحلة العمرية التي يمر بها، فأحلام الصبا بالضرورة مغايرة لأحلام وآمال الشباب، وقد يتحقق بعضها أو لا يتحقق، وإذا تحققت فإن الإنسان بالضرورة ينتقل إلى أمل آخر يتعلق به، إلى أن تأتي مرحلة عمرية تزيد فيها مساحة الرماد الناتج عن احتراق الآمال التي لم تتحقق، وتبتعد الذات نتيجة لذلك عن فكرة التعلق، لأن هناك حاجزًا ممتدًا يفصل بينها وبين التعلق من جديد، أو هي -بشكل قد يكون أكثر صحة- تفقد قدرتها على صناعة الآمال والتماثيل التي تتوجه إليها بالتأمل والمراقبة كل صباح ومساء لمعاينة حجم المتحقق، وحجم المتفلت والمبتعد.
في هذه المرحلة العمرية تتأسس علاقة جديدة مع الكون، ومع الله، فتحقق الآمال مرتبط بسلطة عليا قدرية في المخيال العربي، يتوجه فيها الإنسان من مقام أدنى إلى مقام أعلى. وإذا ذابت أو تفككت مشروعية التعلق بالآمال، يصبح المدى فسيحًا، لتشكِّل قسيمين وفق توجه جديد، لا يرتبط بالنقصان أو الحاجة، وإنما يرتبط بالمحبة والمعرفة، المحبة التي لا تنفي تراتبًا قيميًّا وإنما تشكله في إطار حدس وشعور بالتواصل، خاصة في ظل حضور وتأسيس علاقة جدلية من جانب آخر، تتمثل في الكائن الخرافي الذي لا يخلو من قداسة. وفي ظل ذلك يمكن أن نبرِّر أشياء كان وجودها حتميًّا انطلاقًا من تأمل الحال بشكلها المجمل، ففي قصيدة (رأيت الله) ومن خلال تأمل الصورة المقدمة في بداية النص (لماذا كنت مشغولًا هكذا وأنا نائم- برسم صورة الله- كأنه يتمشى معي على شاطئ البحر)، ونبرر من خلالها غياب الحاجة للشكوى، أو الارتهان للحياة والاستمرار بها دون خوف:
كصديقين نتجرد من هواجسنا
أو كطائرين
هكذا تبدو الصورة قريبة
ليس كاللوحات التي تزين الفضاء
إنما كابتسامة عميقة
يستحقها خمسيني
لا ينام هكذا دون خوف
إن هذه المرحلة هي مرحلة التعرف المغاير على الأشياء، ومرحلة الوصول إلى عمقها، وإلى معناها الفلسفي، ومن ثم تذوب في إطارها الأشياء العادية التي يتعلق بها البشر دائمًا في مراحل سابقة، وتتبدد عواطف وأحاسيس كان هناك يقين وإيمان بديمومتها، فهذا الانعتاق يستند إلى معرفة واعية بحدود الأشياء، وبحدود العالم الذي لا يمنحنا فرصة لتجاوز المحسوس إلى ما سواه سوى بالامتثال والتسليم. هي حالة أشبه بالتدثر بالثبات والرتابة، والسير على طريق ممهدة بالتعود والتكرار، لا مساحة فيها لانتظار القادم، ولا مساحة كاشفة عن تكلف للقيام بأعمال لا يؤمن بها، فالحياة تمضي بالقصور الذاتي. فقد فقدت الذات نتيجة للرماد الذي يشكل طبقات زمنية متباعدة الرغبة والقدرة على الفعل:
الخمسينيون ليسوا رومانسيين قطعًا
ولا يحرصون على ترك انطباع جيد
لدى امرأة وحيدة
ممشوقة ومتعالية كهذه
ولكنهم ينفردون بذواتهم غالبًا
وينزفون شعرًا.
هي أقرب إلى الوتيرة الممتدة لحياة تؤسس وجودها من الاستنساخ اليومي المبني على التشابه بين الآني والسابق واللاحق، وتيرة مكونة من رتابة واستنامة. ويبدو أن الخروج من أسر تلك الرتابة يحتاج إلى محاولات عديدة، وإلى حدث يخلق هزة ليس من السهولة الوصول إليها، فما أصعب أن يتحول الرماد إلى جمرة متقدة، يكون لها دور وتأثير في الإطار المحيط بشكل عام. في نص (عدل الله) تتأسس ملامح واحدة من تلك المحاولات:
كم مهاتفةً تجعل فاسدًا خمسينيًّا
يصلح للمشي في الطرقات
يخالط الهائمين ويغني
مثلما كان
ويوزع صمته على العيون بعدل إلهي؟
النص الشعري هنا يجدل عالمين متباينين، أحدهما حاضر واقعًا فعليًّا، وهو الكاشف عن حالة التسليم والاستلاب، والآخر حاضر خيالًا بفعل الذاكرة والإحساس بالمغايرة في ملامح النزوع، بين العالمين، العالم السابق المملوء بالغناء وخضرة الانتظار، والعالم الآني المملوء بالانعتاق من التعلق بالآمال والقادم.
والشعرية المقدمة في كل عالم وفي كل مرحلة -حتى لا يتصور القارئ أن هناك ابتعادًا عن رسالة الشعر في سموقها- حاضرة بجلالها، حيث تبنى الأولى على فكرة النزال والصراع، وتتشكل حدود الثانية من المعرفة والمصالحة واليقين، تلك المعرفة التي يكشف عنها النص في النهاية في قوله:
ربما أحتاج مساحات أوسع لقدمي
ولكون ليس كهذا الكون
لمزيد من فناجين القهوة
ولجيوش النمل
كي أرى الله من هنا جهرة.
فمساحات الاشتغال والمقاربة حدث لها تحول نوعي، يمسّ ويقلم حدة المنطلقات الأساسية، فمنطلقات الأولى الغناء وما يصاحبه من حالة انتظار ومراقبة، أما منطلقات الأخرى فتتشكل في حدود الوعي الدائم والإدراك لطبيعة الكون والحياة، في كونها لا تستجيب بسهولة للأشياء المقترحة للتحقيق.
فالديوان بنصوصه يشكل حالة من حالات الثبات والوقوف في منطقة ما، لا ترتبط بالسابق، وإن كانت ناتجة عنه، ولا تتعلق بالقادم وإن كانت لا تملك ترف الانفصال بعيدًا عنه، لأنه -كما أشار في نص (الدم الذي يسيل في المقهى)- لا يكرهه تمامًا، ولكنه انتهى في إطار ذلك إلى مصالحة، تكفلت فيها طريقته بالدفاع عنه، وكأنها أسنان واضحة للدفاع عن الهشاشة النفسية، أو وسيلة من وسائل الاستقواء بالذات في وحدتها، محتميًا بكائنه الخرافي الذي يشاركه الحذاء والخطوات، في إسدال النمط الكاشف عن الحدة بشكل لافت للنظر، وعن المغايرة حتى لو كانت مشفوعة بالتسليم والبقاء في سياق خاص من ديمومة الثبات، يقول الشاعر في قصيدة (لست مشردًا تمامًا):
اسمي ليس مناسبًا لي
لا أمشي في طرق لا آلفها
لا أشتري هدايا لأحد ولا أقدم تبريرًا
ولا أقول “أحبك” لامرأة وأنا أعنيها
كما أنني سأموت على وسادتي ذات ليل
دون أن يشعر أحد بي.
آلية رصد الكون ورصد الذات
اعتماد الديوان على رصد الذات في حالاتها المختلفة التي تتكرر برتابة قاتمة قائمة على الثبات والوحدة، لا يعني أنه رصد يتم عن شخص في فراغ، وإنما هو رصد يرتبط بمقاربة ذات منفتحة على مجموع وعلى سياق، كان لهما دور فاعل في تنميطها على هذا النحو. هناك رصد للذات داخل هذا الكون الشعري المتخيل، ولكن الذات تهمل عامدة الكون الذي يدركه الآخرون، وتصنع كونها من منحنيات داخلية شديدة الخصوصية، مستندة إلى أصوات لها قدرة على الإشارة إلى تشابهات خفية، قد تبدو متناقضة في الظاهر، ولكن آلية الربط تقوِّض هذا التناقض الظاهري، وتحركه إلى ارتباط عميق.
رصد العالم في هذا الديوان رصد قائم على التغييب لا يتم الكشف عنه بشكل علني، رصد الإلماح دون الوقوف عند تفصيلات لا يوجبها السياق، ولا تسمح بها طبيعة النص الشعري المشدودة إلى أفق بنائي خاص لا يزيد كل نص من هذه النصوص عن صفحتين إلا في نصين أو أكثر، فهي نصوص لا تتوسل بزيادة إطنابية، وإنما تستند إلى صرامة لغوية. فالنصوص في هذا الديوان ليست مهمومة بتشكيل عالم محدد المعالم والأجزاء، وليست مشدودة إلى نتوءات أو إلى جاهزية بنائية تكمل عناصر الصورة، وإنما ما يجعلها مغايرة، ويجعل حضورها لافتًا يتمثل في تنضيد حياة مغايرة لكائن خرافي، يشكل العالم وفق هواه، ووفق هواجسه وإدراكه المعرفي، وانحناءاته الداخلية التي لا يدركها، ولا يدرك عمقها سواه:
أنا الشاعر الذي يعيد توزيع الكائنات
يصنع آلهة طيبين وأنبياء
يضع النساء في ركن
ويغني
بفساده الفطري
كي تحضر الشياطين لتؤنس وحدته.
تنضيد البناء الشعري في الاقتباس السابق لا يخرق مواضعة لغوية بشكل مباشر، وإنما يتجلى البناء من خلال جمل بسيطة، ربما تكون ممسوسة بنسق فكري ودلالات فكرية، مشدودة ومرتبطة بدلالة الشاعر/ الكائن الخرافي الذي يعيد تشكيل العالم وفق قناعاته، ووفق معان تندُّ عن المعاني المباشرة والهشة للألفاظ في تجليها الأولي، وخاصة معاني ألفاظ مثل (الآلهة، والأنبياء، والشياطين).
فالدلالة تنطلق من فاعلية الشاعر/ الكائن الخرافي/ الظل الموازي والمشارك له في تنضيد العلاقات والنزوع، والإشارة إلى قدرته في تشكيل كون شعري يتساوق مع العالم، ويتشابه معه في وجود آلهة وأنبياء وشياطين، بمعانيها الحرفية داخل هذا الكون الشعري، المشدود لكل ما هو بشري وإنساني في معناه الدقيق والبسيط.
إن هذا الإنساني البسيط الذي يتشكل من الوحدة الدافقة والمطبقة، ومن التكرار الدوري بشكل استنساخي حيث يتجلى في الحركة، وفي الأصوات الهادرة بالخارج التي حافظت نصوص الديوان على الإلماح إليها من خلال أصوات الجيران بفعل التلصص، أو حركة الوضوء، أو حركة عودة المصلين مشدود إلى المقدس وإلى السماوي في تعاليه، لأن محرك الذات وخالق الكون الشعري كائن خرافي يتجذر في سياق خاص يحاول أن يلمَّ شتاته، ويشكِّل نتوءاته، وكأنه يعلن عن غناء جديد، وعن شعرية ما زالت مؤمنة بدورها، ولو تحول هذا الغناء إلى نباح، على حد تعبير نصه، حيث يقول:
ليس بالشقة مكان لمنضدة وحيدة
لهذا أمرُّ بحنكة بين قطع الأثاث
الواقفة تلك
دون وظيفة محددة
إلا احتلال السماء التي لا تمطر، عادة.
الديوان كاشف عن مرحلة من مراحل تطور الشعرية لدى سمير درويش، فشعريته في ذلك الديوان هي شعرية التسليم والسكون، شعرية المغني الذي لا يستطيع أن يتوقف عن الغناء بالرغم من يقينه أن الإنصات إلى صوته لا يتحقق بشكل كامل، شعرية القنوط من أن هناك شيئًا يمكن أن يتغير أو يتبدل أو يؤدي إلى مغايرة، شعرية التوحد بكائن خرافي يشاركه الطعام والطريق، ويستبد في السيطرة، وشد الخناق.