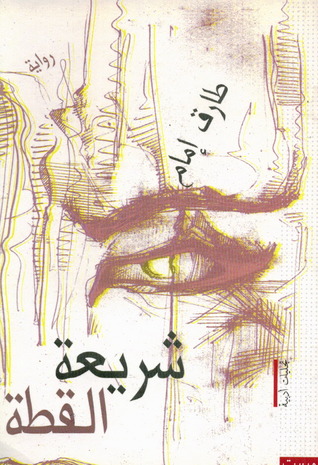محمد أبوالدهب
(1)
الرجل الذي فاحَ حضوره برائحة عطرٍ نسائي، والذي توقّفتْ سِنُّه عند السِّتِّين، وفقًا للمعلومات المتاحة على صفحته، قال: الحياة هتفضل لذيذة. وإجابةً عن سؤالي الخاص بموضوع القرف، وكنت واقفًا على حافة بئرٍ مملوكة لقبيلة بني عبس، مسحَ بكفّه الناعمة على شعره الحريريّ المصبوغ اللامع: مفيش قرف ولا حاجة. ابتسمتُ وقلت: ربنا يطمّنك. كنت نسيت أني سألت نفسي قبل دخوله: ما هذا القرف؟ وكنت غير مطمَئن.
(2)
تقدّم بطيئًا في الممشَى القصير. قمتُ إليه، على خوفٍ منه. لم أكن أعلم أنه لا يزال موجودًا. لم أكن أعلم أنه لا يزال قادرًا على المجيء. عندما صار معنا، وسط الحجرة غير المسقوفة التي تشبه صحن بيتِ أميرٍ من أكابر الدولة الطولونية، بسطّتُ ذراعيّ وقلت: أهلاً. قلت إنني جالسٌ معهم، نتبادل الكلام فقط، ولا نرتكب الأخطاء التي كانت -ولا بُدّ أنها ما زالت- تغضبه، وإنه يستطيع أن يمكث ليعرف بنفسه. وهو كان ينظر.
(3)
كانت الممثلة المعروفة (يسرا) واقفةً في فتحة باب الطائرة، تضحك وترحّب بالركّاب، وفخذاها عاريتان. من موقعي أسفل السلّم همستُ: كلّه تمثيل في تمثيل زيّ الإعلانات. زوجتي سعيدة؛ لأنها ستجرّب الطائرة للمرّة الأولى. وخطر لي أن الرحلة مجّانية. صعدنا. لدى مرورنا بالفنانة، إلتفتُّ إليها، وتذكّرتُ أنها مولودةٌ في نفس يوم ميلاد خالتي الصغرى. بثثتُ إلى صورتها القديمة إحساساً بالشهوة. الطائرة كانت خاليةً من المقاعد. والناس افترشوا الأرضية وقعدوا. لم يتركوا لنا حيّزًا لنفترشه ونقعد. استدرتُ لأقول لزوجتي إننا يجب أن نهرب. وزوجتي هربتْ.
(4)
وثبَ استشاري النساء والتوليد على السور. تسلّل خفيفًا. وصل في النهاية إلى غرفتي الضيّقة في السجن الواسع. وبسبب وضعه الاجتماعي وسنّه الكبيرة أخذت أحدّق إليه باستغراب. وكان رأسه برأس المرحوم أبي على واحدٍ من فروع شجرة عائلتنا رغم فارق السنّ بينهما. السجن لم يكن إلا سطح بيت امرأةٍ كنت أحبّها قبل ثلاثين عاما. ضبطتْني الشرطة عليه وحبستْني عليه. ناولني الدكتور جلبابا مخطّطا بالطول، وقال: إلبس وإجري. والسجناء من حولي يشجّعون. شعرتُ أني لا أقوى على الجري كما يليق بالمطارَدين. وتوقّعتُ أني وصلتُ إلى السطح، طامعًا في مضاجعة المرأة مرّةً قبل أن أموت. وأرعبتْني الغيرة عليها من الآخرين.
(5)
أخوض الحدَثَ بوضوح، بالألوان الطبيعية، التي كانت وما زالت أرفق بي من الديجيتال والإتش دي والبُعد الثالث. كنت أفعل شيئا، غير البيع والشراء، في أحد فروع محلات (المصريين) للأدوات الكهربائية. والفرع كان علي سكّة الحديد أمام قرية اسمها (كفر الجزّار). نعم نعم، كان رجلٌ مجهول ينتظرني في الخارج. أعرف ذلك بالإيحاء. ربما يقف بيننا مبلغٌ من المال. مع ذلك فالأمر لا ينقصه الوضوح. أنهيتُ فِعْلَ ما لا أذكر، ثم احتلمتُ.
(6)
ركبتُ قطاري ذاهبًا إلى العمل، وكنت بِعتُ السيارة واشتريته مع دفْع الفرق. القطار عبارة عن جرّار من النوع المجريّ القديم وخلفه عربة واحدة مكيّفة، لكن التكييف معطّل. مشيتُ به سلِسًا على الأرض دون التقيّد بالقضبان الحديدية. كان أسعد وقتٍ في حياتي، خصوصاً أن قيادة القطار لم تظهر بالصعوبة التي تخيّلتُها. عبرتُ الكوبري الذي يربط قريتي بالمدينة. وفتحتُ السّرعة في شارع الكورنيش الطويل الفسيح. فوجئتُ به يقف أمام فيلا قديمة على النيل. هل شددتُ خطأً الحديدةَ التي تربط الفرامل؟ فُتِحتْ بوّابةُ الفيلا، وخرج، غاضباً وبالزّي الميري، أمين شرطة يصرخ: يعني انت مش لاقي حتة تقف فيها إلا قدام استراحة مدير الأمن، خُد القطر بتاعك ده وغور من هنا. وأنا وقفت في كابينة الجرّار مذعورًا.
(7)
يأستُ من تشغيل السيّارة. الوقت ليلٌ متأخّر، ربما قُبيل الفجر. وأنا أمام البيت حائر، أريد مجاملة الجيران، والسيارة لا تساعد. قالوا قصائد شعر في مدح القاضي، الذي أقسم ألا ينهي الجلسة إلا بعد أن تحكمَ المحكمة. لم أفهم ملابسات القضية رغم أنهم تطرّقوا إليها بعد فراغهم من مدح القاضي. تذكّرتُ أني أعطيتُ أخي، قبل عدّة سنوات، سيارتين من طراز (فيات 128)، ليركنهما في المصنع الذي يعمل به؛ لأن جراج البيت صغير. كان واقفًا مع الناس. ناديته وكلّمته. قال إنه لا يذكر، ومادمتُ أنا أذكر فإنه سيفتّش عنهما في كل شِبر بالمصنع. أثناء ذلك دخل رجل طويل إلى سيارتي، وشغّل المُحرّك، وذهب بها كما لو كان يسرقها.
(8)
كنا نتجوّل في القصر كالضيوف. لا بدّ أن دعوةً ما قُدّمت إلينا. أتجوّلُ بمفردي؛ لأني لا أعرف أحدًا، ولأني أحبّ الانطواء. القصر ضخم، والغرفات كثيرة، والسلالم طويلة وحلزونية، والنوافذ مغلقة بزجاجٍ مطليّ بالأسود. الردهة نفسها شاسعة، حتى أني شعرت بالكسل عندما فكّرت في قطعها سيرًا. ومَنْ يستسلم لغواية الدخول فقد لا يتمكّن من الخروج. ولماذا لا يكون هو المكان الذي يصوّرون فيه الأفلام المخيفة، المتعلّقة بالظلام والأشباح؟ أما عن الممرّض الذي لم يكن يلبس رداء التمريض، فقد ارتقى ثلاث درجات ليصير فوقنا، وفَرَدَ الورقة الفلوسكاب بين يديه، وقال: يا جماعة، إللي يسمع إسمه يتفضّل يموت.
(9)
المرأة التي سُجِنتُ يوماً على سطح بيتها، أو على سطح بيت زوجها، جاءت لتنام عندي، في الحجرة التي لا أنام فيها، وأُخصّصها لاستقبال الزائرين. كانت مهتمّةً بالغطاء، وكلَّمتْني وهي تشدّ اللحاف على جسمها رغم حرارة الجوّ. لم أردّ عليها لأني لم أستوعب كلامها، ولم أرغب في قَوْل: بتقولي إيه ياحبيبتي؟ ولم أتحمّس لاستغلال الموقف، فأحاول مضاجعتها، المضاجعة التي تأخّرت طويلاً؛ لأن هيئتها كانت غريبةً جدّا، خلاف الهيئة التي اشتهيتُها قبل ثلاثين عاما. إضافةً إلى أن باب الحجرة كان مفتوحًا، وعدد من الغرباء يرقدون متناثرين في صالة البيت. رفع أحدهم الغطاء عن وجهه، وصوّب عينين مشتعلتين ناحيتي، وحذّرني: إحنا شايفين.
(10)
الحاصل أنّي واقفٌ، وحدي، ليلاً، في المقابر، أمام قبر مفتوح ومضاء بلمبة نيون، وأرضيّته مفروشة بالجثث. أنظر إلى الأمام وأنظر إلى الخلف، وأتلفّتُ يمينًا ويسارًا، ولا أقدر على إخراج صوتي لأقول: أنا خايف. رأيتُ إحدى الجثث، يرشح كفنها بالدم. الرشح متسارع، حتى أنه غطّى ما يمكن أن يكون النصف الأعلى للجثة. لا أقدر على تحريك ذراعي لأغلق الباب على الجثث والدم. لا أقدر على إطلاق ساقيّ للريح. الحَلُّ الوحيد أن ألتجئ إلى الجثث فأصير جثة. لكنّ الحاصلَ أني واقفٌ، وحدي، ليلاً، في المقابر، أمام قبر مفتوحٍ ومضاء…
(11)
“نُهى جريشة صوتيّة”. هذا ما قرأتُه على شاشة التليفون، التي كان تدفُّقُ ورودِ الاتّصال يُضيئها. كنت في غرفة مغلقة، أتصرّف بطريقةٍ تدلُّ على أنها غرفتي، لكنّني لستُ مَن رتّبَ أشياءها. كانت أقرب إلى مكتبة عامّة صغيرة، في بيتٍ من بيوت الثقافة؛ فالجدران محجوبة برفوف الكتب، والمناضد تلفّها مقاعدُ تنتظر محبّي القراءة. حين رنّ التليفون لم أتنبّه تمامًا لأن النغمة مختلفة عن نغمة تليفوني. ولما ألحّ الرنين تتبّعتُ الصوت إلى أن عثرت عليه بين كتابين. لم أكن أعرف “نهى جريشة”، ولم أتبيّن إنْ كان “صوتيّة” هو اسم جدّها أم أنه إشارة إلى رسالةٍ صوتية منها. عندما سكت الرنين وقعتُ في الظلمة.
(12)
وجدتُني جالسًا معه خارج ورشته على طريق (بنها – شبين القناطر). نصف كنكة الشاي مدفون في وقود النار المحمرِّ على الراكية. كان وسيمًا بصورة لافتة للنظر. جاءت سيارة “جيب” مصنوعةٌ حديثًا. سمعتُ أبوابها تُفتح ثم تُغلق ثلاث مرات. رأيت امرأةً تصلح أُمًّا للثانية وجدّةً للثالثة. الحفيدة كادت تبكي وهي ترجو الوسيم أن يساعدها لتشحن بطارية تليفونها. وصل ابن خالي بسيارته نصف النقل. جلس معنا حول الراكية. كانت بينه وبين الوسيم صداقة قديمة، حتى أنه قصَّ عليه حكايته مع بنت الجيران، التي صفعَها أبوها على قفاها مرّةً بسببه. بعد أن شرب الشاي أخذ سيارته ورحل. تركني وحيدًا على الطريق.
(13)
الشارعُ يشبه الشارعَ الذي وُلِدتُ فيه. لا أزال أزعق على الناصية. عناصر الأمن العام يحاصرون المحكمة من جميع الجهات، مع أن شارعَ مولدي كان منزويًا بقريةٍ معزولة. وكنتُ راضيًا بالإسهام في واقعةٍ خطيرة. الزعيق كان من أجل توفيق الأوضاع بين طرَفين، كلاهما يصرُّ على التنكيل بالآخر. أوشكتُ أقنعهما بالجلوس للتّصالح، لولا أني أَسقُط الآن من ارتفاعٍ غامض على غابةٍ من أشجارٍ عملاقة ناضرة الخُضْرة.
(14)
كأنه معتقل المغول في النسخة الأولى من الفيلم، كان السجن كبيرًا وعتيقًا. وكنتُ حُرًّا، داخله؛ أتنقّل بين الأقبية، وأشاهد أغشيةَ العناكب، عنقوديةً وراسخةً في كل ركن. ثم حُشِرتُ مع السجناء إلى القبو الأسفل، الذي كان أوسعَ، ويُشبه الذي ثقبَ “أنور وجدي” حائطه. تمنّيتُ لو أعيش عمري فيه، لكنْ بصحبة زوجة وأولاد ولمبة (نمرة 10) التي تعمل بالكيروسين، على أن تكون خِلْفتي إناثًا فقط. الحرّاس جعلوني زعيمَ المحبوسين، فقمتُ فيهم أصرخ وأهدّد، ولمّا هدأتُ أراني أحدُهم الطلاسمَ المرسومة على ذراعه. كان يشغلني حتى لا أقاوم عندما يحيطون بي ليكسروا دماغي في حجارة الحائط.
(15)
خرجتُ أقول لهم إن الدماء تسيل في الداخل بسبب 17 جنيهًا. شكلُهم يُنبئ أنهم باشوات؛ لهذا قهقهوا بالضحك. أحدهم، بالفعل، يضع طربوشًا أحمر على رأسه. الداخلُ مدرسةٌ من المدارس الخاصّة المحترمة. والخارجُ حديقةٌ صغيرة ملحَقة بناطحة سحاب، ويحدُّها سورٌ عالٍ. ظللتُ أدخل لأتلصّص، ثم أخرج لأُخبر الباشوات. ولما ظهرتْ المطربة (صباح) على هيئتها في فيلم (العتبة الخضراء) تركتُ كل شيء، ومشيتُ وراءها. شاهدتُها تطلب من وكيل المدرسة السماح لابنتها بالانصراف قبل موعد انتهاء اليوم الدراسيّ. أخذتْها وصعدت السلّم وفتحتِ الباب بالمفتاح. وأنا تعجّبتُ من الحياة، وقلت: يا فنانة، هو حضرتك ساكنة في المدرسة؟
(16)
طاردتُ القطّة، وفي نيَّتي قتْلُها. إنحرفتْ إلى شارعٍ يتلو بقالة التموين. أوقفتُ المطاردة؛ لأن مَدخَل الشارع أعلى من أسطح البيوت، ولا يوجد كوبري. رجعتُ ألمُّ ما سقط منّي أثناء المطاردة: الفلوس وبطاقات الرقم القومي والتموين والخبز. أتى رجل وفي يده أجندة، قال: أنا رحت لك الشغل. فتح الأجندة على صفحتين بينهما قلم جاف. قلت: إزيّك يا مصطفى؟ طلبَ عشرة جنيهات قيمة الاشتراك الشهري. أعطاني القلم بعد أن أشار به إلى خانة التوقيع. دفعتُ ووقّعت. لما ذهب قلت: والله العظيم ما هو مصطفى.
(17)
في مطبخ شقّتي، شربتُ العصيرَ الأصفر الفاقع من الدّورق مباشرةً. إحدى زميلات العمل أدهشها اختفاءُ زميلتها بمجرد دخولهما معًا من الباب. لم نكن في الإدارة الصّحية. أنا قَرَّعتُ المرأتيْن، ولا أرى إلا واحدة: كيف تقتحمان شقّتي؟ والموجودةُ صارت عاريةً، وجسمُها على صورةٍ تُمكّنني من وُلوجها وأنا واقفٌ مكاني. حملتُ الدورقَ لآخذَ شَربةً قبل العملية. شربتُ والتهبَ حَلْقي واستدرت. رأيتُها عادتْ كاسيةً، واقفةً باستقامة. ضحكتْ وقالت إن العصير يخصّ الزميلة المفقودة، وإنها عصَرتْه بيديها.
(18)
طلبوا حضوري على وجه السّرعة، لاستلام المولود. أرسلوا رسائلَ نصّيّة. كنت رجلا قديمًا ومشتاقًا، لهذا هرولتُ إلى الغرفة المجاورة. ضحكتِ المرأة وهزّتْ خصرها، ونقلتِ المولودَ من حضنها إلى حضني. حملتُه، ورحتُ أقبّلُه، وأشمّه. كانت رائحته عجيبة، خليطًا من طيّباتٍ وخبائث. لا أدركُ كيف تأتَّتْ منه، غير أني أرومُ دوامَها. وأقمتُ دهرًا، أقبّلُ وأشمّ، إلى أن مات في يدي. أخذوه ودفنوه. توقّفتُ عن التقبيل ولم أتوقّف عن الشَّمّ.
(19)
انقضَى اليوم على كوبري المشاة. جمعونا ليقدّموا لنا النصائح. بدا منظرنا مثل مُشاغبي المراهقين، الذين يحتاجون إلى العرْضِ على الاختصاصيّ النفسيّ جلسةً أو جلستيْن لتعديل السُّلوك، مع أن أصغرَنا تجاوز الخمسين ويفكّر بالموت. سمعنا عن وجود أفعى على الكوبري، تعبره الآن من جهةٍ إلى جهة. سادت البغضاءُ بيننا سريعًا، وتصارعنا على النزول. حاول ابن عمّتي، مدرّس اللغة الفرنسية، إيقافنا: ارجعوا يا جماعة، دي كلّها إشاعات. لم أكن أصدّقُه؛ لأن ابنة زوجتي أخذت عنده درسًا خصوصيًّا، ثم رسبتْ في المادّة. أزاحوني من طريقهم، فسقطتُ على وجهي أسفل السلّم، ورأيتُ جِلْدَ الأفعى ملسوعًا بالنار، ولا يزال شيءٌ في جسمها ينبض، وتأكلُني بعينيها.
(20)
الرجل في بيتي، يقيس الفتحات في الحوائط، ليُثبِّت مكانها أخشابًا، نقول عليها، دون مراجعة، أبوابًا وشبابيك، مثلما قلنا على الرجل نجّارًا. والنجّار لم يسكت لحظة، وكلامه لم يكن فصيحًا بوجهٍ عام. أسمعُ، وأسير وراءه من الحجرة إلى المطبخ إلى الحَمَّام. رأيتُ خمسةً وسبعين جنيهًا على الأرض في المَنوَر. ثلاث ورقات: خمسون وعشرون وخمسة. ركعتُ والتقطّتُها. النجّار قرّرَ أنها ضاعت منه عندما كان هنا سابقًا. وأنا لا أعرف أنه كان هنا سابقًا. خجلتُ من مجادلته؛ لأن أسرةً كاملة (أب وأم وابنتان) يسيرون ورائي منذ بدأ هو يقيس. كانوا دخلوا من الفتحة التي ستصير بابًا، ليعزموني على زفاف إحدى البنتين.
(21)
أمِّي، التي لها في الموتِ أحَد عشر عامًا، لم تكن ملفوفةً بالأبيض في الأبيض. فقط تلبس الجلباب الأخضر بالورود الصفراء، الذي اعتادتِ القيامَ فيه والنوم فيه منذ اشتراه أبي. عبَستْ، ولم تُحوِّلْ عينيها عنّي. كانت تصدّق أني طرَف المعادلةِ الخائن. مرَّ الوقتُ ولم تظهر الحقيقة. نزلنا إلى شاطئ النيل بعد أن زحَمَ الناسُ الكوبري. على صفحةِ الماء كان مسلسل (أبو زيد الهلالي) معروضًا، وكانوا يردّدون في التّتر: أبو زيد هيفضل معانا. خرج من الماء عددٌ من العاملين بالمسلسل، وأكّدوا لها أنني على الحقّ والآخرون على الباطل. وهي صعدت الكوبري وحدها.
(22)
ظهرت المرأةُ التي أحببتُها قبل ثلاثين عامًا، راكبةً خلفَ زوجِ أختي الذي أحيل إلى المعاش ونظرُه ضعيفٌ جدًّا. وقعَا على ظهريْهما، والموتوسيكل فوقهما. كانا عائدَيْن من عزاء الفقيد. جلستُ في العزاء ما سمحَ لي بالاعتقاد أني عملتُ الواجب. ولما قمتُ لأسعى تذكّرتُ أني نسيتُ العودة إلى ضابط المباحث. وهو كان صرَفَني من مكتبه، وقال: روح خُد لك دوش، وصوّر الصورة دي نسختين وتعال. وشاهدتُ نفسي في الصورة، صبيًّا نحيلا، أمدُّ يدي إلى السيّد المحافِظ لأتسلّم شهادة التقدير. وفكّرتُ خائفًا بأن حرصه على استحمامي تمهيدٌ لاعتقالي. وفكّرتُ مخدوعًا بأن الرجلَ والمرأة يمكن أن يكونا تلامسَا أثناء الركوب، أو حتى بعد السقوط.
(23)
تردّدتُ في النزول حين دخل الشيخُ منكوش الشعر. جلس معنا في المكتب كما يجلس الواحدُ مع عياله في البيت. تكلَّم كثيرًا فضحكنا كثيرًا. والكلام لم يكن مُضحكًا، لكن الشيخ يعاني من (فصام اكتئابيّ مُزمن)، ولا نضمن ردَّ فِعله في حال لم نضحك. لمّا اكتفيتُ استأذنتُ بأدب. لم يمنعْني، أو لم ينتبه. في الطُّرْقة، تفاديتُ الاصطدام بشابٍ يرفع ورقةً بيضاء كما يرفع المحاربُ عَلَم بلاده. سمعتُه يسألهم عنّي. جريتُ، وجَرَى الشاب. أثناء سقوطي الذي طالَ، خشيتُ أن تنكسر ساقي فلا أشهد الجنازة.
(24)
مع بدْء العَرْض، وكنتُ واقفًا على خشبةِ المسرح مُفرَدًا، خايلني شعورٌ كالتَّوهُّم بأني سأقذف. سواء داخل فَرْجِ المرأة، الممدّدة عارية على السطح الرّخاميّ لسور جمعيّة تنمية المجتمع المحلّي، أو ناحية الرّجل الذي يؤدّي تمرين الضغط، عاريًا، على حصيرة مفروشة في زاوية من زوايا مركز الشّباب. وخوفي الأكبر أن ينزل الماء في الفراغ، لا يدري مَنبعه من مَصبِّه. قاومتُ بشدّة حتى لا أُضطّرَّ إلى الاستحمام في هذا البرد. ثم أخذني دفء القذف، بعيدًا جدًّا عن سور الجمعية وعن زاوية المركز.
(25)
الحاجّ (مُنجي أبوشحتّو) يسير أمام بيتنا برقبةٍ مكسورة إلى الخلف، بحيث تدلّتْ على ظهره بين المنكبين. والحاجّ يمشي إلى الأمام وينظر إلى الوراء. وأنا واقفٌ مستند إلى سور الفرندة أشاهد. هو قال: سلامو عليكو، أصل أنا عندي جلطة. ومضى وقد أَوْلاني دُبُرَه وعينيه. دخلتُ البيت، فوجدتُ الناس مجتمعين، الأحياء منهم والأموات. وأمّي التي كانت أوّل الأموات موجودة، ووضعتْ لي ثلاث ملاعق سكّر في كوب الشاي. وكنت أشرب وأفكّر في زيارة الحاج (مُنجي أبو شحتو) حتى لا يقول إني علمتُ بمرضه ولم أهتمّ، على أن يكون ذلك من وراء ظهورهم حتى لا يقولوا إنني معرّضٌ للإصابة.
(26)
أثناء انتظاري وصول السيّارة التي تحمل الأثاث من دمياط إلى بنها، حضرتُ مؤتمرًا أدبيًّا، نظّمه إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي. الأدباء يجلسون على الكراسي سعداء، لا يتوقّفون عن شرب القهوة والشاي، ويتجادلون. ورأيتُ جَدّي (العراقي الجوهري)، الذي هو خالُ أبي والذي لم يمُتْ إلا بعد أن أكمل مئة عام، قاعدًا على الأرض، يحاول إقناع أحدهم بأنه كاتب قصّة جيّد. لم أكن أعرف عنه هذه الحكاية، أقصد كتابة القصص مثل الأدباء، وكنت أسمّيه (حارس القبور)؛ لأن الغيطَ الذي يزرعه يُطِلّ على المقابر، وهو يجلس هناك من الفجر إلى المغرب، ويحفظ متى ماتَ وأين دُفن كل الذين ماتوا. واسترقيتُ النظَرَ إلى الكرّاسة، وقرأتُ القصة. كانت قصيرة جدًّا، وتشي بقاصّ واعد. جاءت سيّارة العفش، ولم يساعدني أحد.
(27)
الصعود والهبوط مستمرّان. الأطفال مسرورون لأنهم حلقة الوصل بين الدور الأرضيّ والدور الثالث. مرّةً ينزل كيس سمك بوري من أجل مائدة الإفطار في رمضان. ومرّةً يصعد مدرّس لغة عربية من أجل مراجعة ليلة الامتحان. والصّغار الخمس ينزلون مع النّازل ويصعدون مع الصّاعد، ولا يتعبون. لم نتمكّن من التصالح، أو على الأقل اتّفاق هُدْنة. ما أَلحظُه ولا أفسّره أن البيت صار أكثر حيوية بعد موْت ساكِنيه. أحد الأطفال وضعَ حدًّا للموضوع، لما هبط وقال: بيقول لك إنه عاوز ينام مع الستّ بتاعتك. وأنا كنت القائمَ بأعمال الدور الأرضي.
(28)
فتحتُ الشُّبّاك. في الحجرة ليلٌ، وفي الشارع نهار. زجرتُ الأولاد. إنهم يريدون تدريب الكلب ليصبح شخصًا عاديًّا مثلنا. وأنا أريد أن أنام. ولكي أبدو حاسمًا قلتُ شيئًا عن النجاسة، وعن التّيمُّم بالتراب سبْع مرّات. العيال ردُّوا بأنهم يعلمون، وإن لديهم طموحًا في أن يصيروا أنجاسًا، ولديهم أيضًا صفحة بهذا الشأن على الفيس بوك. ضغطتُ زرّ البحث على جوجل، فانغلق الشباك، ليستغرقني الليلُ.
(29)
هي صاحبة الحقّ والكلام. خطرَ لنا أن عطف كلمة (الكلام) على كلمة (الحق) بابٌ من أبواب اللغو. لم نحدّد شخصَ الناطق على أية حال. هي تقول إنها مصابةٌ بجروح مثلما نحن مصابون. لسنواتٍ طويلة تدّعي ما ندّعيه. رغبتُنا لا تتزعزع في رؤيتها عارية. تتبدّى دائمًا نصفَ عارية. ولم نكن نناديها باسمها مجرّدا. الإصابة الأولى كانت في الرُّكبة، والأخرى أعلى حاجب العين اليمنى. لو لم يكن عندها حياءٌ لأنبأتْنا بالتفاصيل كلّها. سمعنا أنها (أم شيماء) المُطلَّقة. حتى هذا لم يكن كافيًا؛ لأننا لم نعرف إلا اسم ابنتها. انصرفوا عنّي، وأنا بقيتُ أحاولُ التَّذكُّر.
(30)
بينما (عمرو دياب) يغنِّي “راحل” ويكرِّر اسم الفاعل كثيرًا، دخلتْ مرعوبة. تركتْ لي تليفونها: واحد اسمه (يوسف) بيعاكس. وضعتُه على أذني، وسَببتُ دِينَ (يوسف) ودينَ أهله. جاء ضابطٌ في الجيش، والرُّتبة على كتفه غير واضحة في العتمة. خاطبَها من دوني: يوسف بيقول لِك اركبي تاكسي بسرعة قبل ما يعمل فيكي حاجة. لم أكن أنتوي عملَ حاجة. مع ذلك غضبتُ: خدي قرارك دلوقت. ورجّحتُ أن أكتبَ عليها إيصال أمانة، وأن أجعله على بياض إذا أقرَّتْ أنها نامت معه، لكنّي ضحكتُ لما أتى يوسف بنفسه لإنقاذها. كان وجهه مُخيفًا جدًّا.