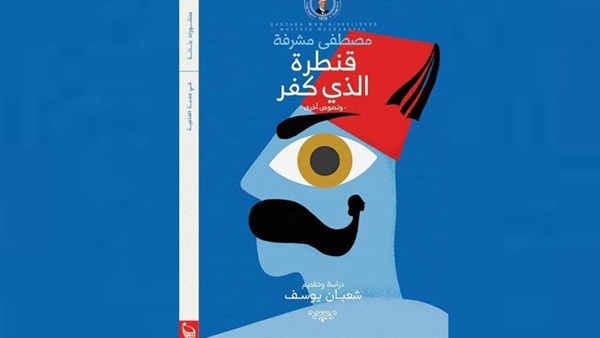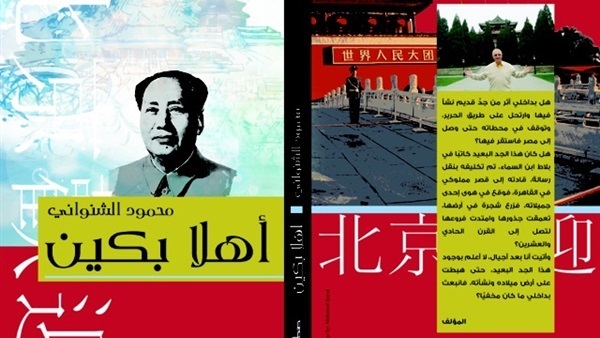حسن عبدالموجود
رغم أن رواية “قنطرة الذى كفر” نُشرت عام 1965 إلا أنها لا تزال صالحة لإثارة الدهشة حتى الآن، وهى رواية رائدة، لأنها من أوائل الأعمال المكتوبة بالعامية، وصاحبها أستاذ جامعى، ينتمى إلى مجتمع حاول طوال الوقت أن يترك مسافة ضخمة بينه وبين تلك اللغة، انطلاقاً من مبدأ ثابت، أن الفصحى هى لغة الأدب، وانطلاقاً كذلك من نظرة متعالية، نظرة لا يمكن أن تركن بسهولة إلى أن العامية قد تخلق عالماً عظيماً بمفردها.
كان من الصعب الإيمان قبل هذه الرواية بإمكانية كتابة عمل روائى بهذه اللغة، لكن العامية هنا ليست مثل تلك العامية المطمورة تحت أكوام من التراب، وقد بدا أن الدكتور مصطفى مشرفة قد أجهد نفسه فى البحث والتنقيب وإزالة الطبقات والزوائد والأتربة عنها حتى وصل إلى جوهر يبدو مثل خيط ذهبى لا نهاية له، خيط ذهبى ينسيك أن هذا الأصفر المتلألئ هو مجرد حروف عامية، وسوف يذوب الفارق بين الفصحى التى اعتدتها، وبين هذه اللغة الجديدة، فهى لا تقل جمالاً، وباستطاعتها كذلك تشكيل صور وخيالات مبهرة برع فيها مشرفة بامتداد الصفحات، والآن أليس مدهشاً، أننى أتناول رواية بالعامية وأنا أكتب بالفصحى؟ هذا أيضاً ينطبق على ما فعله الأستاذ شعبان يوسف سواء فى تقديمه أو دراسته الوافية حول الرواية أو القصص القصيرة الأخرى التى حواها كتاب “قنطرة الذى كفر وقصص أخرى”؟ هذه قضية قُتلت بحثاً ومع هذا لم نصل بعد إلى إجابة شافية، ولم يعد بمقدور الكثيرين منا الإيمان بتجاور هاتين اللغتين، ليس من باب التعامل مع العامية باعتبارها اللغة العرجاء التى تحتاج إلى معاملة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمثيلها بقدر ضئيل فى بعض النصوص السردية، أو إغلاق الباب عليها فى محميتها الطبيعية “محمية شعر العامية”.
لم يكتب الأستاذ شعبان يوسف شيئاً فنياً حول الرواية مفضّلاً أن يترك للجميع حرية إبداء آرائهم، مكتفياً بما قدمه من جهد رائع حول قضية العامية فى الكتابة والإبداع بشكل عام، والصراعات والمعارك العديدة التى جرت فى الصحافة المصرية منذ أكثر من قرن، كذلك اكتفى بإشارة فى تقديمه إلى القسم الثالث من الكتاب وهو بعض قصص أخرى كتبها مشرّفة كذلك بالعامية مدللاً بها على أن “تجربة العامية لم تكن نزقاً أو نوعاً من التمرد، بل كانت تجربة تنبع من قناعة راسخة لديه”، ولكننى سأكتفى بكلامى هنا عن الرواية.
تدور الرواية حول عالم الرَّبع، وهو مطرح فى عابدين، فى زمن ثورة 19، ومحاولات الوفديين، بزعامة سعد زغلول، قيادة المصريين للخلاص من كابوس الاحتلال الذى كان مظلة لحكم ملكى لا يضع المصريين فى الاعتبار، لكن الرواية لا تجذب الثورة إلى السطح، وتتركها هناك، فى تلك المنطقة الغائمة، التى تبدو مثل خلفية بعيدة، صوت ضعيف للغاية ينطلق من بعيد، لم يكن معظم أبطال الرواية يعيرونه انتباهاً فى البداية، لكنهم مع استمرار انكسارهم وتبدد آمالهم فى حياة جميلة، ولإحباطات شخصية كما جرى مع كامل الصعيدى ومع الشيخ عبدالسلام “قنطرة نفسه” انجذبوا إلى ذلك الصوت، فقد وجدوا الخلاص فيه. لم يكتمل حلم كامل الصعيدى بالزواج من امرأة زلزلت كيانه بمجرد رؤيتها، امرأة سمينة وجميلة هى فاطمة الدلالة، امرأة كانت تقرض الجميع المال بحسب مستوياتهم، وتحجبه عمن لا يستطيع السداد. تلك المرأة السمينة دار حولها، كذلك، صراع محموم بين الشيخ قنطرة وعلى أفندى، الاثننين الوحيدين اللذين اعتبرت أنهما يليقان بها وبمستواها.
كانت ثورة 19 بالنسبة لبعض أبطال هذا العمل فرصة لبداية جديدة، لإحساس بأن هناك أملاً ما، يمكن أن يدفعهم للإكمال، خاصة وأن كثيرين منهم فكروا فى الانتحار، كامل الصعيدى مثلاً فكر أن يقتل نفسه وأن يقتل فاطمة الدلالة وأبوأرنبة وعليهم خمسة ستة، كما فكر – ولا يدرى لماذا – فى أن يخنق البنات فى سن الـ12، لكنه قمع كل هذياناته تلك، وكل وساوسه، كما قهر جحيم الكراهية الذى ملأه تجاه العالم، ووضع نقطة ليبدأ من أول السطر، وبالتالى فإن مشرّفة لم يجعل الثورة بطلاً، لم يجعلها هى الأساس الذى تنبنى عليه الأحداث، بل إنها ظلت شبحاً من بعيد، مجرد معارك جانبية نسمع عنها أو نراها فى بضعة سطور بين الجنود الإنجليز الذين لا يرحمون، ويتعاملون بالرصاص، إنهم وقود الحركة السرية وقد كانوا يتحركون كأشباح فى البداية ومجرد أسماء لا نعرف إن كانت حقيقية أم حركية، لكنهم يبدون مع النهاية أشخاصاً كاملين من لحم ودم، مثل سى عبدالعاطى المغدور، وسى محمد الذى يُكمل الرحلة حتى آخر سطر من الرواية.
لا يمكن القول فقط إن الأشخاص هم الأبطال ولا المكان كذلك، وإنما البطولة مقسومة بينهما، فى معظم الحالات يبدو الرَّبع متحكماً فى حركة الأبطال، المكان هو ما يتيح لعبدالسلام أن يرى “سيدة” تجلس حزينة على بُعد خطوات من أمها الكفيفة، راسمة خطوطاً بأصابع قدمها على الأرض أمام عتبة جُحرها، متخيلاً أن هذه حيلة ابتزاز منها، المكان هو ما يسمح لفاطمة الدلالة أن تقف فى طريق الشيخ قنطرة “رايح جاى”، المكان هو ما يسمح لبُحلق “وراقب الاسم جيداً”، أن يراقب الجميع طوال اليوم، المكان هو ما يسمح للجميع بالتنصت، كما تنصت كامل الصعيدى على فاطمة الدلالة وهى تقول لأبوأرنبة إنها ترفض الزواج من شخص صعيدى، المكان هو ما يجعل معركة حامية تندلع بين أربعين شخصاً على الأقل لمجرد أن سيدة قد ألقت مياه الغسيل من النافذة ليسقط على عجين أم عجوة، وبالطبع لن يفلح معها أى كلام حتى ولو من عيّنة أنها مياه وضوء الشيخ قنطرة، المكان هو حياة فاطمة الدلالة التى تظل تدور ببؤجتها حسب خطة شهرية كما يقول الكتاب لتوزيع البضاعة، أو لجمع الغلة فى أول أربعة أيام من كل شهر، متعرضة للأزواج المتحرشين والظريفين ونسائهن المخدوعات والمتنمرات.
المكان يظل دائماً الظل الظليل للجميع، يخرجون منه ليروا العالم الواسع حولهم، لكنهم سرعان ما يعودون، يذهب الشيخ قنطرة إلى حيث المتعة مع مومسات الجندى، لكنه يعود مسرعاً، يذهب كامل ليرفّه عن نفسه لكنه يعود محطماً فى نهاية اليوم، تذهب أم كمال لتبحث عن رزق الله الواسع وتصطدم بأبوالسبح فيعلمها أصول الشحاتة، وتنتهى القصة بفضيحتها على يد المعلم حنفى، لكنه أبوالسبح يعرض عليها الزواج، وأول شىء يفكران فيه، هو العودة إلى الرَّبع، وحدها سيدة المسكينة تموت منتحرة عند عاصم باشا كلب الاحتلال، والذى ظل الشيخ قنطرة يذاكر ابن الرومى سنوات ليكتب على شاكلته قافية فى نفاقه، أملاً فى أن ينشرها ذات يوم بالأهرام، وهو ما سيتحقق بالفعل.
الوحيدة التى كان خروجها ضد إرادتها هى “سيدة”، تلك المرأة المسكينة المغلوبة على أمرها، التى مات حبيبها أحمد بعد قصة حب رائعة، أبدع مشرفة فى تصويرها، خاصة فى الحوار بينهما عن الرغبة الجنسية، التى تكشف عن احترام أحمد للمرأة، وعدم اعتبارها مجرد وعاء، رغم أنه ابن منطقة فقيرة تنهش فيها الوحوش أجساد النساء. سيدة لم تختر طريقها، وإنما اختاره لها الشيخ قنطرة، يدرك قنطرة – فى لحظة صدق مع النفس – أنه عمل قواداً، حيث اصطحب سيدة بنفسه إلى عاصم باشا لينال جنيهات يستطيع بها الذهاب لتمضية وقت ممتع فى الكباريهات، لكن سيدة التى رفضت كثيراً امتهان جسدها على يد “على أفندى” قاومت عاصم باشا كثيراً، لكن إرادتها تحطمت تحت وطأة التهديد بعدم منحها مالاً تصرف به على أمها، وهكذا وحتى تنهى عذابها المتجدد بأنها خانت حبيبها أحمد أكثر من مرة قررت الانتحار. لقد خانته حينما كان يموت حيث رفضت طلبه البسيط بأن تجلس إلى جواره، إذ شعرت بالقرف من منظره. كان “عضماً على لحم” وهو يموت، وقد عافته، وقد أنّبت نفسها كثيراً بأنها كان يمكن أن تمنحه الحياة لو جلست معه قليلاً، ثم شعرت للمرة الثانية أنها خانته حينما سمحت لعاصم باشا أن يدخلها، وحينما انتحرت جاء الدور على الشيخ قنطرة، العائد لتوّه من فرنسا، ليشعر بأنه المسؤول عن موتها فيقرر الالتحاق بالجهاز السرى للثورة.
الرواية ليست مأساة كاملة، ليست عالماً ضاحكاً كاملاً، إنما قشرة من الضحك لا يملك صناعتها إلا ساخر كبير تخفى فى جوهرهاً حشواً حالك السواد، لكن الأمل يتجدد فجأة حينما ينتبه الأبطال أخيراً، أو بعضهم على الأقل، إلى أن هناك حدثاً استثنائياً عنوانه الكبير “الكرامة” وهو ثورة 19، وبالتالى يقفزون فى مياهها النظيفة، وكلهم أمل فى نيل التطهر والخلاص. هذه رواية لم تأخذ حقها الكامل رغم عدد الدرسات التى كُتبت عنها، فشكراً للأستاذ شعبان يوسف ولدار بتانة على أنهما أعادا إحياءها من جديد.