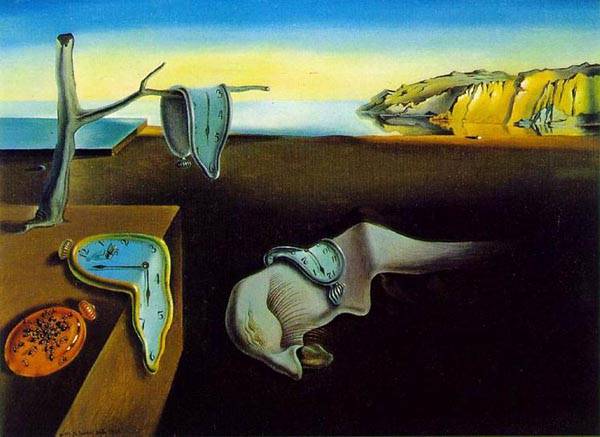شيماء عيسى
منذ تعارفا كانت إشارات البصيرة تخبرها مجتمعة بأنه وليس غيره من سيصحبها في نهاية المطاف؛ إنها مواءمات القدر
ظلت تتحاشى نظرات الأهل المحفزة للحظة الاعتراف بالمرأة، أو الظهور بالأبيض في ليلة العرس! .. تتظاهر برعاية كل مشروع مؤجل يزور بيتهم، ويحمل سجل انجازاته في التعليم والحياة، حتى سليل تجارة الآباء وراعيها الرسمي!
تدخل غرفة الضيوف، أنفاسها مضطربة، وجهها وردة حمراء أوان زهوها؛ تضع صينية العصائر والحلوى.. غير بعيدة تجلس من ذلك الذي جاءت به إحدى قريباتها، لتنفك معه عقدها الكئود!. .
يسألها فتتحدث عن الاستقرار وكثير من تفاصيل السعادة؛ تلمح غبطة عينيه وزهوه؛ يفتعل النكات والثرثرة المغرية بالحديث؛ يتنقل ما بين مكارم الأخلاق الضائعة في زماننا، ليدلف إلى ذلك السؤال البريء “هل ستواصلين العمل لو تزوجنا؟” .. تجيب بصوت مستقر : “أكيد!” .. يضحك بنبرة مختلفة وتتلعثم كلماته ثم يمتد الحديث لمنطقة الرضا بالنصيب!
في كل مرة يبدو السؤال عاديا، فما يكون من جندي يدافع عن حصنه إلا أن يتأهب لقول “لا”؛ هل دفاعا عن ماضي أو حاضر أو مستقبل إذا لم يحمل الضيف في سلته فاكهة السعادة المشتهاة..؟!
بصوت شفوق تخبرها أمها أن فتيات العائلة تتزوجن، فتنسحب لركن قصي من حجرتها، وتعيد فك قيود الحرير، تلتمس الأنس من بضع نجمات لامعة في محيط الليل الطويل، وتغرق في سنا إحداهن الأبيض الشفاف؛ تقفز في خاطرها كلماتها في الإذاعة المدرسية، لوحاتها وأشعارها التي ظلت تنقشها حتى على كتاب الفيزياء، الأتوجراف الذي يحمل كلمات عن تلك الفتاة الاستثنائية في حياة زملاء الدراسة، أو ذلك الذي أهداها أول كتاب فمنحته أول دقة صامتة وابتعدت، وصولا لأول قفزة فرح بتسلم العمل.. كانت ومضات كفيلة بانتشالها من الغرق
تجاوزت الخامسة والثلاثين!؛ وكل عام يحمل 365 يومًا وليلة بالتمام؛ لا تعلم أن بينها عاما غير كبيس؛ أو ليلة لا ينكمش قلبها كعصفور مبلل كسير؛ تدعو ألا ينال منها الوهن؛ وإن حدث فلا يطفو على السطح ويعكر كل شيء..
عليها أن تزيح في الصباح كل ما كان بنذر يسير من الرتوش؛ تستعيد بهاء روحها، وتغمرها السكينة مع الصلاة؛ تنساب مع البشر الملونين في الشوارع؛ تتحاشى ما قد يساء تفسيره؛ تعود على سطح السماء التي ترمقها من نافذة الحافلة صور من تمنتهم من أعماق روحها؛ حتى صديق أخيها الذي جاورهم في شاليه المصيف منذ كانوا صغارا وهو يهديها عقد من الفل وقطعة أيس كريم، وذلك الذي ظلت تكتب له المحاضرات المنمقة في الجامعة وترسلها بحجة غيابه، أو الطبيب الذي زاد ألمها بلطفه غير المتوقع! .. وكل من تجاوزتهم بمرور ساعة و بمرور الزمن ، فكان “كل شيء نصيب” ؛ تتشابك خيوط ووجوه أمامها، فتزفر ما تبقى من أحلام في كأس الرضا الكبير..
لا تعرف لماذا اليوم تصر على تجاهل إشارة زميلها الطيب في العمل، وكأن مسا قد أصابها من مجهول، وقد اندفعت بفرح طفولي يليق بالصباح نحو كوب الكابتشينو الذي تعده لها عاملة البوفيه.. تتفرس قلبًا جميلا رسمته لها بحبات البن المحمص على رغوته البيضاء.. تكبت ضحكة تفضحها غمازتاها وانطباق عينيها الكحيلتين .. هل كان عليها أن تحرم من هذا الكوب كل صباح؟!
…..
يوليو 2019