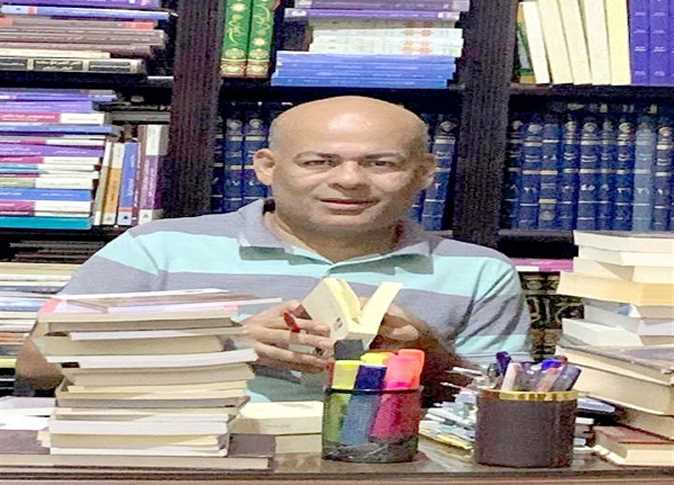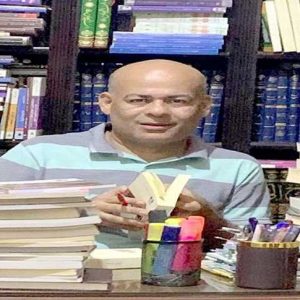محمد فيض خالد
البوسطا جا
لم يكن أهل القرية يعرفون في دُنيَاهم من أُبّهةِ السُّلطِة، وصَولجان الحكومة؛ إلّا هذا الصُّندوق السِّحري، له جبروتٌ ترَبّع كَصنمٍ معبود في فؤادهم، قوةٌ تُسكَبُ كُلَّ يومٍ من فتحةٍ مُظلمةٍ داخل جدارِ بيتِ شيخ البلد، تعبثُ فيهِ يد ” سمير ” البوسطجي مَطلعَ كُلّ نَهارٍ، يشبع الحَبّارة، ثم يُخرِجُ ورقته بعد إذّ أغرقها حبره الأزرق المُنعِش، تُجلّلها العظمة، هَيبة الميري وجبروته، تدورُ عيناهُ في المكانِ قبلَ أن يعمد إلى سلسلةِ مفاتيحه، فَيغلِقه يزهو السُّرور أعطافه. يتريّث قليلا، ريثما يعتصر عينه الضّيقة، ثمّ يطلق صيحةً مكتومة تنَسابُ بعد جَهدٍ صَفيرا مُضحِّكا:” يا أبو الفتوح، وزّع الجوابات وراس أمك”،تتعطّل عجلة الحياة عن دورانها، تتوقف كوانين النّار، ويَبرد أوارها المُشتعل مُنذ الفجرِ، تذوبُ أصواتُ الزرازير في جَوفِ الفَضاءِ، المُمتلئ بالعائدين على الجُسورِ، مُنذُ عرفت دراجة ” سمير ” الأطلس السَّوداء طريقها لقريتنا، التي احتضنها المجهول، والنّاس في أنسٍ منها، تَحملُ إليهم الخَيطَ الذي يربطهم بدنياهم، بَاتَ الشّرّ والخَير سواء؛ فاصِلا من التَّرفيهِ قنعوا بهِ وارتضوه عِوضا عن سَأم المعيشة، تدورُ أحداث حياتهم مع بدالِ دَراجتهِ، ما إن يَلمحهُ الصّغار، حتّى يتهالكوا عليهِ، يُحِيطونهُ في زَفةٍ عَارمةٍ:” البوسطا جا.. البوسطا جا “، في بداياتهِ كَرِه هذا الصَّخب يهشّهم بعنفٍ، لكن بمرورِ الأيام سَلاه، طالما اسبَغَ على مَقدمهِ هَيبةً، وجَعَلَ من شَخصهِ موضع حَفاوةٍ وتقدير، هناك حَيثُ تَدورُ رحى حَرب ضَروس بين ” صدام وإيران ” يَتَسمّع العالمُ فظائعها وأهوالها، يصل قريتنا من مآسيها ما تنَخلع له القلوب، يُهرِوُل الغَلابة جهة ” البوسطا ” ينتظروا بفارغِ الصَّبرِ مقدَمه، دعواتٌ تُرفَع، وأكف تتلقى ندى الصّباح الطاهر في ابتهالِ المُنقطع؛ أن يحفظَ الله الغائبينَ، تندفع ” نفيسة” تَزُكّ بعَرجَتها، تَضرِبُ صَدرها اليّابس بِكَفٍّ وَجِلة، مبهورة الأنفاس:”وبركات يا سمير أفندي مفيش جواب له، بركات وياهم في بغداد “، يشرع صاحبنا مُتأزِّمَا في توزيعِ الخطابات، يُلقي بها مُناديا بلكنةِ تعالي، يهتفُ بهِ هاتف الكبرياء، ساعتئذٍ خشعت الأصوات فلا تسمعُ إلّا همسا، تنفجر الحَناجر ملبية في خُشوعٍ:” أفندم.. أفندم”، يتَشمّم العجَائزُ الأظرفَ في خبلٍ ولوعة، تتقاطر الدُّموعُ سَخية، يعلو النّشيج، يقطع السُّكون المتراصّ صوت فتاة ناهد، مُفعَمَةٌ بماءِ الصِّبا، تُطَالِعها العُيونُ في خَليطٍ يتلظّى وحَرّ الظّهيرة، يخدش صوتها الهدوء كما خدشَ جمالها العيون، يرميها صاحبنا بجذوةِ خُبثٍ من عَينيهِ، تقولُ غيرَ مُكترثةٍ في ميوعة:” مفيش جواب من أبويا يا عمّ سمير؟!”، تتفتّحُ من عينيهِ ينابيع الرّجاء صافية، تترنّح الكلماتُ فوقَ شفتيهِ، أخيرا استطاعَ قمعَ رغبته المحمومة، ينَكبّ كَالمَجنونِ ينبشّ الحقيبةَ، ناولها الخطاب ووجهه مُزبّدا مُتغيّر القسمات، تلقفته في تغنّجٍ صارخ، قبل أن تنفلت كزهرةِ النّرجس تتلاعب بها الرِّياحُ في يومٍ عَاصِف، ينفضَّ الزِّحام، فيسرع ” ابوالفتوح” فيحضرَ كوب الشّاي الثقيل، يتَناوله ” سمير ” في لهفةٍ، يدسّه بينَ شفتيهِ الغلاظ، يحرِّكَ سيجارة من خلفِ أذنهِ لزوم الدِّماغ، توارث النّاس في قريتنا مهابة ” البوسطا”، فكلامه لايُردّ، تجف تقاطيع ” سمير” وهو يُبرِز مظروفا كبيرا مُنتَفِخا بالأوراقِ، وخواطره السّعيدة تمرحُ أمامه، يرد بكلمةٍ واحدة فيّ هدوء:” الحلاوة.. الحلاوة “، يسيل الابتسام في تجاعيدِ وجه العجوز الواقفُ أمامه، يدسّ يده في جيبهِ، يغيب للحظاتٍ ثم ينفحه المعلوم.
انصرمت الأيام جاحدة، لم تسلم قريتنا من هجمةِ الحَداثة، بهتت مكانة” البوسطا”، وعلا غبار النّسيان صندوقه السِّحري، بعدما حلَّ بهِ الكَساد، أصبحَ عبئا لا يُحتَمل، ذاتَ صبيحةٍ، نَزَلَ ” سمير ” من فوقِ دراجته، بدت الوجوه على غيرِ مألوفها، تنتزع التّحيات في فتورٍ مقلق، شيّعهم بابتسامةٍ هازئةٍ، حتّى صاحبه ” أبو الفتوح ” اتخذَ مكانا وسط لاعبي ” السيجة” شيعه بنصف عينٍ ثم تَابعَ لعبه، تَحاملَ ” سمير ” على مضضٍّ، جاهد كي يضحك، فعصاه الضّحك، ألقى التّحيةَ على بيتِ شيخ البلد قائلا في إيجاز:” غدا سوفَ يحضر رجال المصلحة لأخذ الصندوق”، ركبَ دراجته مارِقا يغشاه الصّمت الرّهيب، لحظتها أدركت أنّ القادم لن يُعَوض الماضي..
**
أم مرسي
في تبجّحٍ أُنثوي مُستَفِزّ،تقَشعرّ مِنهُ جُلود الذين يخشون العيّبَ، تَفجّ” أم مرسي” حشود الرِّجال المُتَراصّة فوقَ الدِّكك، تباغِت أسماعهم بصوتٍ يُجلّجل، تُلوِّحُ بخرقةٍ اصطبغت بوهجِ الدّم القاني، تُبعثِّر النَّظرات باشّة،تقولُ بعَفويةِ الخَبير:” وشوبش يا حبايب “، تستثير حُمرَة القماشة الجَمع الذي أصابته رِعدة الخَجل، اجبرت البخيل و المُعثِر فيهم؛ لأن يبقرَ جيبه، يَنتَزِع القرشَ من أذنيهِ في ارتياعٍ تنفطِر لهولهِ القلوب، لمقدمها تَضطربُ مفاصل النّساء، تمرّر والدة العروس يدها فوقَ رأسها، وكأنّ الشّيطان يلقي في أذنيها، عاقدة اللِّسان مبهورة الأنفاس إلى أن يحلَّ المساء، تُبرِز ” أم مرسي” مَحرَمتها، لحظتئذٍ تَستردّ الوجوه الشّاحِبة ابتسامة تُخالِط نَضارتها، صَغيرا تَسللُت لغُرفةٍ امتلأت بالإناثِ تقَدّمَ فتى أخضر العود على جَبينهِ نفحات النُّور، تتأرجح كسَفينةٍ في بحيرةٍ تهوي بها الرِّيحُ، اطلقت عروسه لرؤياه صَرخةً ملتاعة، جاهدت لتفكّ قيودها بعد إذّ نَشبت بها أيدي النّسوة في ضَجعةِ الذّبيحة، جَالَ صاحبنا ببَصرهِ مَفزوعا، وجَبينه ينضَحُ بحَباتِ عَرقٍ كما البلور، يتلاحق صوت لُهاثهِ وقد غامت الدُّنيا أمامه، يُطَالِع فريسته التي غشيتها سكينةَ المُستَسلِّم، اطلقت ” أم مرسي ” شخرةً مخيفة، برّقت في اهتياجٍ؛ فبدت كوحشٍ مفترس، فكّت حصار يدها من حَولِ خصرها، عَاجَلتهُ بلطمةٍ خَلخَلت أسنانه،صاحت مُوبِّخة:” خشّ عليها يا مره يا خِرع”، رويدًا سرى تيار الآمال المُنعِش في أوصالهِ، ليندَفِعَ كمَا الثّور، مُتحرّرا من خَجلهِ، امسَكَ بالخرقةِ البيضاء مُنتزِعا من فتاتهِ أعزّ ما تملك أنثى، امتلأ الفَضاء بالزغاريِد وأهازيج الشّرف، مشى العَريسُ مُستَطِيلا، يُخرِجُ للدُّنيا لسَانهُ بعد إذّ حَاوَلت إِذلالهُ، تمسك بالمحرمةِ يتناثر دمها الحَار، لتبدأ بذوي العروس الذين شُدّت شواربهم في شموخٍ، بعدما جاهدوا تحَتَ غاشيةِ الأماني، تقول بنات القرية عنها في امتعاضٍ:” هذه المرأة قاسية، لا تُميّز بينَ اللّحمِ والحَجرِ، لا تعرف إلّا الدّم”، تسبقها سمعة مشرطها الذي لا يُخطئ هدفه، فمشاعر القلق التي تسبق حضورها الدّامي، عالقة في أذهانِ البنات،وهي تتحسّس بينَ الأفخاذِ، من خَالطَ هذا الغول عن قربٍ يَشفع له، تقول عن نفسها وهي تمَسح يدها في طَرفِ جِلبابها، يَتموّج دُخان سيجارتها على وجهٍ نحتَ الزّمانُ مسالكه:” وهو فيه حد فينا بيختار قدره، جينا كدا وهنطلع كدا”، انقطعت فترة عن المجئ، هبطت القرية ” غزلان” الدّاية، أتى بها ” جلال ” الخفير نكايةً فيها، حَمَلَ ” فوزي” بائع الفخار ذَاتَ صَباحٍ نبأ الوفاة، مرّ كحدثٍ تافه:” لقد وجدوا أم مرسي مذبوحة في بيتها، قتلها عاطلٌ وسَرَقَ مالها “، لم تتوقف الحَياةُ لمصرعها، لكنّ زفارة الدّم المسفوح خبت هنية من قريتنا، ريثما يُؤذن لها.
***
الدُّكان
ظلّت لسنواتٍ أجهلها؛ مغارة ” علي بابا” ممتلئة بما يسيل لرؤياه اللّعاب، لم تكن كنوزه ذهبا، بل شيء من مُغرٍياتِ الطُّفولةِ البريئة، حبات الكرملة وقِطع الطوفي وأقماعِ الجَلاّب ودقيق السُّكر المطحون، سألت بإلحاحٍ عجاىز دربنا عنها:” متى يا تُرى بُني هذا المعبد الرّصين؟” لم اظفر بإجابةٍ شافية، تُعَاجِلني ” رسمية الدّاية” بصوتها الأبحّ الغليظ:” وأنت عايز إيه منها؟!”، تلوي بوزها في امتعاضٍ، وتعاود ترمي ببصرها الجدران، وكأنّ سؤالي يستفزنا هي الأخرى، تعوّدت أمرّر يدي فوق ” طلاسة” الطين اتحَسّس بقايا الجير الأملس، أجدني وقد انجذبت إليها؛ أمدّ طرف أنفي المدبّب اتلقى تيار هواء بارد، قادمٌ مِن فتحةٍ صغيرة في جسدِ بابهِ الخشبي وقتئذٍ يُجَنّ جنوني، امتصّ بلا هوادةٍ روائحها المُنعشة بردا وسلاما، تَتراقص في مخيلتي صور شتى، أغوصُ في أحلامِ يقظةٍ هانئة، تترقرق الفرحة في عينيّ مُتلهيا، اخال المعجزة وقد تحقّقت، انفَلَقَ الخشب إيذانا بتدفقِ ما حَوته الأرفف من طيباتٍ، تتمشّى على شفتيّ ابتسامة مهزومة اتلمظ كقطٍّ جائع، يمتلئ صدري بأريجٍ روائح ٍمُسلية، خليطا من الفانيليا الشّهية، سرعان ما تربكني مُشاكَسات أبناء الدّرب ومضارباتهم، انتزع نفسي في تشظٍّ من هذا البراح السِّحري اعضّ أصابع النّدم، يظل ” الدكان ” كامنا في عجرفتهِ عَصيّا على الزّمنِ، يجذب القلوبَ إليهِ كالصَّنمِ الذي لا يشَبعُ من القرابينِ، تكسو بابه الخشبي ونوافذه المشرعة مهابة ووقار، تلحظ كُلّ هذا في بواقي طلاء بني محروق ينبئك عن عزٍّ غابر، ترميه خيوط الشّمس حين تحبو من فُرجةِ المشرق، فتكسوه ثوبا قشيبا، لم تكن المشاعر حِكرا عليّ وحسب، بل كانت وردا ظَلّ يُردّدهُ أبناء الدّرب من المحرومين، الذين تهافتوا كالفراشِ، يُسَبِّحونَ بحمدهِ بُكرةً وأصيلا، ارتموا كطائرٍ نُتِف ريشه بجوارِ العَتَبة، يَسكبوا من قلوبهم الأماني، يتهامسون بنجوى؛عسى أن تُصيبهم نفخة من نفحاتهِ، علاقتي” بالدّكان” نمت مع أولى حُروفِ الهِجاء، ومع قطع الطباشيرِ اخطّ كلماتي المُهتَزة فَوقَ جِدارهِ، سريعا وجدت من الجُرأة لاعلن عن نفسي في جملٍ قصيرة ركيكة المعنى، يكتمل المشهد إغراءً وتحتكم الشجاعة، فانزع إلى رَسمِ شَخصيةٍ هزلية ” للأفندي” صاحب الدُّكان، رأسٌ دقيق، وأنفٌ كبير، وعصاة معكوفة، وضحكات تخرج من فمهِ:” ها ها ها ها ” تعودت الغضب يكسو نبرانه، شَرِه النَّظرات يُحملِّقُ كالذِّئبِ الجَريح مُنفعِلا:” دي قلة أدب مقصودة “، كان صاحبنا من الغفلةِ، في أن لا يعتقد بأنّ سميره الوفي وجليسه المُخلص هو الفاعل، لم يكن على وئامٍ مع دُكانهِ، يهجره أسابيعَ طِوال لا أحد يدري وجهته، إلّا “زكريا” الحصري، يقول في ثقةٍ وهو يبرم ورقة البَفرة:” إنّه يعمل في مصنع السُّكر في قوص ملاحظ عنبر التوريدات ” يعودُ بعدَ غيبةٍ، يحمل ” فتحي الكلاف ” فوقَ حمارهِ، أجولة وكراتين، بابتسامةٍ غريرة؛ يُمرّر يده فوق الحِمل:” لقد عَادَ ليملأ الدّكان بخيراتِ الله، ربنا يجعلنا من محاسيبه”، لا يعترف أبدا بالهزيمة ولا يقرّها في قاموسه، استطاع أن يجذبَ عقولنا بخيطٍ رقيق مِن حرير، فعلى الرُّغم من خلوِ الأرففِ،ظللنا نتسمّع من ثقبِ الباب ضحكات علب الحلوى، ورنين حبات السوداني واللّب، وزَمجرة قطع البسكويت، يَرجعُ مع خيوطِ المساء يفتح الباب على مصراعيهِ، يُطالِعُ قرص الشَّمس حينَ يخنقهُ الأُفق، يعتصر آخر قطرة من حياتهِ، وعلى مَقربةٍ من ” الكلوب” يُرسل فحيحه المأزوم، يشعَ نوره الأبيض النَّاصع، يُعلِّن عوده صاحبه، ذَاتَ مساءٍ عَادَ ” الأفندي” بعدَ غيبةٍ طويلة، استنفدنا معها كُلّ الصّبر، كرهنا الدُّكان ومللنا روائحه، التي بدت كئيبة، فلم تعد تحمل غير السّأم والزّهق، مشى بخطواتٍ متثاقلة وشّحته الشيخوخة بثيابها الخانق، وما إن تحرّكت شّمس النّهار البرتقالية جهة الغروب، حتّى اغلَقَ صاحبنا الدُّكان، خَرَجَ مُتأفّفا يلعن تصاريف الزّمن، يَضربُ كفا بكفّ، أكَلَ السّوس الأرفف، والتهمَ النّمل ما تبقى من البضاعة، فترك المكان قاعا صفصفا، قالَ في ابتسامةٍ واهنة:” لقد انتهى كُلّ شيء أيها الملاعين “، اجتمعنا من حولهِ كدودِ الأرض، تجللّت جبهته الفرحة كطفلٍ أهوج، جَعل يضحك في نهنهةٍ تُشبه البكاء، يشاهدُ مُتَسليا الوجوه وقد لطخها دقيق السُّكر المطحون.
مَرّت الأيام عَصية، وفي سَاعةٍ مُبكِّرةٍ، اطمئنَ قلبي بعد معاناةٍ، جعلت اُفتّش في شغفٍ عن كتاباتي القديمة، في زاويةٍ من زوايا الجدارِ، وجدتها وقد خلت ملامحها، تبحثُ مُتأرجحة عن الحياة، نظرت من حولي ومن نفس الفتحة مددت أنفي الكبير، لكنّي لم أثرا مما كان..
***
الشّارِد
الجّوع أهون ما يَلقَاهُ في حَياتهِ البائسة، تكالبت عَليهِ مُنذ خَرَجَ من بطنِ أمّه الضّيق، تشعّبت مسالِكه مليئة بالأشواكِ، تُحَملِّهُ أوجَاعا لا يجد عنها مَصرِفَا، حتى ميراث أمّه الذي بنىَ عليهِ عريض أماله، التهمه خاله ودفنه في بطنهِ، حَملا لا يُريدُ أن ينزل، يُردّد في القريةِ كلّما خلا بصاحب ٍفي عَنجَهةٍ وجَشَع: ” كيف يذهب كدّ الرِّجال وعرقهم للأغرَابِ؟!”، بدى ” صلاح” في أسمالهِ البالية مضَعضع الإرادة واهن العَزيمة، دائم الشِّكاية من دُنياه سَاخِطا على أقدارهِ، يُشاهِد شُحُوب وجههِ الطباشيري الباهت على صفحةِ مياه المصرف، يمرّر يدهُ فوق عظامه الناتئة، وقد اعتكَرَ صفاء روحه، يهمس بصوتٍ فيهِ أنّه المكروب:” ألاَ من سَبيلٍ للخلاصِ من هذا الشّقاء، لماذا كُتِبَ علينا الفقر دون العالمين؟!”، تعرّت الحَياة في نظرهِ، نفضت عنها ما يَستر قُبحَها المشوّه، يسعى المسكين وراء حلمٍ غَامض وراء قشّة الغريق، استسلم لهُ حتّى سدّ عليهِ مداخلَ نفسه، تلتمعُ في زوايا روحه خيالات يظنّ أنّ معها الخَلاص من كآبةِ حياته الشَّوهاء، عَاشَ يَغبُ من هذا الإحساس، يُدير خياله الخصب المهتاج مُثرثرا بلا غَضَاضةٍ في كُلِّ مكانٍ، يُديرهُ عينيه في سَقَفِ الجَريدِ المُتَساقِط من فوقهِ، يُشيَعه في حنقٍ يزمجر، لحظتئذٍ يقصّ عليه والده في انكسارٍ قصصِ من سَاروا سيرته، أولئك الذين خَرَجوا ذاتَ يومٍ ولم يعودوا، شَيَعتهم القريةُ إلى كُهوفِ النَسيان لتَحتويهم، بعد إذ جَاهروا بالعصَيانِ، حَمّلوا أنفسهم فوقَ احتمالها، ضَجَروا وبَطروا، قادهم الشَّيطان لمزالقِ الرَّدى وتلك عُقبى الخاسرين، يتراقص الغضب في عُروقهِ، يَنفث أنفاسَ الخيبة، لتنَساب ضحكات حَسيرة تَهتزّ الجُدران الصّامتة بوقعها، يرمي والده بنظرةٍ ساكنة، يبصق على الحائطِ مُتأفّفِا، ثم يندفع إلى الدّربِ لا يلوي على شيء، سئمَ حياة الرِّيف وملَّ أهله،يتنمّر في نظراتٍ محمومةٍ، تُنبئ عن زهدٍ، يُشَعشعُ في رأسهِ بُركان يفورُ ولا يَهدأ، لكنَّه يَركنُ إلى عُزلةٍ يلتقط معها أنفاسه، يخال نفسه وقد هَجَرَ هذا كُلّه، مَاَلَ على هراوةِ فأسه فحطّمها، فأسه الذي استعبده كأسلافهِ من قبل، خيالات تحومُ من حوله، تلفّه في عالمٍ وردي، ضحكات من سبقوه تجوس مراتعَ النّعيم، حياة بلا تعب أو نصَب، ذابوا وسط زِحَام المدينة، خاصموا الطّين وعادوا أهله، ” مختار” حرامي اللّيف، هَجَرنا مُنذ سَبعِ سنواتٍ، انقطعت أخباره، اللّهم إلّا هَمسَا يَدورُ أمام الأفرانِ وجلسات العَزاء، أخباره يحملها على استحياءٍ ” عطالله” سائق اللوري:” كويس، عنده نصبة شاي جنب المحكمة، والأشيه معدن “، لكن ماذا يصنع مع ” زينب” ولم يُصَارِحها بعد بحبهِ، تُرى هل تعلم بهِ وبتبَاريح عشقه؟!، يُقلقه إصرارَ والدها، وأنّى لفقيرٍ مثله حظّه من دُنياه التعاسة أن يستميل الرّجل !، بعدما عَقدَ العَزّمَ أن يزوجها ” مجاهد ” مالك الطاحونة، إنّ اقسى ما يخشاهُ؛ أن تَخبو في قَلبهِ جذوة آماله، أن يَصبح وقد وجدَ نفسه بين عشيةٍ وضُحاها نَسيا منسيا، بعدما تَمشّت بهِ أيامه، كَانَ الصَّباحُ رماديّا، لاحت شُخوص الكائنات باهتة يغشاها السُّكون، وبَينما تتَسلّل أشعة الضُّحى مُتخاذلة تحَتجزُ مَكانا لها وسط الأفقِ المُلتهَب، طَارَ الخبرُ المَشؤوم يَلِفُ القرية:” اختفى صلاح، هَرَبَ ليلا ولن يرجع “، لَملَمَ ثيابه وغادرَ في صمتٍ، انتزعَ نفسه بعدما تخبّط عمرا في أوحالها، نَزَلت الفَاجعةُ كالطَلّ البارد على قلبِ والده، لم يستطع الرَّجل تحمل الصّدمة، فَلزِم بيته يبكي ابنه يفَيضُ في عزائهِ.
مرّت الأيام سريعا كمألوف عادتها، تَطمسُ أثرا وتُحيي آخر، بهَتت سيرة ” صلاح” مِن مَجالسِ النّاس، تَهبُّ علىَ فتراتٍ مُهتزّة وَجلة، قال ” عطا” المراكبي:” رأيتهُ يتوسط حلقة ذكرٍ في مولدِ سيدي القنائي، لكنّه زَاغَ مني “،
في صَباحِ يومٍ شاتي، وردت إشارة من المركز، حملها ” جمعة ” الخفير، وجدوا جُثةً لمجهولٍ مُلقاة بجوارِ محطّة القطار، لم تكن له، لا يَزال في عمرهِ بقية للحكي، وفِي صدرِ والده أمانيّ أن يعودَ الشّارد.