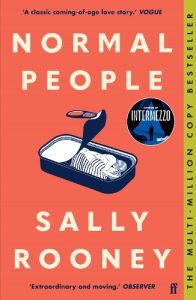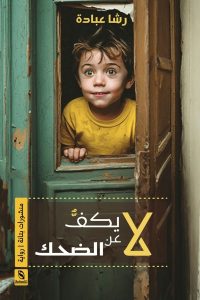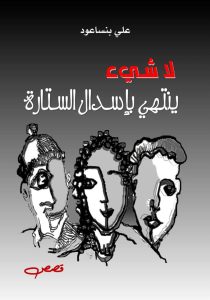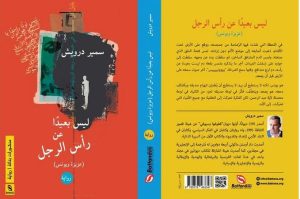د. شيرين تناصرة ـ برغوت*
في تُنسى كأنّك لم تكن:
قال درويش
أَنا للطريق… هناك مَنْ تمشي خُطَاهُ
على خُطَايَ, وَمَنْ سيتبعني إلى رؤيايَ.
مَنْ سيقول شعراً في مديح حدائقِ المنفى،
أمامَ البيت، حرّا من عبادَةِ أمسِ،
حراً من كناياتي ومن لغتي، فأشهد أَنني حيُّ
الطريق حياة، فلماذا تؤدّي إلى الآخرة، كيف غيّر الشاعر مسار الأنبياء جميعًا، فبينما ينادي الأنبياءُ جميعُهم إلى السّير في طريق شائك وصعب يقود إلى الحياة، يبني الشاعر طريقًا إلى الآخرة، فيجعل مهمّة طرح قراءةٍ لقصائد الديوان صعبة ومهمّة الوقوف هنا اليوم جديّة وهامّة. الطريق إلى الآخرة، ما هي إلّا جبلٌ شاهقٌ، ومن يرقَ قمّتَهَ، يصل شطحةً من شطحاتِ صوفيّ زهُد معتكِفًا الديوان.
منَ الشّعر ما يُنظَم ويمضي دون أن تَذْكُرَ حرفًا
منَ الشّعر ما هو سهلٌ ممتَنِعٌ، يمتّعُكَ ويبقى في الذاكرة أغنية رقيقة.
ومنَ الشّعر ما هو كتلة من كلام مكثّف، بيدَ أنّه يفغرُ في ذهنِك ألفَ فجوة كي تصلَ المعنى. هذا الشعر الّذي لا يمتّع أيّ قارئ، هذا الشعر الذي يبحث عن قرّائه، فهم أولئك الّذين يتفاعلون معه، كي يسدّوا ثغراتِه، والثغراتُ يملؤها الوعي الحرٌّ والفكرٌ المتنوّر.
شعر كما الذي في “الطريق إلى الآخرة”، يُذكّرني بسؤالِ أَحدِهم لأبي تمّام: “لِمَ لا تقول ما نفهم؟!”، ليردَّ أبو تمّام: “لمَ لا تفهمون ما أقول”؟ فإذا غامر الشاعر في عباب الكلمة، فَتَولَّدت قصيدةٌ كما “من عتمةِ الجبّ” فيها من التكثيف ما كثُرُ، ومن التناصّ المحكَم الانزياح والمفارقة المضفورة مع المعنى والصورة الشعريّة المحبوكة مولّدةً الوعيَ في عمقِ عتمةِ الجبِّ، استنفذَ الشاعر الكلمة حتّى أطاعَتْه منسجمةً مع أختِها فصارت القصيدة قبيلة، وباتت الحروفُ راسياتٍ في صحرائها.
إذا تحقّق كلّ ذلك في قصائد هذا المؤلّف الشعريّ، فيمكن للقارئ أن يرتقي مع كلّ كلمة ليصبحَ باحثًا، مفكّرًا، ناقدًا تشغلُه أدقُّ تفاصيل القصيدة مثل الخطِّ المائلِ في بعضِها، ليحيك المعنى الّذي يريد، والمقاصد الّتي تلائمه. وهنا تكمنُ، برأيي، قوّة القصيدة، حين يُنتِجُ كلُّ قارئ قراءةً تلائمه.
يقول الباحث بول ڤاليري معرّفًا الشّعر: «إنّ الشعرَ هو الكلام الذي يُراد منه أن يحتمل من المعاني ومن الموسيقى أكثر ممّا يحتمل الكلامُ العاديُّ، والشاعر المجيد حقًّا يمتاز من غير المجيد بأنَّهُ إذا تحدَّث إليك لم يمكّنْك من أن تسير معه كما تسير مع نفسك، وإنما يضطرك أن تفكّر، وأن تجهدَ نفسَك في أن تفهمَه وتحسّه وتشعرَ معه”.
تعريفٌ كهذا قادرٌ أن يأخذنا إلى عتبةٍ أولى في الارتقاء نحو المعنى الحقيقيّ للشعر المتجلّي في “الطريق إلى الآخرة”.
في العنوان “الطريق إلى الآخرة” مفارقة عُظمى للحياة، تُذكّرُ بقول البيّاتيّ في سوق القرية على لسان القدّيس الصّغير “والطريق إلى الجحيم من جنّة الفردوس أقرب”. عنوان موجزٌ يُكثّف عبره معنى الحياة، فالحياة فرصة لخلاص الإنسان، لكنّه يعيشُها غالبًا بعيدًا عن الخلاص، ملتصِقًا بالأرضِ وما يخصّها. هذه الطريق المؤدّية للآخرة وسيعة رحبة، ولربّما متشعّبة، كافية لتغرقك في جبّها حيثُ صدى كلّ الأصواتِ. الطريق إلى الآخرة، ذات بداية ونهاية… وهي طريق كلّ البشر.
نظرة سريعة في عناوين القصائد الواردة في الفهرس، كافية لتأكيد اعتماد غالبيّتها على التّناصّ الدينيّ، وما يميّز التناصّ اعتماده على انزياح المعنى. فالشّاعر يستلهم الموروث الدينيّ، التاريخيّ، الأسطوريّ والثقافيّ، لكنّه يصنعُ معنى خاصًّا به، موظّفًا، في الوقتِ ذاتِهِ، قدرة عالية في تكثيف الألفاظ وصنع المجاز.
أمثلة التناصّ عناوين كما: في المعارج، التجلّي، قاتل وقتيل، في تأويل المعجزة، رسائل الإسكندر إلى أمّهِ، مزامير الوقت، عمّادٌ، محنة الآلهة وغيرها وغيرها. أمّا بعد، وعن القصائد، فإنّنا عبرها نشحذ الفكر ونشعل جذوة العقل والإدراك.
يبتدئ الشاعر المؤلّف بفصلٍ بعنوان “في المعارج”. والمعارج هي النّعم والفضائل، وواحدٌ من أسماء الله ذو المعارج، وفيها استلهام لسورة المعارج وما أُنزل فيها، وهي إحدى السّور المكّيّة، تسبقها سورة الحاقَّةُ وهو اسمٌ من أسماء يوم القيامة في الإسلام أنزلَت فيها آياتٌ تقصّ أهوال يوم القيامة تذكرة للمتّقين، وتليها سورة نوح وقصّة الطوفان. إذًا، المعارج بين القيامة والطوفان، تُذكّر بعذاب اليوم الأخيرة، أو الآخرة، عندما تعرّج الملائكة إلى الله، غير أنّ المعارجَ في الطريق إلى الآخرة تبدأ برباعيّات من التجليّات، حيثُ يرد في القصيدة عشرون رباعيّة، وإذا أحصيناها جميعًا فهي أربعين تجليًّا.
للرقم أربعة رمزيّة دينيّة قديمة، فإنَّ جهاتِ العالم أربع، أمّا عن الأربعين فهو رقمٌ متكرّر في الديانات السماويّة والموروثات الحضاريّة، فهو رمزٌ للتيه والضياع، لكنّه عند الشاعر تجليّات لشخوصٍ وعوالمَ مختلفة تختصر عبرها الزّمان “اليوم والغد”، التاريخ “العهد والوعد” والوجود الذاتيّ الذي يتماهى مع الألوهة تماهيًا كاملًا في لحظةِ الحبّ، فكأنّه يرمي بعباراتهِ إلى المعنى ذاته الذي نستقيه من قول جبران “أمّا أنت إذا أحببتَ لا تقل الله في قلبي، بل قل أنا في قلب الله”.
لو نظرنا إلى قصائد هذا الفصلين الأوّل والثاني: في المعارج ومقام العقل، للاحظْنا أنّ بعضَ العناوين قائمةٌ على تضادّ أو إردافٍ خُلفيّ كما خروج الإله، أو كما في أغيب وأحضر ممّا يعني أنّ القارئ سيتعب في الوصول إلى المقصود. ما يعني أنّ الفكرة ليست عاديّة أو عامّة، ما يعني أن كلّ قصيدة هي حالة من حالات الحبّ أو مرحلة من المراحل في طريق الصوفيّ، فيها لمحتُ الشاعر يرتقي إلى أرقى هذه المراحل شهادة الحقّ بالحقّ، وانكشاف العوالم الخفيّة والأسرار الإلهيّة، كقصيدة “على رجلٍ واحدة”. الكون عنده غير متوازن، الوقت يشبه بَندولًا متأرجِحًا تمامًا كعقارب السّاعة، الّتي تُصارعها الإنسانيّة، تمامًا كالعدل في الأرض، كالحقّ، كالعقل، كالمعنى، وحده الظلم يقف منتصِب القامة على رجلينَ ضاحكًا على ذقون القتلى. كلّ قصيدة تطرح معنى، وجدْتُه متواصِلًا مع فكرة أخرى في قصيدة أخرى، فلماذا يبقى الطواغيتُ على قائمتين، لأنّهم يخافون طائرةً ورقيّة في الأفق (انظر: قصيدة بطاقات مهرّبة من بريد الشّام)، هذه الطائرة هي محاولة للنظر إلى السماء، إلى العلا، إلى خارج الشرط المعاش، وكلُّه ممنوع في ظلّ الطاغية.
من الأمور اللافتة للغاية في هذا المؤلّف قدرة الشّاعر على التلاعب بالكلمات بقوّة خاصّة، بحيثُ يطوّع الشكل ويوظّفه بقصوى قدراتهِ ليخدُمَ المعنى العامّ للقصيدة، فتُصبح دائرةً يتيه القارئ داخلها، ويغرقُ فيها. انظر على سبيل المثال قصيدةِ رسالة حبٍّ ص 92.
تصف مفارقة عُظمى لحظة وجوديّة قاسية، لحظة تُمنع عروسٌ من الوصول إلى عرسها المنتظَر، وفي يدها رسائل الحبّ الحقيقيّة بينما تعيشُ الأخرى الّتي منعتها من الوصول حياةً سطحيّة تتلاعب عبرها بالإيموجي الّذي يعبّر عن حالتها، بينما تلمُّ دمعها عن الورق. التلاعب بالكلمات حتّى تلكَ المعرَّبة كإيموجي أو سلفي، ووضعها في سياقٍ خاصٍّ هو قدرة خاصّة تلائم حالة متفرّدة في هذا العصر.
وعن درب المسرّات، الفصل الثالث، تُختَصَر طرق المسرّة بخطوطِ يدِ امرأة “مجهولة”، لها مقامها، فهي نغمة موسيقيّة خالدة كصوت الناي في البراري، تجعلُ من حبيبها أميرًا مرميّ القلب عندَ الجدولِ. ما يدعمُ قراءتي قصيدة أخرى في نفس الفصل بعنوان الطريق إلى عينيك (108)، فالطريق إلى عينيها، يقود إليها كلُّ ما يحيط العاشق حتّى القطط الواقفة تنتظرُ طعامها. هذا العاشق، تقوده عاطفته المتجلّية في أبسط تفاصيل الحياة.
يمشي العاشق الولهُ دربَ المسرّات، درب الحبّ وعيشهِ، يعمل إلى اليوم في تبويب رسائل العشق مع حبيبتِهِ عهدًا جديدًا من سفر التكوين حتّى خارطةِ الجنّةِ للمبتدئين، فدرب حبّهما تؤدي إلى الجنّةِ حتمًا، لا إلى إلى سفرِ التثنية الذي ينتهي بموتِ يوسف بن يعقوب. وفي فصلٍ آخر عنوانه باب الخيبة: يصوّر الشاعر بابُ الخيبةِ الذي ينفتحُ، حينَ يموتُ الحبّ في قلب الرجل، حين تَقْحَلُ أرضُ العودةِ إلى الملاذ، أو تنقطع العطايا من أيدي الجائعين، حينها تموتُ الكلمة كسيجارة متّقِدة منسية عند باب المنفضة. عبارة فيها تشبيه خاصّ، مختلف وغير عاديّ، يعبّر عن معنى الخيبة الحقيقيّ حينَ تمرّ الحياة دون أن تنعمَ بأبسطِ حقوقِك،كأن تنسى أن تدخّنَ سيجارتَك حتّى آخرها متمتّعًا بأنفاسها رغم حرقتها.
في باب الخيبةِ ذاتهِ مُدنٌ عرضة للاغتيال (قصيدة ص 146)، لكن، أيّ المدن هي هذه؟! مدنٌ نساؤها ينشغلنَ بالكحل وبأشكالهنّ، نساءٌ خاضعات يفتحْنَ للّيلِ كلَّ الأبواب إلى ذواتِهنّ، أمّا الصبايا “نساء المستقبل” فقد ضربنَ الوقتَ عرضَ الحائطَ، لأنّهن مشغولاتٌ بأنفسهنّ وعيش شهوات الجسد دونَ حساب، مدنٌ أطفالُها جياع، ومعلّمو اللّغةِ فيها متنازلون للغاتِ أخرى أتقنها أهل المدينة، قد تكون منها لغة الرياء، والأملُ كاليمام يُربّى على السطوح ويطير. هذه المدنُ كمدنِ الشرقِ جميعِها عرضة للاغتيال، لأنّها مَقودة بمن ينصب لأهلها الكمائنَ، مقودة بمن يتركونَ أهلها دونَ ماءٍ أو هواء، مقطّعي الشرايين، والأهمّ، مسدودي الأفواه.
وفي باب الخيبة: انتظار أطفالٍ جياعٍ لأمّهم وهي تغلي في القدْرِ ما لديها من حصى. صورة كهذه كافية في قصيدة لرسمِ صورةٍ لواقعٍ معيش مخفيّ، ميّت في أذهان الكثيرين، بيد أنَّهُ يُبعَث عبر هذه القصيدة.
وفي أوّل المعرفة، الفصل الرابع، يبدأ الشاعر بالتفاتةٍ نحو القصيدة أو كما يسمّيه النقّاد بالتفاتةٍ ميتا شعريّة وهي نظرة الشعر إلى ذاتهِ، مبيِّنًا أسلوبه في النّظم “كسر الإيقاع” لولادة الفكرة، فالسير مع السرب لا إبداع فيه، بقدر السير خارجه، فإنّ الشّعر تجسيدٌ لمجرّدات و تجريد لمحسوسات.
هذا التجسيد وجدْتُه حيًّا في قصيدة بعنوان محاولات لاحتواء كورونا (ص 180)، تلمِسُك في هذه القصيدة حداثة الحالة، شخصيّات يدور حولها الشاعر، وتفاصيل سياسيّة دوليّة اجتماعيّة، أخذَت طابع البساطة لكنّها أصابت المعنى.
أمّا حال التعبير عن الذات في ظلّ وباءٍ مستجّدُ، فيُجملَ بالعبارة “انحسرت اللّغة وانطوى الشعر”، وأكثر القصائد أخطرُ وباء وهي التفاتة أخرى نحو الشّعر عمومًا.
ثُمّ يستحضر الغائبين “لو أنّ أبي هنا لرمى إلى سلّة المهملات كلّ الأوامر….” مظهرًا ضعفه وقوّة الأب الذي يشتاق إليه.
أما الطبيبة فقد قالت التزم بالتعليمات واحتفظ لنفسِك بحرّيّة التأويل” وكأنّها تقول “صُنْ لسانَك”، فالتأويلات كثيرة لكنّ المرض واحد.
وفي آخر القصيدة، تردُ فكرة سياسيّة اجتماعيّة تلخّص حال الأقلّيّة:
“إذا لم يحبّونا في ملاعبِ الكرةِ
ولا على مقاعد الدّراسة
ولا في السياسة
لن يحبّونا ونحنُ نعالجهم منَ الكورونا
سيعتبرونها واجبَ العبدِ تجاه سيّده
كُرّ يا عنترةَ العبسيّ
فأنت حرٌّ وبشرتُك سوداءُ”
ولو كثرُ الأطبّاء العرب الّذين برزوا فترة كورونا، لكنّه واجب العبد لوجه سيّده، كما يراه السادة، تمامًا كعنترةَ الحرِّ بشجاعته، والعبد لأنّه ذو البشرة السوداء، فيُخاطبُه الشاعر: كُرَّ يا عنترةَ وحاربْ ظلمَكَ!
كلّ ذلك انتشار كورونا والألم والحجر المنزليّ، فائدة لأصحاب الفكرة “فكرة كورونا” وفكرة الموت المنتظر، مات الكثيرون وربح الأوغاد ثمنَ موتهم بينما مشَوا في الجنازةِ مندهشين.
وختامًا أقولُ:
أكثرُ ما يلامسُ قلبَ القارئة الأنثى لهذا الديوان حضورُ الأمومةِ اللطيفُ النسمات في عدد من قصائد فصل غواية السّرد، كما في القصيدة لما كتبتُ الشّعر (ص 213)، فالشّعر ولد مع الشاعر حينَ علّمتهُ أمُّه الحبو، وعندما حفرت أمُّه حكمتها في كيانِهِ صغيرًا، حينها ولدُ الشعر وولدت الكلمة الحرّة. ممّا يؤكّد أنّ هذا المؤلَّف تجلٍ لحضور الكلامِ الحرّ والفكر الناقد الواعي، بالإضافة إلى كيانٍ أُنثويٍّ طاغٍ، تبرزُ فيه الأنثى بأرقى صورِها “الأنثى الأمّ”.
…………………………
*”الطريق إلى الآخرة” مؤلّف شعريّ صادر عن دار جدل ـ فلسطين 2024 400 صفحة من القطع الكبير ـ للشاعر مرزوق الحلبي، أستاذ الأدب والعلوم السياسيّة والحقوقي والمثقّف النقديّ
**د. شيرين تناصرة برغوت، أستاذة اللغة العربية وآدابها، الناصرة ـ الجليل