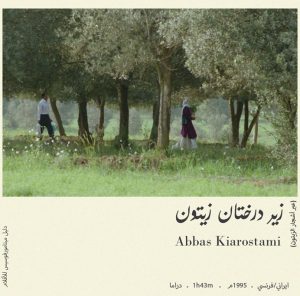وهناك أسئلة أخرى على المسؤولين عن توزيع الأفلام أن يرّدوا عليها، مثلاً خصصت سينما زاوية الشهيرة بعرض «الأفلام الفنية» في القاهرة ثلاثة عروض تقريباً لداليدا على مدار اليوم، وفي الأسبوع الثاني قررت أن تُخفض العدد إلى عرضين فقط، تمهيداً لرفعه وإعطاء مكانه لأفلام أخرى، أفلام ربما من عيّنة «لا لا ند» الذي دعمته الزاوية بالدعاية والإبقاء والإغراء، تماشياً مع هوسة جماعية ودولية بالفيلم، أبقته على شاشتها لشهر تقريباً.
كما تسير الحياة
أسئلة لا رد عليها على الأرجح، لأن الحياة تسيـــر كما تسير عروض الأفلام من دون توقف لإصلاح أخطاء أو لمراجعة الذات، ولأن كلمة المال السهل، أو المتوقع من كلمة المال السهل، هي التي في النهاية تـــقرر الطريق وتقرر الضالين عن الطــريق. أما الأسئلة الوحيدة التي يمكن إيجاد إجابـــات حالية لها، فربما تكون المتعلقة بداليدا نفسها المطربة صاحبة النجاح الاستثنــائي، وبالمتن السينمائي الذي تم إنجازه بصبرٍ طويل وبرغبة في تحرير حياة يولاندا جيغوليتي من فردانيتها المُتــوهمة كفنـــانة كبيرة انتحرت يوماً ما، تاركة وراءها عبارة رقيقة عن السماح، وإطــلاقها في سماوات أوسع تلتحم فيها تجربة داليدا مع حيوات أعداد لا يعرف أحد أن يحصيها من البشر المُعذبين بالهواجس ذاتها، وآلامها المتشابهة.
الحياة التي تسير نحو الحُب لا الموت، وتأثيرات الطفولة ولا يمكن محوها أبداً، أو كالحديث عن الإحساس بالذنب وقدرته الشنيعة على تدمير الناس ودفعهم إلى الانتحار، وسؤال أول وأخير عن دور الفن في إنقاذ فنانيه.
عملياً، لم يخرج فيلم ليزا أوزيلوس المأخوذ عن مذكرات شقيق داليدا «أورلاندو» عن القصص الشائعة على الإنترنت من حياة يولاندا (داليدا)، فمَنْ قرأ يستطيع أن يفهم على نحو أفضل مِنْ الذي لم يقرأ، لقد أعطى الفيلم لهذه الحياة لُحمتها، وهو أمر عظيم لو لم يُحقق غيره، وكان الفيلم يتقدم من مشهد إلى مشهد، وفقاً لبوصلة واحدة هي الإحساس، الدفقة الشعورية التي تتكون من الاستماع إلى أغنيات داليدا، من مشاهدة بهجتها وهي تُغني وترقص، ومن أعداد الصور الكبيرة التي تركتها حولها؛ باختصار الإحساس بحُب داليدا والتعاطف معها إذ يقترب من تقمصها وهذا بالضبط، أعني نهوض الفيلم على الشعور هو الذي يجعله يبدو بلا زمن محدد له. صحيح أنه يحاول أن يترتب قليلاً بناءً على حوادث انتحار أحبائها وذروات مجدها الفني، لكنه يبقى سائحاً في مُخيلتنا، كأننا نفتح ألبوماً للصور، غير مُرتب وفق عُمر، إنه يجعلنا نحلم باليوم الذي أُخذت فيه الصورة، وعلاقته ببقية الأيام في حياة أصحابها، باختصار يصنع هذا الارتباك الزمني لداليدا زمناً جديداً تهيم فيه سفيفا ألفيتي (الممثلة الإيطالية التي لعبت شخصية داليدا) من ألم إلى ألم وفق مُحرك واحد هو الحُب، أو بحثها عن الحُب النهائي.
هكذا، فإن العنوان الرئيس لحياة داليدا هي جملة بسيطة ستقولها وهي نائمة على صدر حبيبها الإيطالي لويجي تينكو قبل انتحاره: «تسير الحياة نحو الحُب لا نحو الموت كما قال هايدغر»، ودالي هي التي ستقول بعد ساعة من مطر القدر السخيف بالفيلم لمحللها النفسي، إنها قد حاولت كثيراً أن تتحاشى الموت، لكنه يحوم حولها. كان لوسيان موريس مُكتشفها وأحد داعميها الأوائل يصف جمالها بالخارق، ــولم يقصد الجمال الجسدي (وذاك لم ينقص داليدا قط) لكنه كان يشير إلى شيء أعمق دائماً، هو الذي أحبها وهي معه مرّة وحين غادرته مرّتين، كان أكثر العارفين ربما بما تعنيه داليدا.
شيء في سؤال داليدا الفيلم إجابته في داليدا المطربة. لماذا داليدا أصلاً؟ ربما تكفي حياتها الدراماتيكية والفائضة عن قدرة احتمال شخص واحد للتبرير، أو الصدى الذي لا يذهب إلى صوتها الذهبي بعد عشرات السنين من موتها، لكن نجمة صغيرة تُجيبنا، تلمع في الشهرة الكبيرة لرسالتها الأخيرة قبل الانتحار: «سامحوني الحياة لم تعد تُحتمل بالنسبة لي»، عشرات الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والطويلة صُورت عن لحظة مغادرة داليدا بوهجها كله، هذه هي النجمة الجاذبة في رواية داليدا، لأننا نحس أن داليدا الطيّبة قد انتحرت نيابة عنّا، كما أحبّتنا وسارت بين صفوف محبيها من دون خوف حين زارت مصر مثلاً، لأنها غنّت لنا بينما كانت تتألم، لأنها تعرف أننا نتألم أيضاً وسنتألم، ولا يُحسن كثيرون منا التعبير عن أنفسهم.
هرباً من الأحزان
من هذه الجهة للرؤية حقق فيلم «داليدا» ما كان يريد أن يحققه منذ كان مجرد فكرة في عقل مخرجته، صحيح ما كان يراه أورلاندو إن فيلماً حقيقياً عن داليدا يحتاج إلى مخرجة امرأة، قد جذب عشاقاً جدداً لأغانيها، ومنح ألحانها فرصة متجددة للوصول إلى هؤلاء الذي ابتدعت من أجلهم، وجعلهم يحسون بأنهم أقرب لها، وهم أقرب منهم. كان الأسهل على داليدا أن تهرب من أحزانها في أغنيات فكاهية عن الحُب وعن الهجران أو الفراق، لكن صوتها كان أعمق دائماً، شيء يشبه الطائر العملاق، وربما الأسطوري؛ أما سفيفا ألفيتا بطلة داليدا فهي ساحرة وواحدة من أهم نجمات هذا العمل، وعندها نصف سرّه، خصوصاً حين تقف في اللقطة الأخيرة بعد الانتحار مُتضرعة إلى (اسمها داليدا) داليدا خالدة، والفيلم ستُعرف قيمته مع الأيام، هذا ليس كلاماً عاطفياً، أو أن العاطفة هنا كل شيء لحُسن الحظ.
……………….
*نقلاً عن صحيفة “الحياة”