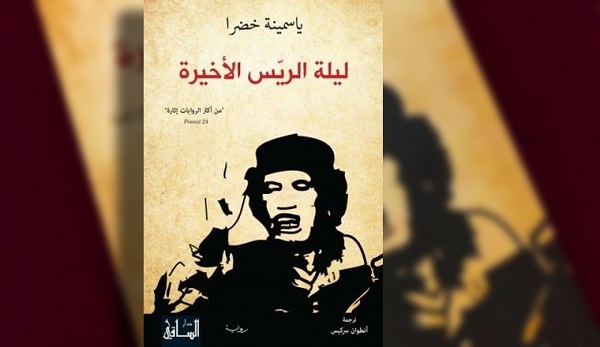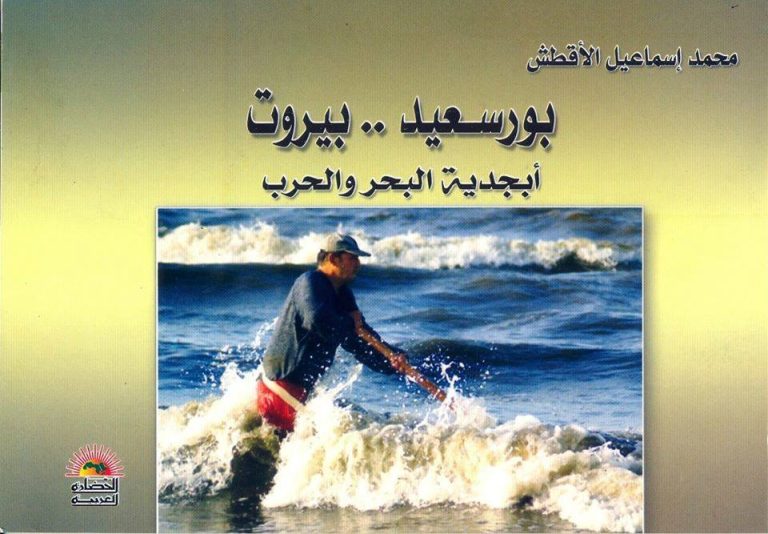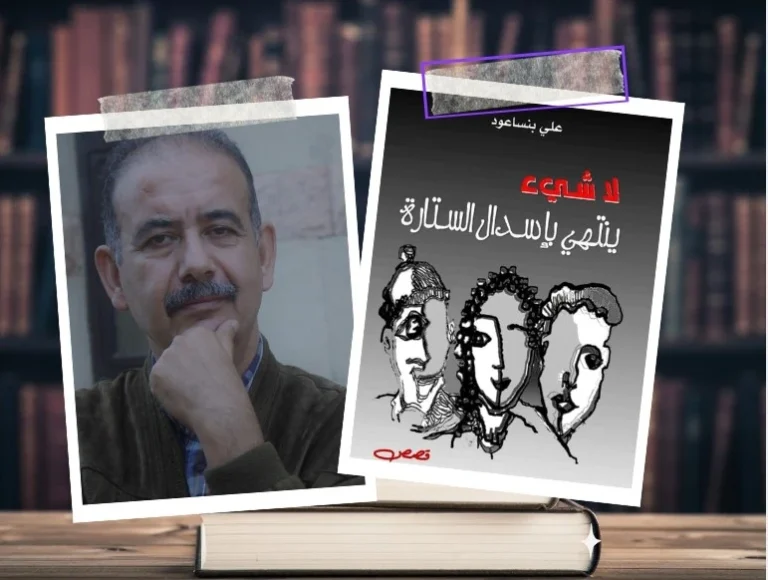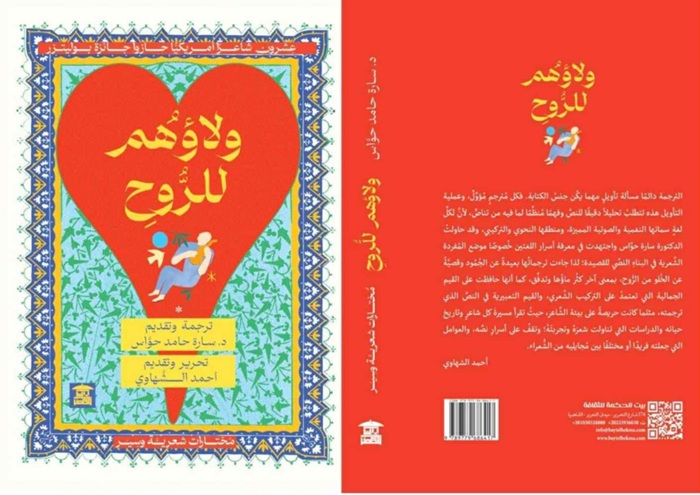ممدوح فرّاج النّابي
لم يصل الأديب صبري موسى[1] المولود في مدينة دمياط عام 1932، عبر رحلته الإبداعية إلى جنس القصة والرواية إلا بعد تجارب متعدِّدة مرَّ بها على أجناس مُختلِفة، مثل الرسم الذي مارسه على مدار عامين كمدرس له، ثمّ أدب الرحلات، والكتابة الصحفيّة، وكتابة السيناريو والحوار لبعض الأعمال السينمائية، وجميعها تجارب أثقلت الموهبة، وأضفت على التجربة ثراءً كما جعلت نتاجاته على تنوِّعها وانفتاحها على أنواع مُختلِّفة مَحطّ اهتمام وتقدير في الأوساط النقدية، وهو ما تُوج بحصوله على جائزة الدولة التقديرية في عام 1974 عن رواية فساد الأمكنة، وفي عام 1999 حصل على جائزة التفوق في دورتها الأولى إضافة إلى بعض الجوائز الأخرى مثل التقديرية عام 2002، وغيرها.
من خلال مسيرته الإبداعيّة طرح صبري موسى أفكارًا، كانت خلاصة تجاربه في الحياة على تنوّع الأماكن التي عاش فيها أو ارتحل إليها، إلا أن جميعها كانت تستمدُّ مشروعيتها من إيديولوجية مُناقضة لإيديولوجيا الواقع المهترئ أخلاقيًّا والمــُترع بالفساد مِن كلِّ جانبٍ، فأضحت حكاياته وأزمات أبطاله بمثابة احتجاجات على القُبح الذي استشرى في مجتمعنا، وإدانة أيضًا للفساد الذي توغّل وتَنَزّت جرثومته إلى الصَّحراء، فجاءت «حادث النصف متر»[2] عام 1962، كاحتجاج بالكتابة على الأنانية المــُفرطة التي وسمت المجتمع، وأيضًا تعريّة للمفهوم الخاطئ للتحرّر الذي وَسَمَ المـُدن وَسَاكِنِيها، بل تُعدّ واحدة من الروايات التي يمكن أنْ تُوسم بروايات «هجاء أخلاقيات المـُدن»[3] إنْ جازت التسمية.
هذا النفور مِن شُرور المـــُدن جعله يهرب إلى الصّحراء، فكانت رائعته «فساد الأمكنة» عام 1970 نموذجًا دالاً على تعرية القبح والفساد الذي طغى على المدينة ليصل إلى الأماكن البكر، فدنَّس طُهر الصّحراء وفض بكارة قدسيتها. العجيب أنّه بعد أنْ خَبُرَ المدينة وشرورها وهرب منهما إلى الصّحراء، وصدمه الفساد الذي ألحقه الإنسان بها، لم يكن أمامه سوى الهروب إلى المستقبل، كما تصوّر في روايته «السيد من حقل السبانخ» عام 1982، ليفجعنا بأن الإنسان سيعود إلى العصور الأولى، بالإضافة إلى انتقاده الاستخدام المفرط للتنكولوجيا والذي صار سمةً من سمات القرن الجديد.
- وجوه الفساد المتعدِّدة
سبق رواية «فساد الأمكنة» التي كانت نتاج رحلة تفرُّغ في صحراء الدرهيب بصحراء مصر الشرقية[4]، روايته القصيرة والصّادمة «حادث النصف متر» والتي صدرت عام 1962، وقد أثارت ضجة وقت صدورها حيث تطرقت لموضوع إشكالي خاص بمفهوم التحرُّر[5]، وإن كان قصر الفساد الذي نتج عنه على المدينة، كإدانة لهذه المدينة بوجهها المتوّحش، الذي فتح الباب لبطل القصّة القادم من الأرياف؛ ليقف في مواجهة مع أخلاقيات المدينة فتصدمه بأخلاقياتها، وهي ذات التنويعة التي ترددت في أعماله اللاحقة ففي قصة «السّيدة التي والرجل الذي لم»[6]، كانت بطلة القصة «صفية» تتفنن في إيجاد مخرج لها لممارسة البغاء، وحين ضَيّق عليها زوحها الخناق، اخترعت قصة ساذجة، ثم تُلقي عليه بدليل خيانتها المتمثّل في الدولارات، عندئذ يقول جملته التي تهوي بالقيم والأخلاق إلى الحضيض: «مِنك لله يا صفية … شغلتي بالي وخلتيني افتكر فيك شيء بطال».
تبدأ رواية «حادث النصف متر» مِن النهاية حيث يحكي الراوي الأنا عن حادث عارض حدث له في مكان عارض وأيضًا في زمن عارض، ومساحة مكانية لا تزيد عن نصف متر، فبعد لحظة الاهتزاز يحدث التطوّر للحدث الذي ينتهي بالنهاية التي استهل بها الراوي في بداية النص ليثير القارئ، فالراوي الأنا العائد إلى البطل المجهول الاسم، يروي سيرة هذا البطل المــُخْتَلِط الأنساب المؤغلة في الزمن، فيرجع بزمنها إلى الماضي البعيد منذ زمن الاحتلال. الراوي يحرص على «أن يكون عصريًّا» وهى الجملة التي يرّددها على طول خط الرواية، وبصيغ مختلفة في محاولة منه للتأقّلم مع وضعية المدينة القادم إليها من الريف، لكن لم يجنِ من هذه المدينة «التي تُزين سماءها (كذا) الإعلانات المضيئة الملونة، ثلاث فتيات» (ص 37).
فيقدِّم نفسه هكذا: «أنا رجلٌ عادي على وجه التقريب … وجميع غرائزي تطل برأسها من داخلي في حذرٍ وهي ترمق قوانين المجتمع بنصف عين» (ص 7) هكذا يُقدِّم الراوي نفسه في محاولة منه لإحداث التعاطف بينه وبين المروي لهم، ثمّ يتوجّه إليهم هكذا: «ولكي نكون على وفاقٍ أحبُّ أنْ تفهموا أنّني لا خبرة لي بالحكايات … إنِّي أحدثكم وأمامي نصف زجاجة من خمر نسائية بيضاء يسقونها للتلميذات في أمريكا … وبعض المطر سقط في أوّل المساء، فبلل زجاج نافذتي، وفي مثل هذا الجو ليس في نيتي أن أخدعكم» (ص 7). بهذه الاعترافات المحدَّدة الزمان (أول المساء)، والمكان (الشتاء، ليلة ماطرة، وبعد مرور عامين على اللقاء) يأخذ الراوي في سرد «التاريخ السِّري لرّجل عادي» كما أوضح في عنوان الفصل الأوّل، إلا أن الحكاية تقول إنّه ليس رجلاً عاديًّا، بل هو رجلٌ محمّلٌ بالخطيئة، منذ اختلطت الأنساب بفعل الغازي، لتنتقل الجينات في دورة التزواج حتى تحلّ في شخصه، ومن ثمّ يسعى لأنْ يكون عصريًّا، وهذه الصِّفة التي سَعى لاكتسابها بل وتمثُّلها في موقفه من هذا الرَّجل الذي انحى أمامه.
البطل الذي أودى بحبيبته إلى نهاية مفجعة انتهتْ بإصابتها بالقرحة واستئصال رُبع معدتها، كانت له تجارب مع الجنس متعدِّدة، يُعدِّدُها بتواريخ محفورة في ذاكرته منذ طفولته، وقد بدأت في العاشرة من عمره مع ابنة الجيران، وخرج منها بإصابة مازال أثرها بارزًا في رأسه، علاوة على مفهوم خاطئ عن الجنس بأنّ القُبلةَ هي التي تكون سببًا في الطّفل، وهو ما قُوبل بسخرية عندما كان في الخامسة عشر من عمره مع الغلامة على الشّاطيء، وعندها فطن إلى اللُّعبة ودخل في مغامرة امتدّت لشهرين، وبعد انتهاء الصّيف رحلتْ، لكنّه في العام التالي علم أنّها تزوجت ولحظتها شَعَرَ بأنّه طُعن في كبريائه وعواطفه، وفي الخامسة والعشرين أَدْرَكَ أنّه «بقليل من الهدايا يمكن الحصول على كلّ هذا (العشق، والطعام وتنظيم البيت والحياة) دون الوقوع في الفخ!» (ص 18)
- شبح الرّجل السّابق
لا تبدأ علاقته الرَّاوي بحبيبته التي انحى أمامه مَن يريد أنْ يتزوجها إلا في الفصل الثاني الذي عنونه بـ «فكرة الوقوع في الحبّ» فمع اعترافه بأنّه لم يقع في«غرام حبيبتي هذه عندما رأيتها لأوّل مرّة…» لكن لحظة إمساكه بماسورة السّقف داخل الأتوبيس جاءتْ إليه الفكرة الجهنميّة بأنه مادام مُحاطًا بنوع من النِّساء لكلّ الرجال فبالتالي هو «رجل لكلّ النّساء»، وهو ما جعله يُعيد حساباته بعد «لحظة الاهتزاز في الأتوبيس» حيث فكّر لحظتها بتصحيح الوضع الخاطئ وتصفية «هذه العلاقات المتعدّدة» ومن ثمّ «الاحتفاظ بواحدة فقط».
لحظة التفكير في تعديل مسار حياته كانت هي ذاتها لحظة اهتزاز الأتوبيس ولحظة اللّقاء بهذه الطّالبة الجامعيّة التي صارت «تفاحة حزنه» وفرضتْ عليه أن يكون إنسانًا عصريًّا بعد عاميْن من هذا الحادث الصغير، الذي لا تكاد تزيد مساحة الأرض التي وقع فيها عن نصف متر، وهو يَقْبَلُ الذي اعترض طريقه في مشهدٍ عصريٍّ، حيث ينحني له ويطلب منه «بطريقة عصرية مهذبة أن (يبتعد) عن هذه الحسناء … لأنه سوف يتزوجها»[7] (ص22). تتطوّر العلاقة بينهما بعد هذه الحادثة، وطبقًا «لقواعد الحب العصرية» بدأ يتخذ الخطوات ليتعرف كلاً منهما على الآخر، فمنحها ساعات الظهر التي تعوّد على النوم فيها، ومن جانبها استغلتْ تحايلاً على القوانين العائليّة التي «لا تسمح (لها) بالتأخّر خارج البيت بعد الثامنة» (ص 28) باختلاس ساعات مِن بين محاضرتيْن، ليتمَّ اللّقاء في الشّوارع والأماكن العامة حتى غدت المدينة بهذا الحبّ بعبارة الرّاوي نفسه «عالمًا بأسره»، وإزاء الرغبة المحمومة التي اعترتْ كليهما وعبّرت عنها «تلك التوسلات الصّامتة … مُنطلقة من الشفاة المنسوجة من اللّحم والدم» ومن كثرة اللقاء صارت «مُشتهاة وضرورية» كان لابد من أن يجد «سقفًا وأربعة جدران … نذيب تحته توترنا اللانهائي» وهو ما جعله يقول بفخرٍ إنّ المدنية كلها صارت «فراشًا لقصتتنا العاطفية» (ص 59). وعبر علاقته بصديقه الذي يخون زوجته تمّ تدبير الأمر عند السيد زينهم وعائلته، وهنا ندخل منطقة أكثر عصرية، وبعد خطة مُحْكَمَة البناء يتمّ خلالها دعوة السيد زينهم إلى السينما، ثمّ يميل عليه ويهمس له برغبته في زيارة بيته مع إحدى صديقاته، وعندها يرحِّبُ السيد زينهم بالأمر وهو يشدّ على يده مُحدِّدًا له مَوعدًا، هكذا تمت الخطة وبالفعل تمّ تنفيذ أجزائها الأولى، ويتحدَّد الموعد.
الصِّفات العصرية التي أضفاها على نفسه ليتعايش وفق آليات «الزمن العصري» كما وصفه، كانت جميعها مُقدِّمة لأن يتقبّلَ «الرجل السّابق المجهول» الذي كان سببًا في أن تدخل حبيبته في موجة بُكاء بعدما أغلق عليهما باب الغرفة في بيت السيد زينهم، وهي ذات الصّفات التي جعلته يفكِّر فيها «تفكيرًا مثاليًا» ويتصرَّف بهذه «الطريقة العصرية» التي جعلته يمتثل لعبارة بلزاك التي كانت تطنُّ في رأسه «لا تبدأ حياتك الزوجيّة باغتصاب زوجتك» ومع إنِّها لم تكن زوجته إلا أنّه مَالَ وامتثل «إلى إطاعة بلزاك» (ص 38). تدخل العلاقة بينهما طورًا جديدًا يمكن أن يوصف باللُّعبة العصريّة فبعد هذه الحادثة التي وقعت في بيت السيد زينهم، وظهور أثر الرجل السّابق بينهما، تختفي ثمّ تُرسل خطابًا توضح فيها أنّ سبب البُعْد هو تمسكُّها به وحبّها له، كما توضح له أن ما توهّمه (عن الرجل السّابق) ليس صحيحًا، بل وَقع نتيجة رياضة عنيفة كانت تُمارسها في الجامعة آلت «لأن تفقد أغلى ما تملك» حسب تأكيدها في رسالتها.
كان الخطاب كفيلاً بعودة العلاقة بينهما بعد غياب استمرّ ستّة أيامٍ، عادت العلاقة بينهما وإن كان شبح الرجل السابق بتعبيره «يقف حائلاً بينهما». صاحب تطوّر العلاقة بينهما تنوّع الأماكن التي شهدت حميمية العلاقات فصار لبيت زينهم يوم واحد في الشهر، وامتلك البطل في كلّ حيّ من أحياء المدينة «مفاتيح بيوت» يَصِفُها بأنّها «لا نملكها» ومن ثمّ صارت المدينة كُلّها «فراشًا لهذه القصة». وتماشيًا مع الأساليب العصرية التزما بـ «جدول عصري يُنظم هذه اللقاءات» (ص55). في مقابل توطُّد العلاقة بينهما كانت ــ على الجانب الآخر ـــ مساحة الغموض لشخصية الحبيبة تتكشف رويدًا رويدًا بعد أنْ قابلهما صُدفة زميله الاجتماعيّ أثناء خروجهما من السينما، فيزوره في اليوم التالي في العمل ليخبره عن صديقته وكيف أنّه تعرّف عليها مِن خلال صديقته التي تعرّف عليها في إحدى حفلات الجامعة وقد أخذها يومًا إلى بيت واحد من أصدقائه، وفي المرة الثانية أحضرت الصديقة صديقتها التي كانت هذه الفتاة.
وعندما حكى البطل لها الحكاية غضبتْ لعدم ثقته بها، ومارستْ غوايتها في الاختفاء كوسيلة ضغط وكانت هذه المرة لمدة ثلاثة أيام، أما هو فثمة صراع كان يدور ويحتدم في داخله بين الدم التركيّ والمصريّ والدم الفرنسيّ الماجن، فالتركي الذي هو مِن رواسب عثمان آغا يقف غاضبًا ويصيح: «كيف تُعطي قلبكَ لامرأةٍ كانتْ لرجلٍ آخر قبلكَ»، أما الدم المصري فيميل إلى أنْ يحبَّها، أما الدم الفرنسي الماجن المُنحدر مِن القرن الثامن عشر، فقد كان أكثر حكمة، ساخرًا مِن رواسب الدم التركي قائلا: «وما يدريك أن هذا الرّجل السّابق لم تكن معها نفس المشكلة؟» (ص 53) وينصحه بأن يكون عصريًّا هكذا «دعك مِن الماضي … فهي جميلة … حاول أن تستمتع بها» (ص 53). ثم في مرحلة لاحقة يكتشف أن حبيبته لم تأخذ الدواء ولم تكن حاملاً بل كانت تريد أن تختبره، العجيب أنّها تحملت المهانة والألم «حتى لا تبدو كاذبة». تنتهي الرواية بذات البداية التي اُستهلتْ بها، حيث جاء إليه الرّجل العصريّ ليخبره بطريقة عصرية أن يبتعد عنها ليتزوَّجها، وكان هذا الطبيب الذي تردّد اسمه أثناء لقاءتهما. لم يقتنع هذا الحبيب بالزواج إلا بعد حكاية صديقه الذي يبيح نفسه لكلّ النساء وبعد أن تزوّج فتاة من بنات العائلات ثمّ طلقها بعد بضعة شهور، بعد أنْ اكتشف «أنّ في حياتها رجلاً … كانت آثاره في روحها أعمق، فلم تستطع أنْ تنساه» (ص 75). في هذه اللحظة اتخذ البطل خطوة الزّواج ــ المتأخِّرة ــ مِن حبيبته التي بدأت تتماثل للشّفاء بعد أن فقدتْ رُبع معدتها على السّرير الحديديّ. لكن كان لحضور هذا الرجل الذي تقدّم في مشهد عصريّ ليطلب منه أن يبعد عن خطيبته، لأنه سيتزوجها، ما أَفْسَدَ عليه خطته وحوّله إلى شخصٍ مهزوم يروي هزيمته وهو جالسٌ يحتسي الخمر الأبيض.
- كيف تُرْوى الحكاية؟
يبدأ الكاتب روايته باستهلال واضعًا مُتلقيه في دهشة هكذا: «تمت المسألة بطريقة متحضرة مُحاطة بكلِّ مظاهر الكبرياء والعظمة، كان طويلاً، فانحى وهو يقدّم لي نفسه … ثمّ طلب مِني أنْ أبتعد عن حبيبتي لأنه سيتزوجها! لم أكن أعرفه … لكن حبيبتي كانت قد تعوّدت في الأيام الأخيرة أن تُنَقْنِقَ باسمه في لذة، كأنّما تهددني به … وقد سارع فأخبرني أنّه يتشرّف بلقائي بناءً على رغبتها، فأخفيت مخالبي وشدّدت على يده … وأحكمتُ قناع الكبرياء على وجهي وأنا أتمنى لهما السّعادة معًا وسرّني أنْ أكونَ مُتحضِّرًا إلى هذا الحد!!» (ص، ص 5،6 طبعة دار التنوير).
هذا الاستهلال الذي يحمل خصائص راوٍ مغاير للراوي المدينيّ الذي هو نِتاج الحداثة التي هي إحدى ثمار «الثورة الصناعيّة» التي فرضتْ طابعها على كلّ أوجه الحياة في الغرب[8]، حيث ظهرت مفردات وعلاقات جديدة ساهمت في تغيّر تشكيل بنية المُدن وهُويتها أيضًا. هذا الراوي الذي يبدو محايدًا (وهو عكس هذا) يأخذ صفات الرَّاوي الشعبي حيث يستميل جمهوره / أو المروي لهم الذين يتوجه إليهم بخطابه مباشرة هكذا (أيها السّادة المبجلون/ اسمحوا لي / واستمعوا لي / فهل لديكم متسع من الوقت) ويتوقف في بعض الأحيان، ليشرح ويُفسِّر لهم بعض المواقف، وهو الأمر الذي انعكس على كيفية قول الحكاية، فجاءت في صيغة سردية تجعل من الحكاية البسيطة، فحسب نانسي كريسي «لا توجد قصة بدون حكاية»[9]، حكاية لها عقدة تبلغ إلى الذروة وتشدّ القارئ وتجعله يتعقّب تبعياتها، فجاءت الرواية تعتمد على بنية سرديّة مرويّة بنظام التفتيت والتكرّار، فالراوي لم يُقدِّم الحكاية مرّة واحدة، فحدث النهاية مكرّر داخل النص بطريقة تجعل مِن هؤلاء المروي لهم دائمًا في حالة تعاطف، ومثلما يبدأ النص بهذا الاستهلال يكرّره ويجعله خاتمة مع تغيير بعض العبارات، نفس الشيء يفعله مع مقدمته وهو يعلن أنه سيروي لنا هذه الحكاية (يتكرر الأمر في رواية فساد الأمكنة، حيث تستهل هكذا: “اسمعموا مني بتأمل يا أحبائي، فإني مضبفكم اليوم في وليمة ملوكية. سأطعمكم فيها غذاءً جبليّا لم يعهده سكان المدن…:فساد الأمكنة، مكتبة روزا اليوسف، فبراير 1976، ص، 6). فكانت وضعيته وضعية المتذكِّر للحكاية، لكنه ابتعدَ عن التداعي الحُرّ، وخلق مِن تكرار الحوادث، ما أَصْبَغَ على زمنيتها الزمن الحاضر، على الرغم مِن أنَّه يروي بعد انتهاء هذه القصة التي استمرت عامين، كما وَزَّع النهاية داخل النص الذي جاء في ستّة مقاطع، أشبه بالمقاطع الشعرية حمل كلّ مقطع منها عنوانًا رمزيًا يعكس جوهر الحكاية هكذا: (التاريخ السّري لرجل عادي، فكرة الوقوع في الحبّ، الرّجل السّابق المجهول، مفاتيح بيوت لا نملكها، الخروج من عنق الزجاجة، والرجل الطويل ينهي المسألة).
فالنص قائم على الاسترجاعات بعد انتهاء الحكاية، ويعيد رَوْيها البطل بعد اكتمالها، متقمِصًّا دور الراوي الشعبي، حيث يحثُّ الجمهور (القرّاء) على الانصات إليه هكذا: «أيها السّادة المبجلون الذين تحمر آذانهم عندما تدخلها كلماتي الواضحة، بعض الصبر، واستمعوا لي» (ص 39)، أو «اسمحوا لي أن أتفلسف» (ص 43) ومرة أخرى: «فهل لديكم متسع من الوقت لشيء من هذا؟» (ص 54)، وقد يقطع سرده ليلفت انتباههم إلى ما يرويه قائلاً: «واسمحوا لي هنا أن انبهكم إلى التقاليد الاجتماعية السائدة» (ص 31). يجعل الكاتب إلى جانب أخذه صفات من الراوي الشعبي ـــ الذي يتقمصه بصورة كبيرة في فساد الأمكنة ـــ من الراوي الأنا راويًّا عليمًا يحيط بكل الحكاية حتى ما يدور في داخل عقل خطيبته، فبعد أن اتفق مع السيد زينهم على زيارته، ويخبر صديقته وهم في الكازينو بأنهما سيذهبان لزيارة صديق مريض، وبعد قبولها لطبله في التاكسي يُحدِّثُ نفسه هكذا: «ولعل حبيبتي كانت تعلم، ونحن في التاكسي، أن شيئًا غير عادي سوف يحدث ذلك اليوم…. ولعلها قد خمنت بغريزتها الأنثوية المتفوقة، كُنْهَ هذا الشيء، وأعجبها ألا ترفضه!» (ص 32). الملاحظ في رويه أنه ليس حياديًّا بل على العكس تمامًا، فقد أعطى لنفسه فرصة التدخل والبوح بما لم تفصح عنه الشخصية، وهي صفة من صفات الراوي العليم.
مع حركة الراوي المسيطر على الحكاية وعلى المروي عنهم، لم يمنعه هذا مِن أن يقدِّم وصفًا لبعض المشاهد يوقف بها حركة السّرد اللاهث نحو النهاية، والمتعطش لها المروي عليهم / الجمهور حكاية هذا الرجل الذي انحى، وكيف دخل الحكاية، وهزم البطل فعندما يذهبان الراوي وحبيبته إلى منزل السيد زينهم لإزابة الخوف، وكسر أفق التوقع عند حبيبته، التي لا تعرف شيئًا. فينهمك الراوي في وصف المكان هكذا: «المدخل أنيق … مقاعده الوثيرة تجمع بين الحشمة والمرح، والسفرة عليها أنقاض طعام، وطفلان لم ينتهيا من الأكل بعد … وسيدة سمراء تشبه الأمهات إلى حد كبير كانت تحدو الطفلين أثناء طعامهما … وخادمة صغيرة منشغلة بنقل الأطباق الفارغة إلى المطبخ» (ص 35)
لا شك أنَّ المدينة فرضت سطوتها على شخصياتها التي سعت جميعها للتحرّر وأن تكون عصرية، «فلم يعد الإنسان المديني ـــ كما كان الإنسان قبل المدني ــ محكومًا بقيود الأعراف والمواضعات والتحريمات التي لم تكن تُحدّ»[10] وهو ما كان له نتائجه السّلبيّة على إنسانها بما سببته له هذه العصرية من أزمات داخليّة، انتهت بالبطل إلى مرحلة الهزيمة والجلوس في ليلة شتائية ماطرة، وحيدًا أعزب وأمامه «نصف زجاجة خمر من خمر نسائية بيضاء يسقونها إلى التلميذات في أمريكا» (ص 7). أما هي فقد تمثّلت لكلّ سمات المدينة من تحرّر واختلاق أعذار لمقابلة حبيبها، بل والتغاضي عن ألمها وإهانته في سبيل تحقيق نشوة وأنانية صديقها الذي اصطحبها إلى بيت السيد زينهم، ثم عندما أمرها أن تُجهض نفسها، قبلت وسلَّمت ذاتها للطبيب وابتلعت الإهانة كاملة مشفوعة بألم سببه لها الطّبيب بفقدها رُبع معدتها.
أما الصّورة الأكثر إبرازًا لإنسان المدينة، الذي هو مخالف لإنسان القرية بما يحمله من قيم وأخلاقيات، فكانت لشخصية السيد زينهم وهو يبدو عصريًّا عندما يستقبل الأحبة في بيته لممارسة الحبِّ، ثمّ يتكرّر الأمر مع الرجل الذي اعترض طريق البطل، وانحى أمامه في مشهد عصري، يُجسِّدُ قمة المأساة التي خلقتها هذه العصرية التي اطردت داخل النص، حتى وسم الصّالة التي كان تضم عيادة الطبيب بأنها «صالة عصرية»، وكان يتبادل الحب مع صديقته على «الطريقة الحديثة»، في ظل أصدقاء يمتلكون «عواطف تقدير عصرية؟» (ص 54)، وهم يتركون له مفاتيح البيوت التي مارس فيها الحبّ العصري مع صديقته، وامتثالاً لهذه العصرية التي هي سمة المدينة طلب منه «أن يبتعد عن حبيبته لأنه سيتزوجها» هكذا بكل أريحية وبساطة تتواءم مع ما صبغته المدينة لإنسانها، وما عكسته عليه من تمزّق وتأزّم في هذا العالم غير المتجانس، وهو ما وضح في غياب الاسم الشخصي للأبطال باستثناء شخصية السيد زينهم، أما البطل وحبيبته فهما أشبه برقميْن داخل متاهة المدينة، في تعبير دال على تكرّار الفعل وفاعله بصورة مطردة مع اختلاف الأسماء القائمة بالفعل.
- الفيلم الذي هدم الرواية
الشيء الغريب أن الفيلم الذي أخرجه أشرف فهمي عام 1983، وكتب له السيناريو والحوار المؤلف نفسه صبري موسى وقام ببطولته محمود ياسين أمام نيللي وسعيد صالح وظهور قليل لمجدي وهبة، أن السياريست لم يغيّر أحداث القصة بل غير أهدافها باستثناء حادثة الأتوبيس، ما عدا ذلك فالفيلم يدور حول موضوع مغاير تمامًا وإن تشابهت الخيوط حيث الشّاب أحمد الموظف يلتقي بوفاء المعلمة (في الرواية طالبة تدرس الحقوق) وبعد الاهتزاز يقع الحبّ، ويبحث عنها حتى يعثر عليها، ويبدأ خطوات الزواج، وفي ليلة رأس السّنة يصطحبها في نزهة بسيارة صديقه بعدما فشل في العثور على حجز في أحد النوادي الليلة ولكن يخرج لهما (عنتر السِّمسار) توفيق الدقن، ويدلُّهما على فيلا مهجورة معه مفاتيحها، وفي لحظة انطفاء النور المتفق عليها مسبقًا تبكي وفاء وتعترف بحكاية خطيبها الذي استشهد في الحرب، وقبل ذهابه إلى الحرب جاء في ليلة السفر ووهبته نفسها، هنا يدخل شبح الخطيب الميت بينهما، وبعد اتهامات متبادلة تُقْدِمُ وفاء على الانتحار، خاصّة بعدما سلّمت له نفسها، وحملت منه ثمّ تنصّل من الزواج بناء على نصيحة صديقه. وعندما يعلم يذهب إليها معتذرًا، ويحدِّد موعدًا لعشاء سيتمّ فيه الاتقاق على موعد الزفاف، لكن يحضر مع الأسف ابن عمها الدكتور مصطفى الذي يرد له هداياه في إشارة إلى انتهاء العلاقة. بمقارنة بسيطة بين نص الرواية والفيلم، نرى أن فكرة الرواية الأساسية التي اعتمدها الكاتب ألغاها تمامًا في السيناريو، فجاءت رؤية الفيلم تتمحور حول قضية معينة: هل يقبل الشّرقي الزواج بفتاة كان لها علاقة سابقة؟ هل ينتصر الحب أم الشك؟ بهذه الرؤية يتعارض الفيلم مع رؤية الرواية تمامًا التي تتحدّث عن الحُرية والتحرّر وإنسان المدينة، كما كانت الرواية في أحد جوانبها، تنتقد أخلاقيات المدينة، وفي الوقت ذاته تنتقد إنسانها الذي أسهم فيما حاق بها من إنهيار أخلاقيّ وقيميّ، وهو ما قاده إلى تجربة الصحراء في فساد الأمكنة عام 1973، لكن أنّى له هذا، فالفساد يلاحقه، ودنس المدينة يدنس طُهر الصحراء.
- السؤال المحيِّر: لماذا لجأ الكاتب نفسه إلى تغيير رؤيته عندما أعاد كتابة السيناريو؟
…………………………….………
[1] . صبري موسى كاتب روائي وصحفي وسيناريست مصري. ولد في محافظة دمياط، عام 1932، وتوفي عام 2018، وهو من كُتاب القصة البارزين في مصر، تخرج من مدارس دمياط وعمل في الصحافة وتعددت مؤلفاته في أدب الرحلات والقصة القصيرة والسيناريو وأبدع في السرد الروائي، خاصة روايته هذه؛ “فساد الأمكنة” التي هي قيد البحث. ولقد عمل مدرساً للرسم لمدة عام واحد، ثم صحافياً في جريدة الجمهورية، وكاتباً متفرغاً في مؤسسة روز اليوسف، وعضواً في مجلس إدارتها، ثم عضواً في اتحاد كتاب مصر، ومقرراً للجنة القصة في المجلس الأعلى للثقافة، وترجمت أعماله إلى عدة لغات”.
تنوعت الأعمال الإبداعية للكاتب ما بين قصص قصيرة مثل: القميص، وجهًا لظهر، حكايات صبري موسي، مشروع قتل جارة، والسيدة التي والرجل الذي لم، ورويات مثل: فساد الأمكنة، وحادث النصف متر، والسيد من حقل السبانخ. بالإضافة إلى كتابات تنتمي إلى أدب الرحلات مثل: في البحيرات، في الصحراء، رحلتان في باريس واليونان. من أهم الأعمال السينمائية التي كتب لها السيناريو والحوار البوسطجي، الشيماء، قنديل أم هاشم، قاهر الظلام، رغبات ممنوعة، أين تخبئون الشمس؟، بالإضافة إلى كتابة السيناريو الخاص بروايته حادث النصف متر.
وفازت روايته فساد الأمكنة بجائزة الدولة التشجيعية، عام 1974، وفازت بجائزة بيجاسوس الأميركية للأعمال غير المكتوبة بالإنجليزية. وفاز صاحبها بوسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
[2] . صبري موسى: «حادث النصف متر»، دار التنوير، بيروت، طبعة عام 1982. ثمة طبعة أخرى صدرت مع رواية فساد الأمكنة، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام. لكن النسخة التي تمت الإحالات إليها داخل المتن هي نسخة دار التنوير، لذا لزم التنوية.
[3]. ويأتي هذا المفهوم نقيضًا، لروايات «استعادة المدن» على نحو ما مثلت روايات نجيب محفوظ عن القاهرة، وأورهان باموق عن مدينة إسطنبول.في روايته: إسطنبول مدينة الذكريات، وعلى المقري عن مدينة عدن في رواية «بخور عدني» ونادية الكوكباني في رواية «صنعائي» وغيرها من الروايات التي استعادت أمجاد المدن وتاريخ نضالها. ومن الروايات التي تتوازى مع رواية «حادث النصف متر»، في موضوع الهجاء، ما كتبه علاء الديب في روايته القصيرة «القاهرة».
[4] . وهو ما تحقّق في رحلته إلى «الصحراء» عام 1963 حيث أمضى في جبل الدرهب بالصحراء الشرقية ليلة، ثم كرّر الزيارة عام 1965 خلال زيارته لضريح المجاهد الصوفي أبي الحسن الشاذلي المدفون في هذه الصحراء، إلى أن حصل على منحة تفرُّغ وأقام فيها لمدة عاميْن، وكانت ثمارها الرواية التي نُشرت مسلسلة في مجلة «صباح الخير» الأسبوعيّة على مدار عامين.
[5]. الدعوة إلى التحرّر قديمة تعود إلى إرهاصات البعثات الأولى التي أرسلها محمد على إلى أوروبا، وعندما وفدت كانت أولى ثمارها تجسدت في دعوات التحرّر، ثم أخذت الدعوة منحى آخر بدعوات قاسم أمين، وهو ما تحقّق فعليًّا في خروج النساء في ثورة 1919، لكن على مستوى الإبداع يعزو الفضل إلى الكاتب إحسان عبد القدوس الذي كان أول مَن تطرق لهذه الإشكالية في رواياته، ونموذجه الباذخ «أنا حرة» التي صدرت طبعتها الأولى عام 1954،ومنذ عنوان روايته اللافت الذي يُعدُّ تدشينًا لمرحلة الثورة والخروج على نظام الأحاريم، وهو الشعار الذي اتخذته بطلتها أمينة كشعار حياة، وسعت لتحقيق أهداقه بتمردها واستقلالها، ورفضها لكل التابوهات المجتمعية. وهو الأمر الذي جعلها البعض بمثابة النقيض لشخصية أمينة زوجة سي السيد (أحمد عبد الجواد) في ثلاثية نجيب محفوظ، التي جسّدت الاستكانة والخنوع لذكورية واستبدادية سي السيد. أمينة إحسان عبد القدوس عاشت مع صديقها دون رباط شرعي يحافظ على عادات المجتمع ونواميسه، أما في صبري موسى فتطرق للموضوع وكأنه نتاج لحداثة المدينة، بعكس إحسان عبد القدوس الذي رأى أن الحرية مساوية للحياة ولا تقتصر على الرجل دون الفتاة، وهو ما تبلور في هذه الثورة التي قامت بها أمينة، وقابلت كل محاولات السؤال عن متي الزواج بسخرية واستهجان.
[6]. القصة من ضمن مجموعة القصصية حملت ذات العنوان «السّيدة التي والرجل الذي لم» صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 1999.
[7] . كل التشديدات الواردة من عندي، لذا لزم التنويه والإشارة.
[8]. حسين حمودة: «الرواية والمدينة: نماذج من كتاب الستينيات في مصر»، سلسلة كتابات نقدية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سبتمبر 2000 ، ص 37.
[9]. نانسي كريس: «تقنيات كتابة الرواية: تقنيات وتمارين لابتكار شخصيات ديناميكية ووجهات نظر ناجحة»، ترجمة زينة جابر إدريس، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط أولى عام 2010، ص، 58.
[10] . حسين حمودة : الرواية والمدينة، مرجع سابق، ص66.