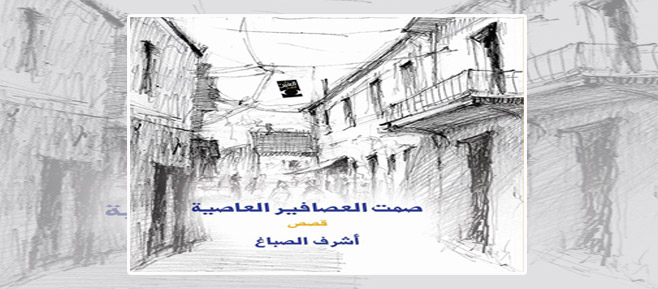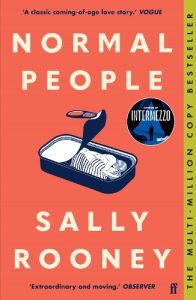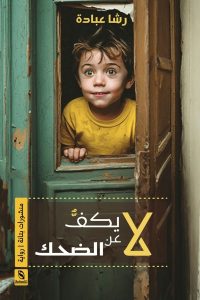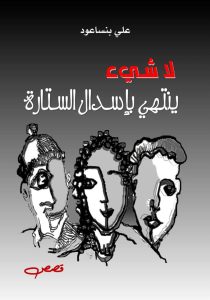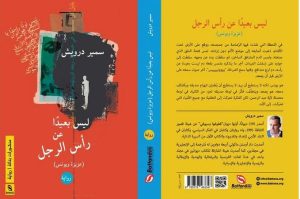منتصر جابر
عبثاً يحاول القاص أشرف الصباغ الهروب من لغته وموضوعاته الأثيرة إلى عالم أكثر شاعرية في قصته الأولى من المجموعة القصصية ” صمت العصافير العاصية” والتي جاءت تحت عنوان ” قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية “. ورغم ما أصدره الكاتب والمترجم من كتب ومجموعات قبل هذه المجموعة وروايات بعدها، ولكن تظل هذه المجموعة بمثابة المفتاح السحري، والسري، لعوالم وشخصيات القاص.
وكما تبدو من عنوانها ” قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية ” تستدعى القصة حالة تراثية شكلاً ومضموناً، حيث تعمد الكاتب أن يذكرنا بقدارته الفائقة في بناء نص شعري في قلب النص القصصي، وبدا الأمر كما لو أن القاص أشرف الصباغ أراد أن يحتفظ بحقه كشاعر، وقد استحق، أن يكون كذلك بعد ثلاث مجموعات قصصية، “قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية”، و”خرابيش”، و”العطش”، بالإضافة الى ثلاث روايات “يناير”- دار ميريت، 2002. و”مقاطع من سيرة أبو الوفا المصري”، دار نشر الدار 2006. ورواية «شرطي هو الفرح»، عن دار الآداب، 2017.
ولكن، وكالعادة، سرعان ما يعود الى لغته “الأم”، والأحب إلى قلبه وهي “اللغة العامية”، التي لا يتكلمها كل الناس، بل تكاد أن تكون لغة خاصة بأبطاله وشخوصه التي تمتزج وتتداخل في مكان الحدث وبيئة الشخوص وتاريخهم العشوائي، وذلك في كل مجموعاته ورواياته، وهي عبارة عن مفردات تكوّن في مجملها مذاق قصصي خاص به، وهي اللغة المتحققة ببراعة في القصص الأخرى للمجموعة وهي “السيوفي” و”الأخر” و”أنا وهي ويوسف”. وإن عادت اللغة قلقة في القصة الأخيرة في المجموعة ” أنا وهى ويوسف”، والتي راوحت ما بين الشاعرية ولغته “الأم” العامية مما يكشف عن عدم استرضائه، في بحثه الدؤوب، عن لغته الخاصة، وهويته اللغوية، بل عن النموذج الأدبي المغاير عمن سبقوه، وكنوع من الرفض للنظرية التراكمية في الأدب، ومستدعياً من العلم النظرية الإنقطاعية.
ولا يفعل أشرف الصباغ ذلك من قبيل التمتع بترف اللغة ولكن للتعبير عن هموم قلقه العام، ولإيجاد الشكل الذي يصوغ ويعكس مضامين حكاياته بالمستوى الذي يليق بتاريخ أبطاله وسيرهم الخاصة، سواء الذين عرفهم فى منطقة ” الوايلى ” الشعبية في قلب القاهرة، في قصة «السيوفي»، أو حالة المثقف في قصة ” الاخر “.
إلا أن القصة الاولى فى المجموعة ” قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية “هى الاكتشاف اللغوى / الشعرى لدى أشرف الصباغ. خاصة وأنه كان بارعاً، إلى حد إنني خلته شاعراً، في تجسيد مرئياته في عالم أصبح من الفجاجة التعبير عنه بغلظة اللغة المتداولة، وأن التناول الشعرى له يمكن ان يعكس عمق عوالمه، ويتيح ثبر اغواره، ويسهم في إثراء الخطوط الدرامية للنص.
فقال مفتتحاً قصة ” قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية “:
قالوا: “بالسر إن باحوا تُبَاح دماؤهم، وكذا دماء البائحين تُبَاح”.
فقال: ما آيتى؟
قالوا: ألا تكلم الناس دهرا. فالصمت صفة العصافير العاصية، وصبر عاصم من عصف العواصف العاصفة، وسيف مسلول مسموم مسحور إن قطعته قطعك، وإن وصلته قطع غيرك.. فالويل لك.. الويل لك.
هذا القص الشعري، أو الشعر القصصي، كان بمثابة إنذار لقراء “الصباغ” الذين يعرفونه أنهم يتقدمون نحو شكلاً جديداً وهوية جديدة، معلناً أن الوقت قد حان ليتخلى عن القص بعض الوقت لإنتاج “نموذجاً” للقص النثري الشعرى، يذكرنا بـ “نموذج” الكاتب المبدع يحي الطاهر عبد الله الذي لم يتورط في التماهي والتمازج، ليس مع القصاصين من أبناء جيله، بل مع أبرز كتاب القصة في عصره وهو الرائع يوسف إدريس، لأن “يحي” كان دؤوباً في البحث عن ” نموذجه” الخاص.. وأشرف الصباغ، وإلى حد كبير، يحاول الهروب من النماذج التي أضحت مبتذلة من كثرة تكرارها مثل الواقعية السحرية والحداثة وما بعد الحداثة.
وإذا كان الكتاب الأشهر “بنية الثورات العلمية” لفيلسوف العلم الأمريكي توماس س كون (كوهن). (1922- 1996). بعيداً إلى حد ما عن الأدب ولكن منهجه في تناول العلم يشبه إلى حد كبير حالة إبداع أشرف الصباغ حيث ” توماس” يرى أن تاريخ العلم ليس دائماً سلسلة من التطور التراكمي الذي تنتج فيه النظريات العلمية انطلاقاً من النقطة التي توقفت عندها النظريات السابقة لها. بل أن تاريخ العلم يحتوي العديد من الانقطاعات “الثورات العلمية” التي تنتج عن فهم مغاير للسابق وتثمر عن توجه جديد في العلم ونظرة مختلفة. هذه الثورات البنيوية تعني تحوّل في “النموذج” وهو “مجموعة القوانين والتقنيات والأدوات المرتبطة بنظرية علمية والمسترشدة بها، والتي بها يمارس الباحثون عملهم ويديرون نشاطاتهم. وحالما تتأسس تتخذ اسم العلم العادي”. مبرهناً على ذلك أن أي نظرية علمية حالما تصدر وتحظى بقبول المختصين شيئاً فشيئاً حتى تتحول إلى شبكة متكاملة من النظريات والتطبيقات والأدوات التي أصبحت تعطي الجواب الحاسم في مجالها ويصبح الغالبية من العلماء يفكرون من خلالها وينشغلون في داخلها. في هذه الحالة تصبح هذه النظرية ” نموذج” لا بد من الاحتذاء به داخل العلم وإلا يتم الاستبعاد والتجاهل. ولكن مع باحثين شباب وفي ظل تزايد الأسئلة الجديدة حول العلم ومستقبله تحين الثورة العلمية الجديدة التي تبدأ بتصورات ونظريات خارج إطار “النموذج” السابق بل ومعارضة له، وتحمل تصوراً للكون وحركته تختلف عن السابق وبهذا يتكون “النموذج” الجديد.. وهكذا.
وأعتقد أن أشرف الصباغ، وتأسيسه العلمي كباحث متخصص في الفيزياء- مثل الفيلسوف الأمريكي توماس كون- لا يبدع انتاجاً قصصياً أو روائياً تراكمي ولكنه يضرب في أرض الواقع الحيوي والمتدفق بالأشكال والموضوعات الجديدة، وهو الذي يعلم مسبقاً إنه في حاجة إلى “طفرة” إبداعية.. واعتقد أن أشرف يبحث بصدق وحب شديدين عن نموذج يصوغ من خلاله إبداعه الخاص لكتابة ما يجرى في الشارع، خارج إطار المألوف، في لغاته وحركاته وإيماءاته ومباشرته ومتغيراته الفجائية والفجة الي حد “قلة الأدب” بالمفهوم البرجوازي الاجتماعي والثقافي “المتأفف”.
وأيضاً، في إطار بحثه الدؤوب عن قارئ خارج دائرة قراء النخبة من أصدقائه، يسعى أشرف في نموذجه أن يكون بمثابة جسر حي بينه وبين قارئ في مكان ما، ومأملا أن يثير هذا النموذج أقلام أخرى للحكي على نمطه. وذلك يذكرنا بمبادرات المفاهيم الجديدة أو المنقولة حديثاً للساحة الأدبية المصرية مثل “حساسية ” الدكتور لويس عوض في ثورته على الأنماط القديمة في ظل الحياة الحديثة، و”الحساسية الجديدة” لدى الناقدين إدوارد الخراط وصبري حافظ أو كما يسميها الناقد جابر عصفور بالحداثة الشعرية، والتي ترمي إلى التطور التاريخي للكتابة وما طرأ عليها من تغيرات بنائية ولغوية ممتدة أو كامتدادات لمتغيرات وتطورات ثقافية واجتماعية.. الخ.
وقد اجتهد أشرف الصباغ في ذلك، إلى درجة التناص مع النص المقدس، ولكن دون أن يتخلى، أيضا، القاص عن خبثه التهكمي الذي اعتاد استخدامه بصراحة ووضوح في النصوص الأخرى. ودون أن يترفع – بشهامة أولاد البلد- عن أبطاله وعوالمهم الذي لم يكن مشغولاً بهم على المستوى الشكل المغاير فقط، بل بدواخلهم، واسرارهم النفسية، وحقيقة كان أكثر جمالاً وتألقا في ذلك. فقد قال الولد عن الغريب الذي جاء به جده الى الدار:
“فقأت شفتاك عين قلبي، وامتطت بسمتك نهر الدم الساريفي كل صوب. التقى ضوء عينيك بوميض أسنانك البيضاء، فاهتزت أذناك الكبيرتان، وارتجفت أرنبة أنفك وطالت بسمتك واستطالت. ورحتَ تتآخى مع الصمت حتى صرتما توأمين، فلا أحد يعرف من أين جئتَ، ولا نسمة متلصصة تخبر النفوس الزنخة عن أصلك ومنبتك. والناس في قريتنا يدخنون الكيف، ويزْنون تحت ستار الليل، ينِمُّون ويرتشون خلف أشجار التين والزيتون، يسرقون بعضهم البعض ليلا ونهارا، ويسرقهم الغير مجانا، فاعتاد كل منهم الآخر واعتادتهم عاداتهم المجوسية”.
ونحن هنا إزاء حالة تتعمد صناعة نصاً شعرياً/ روائياً ليس بهدف التلاعب المرفه بالكلمات ولكن لأن الشخوص ترتجف بالمشاعر والأحاسيس، وترى العالم عبر نفق مظلم من داخلها، وتتعامل عبر جسور من التوصيف المتبادل والمحكم برؤياهم لبعضهم البعض، وهى حالة (إمتاعية ) مثل الموسيقى، وعبارة عن أبعاد ومستويات من الأحلام أو الكوابيس التي تستنفذ ما بالدواخل من مشاعر يصعب حتى الوصول إليها أو لأنها مكبوتة، وإذا كانت الموسيقى تتمكن من تكثيف لحظات شعورية مختلفة ، تمطر المستمع بعوالم عديدة، وتغسله من أعباء يستحيل التخلص منها أو التعبير عنها. وحقيقة “أشرف الصباغ” كان موفقاً الى حد كبير في قصة/ نص “قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية”؛ خاصة أنه كان مولعاً بالغوص في اللحظة.. وجاءت أجمل فقراته في هذا النص:
“ولما أعياك الوجد وأنهكتك الصبابة، ألقيتَ بمرساك على شواطئ العمة الصبية. وفاضت عيناك بمروج العشق الشاهد على شهوة الشرايين المشرئبة، والتمستَ المدد من قلبٍ صَبِىٍّ يمتطى شراع الأفق الممشوق المشدود بالصمت والنور إلى سمت السمات والصفات والأزل. لكن العشق حرام فى قرى المجوس وبلاد الأسافل. فما كان منها إلا أن أحبتْ زيتونك، ورائحة زنديك، ومروج صدرك، وزحمة المساء حين تعود مع القطيع فتلامس أطراف أكمامك أصابعها الفتية المتعبة”.
بينما في قصة ” السيوفى ” قال الصبي: ” كانت الابنة الأصغر بطة تكبرني بعامين تقريبا، وكنت أنا طريق صبحي أبو شرطة إليها. فقد تقرب مني في البداية، وهو ما اعتبرته أنا شرفا كبيرا أن يتقرب لي المعلم صبحي أبو شرطة أحد أكبر حرامية الوايلي الكبير وفتواته”.
أما بالنسبة إلى “بطة”: “التي كانت تمشي في الشارع فتجبر الجميع على النظر إليها. بل كانت ابتسامتها وخطوتها وطريقة سيرها تدفع الكثيرين لاختراع معاكسات جديدة وكلمات رقيقة”.
هذه اللغة المحملة بالعالم المغاير رغم أن “الصبي” واحد تقريباً في القصتين. ومثله كان المكان والشخوص مغايرة أيضاً ما بين قصة/ نص “قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية”. وقصة “السيوفي”.. حيث يقول الصباغ:
“وعلى مئذنة الله العالية أصعد مرددا آذان أبى ذر من أجلك ومن أجل الآخرين فى أرض الله الواسعة، حتى أتسامى أغنية وقصيدة على لسان الطير، والشعراء الصعاليك، والصادقين بمحض إرادتهم. وفى طريق عودتى وحيدا مجهدا أرى أمى فاتحة قلبها النورانى، فتتلقانى مدثرة إياى بلحاء روحها. ولما يشتد أوار المعركة المجاورة، أرى معاوية يفر، والآخر يكشف عن عورته الخلفية بمحض إرادته، ويزيد يسكر حتى مطلع الفجر، فأتقلد سيفى وأضرب الحجاج والمنصور والحاكم بأمر الشيطان حتى آخر خليفة عصرى. وعندما أُلقى برأس آخرهم فى النهر، تلتئم أشلاء ابن المقفع، ويستيقظ الجعد والحسين، وينزل الحلاج والمسيح والسهروردى من فوق صلبانهم، ويعود أبو ذر من منفاه، ويضحك أبو حيان ساخرا من الوزراء الأدباء والأدباء المستوزرين ومَنْ على شاكلتهم”.
بينما في “السيوفي” حالة مختلفة ومشحونة بكل ما هو قادم من بعيد ورغم ذلك طازجاً في الذاكرة، ويطرح نفسه بقوة على اللحظة الآنية وكأنه ولد في التو أو بعث من جديد: “الوايلي له مداخل عديدة من عزبة الجزارين ومن ناحية شارع الشركات وبورسعيد الذي يبدأ من الأميرية ويصل إلى السيدة زينب، ومن ناحية شارع سكة الوايلي وأرض التوم ومصنع النسيج حيث يعمل أحد الذين كانوا يجلسون معنا على المقهى طبيبا هناك وكثيرا ما حكي لنا عن سرقات الأدوية وسوء صحة العمال في هذا المصنع الضخم ومخالفة كل قوانين وشرائع الإنسانية. كان هذا الطبيب بالذات هو الذي ساعد بطة في العمل بمصنع النسيج حيث قابلت زوج المستقبل هناك.. كان يعالج الفقراء بالمجان، ويمنح تخفيضا لمعارفه وأصحابه من عمال المصنع وأقاربهم. وكان أيضا يكتب مقالات عن الفساد في أحد صحف المعارضة أنذاك. كان طبيبا وسياسيا، ثم تطورت الأمور ورشح نفسه في انتخابات مجلس الشعب وخسر مرتين. وفي كل مرة كان يعول على عمال مصنع النسيج الذين يعالجهم سواء داخل المصنع أو خارجه، ويعول على الفقراء الذين يتعالجون عنده بالمجان تقريبا.. ولكن كان مرشح الحزب الحاكم هو الذي كان يفوز دائما!
……………..
* جريدة “القاهرة”