حسن عبدالموجود
كان فتحى عبدالسميع «سكرتير تحقيق النيابة» يتطلّع إلى جثة امرأة اخترق بطنها عيار نارى، ويفكر مندهشاً، فى مستقبل طفلها. لقد نجا الطفل من الرصاصة، لكن أول ما عرفه من الحياة هو رائحة البارود. وُلد هذا الكائن وفى رقبته خصومة ثأرية، ضحاياها أقرباؤه، أخوته، وأبناء عمومته، وهكذا سيُعدّونه ليكون طرفاً فى تلك الخصومة عندما يبلغ مرحلة الصبا، ليصبح قاتلاً أو قتيلاً.
هذا المشهد ليس الأكثر قسوة فى عالم فتحى عبدالسميع الوظيفى، لكننا نحتاج إلى معرفة حكاية فتحى نفسه مع العمل، وكيف وصل إلى هذه اللحظة، وكيف صار كذلك هدفاً للأشباح فى الصعيد.
كانت البداية نزول أحد أقربائه من القاهرة لزيارتهم فى الصعيد. وأول ما لفت انتباه فتحى علامات الوجاهة على هيئة ذلك الرجل، الموظف بأحد محاكم القاهرة. اقترح الزائر على الأب أن يُدخل فتحى «الشعبة القانونية» فى مدرسة التجارة، وهى عبارة عن فصل واحد تم استحداثه، لإلحاق خريجيه بالمحاكم مباشرة. درس فتحى المواد القانونية، وكانت هذه أقصر الطرق وأرخصها للالتحاق بالوظيفة، إذ كانت الجامعات فى المدن البعيدة مثل أسيوط أو القاهرة تعنى تكلفة ضخمة، سواء فى مصاريف التنقلات أو الإقامة.
كان فتحى الابن الأكبر لسبعة أشقاء، وفى هذه السن لم يكن بمقدوره الاختيار، بالعكس كانت الفرصة ممتازة، وجرت الأمور بشكل جيد، فبعد إنهاء دراسته عام 83 تم توزيعه هو وزملاؤه على المحاكم، لكن كان عليه أولاً أن ينهى خدمته العسكرية، وكذلك تجربة حظه فى مجال آخر، حيث سافر للعمل مع أحد أقربائه فى القاهرة، وكان مقاولاً كبيراً، وعده بأن يعهد إليه مهمة الإشراف على كل أعماله، لكن الأمور لم تسر بشكل جيد، ولسبب أو لآخر تشاجر معه فتحى، وقرر أن يعود بشكل نهائى إلى قنا، وبالتالى استلم عمله مع مطلع عام 87. يقول: «فى بداية التحاقى بالوظيفة كنت سعيداً للغاية، لأننى على الأقل سأعيش وسط الأهل والأصدقاء، وأيضاً لأن حياة الطفولة والصبا مع الأنداد ستستمر. فى هذه الفترة كادت كرة القدم أن تكون هى معيار الحياة بالنسبة لى، إذ لم أكف عن لعبها، مع أصدقاء الطفولة، حتى بعد أن صرت شاباً يبدأ خبرته العملية مع الواقع القاسى».
أتاحت الوظيفة لفتحى كذلك الاطلاع على كثير من الأحداث، ورؤية أنماط من الناس لم تكن الفرصة ستواتيه لرؤيتهم لو التحق بعمل آخر. كانت فترة مثيرة، وسيطرتْ عليه الوظيفة، لدرجة شعر معها بأنه يخوض مغامرة طويلة، ولم يكن قد التفت إلى الشعر، ولم يكن الشعر قد التفت إليه. كان مجرد محب للقراءة، وحتى قراءاته لم تكن متعمقة بالشكل الكافى، ويمكن القول إنه كان يقطع المشوار صاعداً السلالم بهدوء، فلا شىء يجبره على الركض، لكن شرارة الكتابة مسّته، وتحولت داخله إلى بركان متفجر. كان شغفه بالوظيفة يزداد، وفى نفس الوقت مسّه شيطان الكتابة، وبالتالى كانت علاقته تتطور بالجانبين، وقد أخلص لكل منهما، رغم أن حبه للعمل لم يستمر، بينما تحول حبه للكتابة إلى ولع لا نظير له.
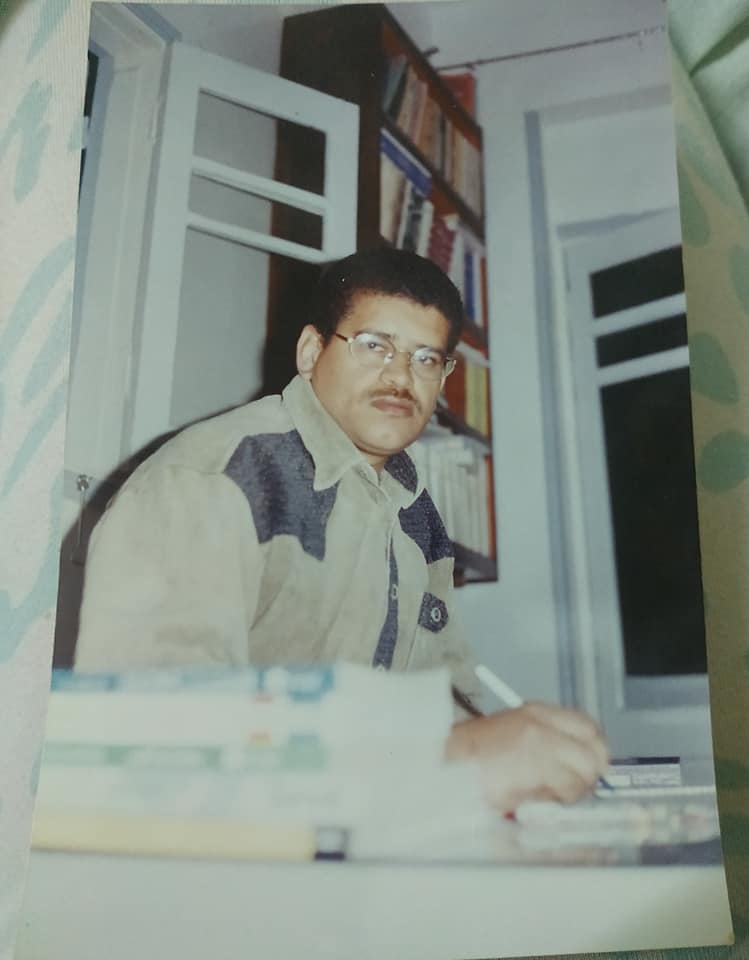
بمرور السنوات بدأ العمل يفقد إثارته، وظهرت جوانب أليمة تتعلق به، عدد ساعاته، وضغوطه، وضعف مردوده المالى: «اكتشفت أن صورة موظف المحكمة فى القاهرة تختلف عن الصعيد، وفهمت متأخراً جداً لماذا كان يبدو قريبى وجيهاً. الإكرامية مثلاً فى وجه بحرى كانت فكرة عادية، لكن بالنسبة لنا كانت تمثل عاراً. كان قريبى يبدو إقطاعياً، عنده عمارة كبيرة ومجموعة سيارات. وقد فهمت متأخراً أن بعض الموظفين يقبلون مبالغ ضخمة مقابل خدمات يقدمونها للناس. تخيل أن بعض الجلسات يُحكَم خلالها فى مائة قضية، وكثير من الناس كانوا يأتون متأخرين إلى القاعات، أو بعد الحكم، وبالتالى كانوا يبحثون عمن يقول لهم ماذا حدث. تخيل أيضاً أن كل شخص من هؤلاء يدفع إكرامية عشرة جنيهات فقط، كم يدخل جيب هذا الموظف؟ كانت الأمور مجزية للغاية لدرجة أن بعض الموظفين اضطروا لإحضار موظفين صغار يساعدونهم، ويمنحونهم مرتبات، والدنيا كانت ماشية».
ضاق فتحى بالعمل، وبدأ يبحث عن مخرج، وفكر فى النقل إلى جهة أخرى يكون فيها ضغط العمل وحجم المسؤولية والتوتر أقل، لكنه فشل قطعاً، ومع تطور طموحاته فى الكتابة أعاد النظر إلى الوظيفة مرة أخرى، إذ اتضح له أنه يعمل فى موقع بالغ الأهمية، موقع يمكّنه من رصد وفهم كثير من الأمور المرتبطة بثقافة الصعيد أو بالعمق الإنسانى بشكل عام، وبدا كما لو أنه يعمل فى وظيفتين، الموظف العادى، والباحث المدقق فى كثير من الأحداث والجرائم الصغيرة بوصفها مرايا تعكس المجتمع وظواهره المختلفة. يقول: «هذه النظرة جعلتنى أتصالح مع العمل من جديد وأعتبره فرصة ذهبية وهبتها لى الحياة، إلا أن زحمة الوظيفة بدأت تخنق ذلك الباحث، وتحرمه من متابعة أمور كثيرة فى متناول يديه، وهكذا حدثت انتكاسة، إذ شعرت باختناق حقيقى منها، لكنى أعترف بأن الرغبة فى ترك المكان كانت قد غادرتنى، وظل الباحث داخلى متعطشاً ونهماً لمعرفة كثير من التفاصيل حولى فى كل ركن داخل المحكمة»..
وصل فتحى حالياً إلى درجة مدير عام، لكنه مرّ بكثير من المحطات ليصل إلى هذه الدرجة، فقد التحق بأعمال كثيرة أهمها «سكرتير جدول الشكاوى الإدارية» وهذه الوظيفة تختص بشكاوى ومنازعات يتم حفظها فى الأغلب، لأسباب كثيرة، منها مثلاً عدم اتخاذ الطريق القانونى الصحيح، أو عدم وجود أدلة كافية. يحكى: «هذا المكان أطلعنى على طبيعة علاقة الناس بالمحكمة، فهم ينظرون إليها باعتبارها مجرد بديل للعمدة، وبالتالى يذهبون إليها للشكوى بدون أى وعى أو اهتمام بالسندات القانونية المطلوبة، ويتصورون بحسن نية وبجهل أيضاً أن المحكمة ستصدقهم لمجرد أنهم صادقون، وهنا كانت تحدث مفارقات كبيرة جداً وصدمات هائلة لبعض الناس بعد حفظ الشكاوى، لأن المحكمة لا تصدقهم، وهذا يعنى أنها شريرة، كما كانوا يبدون دهشتهم بسبب وجود خطأ ما لا يفهمونه، وكان هذا يظهر بشكل أكبر فى القضايا المرتبطة بالنزاعات على البيوت القديمة، والأراضى الزراعية، والميراث، وكنت أنا مجرد مستقبل للشكاوى وأقوم بعرضها على المختص، والمختص يأخذ فيها إجراء، أدوّنه فوراً، كنت فى مواجهة المدفع دائماً، وأتعرض لكثير من المواقف بسبب عدم تفرقة الناس للاختصاصات المختلفة».
فى تلك الفترة شاهد فتحى حالات عجيبة، بطلاتها فى الأغلب سيدات عجائز. كن يتقدمن بشكاوى، ترفضها المحكمة، لأسباب معينة، لكن السيدة تعود من جديد، الأسبوع تلو الأسبوع، والشهر بعد الشهر، والعام وراء العام، تقدم نفس الشكوى، وتدون نفس الكلام، لا تهتم بسند قانونى، ويبدو كأنها لم تسمع ما قيل لها. كان فتحى ينصح الواحدة منهن، لكنها لا تنتبه لما يقوله، بكثير من الطيبة وحسن النية والجهل، وحينما ترفض المحكمة شكواها، تندهش وتغضب وتثور وتتأسى وتتألم وتفزع وتجزع بنفس الطريقة، ثم تصرخ ملتاعة، كأنها تتوقع شيئاً جديداً، كأن السماء ستتدخل لتحل مشكلتها الأزلية: «كان شيئاً خيالياً. كان أغلبهن ضحايا لعائلات ترفض إعطاء الميراث للبنات، خوفاً على الأراضى من تبديدها»..
كتب فتحى عبد السميع قصيدته «عجائز إسماعيل» من ديوانه «الخيط فى يدى» وبها بعض مشاهد رائعة استقاها من هؤلاء النسوة: «أسندوا إليه دفتر الشكاوى الإدارية، تصفحه بحماس مكتوم، وأخذ يترقب أول قادم. عاملها كضيفة، وهو ينظر إلى تجاعيدها بود ومهابة، لماذا تأتين يا جدتى بمفردك؟ من الشقى الذى ينازعها، رائع أن أبشّرها، رائعة فرحة المسنين، عثر على اسمها فى الدفتر، وأخبرها بحفظ الأوراق، ولأنه كان موظفاً جديداً، تطوّع زميله وشرح الأمر، لم تصدق أنها خسرت القضية، أخذت تصرخ فى وجه إسماعيل، تتهمه بالرشوة، وتدعو الله ألا يأخذ روحها، قبل أن تراه مشلولاً» ويعبّر عن علاقته بإحداهن فى أجمل مشاهد القصيدة: «أكثر ما كان يؤلم إسماعيل، الهدايا التى كن يقدمنها، انتظرته إحداهن مرة بصُرّة تمر، وذهبت أخرى إلى بيته، وفى طرحتها دجاجة تضطرب، يرد الهدايا بابتسامة مريرة، وهو يضع يده على جنبه الموجوع، شارداً فى الذين يقبلون مثل هذه الأشياء، دون أن يلتفتوا، إلى الدماء التى تقطر منها».
ليس هذا هو المشهد الوحيد الذى يتذكره فتحى، إذ كان كثير من الأشخاص القادمين للمحكمة مصابون بأمراض نفسية مختلفة: «لم يكونوا مصابين بمرض خطير، إنهم يبدون عقلاء بالكامل، لكنهم يعانون من هوس ما، يأتى الواحد منهم، ويدوّن شكوى، ويقرنها بوقائع لا دليل عليها، شكوى تُحفظ فى الأغلب. أتذكر مثلاً أن أحدهم جاء ليقول إن جاره هدم حائطه، وأتذكر كذلك أن آخر اتّهم مجموعة بالتهجم عليه، ضربوه وقيدوه وانتزعوا منه أرضه، وكانت اللحظة الصعبة هى لحظة إخبارهم بالحُكم. كانت تنتابهم حالة من الغليان والهياج، ويصرخون فى وجهى كأننى قتلت لهم قتيلاً».
البسطاء غالباً فى الأقاليم البعيدة ضحايا، ولديهم، كما يقول فتحى، بعض مشاكل، والكل يُفهِمَهم أن المحكمة تملك حلولاً السحرية لمشاكلهم، ومعظم شكاواهم تتعلق بالمصالح الحكومية، كالمعاش. موظفو تلك المصالح أنفسهم كانوا يوفرون على أنفسهم وجع الدماغ، ويخبرونهم بأن عليهم الذهاب إلى المحكمة، «يضحكون عليهم» حتى يتخلصوا من زنّهم، وهكذا حينما يخسر الشخص منهم قضيته، يعتبر أن المحكمة خذلته، مع أن هذا غير حقيقى. لقد تحول كثير منهم إلى أصدقاء لفتحى. كان صبوراً وطيباً معهم، كما هو صبور وطيب مع أصدقائه. يجلس فى غرفته، ويرحب بكل شخص يطرق بابه، ويطلب له شاياً، ويستمع إلى مشكلته، وعبثاً يحاول إفهامه أنه يحتاج إلى إثبات، وتحت ضغط كبير منه يُدوّن فتحى فى ورقة الفولسكاب أمامه ما يسمعه منه، بل إنه يساعده بقدر الإمكان، ثم يعود إليه ذلك الشخص فيما بعد ويسأله: ماذا حدث؟ وفتحى يخبره بأن الشكوى رُفضت، فينهار ويقول له بتوسل: «حنَّ عليك، أبوس على إيدك، بس حاول مرة تانية»، وهكذا يعيد فتحى الكرة تلو الكرة. كانت بساطتهم تؤلمه، لكنه كان يعرف أنه ليس بيده الكثير ليقدمه لهم، وبالتالى بدا كما لو أنه يساعدهم فقط فى مدّ خيوط الأمل بضعة أيام أو أسابيع. حفظوا اسمه، وحفظ أسماءهم. يقول بأسى: «كل وجه مر بى أحفظه، وكل لحظة أمل انحفرت فى ذهنى، وكل لحظة ألم آلمتنى».
التحق فتحى فى فترة أخرى بوظيفة «سكرتير تحقيق». كانت فترة مثيرة جداً، أكثر إثارة من مجرد استماعه إلى ما يقوله الأشخاص أمام وكلاء النيابة، إذ أن هذه الوظيفة وفّرت له لقاء مباشراً بأطراف الجرائم الكبرى مثل جرائم القتل والاتجار فى المخدرات والأموال العامة وغيرها، وأتاحت له التواجد فى أماكن وقوع الحوادث ومناظرة الجثث فى المشرحة. لا ينسى فتحى دخوله المشرحة لأول مرة. شعر بالصدمة وهو يتطلّع إلى الجثث المصفوفة حوله على الطاولات. عاد إلى البيت ولم يستطع تناول الطعام، وحين ألحوا عليه، أفرغ ما فى جوفه، وتكرر الأمر عدة مرات. كان يصاب بمزاج سوداوى لفترة طويلة، لكنه اعتاد الأمر فى النهاية: «هذا الاعتياد يبدو لى بشعاً. كان التصالح مع هذه المشاهد رهيباً، كنت أحاسب نفسى على أن جزءاً من إنسانيتى يغادرنى». كان فتحى حاضراً مأساة غرق عبارتى «السلام» و«سالم إكسبريس». كان يطالع على مدار يومين عشرات الجثث. يقول: «كل جثة تكاد تكون علامة مستقلة فى تشوهاتها. كنت أعود إلى البيت ومعى أشباح تلك الجثث، تنام معى على فراشى، وتشكل أحلامى وكوابيسى»..
ليس هذا هو أكثر ما واجه فتحى بشاعة، إذ كان فى انتظاره ما هو أكثر قسوة، وأعنى استخراج الجثث بعد دفنها: «بعد دفن المتوفى كان يأتينا بلاغ بأن من دفنوه تعرض للقتل، فيصدر أمر باستخراج الجثة وتوقيع الكشف الطبى عليها. كان فتح مقبرة بعد عدة أيام من الدفن شيئاً رهيباً، وكان الابن هو القاتل فى معظم هذه الوقائع. أذكر أن أحدهم قتل أمه بسبب قيراطين، قتلها ودفنها بدم بارد، وبعد أسبوعين جاءنا البلاغ، وفتحنا المقبرة، والآن بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على الواقعة أشعر بتقلصات موجعة فى معدتى وأنا أحكى لك».
كانت اللهفة تسيطر على فتحى حينما يتعلق الأمر بكبار القتلة، وقد روعوا الناس فى الثمانينيات والتسعينيات. كانت تصل إلى المحكمة عشرات القضايا بالجرائم التى ارتكبوها، وفتحى كان يمنّى نفسه بمقابلتهم لحظة وقوعهم: «لكننى لم أقابل أحدهم تقريباً إلا وهو قتيل، إما قتلته الشرطة فى عملية صعبة وخطيرة، أو قتله الأهالى أنفسهم».
كان هناك مجرمون عتاة، والأهالى يتناقلون عنهم قصصاً أسطورية، لكن هذا المجرم حينما تقبض عليه الشرطة ويمثل للتحقيق أمام النيابة يتحول إلى كائن ضعيف للغاية: «القصص تقول إنه رهيب، وهذا حقيقى، بإمكانك أن تصبح قوياً وأنت تمسك بسلاح آلى، بإمكانك أن تكون مرعباً وأنت محاط بثلة من المجرمين المسلحين، ولكن وأنت فى الكلابشات ستصبح شخصاً آخر. كنت أتمعن فى وجوه هؤلاء المجرمين، وصدقنى لو قلت لك كان حالهم يصعب علىّ أحياناً، إذ يبدو لى كل منهم بائساً وضحية لظروفه الاجتماعية».
لم يقابل فتحى واحداً ممن اشتهروا إعلامياً بـ«خط الصعيد»، لكنه رأى من هم أكثر بطشاً منهم، غير أنهم لم يحصلوا على الصيت اللازم، لكن الأهم من ذلك، أن عمله الميدانى وفر له لقاء مباشراً بأمهات القتلى. يتذكر فتحى إحداهن، سقط ابنها عباس عبدالمجيد فى خصومة ثأرية، احتاجت إلى ثلاثين قتيلاً وعامين كاملين لتتوقف. كان المشهد مخيفاً، إذ كان أهالى القتلة يسيطرون على المكان من جميع الاتجاهات، ممسكين بأسلحتهم النارية فى تحد واضح لأهالى القتيل، وهكذا لم يستطع أحد رجالهم الذهاب باتجاه الجثة ليحملها ويعود بها، لكن الأم الصلبة وجدت فى ذلك المكان شبه البدائى «براويطة» وهى آلة رفع بدائية تُستخدم فى المعمار، لحمل الطين، آلة ذات عجلة أمامية وحيدة، يدفعها الشخص من خلال قائمين. سارت بخطوات ثابتة وقوية، متحدية الرجال الغاضبين وأسلحتهم والموت نفسه، وصلت إلى جثة ابنها وجرجرتها بصعوبة، وعافرت حتى تضعها داخل «البراويطة»، ولم تكفه مساحتها قطعاً، إذ تدلت أطرافه ورأسه من كل جوانبها، لكنها أدت المطلوب. لم يستطع أحد الخصوم التعرض لها، لم يجرؤ أحدهم على تحدى إرادتها، وربما كان بعضهم يدارى إعجاباً بها. يقول فتحى: «جاءت إلينا فى النيابة، بعد ساعات، وكانت ثابتة، ولم تذرف دمعة واحدة. كانت تتحدث كما لو أن الكارثة لم تحق بها».
يعلق: «استطعت خلال هذه الفترة أن أكوّن ما يشبه صداقات بأطراف تلك الخصومات، وهذا كان يشبع الباحث الموجود داخلى، لكن المؤلم هو عجزى عن كتابة آلاف الصفحات، ولو فى صيغة يوميات مرتبطة بمئات الوقائع. كان هذا يحزننى ولا يزال، خاصة بعد أن أدركت أهمية تدوين هذه الحكايات، لكن فى وقت متأخر للأسف، لدرجة أننى بت أحلم بخروجى إلى المعاش، والتفرغ لكتابة هذه اليوميات، مع أننى أشك فى هذا، بسبب ظروفى الصحية، وهذا يملؤنى بمرارة عظمى».
أحبَّ فتحى ذات مرة فتاة ميتة. لا تندهشوا، ويمكنكم قراءة الحكاية كما رواها: «ذهبنا إلى المشرحة لمعاينة جثتها. كنت أفكر بينما أتطلع إليها فى الطريقة التى اشتعلت بها النيران فى جسدها، فى الهلع الذى اجتاحها، وأعماها ربما عن التصرف الصحيح، فى إدراكها لاقتراب أجلها. كانت ممدة على أرضية المشرحة عارية إلا قليلاً، إذ أن النار أتت على جسدها، وملابسها، لكن تبقت بعض شراشيب دارت ثدييها وعورتها. كنت مندهشاً للغاية، كأن العناية الإلهية أرادت أن تسترها حتى النهاية. ذهبنا إلى منزلها للمعاينة، ورأيت وابور الجاز. كانت على ما يبدو فى الصالة تطبخ، وشممت رائحة الطعام مع روائح الغاز والحريق، ويبدو أنها أيضاً كانت تنحنى على الإناء حين هبّت النار وأمسكت بقميصها، كانت تصرخ كذلك، وهرولت فزعة باتجاه الباب ولم تستطع فتحه، واستنجدت بالناس فى الخارج لكن لم ينجدها أحد. كانت المسكينة تتوجع وتصرخ أمام الباب، وتحاول فتحه بكل الطرق، وقد طال وقوفها لدرجة أن جسمها انطبع على الباب ظلاً أسود. كان ذلك الظل ما تبقى من فتاة جميلة كانت منذ ساعات تملأ هذا المكان الفقير ببهجتها غير العادية. جاءنا بعد قليل من يقول إن هناك شبهة جنائية وراء الأمر، وإن مفتش الصحة كتب فى تقريره أن الجثة لامرأة غير عذراء، وإما أنها انتحرت لتدارى فضيحتها، وإما أن أحد أقربائها قد أشعل النار فيها ليقتص لشرفه، وجاءت أمها إلى النيابة، وقررنا عدم مواجهتها بتلك المعلومة حتى يرد تقرير الطب الشرعى، وكان سيتأخر بالطبع، فلم تكن قنا والأقصر والبحر الأحمر تمتلك سوى طبيب شرعى واحد، ثم جاء التقرير أخيراً ليؤكد أن البنت عذراء وأنها ماتت قضاء وقدراً. كنت أكثر الناس سعادة، وبدا لى كأن هناك ترتيباً يقف وراء كل هذا».
عمل فتحى كذلك «أمين سر جلسة». كانت مهمته الجلوس مع القاضى، وتدوين أحكامه. هذا العمل كان أقل إثارة، وشديد النمطية، لأنه يرتبط بعدد من التهم الثابتة، مثل الخصومات فى قضايا الضرب والشيكات وإيصالات الأمانة. كما عمل فى «جدول الجنايات» وشغله مكتبى، إذ كانت ترد إليه قضايا الجنايات من جميع الأماكن، البحر الأحمر، والأقصر، وقنا طبعاً، وكان عليه أن يقيّدها مسلسلة، ويضع لها الوصف المناسب، ويدوّن التهم، وأسماء المتهمين، وينتظر حتى صدور الأحكام ويكتبها كذلك. كان بإمكانه أن ينشئ إحصائيات دقيقة عن قضايا القتل، المرتبطة بالثأر، لكنه لم يستطع، بسبب ضغوط رهيبة أثقلته من كل اتجاه.
لم يكن فتحى قادراً على استضافة أصدقائه فى مقر عمله بسبب الضغط المتتالى، وبسبب حساسية العمل كذلك. كان يؤجل تلك اللقاءات إلى الليل، وكان يعرف كل مرة يجلس مع أصدقائه أن عليه المغادرة سريعاً، ليتمكن من قراءة أو كتابة شىء، ليتمكن من رؤية أسرته، ليتمكن من النوم، إذ ينتظره العمل من جديد فى الصباح، وكان محمود مغربى حلقة الوصل مع أعداد كبيرة من هؤلاء الأصدقاء، إذ كان محمود يقيم على بعد أمتار من بيت فتحى.
كان فتحى فى كل خطواته يتأمل الحياة حوله، ويحاول فهم الناس وعلاقتهم بالمكان. يقول: «الصعيدى يعيش حبيساً بإرادته داخل قريته، ولا تُتاح له فى الأغلب زيارة كثير من القرى، وبالتالى لا يعلم شيئاً عن الصعيد، والقرى قد تتشابه، لكنها لا تتطابق، فكل واحدة لها خصائصها وعالمها المستقل، وقد أتاح لى عملى زيارة عدد كبير من القرى، وبالتالى عاينت عوالم مختلفة». ويضيف: « الشعر قوّى إحساسى بالتأمل وأهميته، وقوّى رغبتى فى فهم الناس والمكان، وبالتالى جعلنى أهتم كثيراً بموقعى فى العمل، والموقع نفسه فرض علىّ الاهتمام بقضايا لم أهتم بها سابقاً، مثل قضية الثأر، التى خصمت من عمرى عشرة أعوام لدراستها، ولولا الوقائع الكثيرة وتوفر معلوماتها أمامى ما وجدت حافزاً للكتابة فى موضوع كالثأر».
طوال الوقت يعانى صاحب «الموتى يقفزون من النافذة» بسبب الصراع بين شخصية فتحى الموظف، وشخصية فتحى الكاتب. وقد استطاع أن يجاور بينهما أحياناً، لكن إحداهما كانت تجور على الأخرى غالباً. كان الموظف يأخذ حقه، لأنه يعمل بجدية، لإرضاء ضميره. وكان الفنان ينتصر أحياناً، لكنه يكتشف أن الانتصار لا يحدث إلا فى أوقات الإجازات، وراحة البال، وهى قليلة، قلة السعادة فى حياتنا. لكن فتحى لا يُنكر أبداً – رغم أنه يريد الحياة بقية عمره كشاعرٍ – فضل الوظيفة: «لقد حفظتْ لى كرامتى، وكرامة أبنائى. العمل هو حياتى، وهو مصدر رزقى الوحيد. لا أنشر فى مجلات عربية، والمكافآت التى تأتينى من الكتابة ضعيفة ولا تفعل شيئاً. لقد حصلت على جائزة الدولة التشجيعية، وأول شىء فكرت فيه أن أستخدمها فى شراء مقبرتى، وها أنا الآن بت مطمئناً على رفاتى، لكنى أريد أن أطمئن على البقية الباقية من حياتى».








