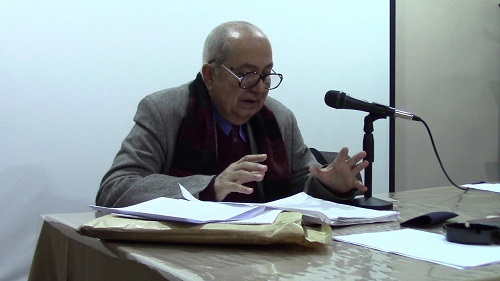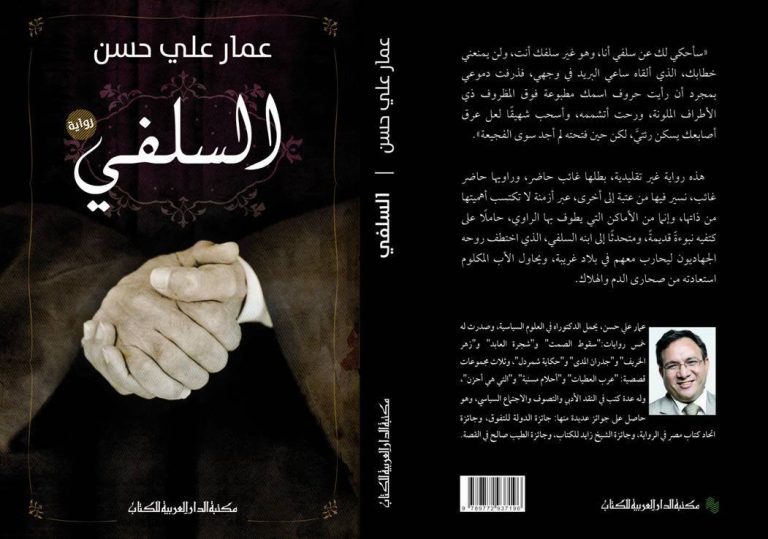هشام بن الشاوي
يستهل الكاتب والروائي المصري عزت القمحاوي كتابه الماتع : “غرفة المسافرين”، باستحضار شيوخ قريته، الذين اعتاد رؤيتهم ملازمين لنفس المكان؛ تقتصر حركتهم اليومية على بضع خطوات محفوظة، يمشيها المبصر والأعمى على حد سواء، بأمان وروية، يخرجون من دورهم ليجلسون أمام المسجد. ومع كل نداء للصلاة يدخلون لأداء الفرض، ثم يعودون إلى جلستهم صامتين معظم الوقت، ينتقلون مع الظل إلى أن يحين أذان الصلاة التالية، ولا يتغير روتين هذا الإيقاع اليومي إلا عندما يسحب منهم الموت أحدهم، فيمشون في جنازته دون أسى، ويعودون إلى جلستهم، التي سرعان ما ينضم إليها شخص جديد، اكتشف أنه صار مسنا، لأنه لم يعد قادرا على مواصلة العمل الزراعي الشاق.
ويشير القمحاوي إلى أنه قد يسافر أحدهم إلى المدينة القريبة، في مناسبات محدودة، لتسجيل قطعة أرض جديدة، أو مصاحبة مريض، ولأنهم أميّون، فهم لم يجربوا متعة السفر في كتاب.. ويفكر فيهم صاحب “السماء على نحو وشيك” بعطف، و يخشى أن يكون مصيره مثلهم، ويتساءل: “ما معنى الثمانين عاما التي يعيشها إنسان في مكان واحد، تمضي فيه وقائع أيامه بتطابق مطلق بين اليوم والذي يليه؟”، ويعتبر القمحاوي من لا يغير مكانه، لن يعرف في حياته إلا القليل الذي يمكن أن يدهشه مهما طالت، ولن تكون حياته مصدر دهشة لأحد إلا إذا قام بانقلاب جنوني، كأن يرتكب جريمة شنعاء أو أن يكون ضحية لجريمة.
ويؤكد صاحب “غرفة ترى النيل” أنه من الصعب على من لا يسافر أن يغير الصورة المرسومة له سلفا، “لذلك كان لابد لكل نبي من هجرة. البعيد منبع الحكمة وموطن الغرابة”، ومن يعجز عن السفر في المكان، يرتحل في الزمان.. إلى سالف العصر، كما في الحكايات الشعبية، أو إلى المستقبل كما في روايات الخيال العلمي، ويتساءل الكاتب بصوت عال: “ماذا يمكن أن يتبقى من “ألف ليلة وليلة” إذا حذفنا السفر من متنها؟”.

ويعتبر عزت القمحاوي شهريار محظوظا بامرأة ذكية، سافرت به في حكاياتها ليلة بعد ليلة؛ حيث استبدلت عذرية الأماكن بعذرية البنات، وبعد ثلاث سنوات من الترحال في الحكايات، كانت قد دجنته، وأنجبت منه ثلاثة أولاد، ولم يعد يستغني عنها، فقرر الزواج منها.
هكذا أنقذت شهرزاد بسفرها في الحكايات رجلين لا رجلا واحدا من شهوة الدم، حيث تنازل شاه زمان عن ملكه، مفضلا عليه البقاء مع عروسه لدى شقيقه… ويخلص عزت، بكل اطمئنان، إلى أن “ألف ليلة…” كتاب في السفر، من دون الرحلة يسقط العجائبي، العمود الفقري لليالي. لهذا انحاز السرد فيها إلى الارتحال الدائم .. وتيمنا بالليالي يظل السفر هو روح السرد في كل زمان، يمده بالدهشة، ويمتد للانطلاقات الكبرى في الحكاية، من “دون كيخوته” إلى “موبي ديك”،إلى “مدن لا مرئية “، لهذا يحب الروائيون السفر، باستثناءات نادرة كنجيب محفوظ، وأبطاله مثله لا يسافرون، وإذا سافروا، فإننا نعرف سفرهم أو عودتهم كخبر في جملة.
وعند حديثه عن لقائه بصديق طفولة يقيم في إيطاليا، يفرق القمحاوي بين الإقامة والعيش هناك؛ لأن الإقامة تختلف عن العيش تماما. لم يسافر ذلك الصديق القديم إلا للضرورة، بحثا عن الستر، الذي يجلبه العمل في الخارج، ولم يسافر بحثا عن المتعة، ولا عن مضاعفة العمر الذي يبتغيه الناس من السفر، ويذكر ذلك الصديق عزت بحلمه القديم بالعيش في الريف الإنجليزي، فيستحضر تلك الفرحة التي لن تتكرر، عند توصله بمجلة من إذاعة “البي بي سي”، فتنته الألوان المبهجة، وسلب خياله العشب الأخضر الزاهي، الممتد بين البيوت الأنيقة، وبدت له حياة الريف الإنجليزي ناعمة ومصقولة كورق تلك المجلة، ويعترف الكاتب بأنه من حسن حظه أنه لم يزره حتى الآن، ولا يسعى لزيارته لاحقا، حتى لا يجرح صورة تلك الجنة التي حلم بها طفل في قرية مصرية، حلم بمكان بعيد، بريف بعيد جدا، ولم يحلم بمدينة، وكأن المدينة شيء يتجاوز قدرة أحلامه، وربما كان العالم – بالنسبة إليه- مجرد ريف متعدد الأشكال.. ويعترف عزت القمحاوي بأن حلم العيش في الريف الإنجليزي قد لا يراود الكثير من الناس، لكن الشوق إلى لقاء المختلف والمدهش يتطابق وأحلام الملايين من البشر.
السفر اكتشاف لأنفسنا أكثر مما هو اكتشاف للمكان المختلف، حيث نصبح أكثر قدرة على التقدير الصحيح لمشاعرنا بعد الانتقال إلى عالم آخر. وعلى قدر السطحية التي تصبغ العلاقة بالناس والأشياء في السفر على قدر العمق الذي ينشأ بين الإنسان وذاته، يكتشف نفسه ويعرف ما عليه روحه حقيقة وليس ما تبدو عليه بين الآخرين. السفر يحررنا من الرقابة الاجتماعية، فنكتشف أن هذه الأدوار لم تكن لنا، وأن استمرارنا في أدائها محكوم بالنفاق والاستكانة إلى الصورة، التي رسمها لنا الآخرون.
وإذا كان الهروب من الموت مستحيلا؛ فالسفر – بنظرة بنظرة أخرى- محاولة لاستئناس ذلك العدو؛ الرحلة عرض لطيف نقوم فيه بأدوار الموتى، ثم نخرج منه سالمين، مثلما يغادر الممثل المسرح عائدا إلى بيته، بعد أن رأيناه يسقط مقتولا. هذا الموت الرمزي لا يعني أن خطر الموت الحقيقي غير قائم خلال الرحلة، ويؤكد الكاتب أن كل المسافرين تنتابهم قبل الشروع في الرحلة مخاوف الموت في حادث طائرة أو قطار… لكن رحلة الفرار من الموت الوحيدة، التي تكللت بالنجاح، هي رحلة النبي نوح عليه السلام، وقد صارت بمثابة خلق ثان للعالم، لكن القدر لم يكرر منح جائزته لهارب آخر، ويرى صاحب “بيت الديب” أن أسطورة أوديب الإغريقية، التي استلهمها كـتّاب المسرح، وتلقفها فرويد لتفسير ظاهرة تعلق الولد بالأم، تنطوي على ثلاث محاولات للهرب تفاديا للمصير دون نجاح.. وإذا كانت رحلة نوح قصة الهروب الوحيدة الناجحة، فإن الفرار غير المجدي لأوديب مثال للحبكة الأدبية المحكمة، التي تشي بأن الفرار من الموت سعي خائب، ومع ذلك لا نتخلى عن المحاولة.
ويرى القمحاوي أن جنون الحرب الخاسرة سلفا ضد العدم في كل فن عظيم، لكن لا أحد تيسرت له رؤية ذلك العدو مهما أطال التحديق.. إنه الزمن؛ عدونا الخفي، الذي نرى أثر عبوره فحسب، ونسافر على أمل الإمساك به، ويبدو المكان ظاهريا، هدف مطارداتنا، لكن في العمق نحن نطارد الزمن.
“يكتب عزت القمحاوي عن خفة الكائن خارج مكان عيشه الأصلي، عن السفر بوصفه موتا لذيذا، نعود منه لنتأكد أن من نضحي بحياتنا من أجلهم يستطيعون العيش من دوننا.. يكتب عن أشياء صغيرة وأحاسيس سبق أن عشناها، لكننا لم نفكر فيها من قبل.. في نص مفتوح على كل فنون الكتابة، مكتفيا بمتعة القراءة ومهنة العيش مع حس صوفي يسري داخل النص سريان عصارة الحياة في عروق شجرة مبتهجة”.
غرفة المسافرين ” من الكتب العصية على التصنيف، العابرة للنوع، على غرار كتب سابقة للكاتب، من قبيل “الايك في المباهج والأحزان “،”كتاب الغواية” و”العار من الضفتين”، حيث يصافح الحكي الانسيابي التأمل الفلسفي العميق، متوسلا بأسلوب شاعري تتشابك فيه الكثير من المعارف، الأشواق، القراءات، الخبرات والهواجس الانسانية، فالسفر سعي للعيش الكثيف طالما أن وقتنا على الأرض محدود، ومحاولة لتوسيع للمكان طالما ليس بمقدورنا تمديد الزمان، لكن علينا أن نحذر نظرة الجمال المرتدة المدمرة…
طوبى للشغوفين بالتقاط الصور أثناء رحلاتهم!