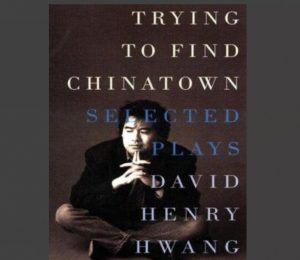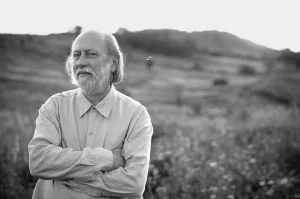ترجمة: عثمان بن شقرون
يعتبر الكاتب الأرغوايي إدواردو غليانو من الكتاب الذين لا تكل عندهم بهجة الحكي أبدا، حتى عندما يتكلم عن واقع اجتماعي قلما يبعث على الحماس، واقع قارة مهووس بحبها. يعد كتابه ” الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية” (1971) عملا مرجعيا لكل من أراد فهم تاريخ و واقع هذه القارة. حيث تعتبر نقطة انطلاقته لغزا محيرا: لماذا هذه الأرض التي وهبتها الطبيعة الكثير ليست بنفس الحظ على المستوى الاجتماعي و السياسي؟” في هذا المؤلف المختلج كرواية بوليسية يحكي بشغف وليونة وسخط عما يسميه إدواردو غليانو ب”النهب” التي تعرضت له القارة الأمريكية اللاتينية. في البداية من طرف الإسبان والبرتغاليين، بعد ذلك من طرف الغرب والنخب المحلية. وبدون مركب نقص يسخر إدواردو غليانو من الحدود التي تفصل بين مختلف الأجناس الأدبية. إن كتبه التي تتموقع في مفترق طرق السرد والبحث والشعر واليوميات تروي أصوات الروح والشارع وتمنح توليفا للواقع الحالي والذاكرة.
ولد إدواردو غليانو 1940 في مونطي فيديو بالأرغواي. عمل بمسقط رأسه رئيس تحرير لأسبوعية “ماركا” ومدير يومية “إيبوكا”. وفي “بوينوس إريس” بالأرجنتين حيث نفي، أسس وأدار مجلة “كريسيس” قبل أن يلتحق بإسبانيا. له رصيد صحافي محترم. أغلب مؤلفات إدواردو غليانو ترجمت إلى العديد من اللغات. ومن أهم أعماله: الثلاثية: ذاكرة الموت – الوجوه والأقنعة – عصر الريح(1985-1988 ). “أيام وليالي الحب والحرب” (1987) –” أمريكا: الاكتشاف الذي لم يقع بعد” (1992) – “كتاب المعانقات” (1995) – ” كرة القدم، ظل وضوء”.( 1998). نال عدة جوائز عالمية عن كتبه وخصوصا عن الثلاثية التي ذاع صيتها. توفي إدواردو غليانو في مسقط رأسه سنة 2015.
في هذا الحديث الطويل المقتطف من مجلة “بريد اليونسكو” سنصغي إلى الكاتب الأرغوايي إدواردو غاليانو وهو يعمد إلى تعرية الواقع حيث يتفحص بدقة كل من العولمة والذاكرة والهوية الثقافية ونضالات الأهالي والإنسان والأرض… و كرة القدم.
***
ماذا عن العولمة؟
ليست العولمة ظاهرة جديدة لكنها نزعة تأتي من زمن بعيد. و تسارعت خطواتها بشكل حثيث في السنوات الأخيرة على إثر التطور المذهل لأنساق التواصل و وسائل النقل، اللذين يبعثان على الدوار. إنها أيضا محصلة لتمركز الرساميل على المستوى العالمي، ليس أقل بعثا على الدوار. لكن لا يجب أن نخلط بين العولمة والعالمية. يمكن أن نومن بكونية الشروط الإنسانية، أهواءنا ومخاوفنا وحاجاتنا وأحلامنا… لكن “محو ” الحدود الذي يسمح للمال بالتنقل بكل حرية فهو أمر ذو نبرة مختلفة تماما. مما يعني أن حرية الأشخاص شيء مختلف عن حرية المال.
تقرير المصير الغذائي.
إن العلامة المثلى للعولمة هو هذا النجاح الباهر لمؤسسات ” ماك دونالد”، التي تفتح كل يوم خمسة مطاعم جديدة في سائر الأركان الأربع للكرة الأرضية. إنها بالنسبة لي أكثر دلالة من سقوط جدار برلين. إنها الطابور الذي يقف فيه الروس أمام “ماك دونالد” في الساحة الحمراء في موسكو. في نفس المكان الذي انهار فيه ما سمي ب “ الحاجز الحديدي “. و نظرا للطريقة التي انهار بها كان بالأحرى حاجزا من ورق. إن العولمة الكونية تفرض أن يتناول المرء و جبة في البلاستيك. لكن وفي نفس الوقت فإن نجاح “ماك دونالد” ينتهك إحدى الحقوق الأساسية للإنسان، الحق في تقرير المصير الغذائي. إن البطن دائرة الروح والفم بابها. قل لي ماذا تأكل أقول لك من أنت. أن تتغذى يعني أن تختار طريقة ما للأكل. إن طريقة الطبخ سمة من السمات المهمة للهوية الثقافية. لا يتعلق الأمر بكمية الغذاء، وإن كانت لها أهمية كبيرة بالنسبة للشعوب الفقيرة والأكثر فقرا. إنهم لا يأكلون كثيرا أو لا شيء تقريبا. ولكنهم يحافظون على التقاليد التي تجعل من هذا الفعل البسيط لأكل القليل أو لا شيء تقريبا، يتحول إلى شكل من أشكال الاحتفال.
ضد قولبة أنماط الحياة.
أفضل ما في العالم كونه يحتوي على عوالم متعددة. وهذه التعددية الثقافية، التي هي إرث للإنسانية تتوضح أكثر في طريقة الأكل. لكنها تتوضح أيضا في طريقة التفكير والإحساس والكلام والرقص والحلم. واليوم توجد نزعة متسارعة لقولبة أنماط الحياة. لكن في نفس الوقت تزداد ردود الأفعال المدافعة تبلورا: إن أنصار التعددية والاختلاف جديرون بالمساندة. ويجب أن نعمل على إبراز الاختلافات الثقافية وليس الاجتماعية. من أجل أن تبقى الإنسانية متعددة الألوان وألا تنصهر في لون واحد. لكن في مواجهة تدفق التجنيس الإجباري. إذا كانت بعد ردود الأفعال تبدو صحية فإن الأخرى تكشف أحيانا عن جنون: كالتعصب الديني ومختلف أشكال التعبير الميؤوس منه للهوية. وما أعتقد هو أننا لسنا محكوم علينا مطلقا في عالم لا يترك لنا إلا خيارا واحدا إما أن نموت جوعا أو ضجرا.
الهوية تتحرك باستمرار.
ليست الهوية الثقافية مزهرية ثمينة معتقلة بوداعة داخل واجهة متحف. إنها حركة مستمرة تتغير بدون انقطاع. وتخضع دوما للتحدي من طرف الواقع، بل إنها في حركة أبدية. أنا هو أنا، ولكن أنا أيضا هو ما أفعل لأغير من أنا. إن الصفاء الثقافي لا يوجد أكثر من الصفاء العرقي. ومن الحظ أن كل ثقافة هي نتاج خليط يحتوي على عناصر خارجية. إن ما يحدد ملامح نتاج ثقافي، سواء كان كتابا أو رقصة أو تعبيرا شفهيا أو طريقة للعب كرة القدم، ليس أبدا أصله وإنما محتواه.
إن مشروبا كوبيا أصيلا ك” دايكيري” لا يحتوي شيئا كوبيا. إن المثلوجات تأتي من مكان آخر، نفس الشيء بالنسبة لليمون والسكر والروم. كريستوف كلومب هو الذي جاء بالسكر من جزر الكناري. ومع ذلك لا يوجد ما هو أكثر كوبيا من “دايكيري”. إن ” تشوروس” الأندلسية ( فطائر مقلية في شكل حلزوني) جاءت من عند العرب. والعجائن الإيطالية جاءت من الصين. لا منتوج يمكنه أن يكون مؤهلا أو يُجرد من أهليته على أساس أصله الوحيد. ما يهم، هو ما نفعل بهذا المنتوج. وإلى أي حد تستطيع جماعة ما أن تجد نفسها في رمز له علاقة بطريقتها المفضلة في الحلم والحياة والرقص واللعب والحب. من هنا تأتي سعادة العالم: من هذا المزيج اللامنقطع الذي يولد إجابات جديدة لأسئلة جديدة. في حين توجد حاليا نزعة حثيثة للقولبة كنتاج للعولمة بزحفها المحتوم. هذه النزعة مرتبطة في جزء كبير منها بتمركز السلط بين أيدي المجموعات الكبرى للتواصل.
الأمل: الإنترنت والإذاعات الجماعية.
هل تم اختزال حق التعبير، المعترف به في جميع الدساتير، إلى حق بسيط في الإنصات؟ أليس حق التعبير هو أيضا الحق في الكلام؟ لكن من له الحق في الكلام ؟ هذه الأسئلة ترتبط عميقا بالخسائر التي تتكبدها التعددية الثقافية اليوم. إن فضاءات الحرية في عالم التواصل تقلصت كثيرا. وجماعات التواصل المهيمنة لا تفرض خبرا مخدوما ومشوها فحسب، ولكن تفرض أيضا رؤية معينة للعالم تنزع أن تكون الرؤية الوحيدة الممكنة. إن الإنترنت تبدو اليوم وكأنها مانحة لوعد كبير. إنها إحدى المفارقات التي تغذي الأمل. لقد ولدت الإنترنت عن حاجة لتمفصل المخططات الحربية على المستوى العالمي. بعبارة أخرى، إن الشبكة صممت من أجل خدمة الحرب والموت. والحال أن الإنترنت اليوم حقل التعبير لمختلف الأصوات التي كانت بالبارحة مسموعة بالكاد. من الأكيد إن الإنترنت استغلت أيضا من أجل غايات تجارية، لكن الشبكة فتحت فضاء جد مهم لحرية التواصل المستقل، هذا الذي يتحمل الكثير من أجل شق طريق له وسط وسائل الإعلام كالتلفزة والصحافة المكتوبة. أما في الميدان الإذاعي فالوضعية تتطور بشكل إيجابي. إن تطور الإذاعات الجماعية في أمريكا اللاتينية يشجع التعبير الشعبي إلى حد بعيد. أن نتكلم إلى الناس ليس هو نفس الشيء بأن نستمع إليهم يتكلمون. أن نسمع الأصوات التي تستطيع أن تعي الواقع حينما يتاح التعبير عنه وحينما يمارس الشعب حقه في التعبير الحر.
الغاية و وسائلها.
عند اليونان قديما لم يكن القاتل وحده يدان. وإنما تدان معه آلة الجريمة أيضا. حينما كانت ترتكب جريمة ما فإن الآلة يرمى بها في نهر من الأنهار. و اليوم نعلم أنه لا يجب أن نخلط بين الوسائل والغايات. والكارثة في أمريكا اللاتينية لا تكمن في كون التلفزة كلية الوجود. وإنما في النمط التلفزي التجاري لأمريكا الشمالية المفروض عليها. نحن لم نتعلم شيئا من النموذج الأوروبي لتلفزة موجهة نحو غايات أخرى. في العديد من الدول الأوروبية كألمانيا والدانمرك وهولندا، تباشر التلفزة وظائف ثقافية غنية ومهمة ( أكيد أقل من السابق) مستندة على وضعها كمرفق عمومي. هنا وبالعكس تماما وبمقتضى النموذج الأمريكي الشمالي كل شيء صالح مادام يستطيع أن يساهم في البيع، و كل شيء رديء لا يستطيع أن يساهم في البيع.
نضالات المواطنين الأصليين.
من بين العديد من القوى الخفية والعديد من مصادر الطاقة التي تحتويها أراضي أمريكا اللاتينية هو شعبها ونهضة الحركات الأهلية والحيوية العجيبة للقيم التي تجسدها. إنها قيم المشاركة مع الطبيعة. والقيم الجماعية للقسمة وليس قيم الرغبة. إنها قيم تأتي من الماضي ولكنها تتكلم عن المستقبل. هذه القيم لها الكثير مما يمكنه أن تقدمه لنا. إنها تلقى صدى واسعا، لأنها القيم التي يجب على الإنسانية جمعاء أن تهتدي إليها ثانية. لأنه في عالمنا وخلال السنوات الأخيرة أصبحت روابط التضامن متأثرة بشكل خطير وفي أغلب الأحيان منقطعة. إن عالمنا متمركز حول الأنانية، “كل شخص بمفرده”. “ويفر بجلدته من يستطيع”.
الإنسان والأرض.
لقد مرت خمسة قرون على تدجين أمريكا اللاتينية وفصل الطبيعة عن الإنسان، على كل حال هذا الذي نسميه الإنسان، لكن هل يشمل في الواقع الرجل والمرأة. الطبيعة من جهة و البشر من جهة أخرى، العالم كله عرف هذا الطلاق. العديد من الأهالي الذين حكم عليهم بأن يحرقوا أحياء بسبب وثنيتهم كانوا في الواقع من نسميهم الآن بالأيكولوجيين. لقد مارسوا في زمنهم الإيكولوجيا الوحيدة التي تبدو لي مقبولة: إيكولوجيا المشاركة مع الطبيعة. المشاركة مع الطبيعة و الروح الجماعية هما المفتاحان اللذان يفسران بقاء القيم الأهلية التقليدية، رغم خمسة قرون من الاضطهاد والاحتقار. والآن وبما أننا جميعا “خُضر” كوصلة إشهار كاذبة مصنوعة من كلمات وليس من الواقع، فإن الطبيعة أصبحت شيئا يتوجب علينا حمايته. ولكن في هذه الحالة أو تلك، وسواء كانت الطبيعة موضوعا للهيمنة حيث نستطيع أن نجلب منها بعض المنافع، أو موضوعا للحماية فإننا منفصلون عنها. يتوجب علينا أن نعثر ثانية على المعنى الأهلي للمشاركة مع الطبيعة. إن الطبيعة لا تختزل إلى مشهد ريفي. إنها بداخلنا وتحيا معنا. لا أفكر فقط في الغابات ولكن في كل ما يمس مفهوم المقدس الذي تصوره الأهالي الأمريكيون حول الطبيعة ولا زالوا يحملونه عنها. المقدس بمعنى: أن كل ما يمكن أن نمس به الطبيعة قد ينقلب ضدنا يوما. كل الجرائم تتحول إلى انتحار كما تبرز ذلك المدن الأمريكية اللاتينية الكبرى، هذه النسخ الرديئة للمدن المتطورة. حيث إنه من المستحيل فعلا أن تتمشى وأن تتنفس فيها. نعيش اليوم في عالم حيث الهواء مسموم والماء مسموم والأرض مسمومة ولكن بالخصوص الروح مسمومة. أملنا في السماء لكي نستطيع أن نُبعث ثانية لكي نشفى.
الوصف الذاتي.
كل كتبي يصعب تصنيفها. إنه من الصعب أن نميز ما هو خيال وما هو ليس كذلك. الشيء الذي أفضله هو أن أحكي. إني أحيا كراوٍ، آخذ وأعطي. إنه شكل من أشكال الذهاب والإياب. أنصت إلى الأصوات وأعيد ترميميها في شكل حكي وبحث وكتب غير قابلة للتصنيف، حيث تتجمع كل الأساليب والأجناس. إني أحاول أن أبدع مؤلفا يذهب أبعد من التصنيفات التقليدية التي تميز بين القصة والبحث والرواية والشعر والحكاية واليوميات. إني أحاول أن أقترح رسالة شاملة لأني أعتقد أن الكلام الإنساني يجعل من هذا التأليف شيئا ممكنا. لا توجد حدود بين الصحافة والأدب. إن الأدب هو مجموع الرسالات / Messages المكتوبة التي يرسلها مجتمع ما مهما كان شكلها. يمكننا دائما أن نقول ما نرغب في قوله سواء بصفتنا كتابا أو بصفتنا صحافيين. إذا كانت الصحافة من النوع الممتاز يمكنها أن تنتج أدبا راقيا. كما تدل على ذلك إنتاجات العديد من كتاب أمريكا اللاتينية. لقد كنت دائما صحافيا، وسأبقى صحافيا. إنه بمجرد ما ندخل إلى عالم التحرير العجيب، من يستطيع أن يخرجنا منه؟ للصحافة فضائل، إنها تعلم الإيجاز لمن يريد أن يكتب حول زخم الأشياء. إنها ترغم المرء بأن يخرج من عالمه الصغير ليغوص في الواقع وأن يرقص على نفس إيقاع الآخرين. وترغم كذلك على الخروج من الذات للإنصات للآخرين. وللصحافة أيضا مساوئها. أولى هذه المساوئ كونها تتطلب عملا مستعجلا. أحيانا يمكنني أن أتعثر في كلمة وأقضي ثلاث ساعة أبحث عن أخرى. إنه ترف لا يمكن للصحافة أن تمنحني إياه.
الحلم واليقظة.
و ظيفتي الوحيدة هي أن أحاول تحيين الواقع المقنع، والكلام عما نراه وعما يبقى مستورا. إنه واقع اليقظة إنه واقع مزيف وأحيانا كاذب ولكنه أيضا واقع مليء بالحقائق المهملة أو نادرا ما تُسمع. لا وصفة سحرية تتيح لنا تغيير الواقع إذا لم نبدأ بالنظر إليه كما هو. لكي نستطيع تغييره يجب في البداية أن نتقلده. وهذا هو مشكلنا في أمريكا اللاتينية لا نستطيع إلى حد الآن أن نرى الواقع. نحن عميان لا نبصر أنفسنا لأننا حملنا على رؤية أنفسنا بعيون ليست عيوننا. ولهذا السبب لا تعكس لنا المرآة سوى بقع كمداء ولا شيء غير ذلك.
… وكرة القدم.
نحن جميعا في الأرغواي نولد ونحن نهتف: “هدف”. ولهذا السبب يوجد كثيرا من الضجيج والضوضاء في دور الحضانة. وككل أطفال بلدي أحببت أن أصبح لاعب كرة القدم. كنت ألعب وسط الميدان ولكني لم أكن أبدا لاعبا ممتازا لقد كنت طائشا بشكل فظيع. ولم يحصل يوما أن استطعنا أنا والكرة أن نتفاهم. لقد عشت أنا والكرة قصة حب غير متقاسم. بالإضافة إلى ذلك فلي موقف مفجع: حينما كان الخصوم يقومون بإجراء مقابلة شيقة كنت أذهب لتهنئتهم، الأمر الذي كان يعتبر ذنبا لا يغتفر في سياق كرة القدم الحديثة.