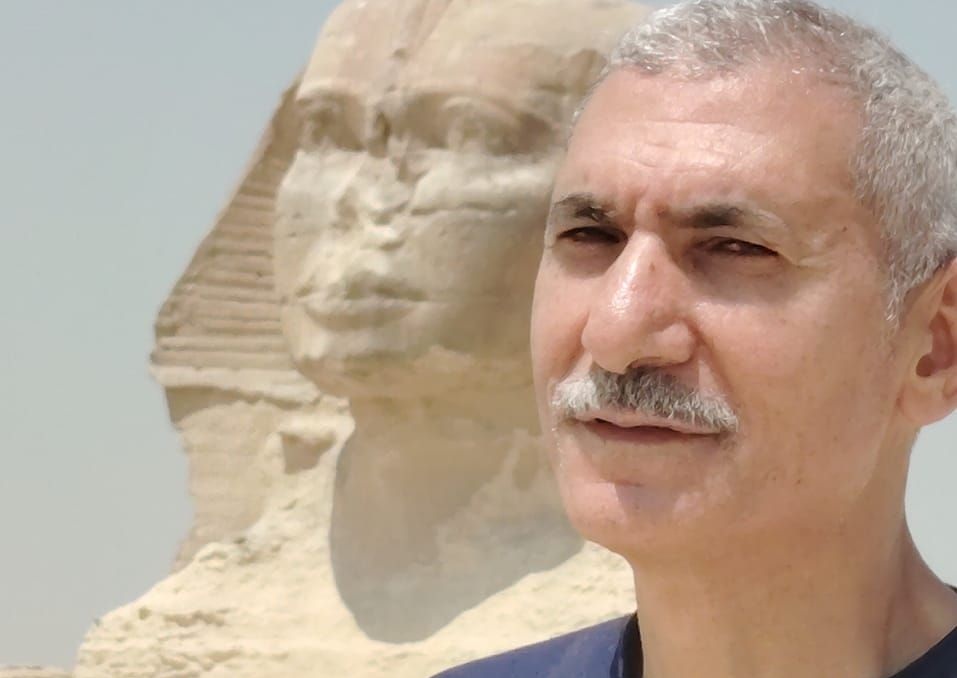د.شريف صالح
“لو كانت لي شجاعة كافية، كل يوم، كي أصرخ ربع ساعة، لتمتعت بتوازن كامل”، تصلح مقولة إميل سيوران للإشارة إلى الشاعر والروائي سمير درويش. أو على الأقل انطباعي عنه أنه شخص يجيد الصراخ. ليس بالدلالة السلبية للمفردة، فهي صرخة الوعي للنطق بالمسكوت عنه والتعبير عن الرأي والذات. صرخة لا تخلو من موسيقى الشعراء وحكمة وعقلانية المفكر.
أتابع تعليقات كثيرة ينشرها على صفحته في الفيسبوك وعبر تلك المنصة تعارفنا، وكانت مفارقة لأنه تعارف متأخر جدًّا برغم أن سمير يسبقني بخطوة أو مسافة جيل في الوسط الثقافي، فهو ينتمي لما يسمى جيل الثمانينيات بينما أصنف ضمن جيل التسعينيات. وبحكم تلك الأسبقية كان من المفترض أن نلتقي لقاء التلميذ بالأستاذ أو الزميل الأكبر بالأصغر مثلما حدث مع آخرين مثل الشاعر والروائي علي عطا والشاعر عزمي عبد الوهاب.
بمعنى آخر لم يكن كافيًا أن نعمل في المجال ذاته وتتنوع اهتماماتنا بين الصحافة والثقافة منذ ثلاثين أو أربعين عامًا ولم يجمعنا فضاء وعمل مشترك.
مع ذلك كانت صرخات سمير درويش العقلانية الشارحة الناقدة مثل مصابيح هادية لتفكيك كتل الظلام، وكانت هي ما جذبني إليه. هذا العقل الذي يساجل بدقة وهدوء بلا تشنج ولا ادعاء ولا انتقام ولا تصفية حسابات. فقط يقول كلمته واضحة الحروف والأبعاد ويطرحها للنقاش وفتح قنوات اتفاق واختلاف معها.
يبدو هذا الكلام طبيعيًّا، أو هو المفترض أن يكون، لكن من خبرتي المتواضعة بالوسط الثقافي فهو مليء بأوهام العظمة والنرجسية والمليشيات والتقية والاستبطان، ويقول الكلام كي يعني شيئًا خالف ما يُفهم منه.
وليس إلى ذاك المسعى يتجه صوته وإنما هو يوفر المعلومة من واقع خبرته المباشرة لأربعة عقود في الحياة الثقافية، شاهد حي على أحداث ومؤتمرات ورجال سواء في هيئة قصور الثقافة أو اتحاد الكتاب.
هذا النزوع “الليبرالي” الذي يناسب مزاجي هو ما خلق ألفة بيننا كأننا أصدقاء منذ عقود. وهو ما يجعلني أحيانًا أقول لنفسي إنه كتب ما كنتُ أفكر فيه بالضبط وصرخ نيابة عني وعن آخرين.
والصرخة بتعبير سيوران هي احتجاج ضد كل ما ليس متزنًا بهدف استعادة التناغم إلى المعنى والموقف. هي تعبير مثالي نزيه يعرف كيف يأخذ مسافة كافية من جميع الأطراف، مثلما ينصف من يكرههم أو يختلف معهم قدر إنصافه لمن يشبهون عقله.
لذلك حدث في بعض المرات أننا اختلفنا حول تعليق سياسي أو موقف ثقافي معين، وربما اختلفنا في تقدير رجال لكن لم ينقطع حبل الود بيننا أبدًا.
تسمح تلك الليبرالية الهادئة بحق التعبير عن الرأي، ليس لأنه صواب أو خطأ وإنما لأنه رأيك وحقك، ولك أيضًا مطلق الحرية أن تغييره متى تشاء ولا تصادر حق الاختلاف معه.
هي آراء بعيدة عن الضغينة والإساءة وقناع المصلحة، تسمح لنا بمراقبة ما يدور حولنا بما في ذلك تابوهات الدين والسياسية التي كثيرًا ما أعاد دوريش تفكيكيها في تدويناته، وكذلك في افتتاحياته المهمة في مجلة ميريت الثقافية.
لا يرعى دوريش -بحكم مناصبه المتعددة- رفاق الدرب بمنطق الشلة وتبادل المصالح؛ بقدر ما يرعى حيوية الثقافة ذاتها، ودفعها للأمام والدفاع عنها ضد التهميش والدعشنة.
وهذا ما تأكد لي بجلاء في تجربة “ميريت الثقافية”، المجلة التي حفلت بمئات المواد واحتضت مئات المبدعين العرب برغم أنها تجربة قصيرة نسبيًا.
وكانت “ميريت” جسرًا ممتدًا بيينا، والتجربة الأساسية التي جمعتنا حين أتاح لي فرصة النشر بانتظام لنشترك معًا في تفكيك الظواهر الثقافية. منحني مساحة حرية مدهشة وليس فقط مساحة صفحات واسعة.
وبالمحبة نفسها فاجأني بالاحتفاء بتجربتي الإبداعية عبر حوار موسع لـ”ميريت” مثلما أدهشتني قراءته الشفيفة لروايتي “ابتسامة بوذا”.
هنا لا أتحدث فقط عن نزاهة التفكير والأفكار، وإنما أيضًا عن نزاهة العطاء، لأننا لا تجمعنا أية مصالح مشتركة ولا عضوية لجان، فقط محبة الكلمة ومحبة العطاء الإنساني.
في ظني لا يصل المرء إلى هذا النضج بمجرد تراكم العمر، فكم من شاعر تجاوز الستين وما زال نزقًا صبيانيًّا ومبتذلًا في أفكاره ومعاركه، وكم من روائي نشر عشرات الروايات ولا يبدو أن الثقافة تركت أثرًا حميدًا في أدائه قولًا وفعلًا.
هل نحن هنا ندور في فلك مفهوم غرامشي الشهير عن “المثقف العضوي” الذي يتميز بوعي ناضج يتجاوز مجتمعه؛ ومن ثم يقوده نحو الفضيلة متحملًا مسؤوليته التاريخية بشجاعة؟
ربما هو المفهوم المناسب في توصيف تجربة سمير إنسانًا ومبدعًا فعالًا، لا يتراجع ولا يهادن، وفي الوقت نفسه لا يشخصن ولا ينجر وراء مهارات لتغذية نرجسية الذات. ثمة حكمة تغلف آراءه مهما كانت جارحة وحادة ومشككة في مسلمات شائعة.
حكمة أتاحت له أن يتنقل بهدوء ما بين عضوية مجلس إدارة اتحاد الكتاب ورئاسة تحرير مجلة الثقافة الجديدة، وفي كل أحواله -داخل إطار المناصب أو خارجه- يحافظ سمير درويش على النسيج ذاته، يلتزم بالجدية والألفة والوضوح ودقة وشفافية التعبير، يحافظ على العطاء ولا ينتظر التكسب من ورائه، مثلما يواجه ولا يراوغ.
ليس أيضًا ممن يشكو ضياع الفرص ويتباكى على جوائز سلبت منه ولا يبدو -وهو مستحق كل تقدير- أنه يعطي عطاء مشروطًا بأي مقابل.
أدعي -والأيام قد تكذبني- أن فيَّ الكثير من سمات سمير، وربما هي جينات الفلاح في داخلي وداخله، الذي يراقب الشمس ويواجهها ويغرس البذرة غير عابئ بمن سيقطف الثمرة.
ربما هي التأثيرات المتقاربة زمنيًّا لأننا تعلمنا وتأثرنا بالأساتذة أنفسهم. ربما تقاربنا أنا وهو بقامات مثل جابر عصفور أو عبد المنعم تليمة أو الطاهر مكي أو محمد عناني. أيًّا كانت الأسماء التي أثرت فيَّ وفيه، فكلانا كان محظوظًا بتلمذة روحية وفكرية على أساتذة عظام.
آنذاك كان في الأجواء نفحات من الدقة والإتقان والإخلاص وذلك الاتساق بين القول والفعل. لم يكن الماضي فردوسًا مفقودًا بطبيعة الحال، لكنه بموضوعية كان أفضل حالًا من الآن والراهن. كان لدينا أساتذة وأئمة أصحاب كرامات بادية وإنجازات تشحذ طاقتنا كي نتشبه بهم.
مؤكد أنه أحب منجز إبراهيم أصلان والبساطي ومستجاب وعبد الحكيم قاسم وصنع الله إبراهيم مثلما أحببتهم. ولأنه شاعر فحتمًا تلاقي مع نصوص عفيفي مطر وحلمي سالم وعبد المنعم رمضان مثلما التقيت بها.. وحتى مع أرواح وإبداعات من ينتمون إلى جيلي وجيله مثل حمدي أبو جليل.
كنا ورثة تلك الأسماء وذلك المناخ وإن لم ننتمِ إلى الجيل ذاته، مثلما نحن ورثة الفلاح الفصيح نفسه برغم نشأته في ريف القليوبية وانتمائي إلى ريف دمياط، وحين يستدعي حكايات منه أو يكتب شيئًا عن والدته، أحس كأنه يكتبني.
تدربنا -وإن بدرجات متفاوتة- على أن نهب حياتنا للقراءة والكتابة، بينما نرضى بحياة عادية خارج ذلك. لا يشغلنا المال إلا في حده الأدنى، ولا تقديم السبت من أجل الأحد.
تشابهنا في الأفكار وتدوين اليوميات والدفاع عمن لا صوت له، عن الغائب والراحل والمظلوم والآتي الذي لم يولد بعد.
ولا يخفي قناعنا العقلاني الهادئ وسجالنا المتزن وصرختنا المغلفة بالموسيقى ذلك النزوع إلى التمرد والرغبة العميقة في التغيير، لأن الحياة لا تندفع إلى الأمام إلا بجدلية الهدم والبناء. المهم أن نهدم ونبني بتأن وإتقان.
حين التقينا لقاءً عابرًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب أهداني روايته الجديدة “ليس بعيدًا عن رأس الرجل: عزيزة ويونس”، للوهلة الأولى لفت نظري غرامه بالتراث والفلكلور، وهو غرام يستبد بي أيضًا، وقناعة أنه دون فهم الجذور لن نعرف الطريق إلى المستقبل.
لفت نظري أيضًا منذ الصفحات الأولى، وبرغم أنه فرض نفسه واسمه شاعرًا كبيرًا، أنه أيضًا روائي كبير يعي تمامًا ماذا وعن ماذا يكتب. لم يفقد البوصلة ولا حاسة الإتقان والإجادة والجودة. لا يساير موضة هروب الشعراء إلى مراعي الرواية، وإنما لأن لديه ما يقوله ويعرف بدقة كيف يقوله.
هذه السمات العميقة بيننا خلقت صداقة عميقة وإن لم تتح لنا الظروف العملية لقاءات كثيرة في الواقع. وهي نفسها ما دفعتنا لإصدار نحو عشرين كتابًا لا تخلو من لعب وتجريب وهروب بين أشكال الكتابة المختلفة والسياحة بين الفلكلور والسينما والشعر والرواية والأساطير والنصوص الدينية وأوجاع السياسة.
لذلك سمير درويش هو الشاعر الذي أحب وأحترم تجربته مهما تباعدت بيننا المسافة أو اختلفنا في رأي. وهو المثقف الذي أحب أن أكونه، الذي يعرف كيف يطلق صرخته لإيقاظ الآخرين وليس لخداعهم.
إنها صرخة حكيم تنشد التوازن في الكون وتنير العقول دون أن تؤلم وتجرح القلوب.