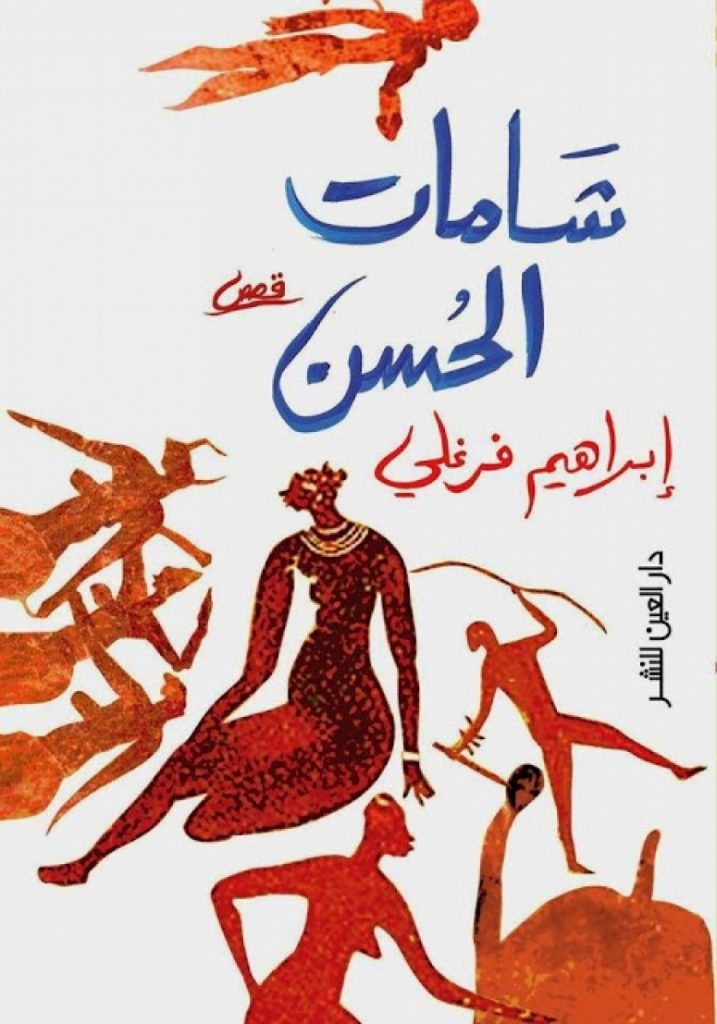“أريد أن أتعرى أمام عينيك المغردتين/ أريد أن تراني أصرخ لذةً
أن تتلوى أطرافي تحت وزن جد ثقيل/ أن تدفعك إلى أعمال كافرة”
جويس منصور
لم يخطر على بالي إطلاقاً أن يهطل المطر بهذه الغزارة. انفتحت السماء على اتساعها. وأمامي كانت جموع البشر يفرون بحثاً عما يسترهم ويحميهم من قذائف السماء المائية. وشيش المياه يدوي إثر ارتطام قذائفه بالأرض والشجر والبنايات والسيارات المارة والمتوقفة المتكدسة.
وجدت بناية قريبة فهرعت أحتمي بها، ووقفت قريباً من مدخلها. ورغم المطر لم يكن الجو بارداً بل دافئا رطباً. احساسي بالبلل أشعرني بالشلل. لا أستطيع أن أفكر في أي شيء. وجدت امرأة تقف على بعد خطوات. ملامحها آسيوية، منمقة، شعرها من بعيد يبدو أشقر، ترتدي معطفا منحها لمسة ارستقراطية مدهشة. تمسك بمظلة ويبدو أنها نجت بها، بحيث وقفت في هذا المكان كأنها تقف في جو صحو. تتلفت حولها، ثم تحدق في اتجاهي. هل كانت تلك ابتسامة؟ خلعت نظارتي ولم أتيقن مما اذا كانت هذه ابتسامة حقيقية ام خداع نظري المعطوب؟ لمحتها تفتح معطفها لأرى جسدها، عارياً تماماً، تحت المعطف. تركتني أتأمل جسدها لثوان ثم اغلقت المعطف واحكمت غلقه. مر “جيبي”* Geepi مكدس بالبشر، ومن السيارة العتيقة لوّح لها شاب وسيم، تجاهلته ثم نظرت إليَّ وابتسمت مرة أخرى.
انخطف قلبي، واستجمعت، بالمطروالصخب، شجاعتي، وتوجهت صوبها ركضاً، مثل عشرات الفارين من هجوم السماء إلى أمان السقيفة الأسمنتية التي تقف تحتها. ابتسمت لها ابتسامة متواطئة عبّرتُ بها عن المشترك الإنساني الذي يجمعنا معاً ككائنين اتفق لهما أن يشهدا معاً جانباً من غضب، أو ربما مِنَح، الطبيعة، فردت الابتسامة بالتواطؤ ذاته. حييتها:
ـــــــــــــــــــــــــ
• “جيبي” سيارة لنقل الركاب مميزة تبدو كحافلة جيب صغيرة من طراز Geep، من مخلفات الحرب الأمريكية اليابانية في الفلبين.
– “هالو”.
ابتسمت لي وهزَّت رأسها.
– هذه المرة الأولى التي اتعرض فيها لمثل هذا الموقف.
ابتسمت لي وقالت:
– أهي المرة الأولى التي تأتي فيها إلى مانيلا؟
– بالضبط. هذا هو.
ضحكت ثم قالت:
– دائماً لا يجد زوار مانيلا الدليل الصحيح الذي يخبرهم بما يجب أن يفعلوه أو يتجنبوه.
تأملت وجهها. عيناها سوداوان كالحتان، ضيقتان،عظمتا الوجنتين بارزتين قليلاً، وشعرها الثقيل الناعم القصير مصبوغ بلون كستنائي داكن، بطريقة عصرية. بصراحة لم يكن متماشيا مع المعطف الكلاسيكي الأرستقراطي.
رأيتها تتأملني للحظة ويبدو أنها فهمت ملاحظتي فقالت:
– كنت عند صديق من أصدقائي وباغتتنا أمه، لم اتمكن من ارتداء ملابسي، فاكتفيت بالمعطف، ونزلت من غرفة خلفية. أتمنى أن يكون نجح في إخفاء ثيابي.
وسعت ابتسامتي مبديا ملامح عدم تصديقي لها. ثم قلت:
– ولو صادفتُ الدليل الصحيح فبماذا كان سينصحني؟
ابتسمت وقالت: ها نحن ذا. ثم ضحكت.
نظرت لها بابتسامة مستفسرة بينما لاحظت أنها أصغر عمراً بكثير مما كنت أظن.
قالت: أولا أن الطريقة المثلى لمواجهة المطر أن تتخلص من ثيابك.العري تحت مطر مانيلا هو الطريقة المثلى لمواجهته والاستمتاع به.
– مثلك؟
– بالضبط.
– وثانيا؟
– ألاّ تستسلم للقاء فلبينية تقف تحت المطر مساء بمفردها.
نظرت إليها مفاجأ ومندهشاً، وللحظة شعرت بالخوف، لكنها أخرجتني من ارتباكي وضحكت قائلة:
– النصيحة الثالثة ألا تصدقها إذا حاولت أن تخيفك.
حلَّ على قلبي إحساس يائس كمن يجد نفسه في زنزانة مغلقة أو غرفة مظلمة. فقلت لها:
– ألا يوجد مكان آخر يمكن ان نستكمل فيه كلامنا؟
– أنت عربي؟
– أليس واضحا؟
– بلى لكن لأتأكد.
– تأكدي.
– توقعت ذلك..المهم. أنظر هناك.
كانت تشير الى مبنى صغير من طابقين على بعد عدة أمتار.
– يوجد مقهى هناك يقدم القهوة التركية والشيشة. هل تود ان تصحبني؟
– أريد أي شيء باستثناء الوقوف هنا في هذا السيل الجارف.
– اوكي. سوف نتجه الى هذا المحل القريب أولا، سنشتري منه مظلّة أخرى لك، وبعدها نركض الى المقهى. هيا اتبعني.
وبدأت تركض كالمجانين فجأة وتضحك.
يلعن أبو جنانك. ولم يكن لديَّ ما أفعله سوى أن أعدو خلفها مثل كلب يتبع عظمته الطائرة في الهواء.
في المقهى جلسنا إلى منضدة صغيرة تطل على الشارع. قلت لها ضاحكاً:
– إما أنك جريئة جداً، أو أن مجتمعك متسامح؟
نظرت لي بابتسامة لم تستطع أن تكبح بها فضولها لفهم السؤال. فقلت لها: “ليس لديّ شك أن عشرات غيري شاهدوك اليوم عارية تماما”.
ضحكت وعادت للخلف لتفسح المجال لقهقهاتها الصغيرة الناعمة، ضاقت لها عينيها السوادوين، ثم اقتربت مني وسددت لي نظرة شهوانية وقالت بصوت خافت :”أنا أحب الاستعراض. هذا يثيرني جنسياً. كان الأحرى بي أن أعمل عارضة استربتيز”.
“حقا؟”.
“لا يمكنك أن تتخيل”.
ابتسمت وأنا أتأملها دون أن أنطق بشيء، بينما رسمتْ هي تعبيراً فضولياً يكشف عن ترقبها لما سأقول.
“إذا نمنا معاً في غرفة مغلقة فلن يكون لهذا أي معنى بالنسبة لكِ إذن؟”.
غيرت ملامحها تماماً حتى بدت جادة ووقورة ثم قالت:”إيييه.. إنتبه لكلامك. أنت تتحدث عن النوم مع امرأة تعرّفت عليها قبل خمس دقائق فقط. هذا خطيييير”.
وقبل أن أرد عليها بشئ قرقرت بضحة مباغتة ثم أردفت:
“أنا لا أمارس الحب الا في الشوارع أو الشرفات”.
انفجرتُ ضاحكاً من الطريقة الجادة التي تقمصتها وأنا أردد لنفسي: بنت الحرام دي مش ممكن. لطيفة جدا!
كنا نجلس في مقهى له طابع عربي يحتل طابقاً علوياً واسعاً من مبنى صغير في حي “ماكاتي” في قلب مانيلا. تنتشر الملامح العربية ودخان الشيشة حولنا. حضرتْ نادلة قصيرة القامة، بيضاء البشرة على عكس الشائع حيث يسود اللون الحنطي هنا كلون مميز لبشرة الفتيات والرجال. شعرها الأسود الثقيل الناعم القصير يكمل شخصيتها الخاصة التي تبدو مزيجا بين الفلبينية التقليدية وست البيت العربية؛ خصوصاً وهي ترتدي عباية طويلة مقلمة بخطوط عريضة ملونة بالبرتقالي والبني والأحمر والذهبي، وسألتنا عما نرغب بابتسامة.
بعد أن انصرفتْ النادلة قلت للفتاة مباشرة ما اسمك؟ فقالت: ريزال.
قلت: ريزال؟ أليس هذا اسم بطلكم القومي وكاتبكم الكبير خوزيه ريزال؟
ابتسمت بإعجاب وقالت: أنت تعرف شيئا مختلفا عن الفلبين! هل تعيش هنا من فترة طويلة؟
“نعم لكني لم يسبق لي ان نمت مع أحد هنا لا في الشارع او الشرفة”.
ضحكت ثم قالت :”يمكنني أن أتنازل وأنام معك لو شئت، على سطح أي بناية في مانيلا. لو كان السطح عالياً جداً سأكتفي بمراقبة النجوم لنا ونحن نمارس الحب”.
قلت:”هذه صورة شعرية”، فابتسمتْ بخجل، ولم تقل شيئاً.
فقلت:”بما إنك لا تعملين راقصة استربتيز فماذا تفعلين؟”.
قالت: أووف. مارست مهناً عديدة. الماساج. نادلة. وعاملة في محلات لبيع الملابس…آه وكاشيرة في سوبرماركت صغير، لكني لا أريد هذا كله”.
“ماذا تريدين إذن؟”.
“الرقص في مسرح مع فرقة فنون شعبية. أو أن أعمل في مكتبة”.
“مكتبة؟ رائع، تحبين الثقافة؟”.
هزت رأسها بارتباك وقالت: “لا تفرط في توقعاتك عني. لا أنتمي للنخبة المثقفة هنا.انا فتاة عادية.أريد أن أعيش حرة وسعيدة”.
****
اتفقنا أن تمر عليَّ ليلاً في غرفتي، وودعتها في طريقي إلى الفندق.
****
نظرت إلى الساعة فوجدتها تجاوزت الثانية صباحاً. كنت نائماً بملابسي، على ظهري، وشاشة التليفزيون أمامي مفتوحة. فتاة عارية تمسك نهديها وتتطلع إليَّ، عبر شاشة التلفاز، بشبق تمثيلي. تمسك نهديها الكبيرين وترفع أحدهما إلى الأعلى قليلاً لتداعب حلمتها بلسانها. نهضتُ بتثاقل، والتفت الى سجائري بجواري، التقطت سيجارة ثم أشعلتها ونفثت الدخان.
تطلعت الى السقف. فكرت بأن الفتاة لن تأتي، ربما يكون موعدها مع رجل أرادها أن تقضي الليلة معه. شعرت بالجوع. فنهضت باتجاه الثلاجة الصغيرة المجاورة لباب الغرفة. فتحتها فانفلت ضوء ساطع من داخلها ليستلقي بوهجه على الموكيت البني الأنيق. تناولت قطعة شيكولاتة وزجاجة مياه باردة وعدت للفراش. تناولت الشيكولاتة وتجرعت المياه بنهم وعطش.
دق جرس الهاتف فالتفت إليه وابتسمت. رفعت السماعة فجاءني صوت موظفة الاستقبال:”هل تنتظر ضيفة الآن يا سيدي”؟ لم ارتح لصيغة السؤال لكن ظلال الابتسامة التي لاحت لي في صوت الفتاة جعلتني أقول لها بأريحية :”نعم انتظر ضيفة. دعيها تصعد”.
بعد عدة دقائق دق جرس الباب، فنهضت وفتحت الباب مبتسما. وجدت أمامي فتاتين: إحداهما نحيفة، شعرها بني داكن، عيناها ضيقتان، تبدو بملامح وجهها الدقيقة أشبه بالكوريات، بينما الثانية سمراء مدملكة الجسد، عيناها واسعتان عسليتان مدهوشتان على نحو ما، كأنها فتاة من فتيات “جويا” قد هربت من إحدى لوحاته وجاءت إلى هنا.
نظرت إليهما بدهشة واستنكار فوسّعت الفتاة البيضاء من ابتسامتها قائلة:”الن تدعونا للدخول؟”. نظرت إليها أدقق النظر في ملامح وجهها التي كشفت أنها في عمر صغير ربما لا تتجاوز السابعة عشر. وقلت لها بصرامة من دون أن أتخلى عن ابتسامة باردة :”لا لن أدعوكِ للدخول. هل سبق لي ان دعوتك للحضور إلى هنا؟ اعتقد أنك وصلتِ إلى الغرفة الخطأ”.
ابتسمت وهي تقول: “لا لا أنا جئت من أجلك أنت. الست السيد..؟
هالني أنها تعرف اسمي وأدركت فورا أن الفتاة ريزال، هذا إذا كان اسمها اساساً، مجرد قوّادة؛ أرسلت لي هاتين الفتاتين بعد أن عرفت عنوان غرفتي. “غبي” هتفت لنفسي بلا صوت. ثم قلت بحسم :”تأخر الوقت وينبغي لي أن أنام الآن”. وشرعتُ في إغلاق الباب. لكن الفتاة حافظت على رباطة جأشها وهي تصد الباب بذراعها وتقول :”انتظر لحظة. من فضلك يا سيدي كيف لنا أن نعرف أنك تنتظرنا؟ وفي كل الأحوال لن تندم على قضاء الوقت معنا”.
ابتسمت لها بسخرية قائلا : “ومن قال لك أنني أريد أن أقضي الوقت معك أو معها؟”.
قرقعت أرضية الردهة الخارجية بصوت خطوات امرأة تنتعل كعباً صلباً، فالتفتت شبيهة فتيات تاهيتي إلى مصدر الصوت بقلق، أما الأخرى فتوقفت للحظات لكنها لم تبد أي لون من ألوان القلق أو الارتباك، بل اقتربت مني قليلاً وقالت بصوت هامس: “ارجوك دعنا ندخل ولن تندم، سنفعل لك كل ما ترغب فيه”.
شعرتُ بضيقٍ شديد من إلحاحها، لكن نظرة الفتاة الأخرى الراجية جعلتني افتح الباب وأقول لهما :”ادخلا قبل أن أغير رأيي”.
بعد فترة من الحديث الممل وطلبي المستمر منهما الانصراف لرغبتي في النوم، وإلحاحهما في البقاء حتى الصباح لخطورة تواجدهما في الشارع في هذا الوقت لأن عمر كل منهما أقل من السن القانوني، امتثلت وقلت لهما أن تناما حتى الصباح بعد أن طلبت من كليهما أخذ حمام دافئ، ففعلاز وبعد قليل خرجت كل منهما عارية إلا من منشفتين كبيريتين.
تسللتُ من الفراش بعد أن سمعتهما يغطان في النوم. لم تستغرق اي منهما أكثر من عشر دقائق حتى كانتا تغطان في النوم. كأنهما لم تناما ليومين سابقين.
اتجهت للأريكة الموجودة أسفل النافذة الكبيرة وتمددت عليها. كنت ناقماً على غبائي الذي جعلني اسمح لهما بالدخول، وعلى قبولي صعودهما إلى الغرفة دون أن أتأكد من هويتهما.
لعنتُ الفتاة الشقراء ريزال، فهي السبب في كل هذا. فتاتان مراهقتان تغطّان نوماً في فراشي. لكل منهما تاريخ، حتى لو كان صغيراً، واحلام، ومصادر بهجة وتعاسة، لا أعرف شيئاً عنها، ولا أريد. ولا أستطيع النوم خشية أن تكونا لصتين صغيرتين، بالرغم من انني كنت أضع نقودي وجواز سفري في خازنة الغرفة، لكنني كنت أشعر بالقلق منهما. فحتى عندما عرضت عليهما النقود بلا مقابل. أصرتا على البقاء.
لا أعرف كم مرَّ من الوقت، تقلبتُ خلاله عشرات المرات، قبل أن اسمع حفيفاً خافتاً لخطوات أقدام، وسرعان ما تبينت أنه يخص الفتاة الغريبة شبيهة فتيات تاهيتي. كانت تقترب من الأريكة بحذر. وعندما توقفت أمامي تماماً وجدتها عارية. انحنت مقتربة مني حتى أصبح وجهها قريباً من وجهي وقالت هامسة:
– لماذا تنام هنا؟ هل وجودنا يضايقك إلى هذا الحد؟
– لا لا . أنا فقط معتاد على النوم بمفردي. لا أستطيع النوم بجوار أحد.
– أشعر أنك مرتاب وقلق. أرجوك ألا تخشى شيئاً. نحن مجرد فتاتين فقيرتين، وريزال أرادت أن تساعدنا بعد إلحاح ابنة خالتي عليها. في تمام السابعة سنخرج من هنا لأن عليَّ الذهاب الى الجامعة.
نهضتُ وجلست مرتدياً شورت وتي شيرت أرتديهما للنوم عادة، فجلستْ بجواري. شعرت بجسدها دافئاً وغضاً. وضعت ذراعي حول كتفها. الإضاءة الخافتة المتوترة القادمة من جهاز التليفزيون المقابل للفراش كانت تضيء لي جسدها الحنطي الجميل. ثدياها صغيران. عندما انحنت لتقترب مني اتخذ كل منهما تكويناً مخروطياً صغيرا. قربت وجهي منهما، ووضعت لساني على أقربهما، ومصصت الحلمة، طعمها حمضي قليلاً، ضمت رأسي إليها بشبق. رفعت رأسي لأتأمل وجهها فوجدتها تفتح عينيها المدهوشتين بشبق.
ثمة شيء مدهش فجّر الشهوة في جسدي، رائحة جسدها البدائي بلا عطر، وشعرها المتموج الكثيف، أو ربما صور فتيات جوجان العاريات اللائي استدعتهن ذاكرتي من حيث لا أعلم، وبينهن صورة مستوحاة من فتيات تاهيتي صوّرها فنان فوتوغرافي لا أعرفه؛ أجلسها على سور حجري تحيطه غابة من الأشجار، تجلس عارية، إلا من إزار أحمر بوردات بيضاء كبيرة، ووردة طبيعية بيضاء تنغرس في جانب من شعرها الطويل، تكشف عن نهدين كبيرين، واقفين بلا سند، وتمسك في يدها مصباح يشع بالضوء.
بدت لي هذه الفتاة تجسيد نموذجي لهن جميعا، أقبلتْ عليَّ فأقبلتُ. قبّلتُها واحضتنتها. اعتليتها فاستكانت، فأتيتها من مأتاها، ثم امتطيتها فاستدارت، ألهبتُ ردفيها بضرباتٍ تسبق هصراً وزعتُه وفقا لإيقاع صرخات مبحوحة كأنها تحاول أن تهمس بها حتى لا يفضحها صوتها.
أنصت جسدي لهاتف غامض أراد أن يحجِّر اللحظة فاستجاب له الجسد، شعرت كأني خدرت عضوي، وبدت لحظة الذروة بعيدة رغم احتراقي بلهيب جسد الفتاة. امتطتني فتحَوَلَتْ إلى كتلة من ظلام شهواني دافيء، كتلة من توق جسدي تشتعل حرارته من تناقض الملامح المندهشة العالقة في ذهني، وبين صبا الجسد وحيويته وإيقاعه الفتي. حلَّت كتلة الظلام الشبقة في بدني، فيما تؤجج شهوتي اكتشافات تفاصيل الكتلة في تمرغ الجسدين، الوركين الناعمين المتماسكين، الكفل البض، الظهر مشقوقاً بعموده الفقري، ثم صارت موجة، تنقلب لتعلو ثم تهبط، فيما ريح النشوة والشهوة تتأجج وتخبو وفقا لإيقاع لا أعرف كيف تملك خبرته فتاة في مثل عمرها.
كنت في أوج شهوتي، وغيابي في جسد الفتاة السمراء، أتساءل عمن تكون؟ سؤالٌ يولده العناق الشهواني، والخيالات، واللذّة. وكانت الإجابات غامضة. كيانٌ شبحي يفيض بما تفسره الإيروسية بأنه الغرام، أو بأنها روح مسافرة من زمن بعيد إلى جسد يعيش في الحاضر. كان أداؤها يبدو كعاشقة تخلص في حب عشيقها، لا مجرد عاهرة صغيرة تمتع رجلا لا تعرفه من أجل النقود. وأياً كانت قلت لنفسي إنني بوجودها الحسي الدافئ الحميم هذا أشعر بأني في حلم يروق لي أن أعيشه مطولاً، لكنه تحول، بغتة، بل ربما في لحظة واحدة، تشبه لحظة الإفاقة من حلم جميل، إلى كابوس، حين لمحت الكورية البيضاء النحيفة الغلامية تقف عارية أمامنا وعيناها تومض ببريق غامض وتبتسم ابتسامة بلا معنى.
لم تنطق بشيء، فقط دفعت بجسدها النحيف إلى المشهد، ورسمت ببياض جسدها مع لون القهوة الذي يميز جسد الأخرى، تشكيلاً حسياً لم أكن خبرته سوى في الصور والأفلام. وبالرغم من أنه أثار انتباهي بصرياً، لكنه لم يثر أي من حواسي. توقفت فتاة الجُزُر النائية والبحار البعيدة عن عناقي. واحتلت الأخرى المشهد. اكتفت الفتاة الكورية بجنس فموي استجبت له بدافع الشفقة. وتمددت نائماً وطلبت منها أن تعلوني حتى أتمكن من تحسس إليتيها الناعمتين، لكي أُثير نفسي، متغلباً على نفوري منها. كانت تؤدي أداءً مصطنعاً خاليا من أي روح أو إحساس، ولكني استجبت لها لأنني فهمت أنها تحلل ما تريده من نقود. فيما ظلت روحي معلقة بفتاة الجُزر الاستوائية، ورائحة البحر، وحرية الآفاق الممتدة خلف المحيطات، وأعشاب الوديان الخشنة، وبنظرتها المندهشة في براءة غريبة.
عندما انتهينا كنت أتمنى أن تبقى الفتاة الخلاسية الفاتنة نائمة في حضني فاغرة عينيها بهذا المزيج الآسر من الدهشة والبراءة والسكينة. أن أثرثر إليها بكل أسراري دفعة واحدة، متأكداً أنها ليست سوى جنيّة من جنيّات البحر، سوف تغمر أسراري في مياه المحيط.
لكن ما حدث هو أن الخلاسية بقيت مستكينة في مكانها بعينين ناعستين على شفا النوم، فيما الحليبية تثير الإزعاج بالثرثرة، وبرغبتها في إيجاد أرز للفطور:
أرز للفطور؟
نعم أرز للفطور. هذا فطوري اليومي.
ثم تعود لتزعجني بتأكيد احتياجها للنقود والمساعدة، فيما تردف كل كلمة بندائها لي “دادي. دادي”.
صرخت فيها:”ششششششششششششش! أصمتي. أنتِ تثيري أعصابي بصوتك. أريد أن أنام”.
نظرتْ لي باستكانة تمثيلية، ثم أخذت تحكي لي عن أبيها الذي لم تره لأنه هرب من أمها بمجرد أن حملت بها!
– هل كان كوريّاً؟
– نعم. كيف عرفت؟
– هل يحتاج ذلك الى نباهة؟ انت تبدين ككورية، أو يابانية، لا شيء يدل على أنك من الفلبين، ربما سوى لغتك وأنت تقرقرين بها مع صديقتك ولا أفهم منها شيئاً، وهل بحثت عنه؟
– أمي كانت ترفض ذلك.
– وأنتِ هل كنتِ توافقينها؟
– أمي كانت تقول أن ذلك لن يجر عليَّ سوى التعب والألم، وأن الأفضل لي ألا أعرفه.
– وهل تؤمنين بذلك؟
– أريد أن أعرفه. رغبتي في التعرف عليه أكبر. رغم أنني أحياناً أقول أن سبعة عشر عاما لم يبحث فيها عني تكفي لأمحي فكرة وجوده من ذاكرتي.
– وما المشكلة إذن؟
– أين أجده وكيف؟
– معقولة؟ الفيس بوك. تويتر. هل سمعت هذه الأسماء قبل ذلك؟!
– هذه فكرة فعلاً. ليس لديَّ حساب على الفيس بوك. سأفعل. فكرة رائعة أشكرك عليها يا دادي.
ابتسمت لها ابتسامة باردة ثم قلت:
– شكراً لك، والآن أريد أن أنام، فقد ظهر ضوء الفجر.
– أعطني أموالاً لأشتري أرزاً لإفطاري أنا وابنة خالتي.
– تحدثي عن نفسك.
– جئنا معا ونستحق رعايتك نحن الاثنتين.
– وماذا تريدين؟
– نقوداً مقابل ما فعلته لك.
– أوكي.
– وهي أيضاً.
– ما شأنك بها؟
– ابنة خالتي، وهي لا تهتم بحقوقها. لكن أنا أهتم. أنظر إليها. إنها مخلوقة شديدة الطيبة ولا تستحق منك هذه القسوة. تحتاج لنقود لتصرف على نفسها في الجامعة. أنت لا يمكن أن تصدق مدى فقرنا.
– خذي حقك وانصرفي.
– والحلمات؟
– اي حلمات؟
– حلماتها! الم تمصّ حلماتها؟
نظرتُ إليها وضحكتُ طويلاً، ولوهلة مر على ذهني خاطر أن أمسك بها من شعرها وأخرج بها عارية كما هي، وأذهب بها إلى إدارة الفندق مدعيا أنها لصة. ولكني تراجعت وقلت لها بهدوء:
– أخرجي الآن. هاك نقودك. إنصرفي وإلا..
*****
بعد خروجهما شعرتُ براحة عميقة. لم أرغب في شيء قدر رغبتي في النوم. ألقيت بنفسي في الفراش، وتذكرت الفتاة السمراء وابتسمت. هذه فتاة ليست من الواقع رغم أنها واقعية جداً، لكن ملامح وجهها تمنح الإحساس بأنها تسللت من لوحة فنية إلى الواقع، تحمل نظرة الدهشة التي رسمها بها الفنان، وتستقبل كل ما يحدث حولها كأنه لا يمتُّ لها بصلة. تمنيت فعلاً لو أنها كانت جاءت بمفردها. كنت سأئتنس بوجودها. حتى ممارسة الجنس معها، بدت لي استثنائية.
دوما يبدو الجنس مع امرأة لأول مرة غريباً. هناك فتيات مارست معهن الجنس واستمتعت، لكني لم أعد أذكر شيئا عنهن لا أذكر ملامح الوجه، ولا لحظة الذروة. لكن هذه الفتاة تمنح بعد دقائق قليلة الإحساس بحميمية جسدها، جسد يفرض نفسه، ويعطل الذاكرة بحيث لا تقارنه بغيره. يفرض وجوده اللحظي بعيداً عن أية خبرات أخرى. لكنها تظل في الوقت نفسه تفرض هذا الإحساس المُحيّر. أن هناك ما يشغلها، ليس شيئاً من أمور الحياة اليومية والمادية المفرطة كما صديقتها الصغيرة المتذاكية. لا لا. تبدو كأنها مشغولة بمسألة وجودية عميقة تؤرق كيانها كله، وأن ممارسة الجنس بالنسبة لها أيضا محاولة للتفكير أو حل هذه المسألة.
*****
استيقظتُ على صوت طرقات خافتة على الباب، لكني لم أتحرك. اعتقدت أنها طرقات على الباب المقابل لباب غرفتي. نظرت في الساعة وكانت تعلن لي نومي لثلاث ساعات متصلة منذ غفوت. لا بأس. قلت. وعادت الطرقات فنهضت متشككاً في أن تكون إحدى عاملات نظافة الغرف.
نظرت من العين السحرية فبوغت. ترددت للحظة، ثم فتحت الباب، وامسكت بذراع الواقفة خلف الباب بقوة وأدخلتها الغرفة. كانت هي ريزال نفسها في هذه المرة. صرختْ مباغَتة. وهي تندفع باتجاهي ثم ترتطم بي لأني وقفت لكي أغلق الباب بعنف. ثم دفعتها الى الباب بكل ما أمتلك من قوة حتى ارتطمتْ به.
صرختْ وبدت مرتاعة، ثم قالت:”ماذا حدث؟ ماذا بك”.
فجذبتها من يدها التي رفعتها لتحمي بها وجهها عندما اقتربت منها، وبكل غيظي دفعتها الى الفراش. كانت ترتدي بنطالاً جينز وقميصاً أحمر مفتوحة أزراره العلوية. وحذاء أسود خفيفاً.
ارتطمت بالسرير نائمة هذه المرة، وبدت شديدة الجزع وهي تصرخ: توقف وإلا سأطلب إدارة الفندق. أنت مجنون.
توجهت إليها وملت عليها وأنا أثبت كلتا ذراعيها ثم قلت:
– أنتِ لم تري شيئا بعد حتى تستغيثي.
– توقف.
– أصمتي. من هما تينك القحبتين اللتين أرسلتيهما لي؟
– لم أرسل لك أية قحاب.
– بلى فعلتِ.
– ليستا قحبتين.. هما فتاتان صغيرتان فقيرتان.
– وهل قيل لك أنني مؤسسة إعانة اجتماعية للمومسات؟
– انتظر. انت تؤلمني.
ضغطت على كتفيها بقوة أكبر وأنا أقول بغيظ:
– رائع لأنني أريدك أن تتألمي.
– أووف دعني وشأني. أنتم العرب هكذا دوما تحبون العنف.
في تلك اللحظة التمعت عينيها، ولمحت تحت الوجه المتغضن بملامح الألم نظرة غريبة، بينما فكرت أن اصفعها، لكني تراجعت وجذبت شعرها من الخلف وقلت:
– إياك أن تنطقي بحرف آخر عني أو العرب.
– آآآآآه دع شعري. وكفاك تمثيلاً.
– ماذا؟
– أنت تريد أن تمارس العنف عليَّ لكي تخفي ضعفاً في شخصيتك.
– ماذا تقولين يا ابنة القحبة؟
– لا تسبني. هذه هي الحقيقة. أنت تعالج ضعفك مع فتاتين فقيرتين لم تستطع أن تطردهما من الغرفة بممارسة العدوان عليَّ.
وقبل أن أردّ عليها بأي شيء وجدتها ترفع رأسها قليلاً، وتقاوم امساكي بذراعيها، ثم تخطف وجهها نحوي بحركة سريعة وتلعق إحدى وجنتيّ بلسانها. وضعت ركبتي حول خصرها، فحاولت أن تلف ساقيها على ظهري، لكنها لم تنجح، لكن حركتها العنيفة جعلتني أسقط عليها فقبلتني في عنقي، وفاض أنفي بعبق دبق من شعرها، كان مزيجاً من عطر ورائحة مطر عطنة. والعبق شبق.
بدت لي قبلتها، رغم شهوانيتها، كطعنة رهيفة كحد سكين أرهفه الصقل، يمر على بطن المعصم، فينبثق الدم ولا يشعر المجروح بألم.
شعرت أنها استثارت من العنف فقررت أن ألعب الدور للنهاية، تركت ذراعيها ثم أمسكت عنقها بكفي وشرعت في خنقها. بوغتَتْ، لكنها بين الذُعر واللَّذة أماتت ضحكة ارتسمت، لثوان، على وجهها الذي احمر بقوة، وبحركة واحدة خفيفة كانت قد تسللت بذراعيها أسفل الـ”تي شيرت” الذي أرتديه، ومررت أظافرها على ظهري بوحشية فصرختُ من الألم، لكني حررت رقبتها ووضعت يدي أسفل التي شيرت الذي ترتديه أهتصر ما تقع عليه كفاي. بطنها وصدرها، والسوتيان الصغير الذي رفعته بأصابعي وقبضت على إحدى نهديها من أسفله، فوجدتها تطبق بفخذيها معا على إحدى فخذي، وتموء كقطة في أوج مناداتها بالشبق. استثارني ملمس بشرتها. وهكذا بدأنا نخرج عنفنا المبتور كل تجاه الآخر، بيقين متبادل بأنه كلما زاد العنف زادت شهوتنا، وقد كان.
حين استرخيتُ على بطنها، بينما أمواج الشهوة لا تزال تتدافع بين رأسي وظهري، وألم خفيف لا يزال ينبض خافتاً في إيري، وقلبي يدق بعنف وأنفاسي المتتابعة تجعلني الهث ككلب. ابتسمتْ لي بدلال وقالت: ها أنت ترى. لقد انجزت لي إنجازاً استثنائياً. هذه المرة الأولى التي تأتي فيها شهوتي بلا استعراض.
– بلا استعراض؟
– دون أن يراني أحد وأنا أمارس الجنس؟
اضطجعتُ إلى جوارها؛ ملقياً بجسدي كأنني أنازع من شدة اللهاث، رافعاً ذراعي في الهواء، وابتسمت لها وأنا أبتلع ريقي، ثم أمسح جبهتي المتعرقة:
– هذا الموضوع حقيقي؟
– جدا؟
– كيف؟
نهضت وهي تفتش بجوارها على علبة المناديل الورقية التي سحبتْ منها منديلاً وضعته بين فخذيها، ثم ركضت صوب الحمام. تأملت جسدها الصغير المكتنز في تناسق، وأردافها، وساقيها الجميلتين وهي تتحرك على أطراف أصابعها المطلية أظافرها بلون نبيتي داكن ولامع، تتجاوز ثيابنا المتناثرة على الأرض. أضاءت مصباح الحمام وفتحت المياه. ومع وشيش المياه قالت:
– اذا أحببت سأصطحبك اليوم في سهرة خاصة جدا.
– ليس لديّ مانع.
صمتت لوهلة ثم قالت:
– لكنك عنيف فعلاً. ها أنت أثبتَّ لي أنك لست مخصياً فلماذا لم تفعل ذلك مع الفتاتين الصغيرتين؟
تأملت سؤالها الذي جائني مختلطاً بصوت مياه الدش في البانيو، وأنا أسبَّها في سري: يا بنت الشرموطة.
********
قبل أن نقرر الخروج من الغرفة كنا قد أنهينا نقاشاً غريباً حول العنف والجنس، بدت فيه مدهشة بمعرفتها بالجنس.
قالت: كنت أداعبك فقط. لكن في تفسيرات بعض السيكلوجيين أن ارتباط العنف باللذة تعويض أو دفاع عن شعور باطني بالإخصاء. الشخص يقاوم إحساسه أنه مخصي بممارسة العنف.
فكرت قليلاً في كلامها وتتبعت تاريخ علاقاتي الجنسية كله، وبدا لي أن كل ما مارسته من جنس كان دوماً ناعماً ورقيقاً، مع ذلك فهذا لا يثبت شيئاً، بالعكس، فإحساسي بذاتي أنني رقيق أكثر مما ينبغي في ممارسة الجنس.
قلت لها هذا فابتسمتْ، ثم قالت: أريد أن أقول لك أنت تذكرني بتشارلز برونسون.
– تشارلز برونسون؟!
– أما كانوا يلقبونه بأجمل قبيح؟
– لا أعرف.
– بلى.
– وإذن؟
– أنت أرق القساة.
ابتسمت لها وقلت لها:
– أظنك تحبين العنف، ولهذا تستفزيني باستمرار.
ضحكت ضحكة طفولية شقية ثم قالت بنبرة طفلة صغيرة:
– أنت تظلمني يا دادي.
ضحكت لأنها التقطت ما حكيته لها عن الفتاة الكورية، ودفعتها في كتفها فابتعدت عني بكتفها فقط لتتجنب الضربة، ثم عادت مباشرة ولعقت وجنتي.
فضحكت بصخب وقلت لها:
– أنتِ قحبة كبيرة.
كانت تجلس بالسوتيان والكيلوت، وبمجرد أن قلت لها الكلمة نهضت ثم خلعت الكيلوت ووقفت أمامي وألصقت بطنها بوجهي وقالت لي بصوت شهواني مثير:
– ها أنت ذا يا حبيبي تعرف الآن كيف تهيجني بهذه الكلمة والآن لن أدعك تفلت مني. وقبل أن أنطق بحرف كانت بدأت تداعب بلسانها وجهي وأذني وصدري، وكنت أهتف :يا بنت الحراااام.
*******
تمشينا في حي “ماكاتي” الذي كان مزدحماً، تحيطنا الرطوبة من كل اتجاه، والمارة من كل الفئات. انحرفنا الى اليسار فوجدنا شارعاً جانبياً أقل زحاماً، تتراص المقاهي الأمريكية الطابع على جانبيه، بينما يلاحقني بين آن وآخر أطفال يمدون أيديهم بالشحاذة، وشباب يمد يده بأدوية مقوية جنسياً، وفتيات يمسكن بكروت تحمل أرقام هواتف فتيات يقمن بالمساج بتكلفة تقل كثيراً عن اسعار الفنادق. وكانت هي تتكفل بالقرقرة معهم لإبعادهم عني.
من بعيد لاح لي ما يشبه مرقص ليلي تعلو مدخله لافتة مضاءة بأضواء النيون كتب عليها Pussy Cat، وقبل أن أسألها شاهدت فتاة ربلة، بملامح آسيوية متناسقة وشعر أسود فاحم، ترتدي فستاناً أخضر اللون لامعاً، طويلاً بلا أكمام، مشقوقاً من عند الفخذين وحتى القدمين. كانت الفتاة تندفع باتجاهي كأنها تعرفني من سنوات وهي تنادي علي بعربية مشوهة: هاي هابيبي.
ووجدتها تقف أمامي وتعترض طريقي كأنها تهم باحتضاني. نظرت الى ريزال فوجدتها تبتسم، لكنها لم تعلق بشيء.
ابتسمتُ للفتاة وقبلتها. لفحتني أنفاسها وشعرت بالإثارة فقلت لها:
– ماذا تريدين؟
– أن نقضي الليلة معاً.عليك أولا أن تتناول معي مشروباً هنا في الداخل ثم ننطلق معاً.
ابتسمت لها فقالت بسرعة:
– لا تخف! وحتى لو رغبت أن أشاركك أنت وصديقتك الليلة لا بأس كما تريد.
ابتسمت لريزال وقلت لها:
– الحياة هنا يمكن أن تصبح مثيرة فعلاً.
ابتسمت وهزَّت كتفيها كأنها تقول أن الأمر كله يرجع لما أرغب فيه. قاتلت رغبتي في الفتاة الجميلة والواقفة أمامي وقلت لها:
– دعينا نرتب هذا الأمر، سأمر عليكِ غدا.
وقبل أن ترد الفتاة وجدت ريزال تجذبني من يدي وتخطو بخطوات سريعة وأنا أنظر خلفي للفتاة التي كانت تقف في منتصف الطريق، ترمقني وهي ترسم نظرة حسرة تمثيلية هوليودية كادت تدفعني للعودة إليها لولا إطباق يد ريزال بحسم كامل على يدي كأنها كانت تعرف ما أفكر فيه.
قلت لها:
– لماذا تبدو مدينتكم بلا خصوصية، تشبه الكثير من المدن العربية، بنايات حديثة، وسيارات وزحام، لا شخصية مختلفة؟
– للأسف احتلتنا أمريكا لفترة فأسبغت على المدينة طابعها، حداثة بلا خصوصية. إذا أردت الخصوصية فيمكنك أن تزور الجزء القديم من المدينة، وهو أيضا لا يخصنا نحن بل يحتفي بشواهد وآثار الإسبان الذين احتلونا 300 عاما.
****
كنت أتأمل المدينة والناس، حينما احتضنت ذراعي لتنتحي بي صوب بناية كانت تقع إلى اليسار. دخلنا المصعد وخرجنا منه أمام ردهة بها ثلاث شقق. وقفت أمام واحدة منها وقرعت الجرس.
فتحت لنا الباب فتاة شابة، ملامحها عادية، ترتدي زياً ضيقا أصفر اللون، عارياً مكوناً من جزئين؛ يلف الأول صدرها وجزء من ظهرها، والباقي يشبه إزاراً بالكاد يغطي عورتها، بينما تنكشف لنا بشرتها القمحية عبرعري كتفيها وبطنها وفخذيها، حافية القدمين. قدمان نحيلتان معتنى بأظافرها المطلية بلون نبيتي قاتم. وشعرها أسود ناعم ينسدل على كتفها. ترسم ابتسامة رقيقة وتقبّل ريزال بمحبة وتصافحني، ثم تدعونا للدخول.
دخلنا الشقة. كانت هادئة تماماً. أنيقة بما يفترش أرضياتها من السجاد الفاخر، وبالأنتيكات الموزعة في كل مكان، تقودنا الردهة إلى غرفة صالون حديثة ألوانها مزيج من النبيتي والأرجواني. أريكتان ضخمتان متجاورتان بحيث تصنعان معا حرف L، وبمجرد أن جلسنا عليها اكتشفت مدى ضخامتها. جلست مستريحاً ومترقباً. بينما كانت ريزال تجلس بجواري وتبتسم لي. بعد لحظات دخلت فتاة تحمل صينية يعلوها كأسان بكل منهما مشروب بلون الماء وبجوارهما طبقا صغيراً يضم قطعا من الثلج. تجرعت كأس الـ”جين” ، باستمتاع ممتلئاً بالترقب. فيما قالت لي ريزال: هل أنت مستعد؟
– لأي شئ بالظبط؟
– لكل شيء.
ابتسمت لها ابتسامة متسائلة ومستريبة. قلت لها:
– كل شيء؟ ما هذه الأسئلة الغريبة؟
– إذن دعني أوضح لك الأمر. هذه الشقة هي مكان يعرف باسم النزوات. هنا بإمكانك أن تجد اي شيء ترغب فيه أياً كنت وأياً كانت نزواتك. اذا كنت مثلياً ستجد ما تريد، وإذا كنت تحب أن تشاهد الفتيات العاريات يرقصن ستجدهن، وأذا رغبت أن تضاجع اي منهن سراً او علناً فهذا أيضاً متاح.
– معقولة ما تقولين؟ أنا في شقة أصدقائك أم في بيت الأرواح الشهوانية؟
– كما تشاء. سمه ما شئت. الكل هنا يثقون في بعضهم ثقة عمياء، وما يدور هنا، ينتهي تماماً بمجرد الخروج من الشقة. فقط إذا كان حضورك للمكان لأول مرة، فسوف يقتضي الأمر استضافتك هنا أولاً لتتناول كأسين أو ثلاثة حتى تتأهل نفسياً وتألف المكان قليلاً.
في هذه اللحظة جاءت الفتاة التي فتحت لنا الباب، مرة أخرى، وهي تحمل كأسين أخريين يمتلآن بالنبيذ في هذه المرة، ووَضَعَتْهما أمامنا وابتسمت لنا وسرعان ما انصرفت.
نظرت لي ريزال وقالت:
– ما يهمني فقط هنا أن تتحرر فعلاً..من كل شئ وأولا من ذكوريتك الشرقية.
– عدنا للفذلكة. أي شرقية تقصدين؟
– أعرفكم أنتم الرجال وخصوصا الشرقيون تريدون في علاقاتكم كلها وبينه علاقاتكم الجنسية أن تشعرون بأنكم تمتلكون المرأة التي تواقعونها. أنت نمت معي، وتعرف انني بالتأكيد أمارس الحب مع آخرين لكنك لم تر هذا، فكن مستعداً له.
– لستِ زوجتي على أي حال.
– إذن كن مستعداً أيضاً أن ترى عشاق هنا يتبادلون الشريك، أو حتى يمارسون جنساً جماعياً.
نظرت لها ثم امسكت بكأس النبيذ وتجرعت منه جرعة كبيرة لم تبق معه سوى الثمالة. تقلصت ملامحي من أثر مرور النبيذ بجرعة كبيرة في جوفي.
نظرت ريزال إليَّ وابتسمت، ثم قبلتني بعنف على شفتي وقالت:
– استطيع أن اعتبر إجابتك هذه إجابة نموذجية.
التفت إليها وقلت لها:
– ما هو طبيعة الجمهور؟
– من كل الجنسيات. أمريكيون، صينيون، يابانيون، وأحيانا أوربيون وحتى أفارقة.
– عولمة الجنس.
ضحكت ثم قالت:
– هذه فكرة نظرية، لكن الحقيقة أن ما يمارس هنا هو إعلان عن موت الجنس.
– موت الجنس؟
– طبعا.
نظرت لها دون أن استوعب تماماً ما تقول. تناولت الكأس وتجرعت ما فيه ثم قلت:
– ماذا تقصدين بموت الجنس؟
– هذه الفكرة لا تقال بشكل مباشر، لكن مع مرور الوقت ومع استنفاذ الفانتازيات المختلفة، ووجود كل هؤلاء الأشخاص، ستجد أن أغلب من يأتي هنا إما قد انتابه شعور بموت الجنس من فرط الاعتياد أو بسبب الاكتئاب أو الملل. وقلة قليلة من أصحاب الطاقة الجنسية المفرطة يأتون لإيجاد وسائل تتناسب مع هذه الطاقة.
– تقصدين نهاية الثورة الجنسية؟
– نهاية الثورة الجنسية؟ لا أعرف. في بلادنا ربما نكون قريبين للمزاج الغربي، لكن لا أعتقد أننا بلغنا هذه المرحلة، ليس لدينا ثورة جنسية أصلاً. نحن نمارس الجنس بشكل عادي.
– لا أتحدث عنكم، بل عن المجتمع العالمي أو العولمي الذي تقولين أنه يتردد على المكان.
– أظن أن وجودنا نحن ما يمنح المكان خصوصيته. أو بالأحرى نحن من نمنحه سمة الغرائبية للأجانب، لو كان المترددين من الأجانب فقط لن يشعروا بالمتعة. لا ليس هذا ما أقصده. لكن يمكن القول أن موت الجنس هو بداية مرحلة ما بعد الجنس.
– أووف. . أنت امرأة خطيرة، تقدمين نفسك بتواضع كبير، لكنك تتحدثين بأفكار مختلفة. من أنت؟
قرقرت بضحكة صاخبة وابتسمت وهي تنظر لي بمودة وامتنان خجول، ثم قالت:
– لماذا تقول هذا الكلام؟
– لماذا أقول هذا الكلام؟ لم أفكّر فيما تقولين من قبل. الجنس وما بعد الجنس. كأنك تتحدثين عن الحداثة وما بعد الحداثة. الجنس الحُر والحرية الجنسية هي ظواهر التحرر الجنسي الذي صاحب مرحلة الحداثة، أما الجنس المتعدد، وغيره هو ما بعد الحداثة.
صمتت قليلاً ثم قالت: ربما لا أقصد ذلك تماماً، لكن الفكرة عموماً قريبة مما تقول. لكن لا تفهمنا خطأ، فنحن هنا في الفلبين، في النهاية، مجتمع عائلي كاثوليكي.
ابتسمت لها ثم تجرعت ما تبقي في الكأس ثم وضعته على المنضدة بحماس وقلت لها بنبرة حماسية:
– أنا الآن مستعد..
ضحكتْ. تأملتُ ضحكتها بود ثم أضعفت صوتي وقلت بنبرة رجل عجوز متهاو: لكني مستعد للفرجة فقط.
تحولت ضحكتها إلى ضحكة طفولية صاخبة ثم قالت بصوت مختنق: ها قد بدأنا.
نهضت واشرت لها أن تتأبطني وفعلتْ، وقادتني للخروج من المكان عبر ردهة طويلة انتهت بستارة صغيرة زرقاء اللون من القطيفة، نحّتها جانباً وأدخلتني عالمها.
****
عفاريت العولمة كانوا جميعاً، وأنا بينهم، ريزال، وفتاة أخرى ذات شعر داكن قصير وجسد مكتنز بلون القهوة، قالت أن اسمها إيميلدا، تتميز بقدمين جميلتين تكويناً، وانيقتين بأظافرهما المقلمة بعناية والمطلية بلون أخضر قاتم غريب، ترتدي فستاناً أخضر، صيفياً أنيقاً قصيراً؛ لا يكاد يغطي ربلتي فخذيها المدملجتين، والأمريكي الأسمر الرياضي الضاحك الثرثار، الذي حلق شعر رأسه تماماً واحتفظ مع ذلك بملامح وسيمة، والبريطانية الثلاثينية ممتلئة الجسد ذات الشعر الكستنائي الخفيف، وسيدة أخرى في أواخر الأربعينات لكنها لا تزال تحتفظ بجمال جسدها، ببشرة قمحية، تتقن الفرنسية والإنجليزية وتعرف الفلبينية، وبينما تبدو من أمريكا اللاتينية فقد رفضت أن تعرّف موطنها مؤكدة لنا أنها مواطنة عالمية بلا جنسية محددة، ولم يكن أحد مشغولاً بجنسيتها بقدر شغفهم بجمال جسدها الخمري.
تقارعنا الكؤوس حتى دارت الرؤوس، وتخففنا من ارتباك التعارف الأول، وتخففت الفتيات من أغلب ثيابهن تباعا. تعالت الضحكات، فيما كنت أختلس النظر إلى السيدة عالمية الموطن، وهي تكتفي بالابتسامات والضحكات، ثم تنظر إليَّ بدلال وتتجرع كأسها. كانت تضع سلسلة ذهبية رقيقة حول كاحل ساقها اليمنى، خطفت بها اهتمامي طوال الجلسة.
كنا عفاريت العولمة، ضحايا ما بعد الحداثة، وأهلها، المارقين على الحداثة بانسجامها الذي بدا مبتذلاً في عالم تختلط فيه كل القيم. ضحكاتنا مزيج من ضحك العالم الأول على العالم الثالث، وشهواتنا مزيج من رغبات مكبوتة أن يمتطي رجال العالم الثالث نساء العالم الأول، وأن تنسحق سيدات الأول تحت أجساد رجال الشرق الذين تتندر المدونات على فحولتهم.
مع ذلك بدونا منسجمين، نضحك معاً، ونقدم اجسادنا لوليمة العولمة؛ مستثارون، ومرتبكون، مقبلون على الحياة وناقمون على ذواتنا وعلى لاعدل العالم، نبحث عن حل للملل، وعن معنى الشهوة واللذة وحيل الإيروسية، مخدّرين، تدغدغ الخمر مشاعرنا وتصفيها، نخلع أقنعة النهار الكاذبة التي يخلقها الواقع، ونستسلم لبراءة الخمر فنصفو، وتمتزج رقة النفوس بالقوة التي يخلقها بخار الكحول، فيما تصبح ضحكاتنا مع الوقت أكثر براءة.
في لحظة بعينها يشعر الجميع أن الضوء الأحمر قد انطفأ، وأن اللون الأخضر الآن بإمكانه ان يجعل الأمريكي الرياضي يقبل على ريزال ويضع يده في مهبلها بلا مقدمات، ويجعل عالمية الموطن تقترب مني وتمدد رأسها على فخذي غير عابئة بتسلل يدي إلى نهديها الدافئين الناعمينِ، وأن تنهض إيميلدا لتسقط فستانها الأخضر لتصبح عارية تماما، لكي تبدأ وصلة راقصة كأنها خادمة معبد موغل في التاريخ تهب نفسها ضحية للآلهة، لكنها مثل غيرها هنا، لا تستقطب من الاهتمام سوى لحظات، فلا يهتم أحد هنا بغيره طويلاً. فعفاريت العولمة يكشفون أن الاستعراض هنا ليس مجتمع فرجة استهلاكي، بقدر ما هو مجتمع يتجرد من عبايات الأعراف والتقاليد ويتخفف من قيود توارثها ولم يصنعها. مجتمع يسمح ويتسامح مع كل شيء. مجتمع يؤدي طقسا مستلهم من أديان ما قبل التاريخ. يبحث عن ذاته الضائعة في عالم لم يعد يقدس سوى المادة.
وضعتُ يدي على ردف ريزال وهي جالسة على فخذي الأمريكي يضاجعها بلا كلل، فوضعت إحدى كفيها على يدي برقة كأنها تشركني في لذتها. وحين تتوقف ايميلدا عن رقصها لتقبل عانة السيدة عالمية الموطن فإن تلك السيدة لا تتوقف عن قبلتها العميقة معي، بل تكتفي بوضع يدها الحرة على رأس إيميلدا كأنها تبارك ما تفعله.
تظهر الفتاة التي فتحت لنا الباب، أخيرا، وتقترب مني كأنها كانت تنصت لافتتاني الباطني بها. تأتيني عارية، وتقترب مني لتسكرني بشفتيها، وبفتنة بشرتها، كمن يرقب فنانة مسرحية ويكوّن لها صورة ذهنية ثم يجدها فجأة أمامه.
لم أدرك ليلتها أنني أصبحت، بالصدفة وربما عن عمد، لا أعرف يقيناً، جزءً من مجتمع مارق عن كل أعراف الخارج الثقيل، متخفف من الظاهر أملاً في باطن اللذة والمعرفة، في جوهر الحب والتسامح والتنوع.
لا أعرف متى انتهت هذه الوليمة الجنسية العولمية، ولا أذكر متى غفوت في حضن السيدة المترفعة عن القوميات.
لكني استيقظت في باطن الليل، ثقيل الرأس، وتأملت الأجساد الغافية من حولي. كانت ريزال تغفو في حضني راضية وكنت في حضنها أغفو وأنا أشعر بأنني مدين لها بإحساسي هذا الذي خففني من أثقال عديدة.