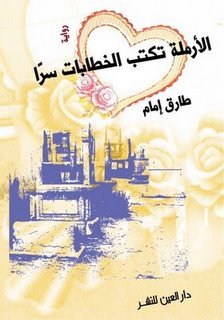إلا أن الحياة الأدبية لم تعدم من تختلف رؤيته عن تلك الصورة السوداوية ، فينظر إلي الأمور بنظرة شبابية ، شكلا ومضمونا ، حتي وإن استخدم الصورة السائدة والعاكسة لشكل المجتمع الراهن . فيكتب ” طارق إمام ” عن القتلة وقتلهم العشوائي ، إلا أنه رأف بقارئه ، فجعل قتلته يقتلون في هدوء ، فكانت روايته البديعة ” هدوء القتلة “[1] والتي سعي من خلالها إلي تحويل صورة القتل المرعبة ، إلي صور محبببة ، فكان الحب هو المسعي والمرتجي .
ثم تأتي روايته التالية ” الأرملة تكتب الخطابات سرا “[2] ليبين أن الحب بمعانيه السامية ، وظلاله الوارفة ، هي نسمة الهواء في قيظ الحياة وقسوتها ، وأنه – الحب – قادر علي فعل الصعاب : { .. تجيئ فتاة . كيف تسللت من بيتها في الفجر ؟ كيف عبرت الشوارع الموحلة ووصلت إلي هذا الباب بحذاء نظيف ؟
إنه الحب
تسأل الأرملة نفسها وتجيب .. }[3]
إذن فلم يكن الحب عارضا في رواية كتبها ، وإنما هو مشروع يؤرق الكاتب ، بإعتباره – الحب – أسمي آيات التواصل الإنساني ، هو النبض ، خاصة بعد أن انتشر الموات وزحف الموت إلي قلب المدينة النابض ، فلم يعد نابضا : { فمع تمدد المدينة صار الموتي يقطنون قلبها النابض .. } [4] . وهو ما يضع طارق إمام في زمرة الكتاب أصحاب الرسالة ، واصحاب القضية ، فتأتي الأرملة استكمالا لما بدأه في ” هدوء القتلة ” ، وكأنها جزء ثان في مشروعه الروائي .
وكما فعل في القتلة ، يبدأ طارق روايته الجديدة بمقتطفين يوحيان بأن الحب هو مشروعه الكبير ، أحدهما تراثي عربي ، والآخر حداثي غير عربي . الأمر الذي تؤكده الرواية ، وهو أنه يجمع بين الأصالة التي تتمثل في الحفاظ علي الحبكة الروائية التي هجرتها الرواية في القرن الحالي ، فضلا عن سلامة اللغة التي أصبحت من نوادر الرواية – أيضا – في هذا القرن .
والمعاصرة المتمثلة في غياب التتابع التصاعدي والاعتماد علي الصورة الشعرية في إضفاء المتعة القرائية والذهنية وصولا لرؤية كلية لاتعدم التفاصيل المتضافرة .
فيأتي المقتطف الأول من ” طوق الحمامة ” لإبن حزم الأندلسي – المولود في القرن الرابع الهجري – الذي يعتبر أول من وضع ما يشبه الموسوعة عن أحوال الحب وصفاته وأنواعه .
وقد التقت به ” الأرملة تكتب الخطابات سرا ” عندما راحت تسأل الأرملة نفسها فيما يشبه وضع مواصفات للحب :
{ العاشقات كثيرات ، وآلام الحب واحدة ، تماما كسعاداته . تضطر ………………….
مصادفات اللقاء السريعة الفجائية ، وترتيبات الوداع الطويلة . تخمن أن لكل دموع الحب نفس المذاق حتي لو اختلف اسم العينين في كل مرة } [5]
وجاء المقتطف الثاني لشاعر من القرن العشرين اشتهر بقصائد الحب هو الشاعر المكسيكي
أوكتافيو باث[6] والذي اقتطف منه ما سار علي نهجه في تصوير الحب أيضا . فجاء المقتطف يقول : { زمن الحب ليس كبيرا ولا صغيرا .. هو الإدراك الفوري لكل الأزمنة في زمن واحد ، بكل الحيوات في هنيهة واحدة .. لا ينقذنا من الموت بل يجعلنا نراه وجها لوجه }
وهي ذات الرؤية التي وضحت لدي الأرملة التي قررت إعادة كتابة خطابات الحب التي كتبتها في شبابها ، برؤية ناضجة ، تأملت أول خطاب كتبته ثم : { كتبنه عشرات المرات كما هو ، بفواصله ونقاطه المرتجلة .. لم يكن من الممكن أن تصدق أن كل هذه السنوات عبرت لكتشف أنها لاتزال في نقطة الصفر }[7] ليؤكد طارق إمام أن اختياراته لم تكن عشوائية ، كما أن عناوينه لم تكن كذلك ، فالأرملة – التي تطالعنا فور إمساكنا للكتاب – علي الفور ، توحي بالفقد ، والوحدة ، وربما عدم التواصل ، وكانت بالفعل أرملة عجوز تعاني الوحدة ، ويحوم الموت حولها من كل اتجاه ، فلا أب أو أم أو صديق تأتنس إليه . وكانت عودتها إلي البلدة التي هجرتها من عشرين عاما للبحث عن الموت ، لتبحث عن مقبرة . كما أن الخطابات – التي تلتصق بالأرملة في العنوان – خاصة إذا أضفنا إليها سرا ، توحي – كما هو مألوف في تراثنا – بالغرام ، والحب والشباب . وقد راحت تأتنس في وحدتها ، وكأنها تستعيد الشباب ، تستعيد الحياة ، فكانت تكتب الخطابات الغرامية لتميذاتها ، وتضعها لهن في كراساتهن ، تكتب الخطاب لكل تلميذة حسب ظروف قصتها مع من تحب ، تكتبها بخطها المنمق ، ثم تجعل التلميذة تكتبها هي بخطها .
وإذا فالأمر مشوق . وهو ما يدعونا للعودة إلي البداية كي نتابع قصة تلك الأرملة ، وكيف استطاع طارق إمام أن يشدنا إليها .
يدور الحدث الرئيس في ” الأرملة ” علي واقعة تكاد تكون رئيسة في روايته السابقة ” هدوء القتلة ” وهو وصول خطاب من طرف خفي في العالم الآخر ، ويكون له تأثير كبير في مجريات حياة الطرف المرسل إليه علي الأرض . فالأرملة تفاجأ بخطاب يحطم زجاج بلكونتها ، ويخترق الحواجز ليلتصق ( بجسمها ) وعلي سريرها . ولم تر غير الخطاب الذي شعرت به كرجل بات ملتصقا بجسدها طوال الليل . من قذفه ؟ كيف وصل إليها ؟ وهل هو خطاب حيقيقي أم أن الخيال هو الذي تسلط عليها ؟
أسئلة يأبي طارق إمام أن يجيب عليها مباشرة . غير أنه يتصاعد في إدخالنا تيه البحث ، فيأتي بالراهبة التي تؤكد للأرملة بأنها رأت حجرا ينقذف علي بلكونتها ويحطم زجاج النافذة ، لتدخل الأرملة ذاتها – ونحن معها – في التيه ، وهو أحد عناصر حيوية الرواية وتأبيها علي منح ذاتها بسهولة ، وتعود الأرملة إلي بيتها لتعيد البحث عن ذلك الحجر ، ولكنها أيضا لا تجده .ووجود الأثر دون وجود أداة الفعل ، نصبح أمام القدر الذي يرسل الرسالة لتنتبه الأرملة إلي شئ غير الذي يخيم عليها ، فيعيد ترتيب الأشياء . فيتحول البحث عن الموت لبحث عن الحياة ، والخروج من عزلة الوحدة إلي تمام الوجود بالوصل والاتصال . حيث تؤكد الرواية تلك الرؤية بجملة واحدة وُضعت مستقلة وكأنها فقرة كاملة عندما بدأ تدافع التلميذات علي الباب و … { بدأت الطرقات علي الباب ..}[8] لتعود بنا الذاكرة إلي قدرية بيتهوفن [9]، وطرقاته القوية ، وتعود بنا الذاكرة إلي قصة ” اللكمة “[10]. ولتخرج بنا الرواية من مجرد مشهد فردي ، إلي العالم الكوني الأوسع ، وننتتقل من الخاص إلي العام .
يمهد طارق إمام لصورة الأرملة بتمهيد يصور ما هي عليه من تسلط فكرة الموت ،إذ بينما تقلب الخطابات ، يتسلل خطاب الموت محلقلا في الأفق – دون أن يكون شيئا ملموسا تمسك به ، يراوغها : { في هذه اللحظة فقط تجد خطابا يخبرها بأن عليها الآن أن تموت ، خطابا يرفرف وتمد يديها نحوه وهو يحلق في سماء الصالة ، لكنها كلما تهم بالقبض عليه يراوغها ..} [11] . { .. تفكر في السنوات الثلاثة التي قضها تحت هذا السقف لا تفكر في شئ سوي الموت ..}[12] .
بل إن الموت بالنسبة لها هو اكتمال الدورة الحياتية ، فهو النهاية الحتمية التي تكتمل بها الحياة ، ولا أمل لها في شئ بعد : { .. وشعرت بأنها مكتملة حتي أنها مهيأة للموت .. } [13] .
إلا أن الطبيعة البشرية – التي يعبر عنها طارق بنجاح – وتمسكها بالحياة ، رغم حتمية وجود ذلك الذي ينتظرنا جميعا في نهاية الطريق ، لتجري الدماء في عروق الأرملة ، وتتحول من إمرأة علي الورق يرسمها كاتب ، إلي إمرأة حقيقية ، لا تلامس الحياة فقط ، بل تعيش بين ظهرانينا ، تقاوم ، الموت ، بصوره المختلفة ، حتي لو كان بتغير السنين وأساليب الحياة ، ووجود ما يهدد هويتها وصورة حياتها :
{ .. قالت : بعضهن يحملن تلك التليفونات الصغيرة ، يتحدثن في أي وقت ، ويكتبن الرسائل أيضا . أصابها حديثها ذاك لنفسها بشئ من الإحباط ، ولكنها عادت : ليس هناك ما يعوض خطابا كتبته يدك تلك . وفردت كف يدها اليمني أمامها في الشبورة الصباحية ، فلم تر سوي بريق الخاتم الذهبي الغليظ ، قربتها قليلا ، ورأتها مزرقة وشاحبة كأنها سبقت جسدها إلي الموت . غالبت الحسرة قائلة : هل تستطيع واحدة من هؤلاء أن تكتب ثلاث أو أربع ورقات علي هذه الشاشة البخيلة ؟ إنها تصلح فقط للاتفاق علي موعد أو لتوضيح موقف عابر .} [14] .
وفي ظل صغر الرواية وتكثيفها غير المخل ، لابد أن يثور التساؤل حول { فلم تر سوي بريق الخاتم الذهبي الغليظ } لنتبين – فيما بعد – أنه إشارة لزوجها الراحل ، لنتبين رؤية الأرملة الداخلية لذلك الزوج ، ولما تمثله مرحلته – رغم ما فيها – وأنها في مقابل ما تعيشه الآن ، هي الفترة الذهبية ، وهو ما سينبني عليه مشهد الختام ..
وفي أثناء الانتظار ، تسوق الصدفة “رجاء ” في طريق الأرملة ، لتعمل لديها كسكرتيرة ، ورغم ما قيل حولها ، تقرر الأرملة أن تصنع لها نسخة من مفاتيح شقتها ، حتي إذا ماتت الأرملة وحيدة ، وجدت من يعلم بذلك ويخبر عنها ، وتستغل ” رجاء ” هذه الثقة ، فتأتي بمن تفاجئها الأرملة معه علي سريرها . ويتماهي ذلك الشخص في شخص الصائغ – زوج الأرملة – . وهنا ينجح طارق إمام لحد بعيد في تصوير أعماق ودواخل ودوافع ملك ( الأرملة ) دون أن يصرح بشئ ، فقط تصوير الموقف ورد الفعل الذي قد يثير التساؤل . فهي لم تغضب ، ولم تنفعل – ظاهريا – ولم تفكر في طردها . بل { لا تعرف كم مر من الوقت ، إلي أن سمعت الطرقات علي الباب . نهضت لتفتح ، وفي هذه اللحظة فقط اكتشفت أن رجاء لم تعد موجودة .. } [15]. إذن فقد استغرقها المشهد ، تنبهت علي شئ غائب ، وليس الغياب هنا هو غياب رجاء ، وإنما غياب الفعل . خاصة إذا ما ربطنا بين المشهد في بداياته وربط الشخص مع الصائغ ، ذلك الذي كان معه الاتصال . وهنا نبدأ تحولا في مسار الأحاسيس . فهي وإن كانت قد تناست الموقف ولم يثر أي عواصف ظاهرية ، فقد بدأ مشهد تبول خفير المقابر الذي ذهب ليريها أن مقبرتها قد أصبحت جاهزة . ويأخذها المشهد بعاديته وبساطته – مشهد التبول علي حيطان المقابر . ويسيران داخل المقابر ، ولا نعرف أي منهما يقود الآخر بين حارات المقابر التي أصبحت موحلة ليتضافر المشهد الخارجي للطبيعة التي ينجح الكاتب في وصفه وتسخيره ، مع المشهد الداخلي الذي يقود الأرملة لعملية الاكتمال ، تلك العملية التي تغذيها عندما { لم تعد قادرة علي تشمم سوي أنفاس الرجل المعبأة بالتبغ والكحول } فاكتملت ، واكتملت بها الرواية عندما : { .. أحاطت اليدان القويتان بخصرها ، وواجهها الوجه الشمعي بلا تعبير ، ووجدت نفسها ترتفع لتستريح مؤخرتها علي حافة المقبرة ، قبل أن تجد ساقيها ترتاحان علي ذراعيه .. } [16] ، ولنتذكر علي الفور قصة ” العملية ” ليوسف إدريس ، تلك التي أراد فيها التعبير عن تجاور الموت والحياة ، وسيرهما معا في نفس اللحظة ، إلا أن طارق إمام هنا – فيما أتصور – بتصويره هذا المشهد واللقاء الجنسي فوق المقبرة عند اكتمالها ، إنما أراد تصوير اكتمال التواؤم النفسي البشري ، الذي عبر عنه في ” هدوء القتلة ” باكتمال ديوان الشعر . وليصبح تاريخ العملية هو الشئ الوحيد الذي كان ينقص المقبرة – تحديد تاريخ الوفاة ، بعد أن وضعت الرخامة المنقوش عليها اسمها – ولتتحول عودتها للبلدة من عودة لبداية رحلة الموت ، إلي بداية لرحلة البحث عن التحقق .
فإذ كانت الحواس هي وسيلة الاتصال بين البشر ، والتفاعل معهم والإحساس بهم ، وإذا كان الائتناس بالآخر هو الدفئ والأمان والراحة النفسية . و إذا كانت الآرملة قد { .. اكتشفت أن حتي حواسها كانت معطلة كل هذا الوقت .. } [17] . فقد تيقظت حواسها بتلك الفعلة اللاإرادية التي انساقت إليها دون مقاومة ، وانهمر المطر الذي يعني في المخيلة الجمعية انهمار الخير ، وتفتح الزهور والزروع . في تصوير جمع بين المطر ودلالاته ، وبين طين الحارات بين القبور ودلالاتها . كمشهد خاجي يصور المشهد الداخلي .
…………….
[1] – – هدوء القتلة – طارق إمام – ميريت – الطبعة الأولي 2007 .
[2] – الأرملة تكتب الخطابات سرا – طارق إمام – دار العين للنشر – الطبعة الأولي 2009 .
[3] – الأرملة ص 45
[4] – الأرملة ص 41
[5] – الرواية ص 46
[6] – أوكتافيو باث 1914 – 1999 ( حصل علي نوبل 1990 ).
[7] – الرواية ص 36
[8] – ص 12 .
[9] – سيمفونية بيتهوفن الملقبة بالقدرية ، والتي جاءت مع بدايات حالة الصمم التي أصابته .
[10] – قصة بهاء طاهر في مجموعته الأولي ” الخطوبة ” .
[11] – ص 12
[12] – ص11
[13] – ص 11
[14] – ص 15
[15] – ص 72
[16] – ص 78
[17] – ص 73