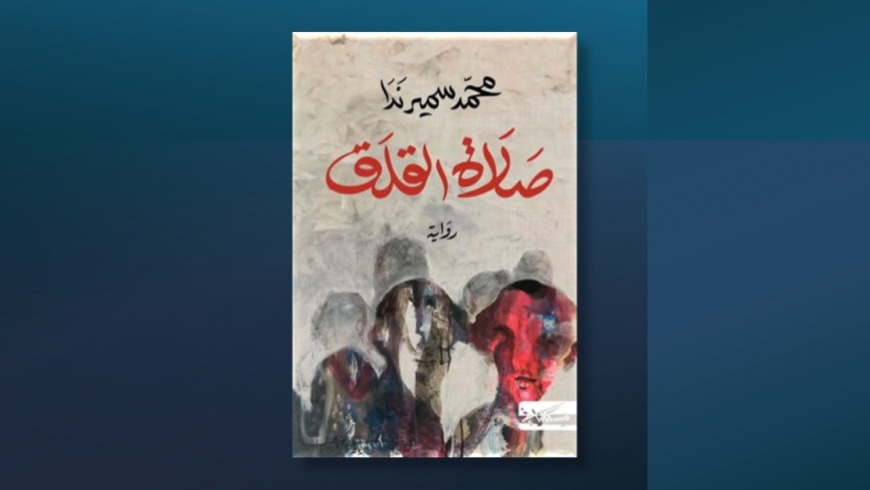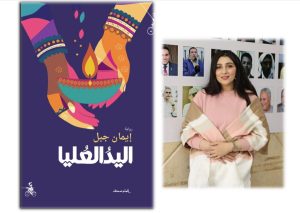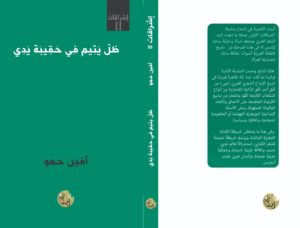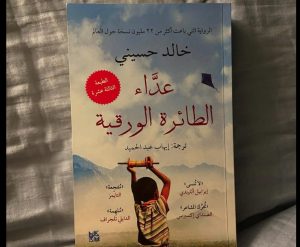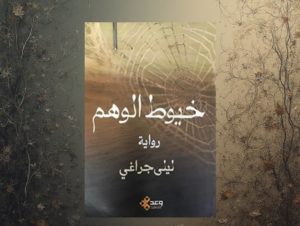د. رضا عطية
تدفعنا رواية صلاة القلق للكاتب المصري محمد سمير ندا الصادرة عن “ميسكلياني” التونسية، هذه الرواية الفائزة مؤخرًا بجائزة البوكر العربية (2025) عبر أكثر من موجَّه من إطاراتها النصية إلى قراءاتها- وفق افتراضات سياسية وتاريخية- بحسب ما تعلن مؤشراتها وبوصلتها أنَّها تقدِّم تاريخًا آخر غير التاريخ الرسمي الذي خبرناه، فالمؤلف الضمني يصدِّر روايته بـ”إهداء” بنص تعبيره “إلى جموع الصامتين الذين شهدوا على تاريخِ لم يُكتب بعد”، غير أنَّ الكلمة الإضائية التي ختم بها الناشر الرواية للكاتب التونسي “عيسى الجابلي”، أحد الذين وجَّه إليهم مؤلِّف الرواية الشكر باعتباره واحدًا ممن استفاد المؤلف- بحسب قوله المدوَّن- من آرائهم وملاحظاتهم- جاءت هذه الكلمة صادمة للحس الوطني المصري وموجَّهة لاتجاهات النص ومقاصده وفق ما تزعمه إذ يقول الجابلي “تُلقي الرواية الضوء على عشرية قاسية تمتد من نكسة حزيران سنة 1967 إلى لحظة وقوع الانفجار وانقلاب وجوه القرويين إلى سلاحف….أما قاع الرواية فمساءلة سردية للنكسة وما تلاها من أوهام بالسيادة والنصر. فمن يكتب التاريخ الحقيقيَّ: الجزمة (هكذا كتب الكاتب) والبندقية وسلاسل الحديد أم صرخات التمرُّد التي لا تموت؟ وما الذي يوقظه فينا العام 1977؟ موت المعنى والفن أم عبث المصير والسلام الزائف؟ أليست قرية «المناسي» استعارة كُبرى لجيل من الممسوخين؟”.
لقد ألقت كلمة الكاتب عيسى الجابلي النص الروائي في مدار دائري ينطلق من نكسة يونيو 1967 حتى العام 1977 والتلويح بما وصفه الكاتب التونسي بـ”السلام الزائف”، حتى يجيء تغافل أحداث الرواية التي يكتبها “حكيم”، أحد شخصيات الحكاية الروائية- على لسان ثماني شخصيات لنصر أكتوبر ليضع علامة استفهام كبرى باسترجاع كلمة الكاتب التونسي على ظهر غلاف الرواية، وكذلك بإشارته أن كتابة التاريخ الحقيقي قد تتراوح بين “الجزمة والبندقية وسلاسل الحديد” المرجح إشارتها إلى العسكرية في مقابل صرخات التمرد، في منظور يبدو بالغ الخطورة بافتراض تلك الحدية التقابلية في تصوُّر من يكتب التاريخ. وأيًّا كان مقصد الكاتب عيسى الجابلي من صراع يفترضه بين مرجعتين لكتابة التاريخ، فإنَّ استعماله مجازات مثل “الجزمة والبندقية وسلاسل الحديد” يبدو جارحًا للكبرياء الوطني ولا يمكن قبوله كاستعارة عن العسكرية المصرية التي افتدى أبناؤها الأبطال وطنهم بالروح وروا ترابه بالدماء.
مساءلة للنكسة أم تغافل لنصر أكتوبر 1973؟!
إذا كان منطلق الرواية كما حدده الإهداء بادعاء كتابة تاريخ لم يكتب بعد، تاريخ شهده جموع الصامتين، أي الزعم بكتابة المسكوت عنه تاريخيًّا، فهل تكمن المشكلة أو أزمة تلك الرواية في مساءلة النكسة كما دفعت كلمة النبذة على الغلاف الخلفي للرواية للكاتب التونسي عيسى الجابلي إلى توجيه قارئ الرواية إلى هذه الزاوية؟!
بالطبع لا يمكن المصادرة على كاتب أو نص في ممارسة حقه الإبداعي في مساءلة التاريخ ومحاولة فهم أحداثه وتأويل حركته وتفسير صيرورته واستيعاب أحداثه المفصلية الكبرى، لكنَّه على نحو آخر فإنَّه من الخطورة التصدي لكتابة التاريخ أو بزعم ذلك من وجهة نظر تتغافل أحداثًا مهمة ومفصلية وانتزاعها من سياق تناول تاريخي لحقبة ما، وهي الأزمة الكبرى لرواية صلاة القلق التي زعمت مساءلة نكسة يونيو/ حزيران 1967 وفق التوجيه المحرِّض لتلك الكلمة التي كانت في مختتم الرواية على ظهر غلافها، بينما دارت أحداثها على امتداد ما وصفته نبذة الغلاف الخلفي بالعشرية القاسية من العام 1967 حتى العام 1977، في حين أنَّ أحداث الرواية قد تغافلت تمامًا الحدث الأهم في تلك الفترة وهو حرب أكتوبر/ تشرين أول 1973 التي حققت فيها مصر انتصارًا كبيرًا على إسرائيل بعبور الجيش المصري قناة السويس واقتحام خط بارليف المنيع، وهو النصر الذي زلزل الدولة العبرية وأقرته وحاولت البحث في أسبابه كما في محاكمات لجنة “أجرانات” التي شكلتها إسرائيل للبحث في أسباب الهزيمة في حرب أكتوبر، وغيرها من وسائل البحث والدراسة التي لجأوا إليها في الدولة العبرية لاستيعاب دروس الهزيمة.
وإذا كان البعض يتصور أنَّ كتابة الرواية للتاريخ تعني محاولة الرواية تقديم وجهة نظر جديدة أو مختلفة عما هو قار في مدونات التاريخ الرسمي فإنَّ هذا الافتراض يصبح عبثًا في تصوُّر حدود كتابة الروائي للتاريخ حين يُسقِط حدثًا تاريخيًّا فارقًا ومفصليًّا في حقبة تاريخية يدعي تقديمها لاسيما وأنَّ هذا الحدث الذي تتغافله الراوية في سرد مرتبط بالحدث الذي تقدمه باعتباره منطلقًا للسرد وغاية في مساءلته، فحدث انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973 لا يمكن تجاوزه في رواية تزعم أنَّها تقدِّم تاريخًا لعشرية تمتد من 1967 إلى 1973، لأنَّ هذا التغافل مخل بالنسق التاريخي للحقبة التي تدعي الرواية- بحسب الكلمة الموجَّهة للقراءة على غلافها الخلفي- أنَّها تقوم بمساءلتها.
ويشهد تاريخ الأدب العربي وبخاصة في مصر نماذج مهمة وتجارب بالغة الثراء والتميُّز وخطابات إبداعية شديدة الجسارة في مساءلة الأدب لحدث نكسة يونيو/ حزيران 1967، كما في تجارب إبداعية متنوعة الأجناس الكتابية، مثلما كان في نصوص لعبد الرحمن الأبنودي شاعر العامية المصرية كما في أغنيته الشهيرة “عدى النهار” التي غناها عبد الحليم حافظ من ألحان بليغ حمدي، ومسرحية، وديوان الفصول للأبنودي أيضًا، وديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة لأمل دنقل، وهوامش على دفتر النكسة لنزار قباني، وبعض قصائد ديوان مرثية للعمر الجميل لأحمد عبد المعطي حجازي، ومسرحية حفلة سمر من أجل 5 حزيران لسعد الله ونوس، وحتى من قبل هزيمة يونيو 67، كانت هناك روايتا ميرامار وثرثرة فوق النيل لنجيب محفوظ تسائلان مشروع دولة يوليو وتنتقدان سلبياته.
عبّر الأبنودي عن المشاعر المتناقضة إزاء الهزيمة في يونيو 1967، في الأغنية الشهيرة، “عدى النهار”، التي غناها له عبد الحليم حافظ، تلك الأغنية التي تحمل رؤية واعية لحال الوطن ومحاولته الخروج من تحت أنقاض الألم والهزيمة لمعاينة النهار مرة أخرى:
عدّى النهار والمغربية جايّة
تتخفّى ورا ضهر الشجر
وعشان نتوه في السكة
شالِت من ليالينا القمر
وبلدنا ع الترعة بتغسل شعرها
جانا نهار مقدرش يدفع مهرها.
كما يتبدى من النص ثمة شعور بالهزيمة المباغتة للمصريين في ما سُمي بحرب الأيام الستة، وهو ما أدى لردة فعل نفسية مكافئة لهول المباغتة تبدى في الشعور بالليل المخيم بثقله على نفسية المصريين، ما ضاعف من حجم الشعور بصدمة الهزيمة،.
ومع الشعور بفداحة الهزيمة في يونيو لم يتخل الخطاب الشعري لدى الأبنودي عن الرجاء في تجاوزها:
يا هل ترى الليل الحزين
أبو النجوم الدبلانين
أبو الغناوي المجروحين
يقدر ينسّيها الصباح
أبو شمس بترش الحنين
أبدًا بلدنا ليل نهار
بتحب موّال النهار
لما يعدّي في الدروب
ويغنّي قدّام كل دار.
في هذا المقطع تبدو هنا نقلة وتحول ما في مسار الأغنية/ القصيدة، “عدى النهار”، فمن حالة التشكك أو انخفاض اليقين وتردد الذات في إمكانية تجاوز الليل/المحنة، إلى النفي القاطع للاستسلام لذلك الليل، وتأتي لفظة (أبدًا) لتمثل الانقلاب الحازم نحو الإصرار على رفض الهزيمة ودفع الليل، ويكون التحول من سيادة الزمن الليلي في أجواء القصيدة/ الأغنية إلى ترجيح النهار حتى في الليل (أبدًا بلدنا ليل نهار/ بتحب موّال النهار) ما يؤكّد على انبعاث روح جديدة رافضة لليل ومقاومة للهزيمة بالجدل الذي يزكي درامية النص بين الاستكانة لليل والاستسلام للحزن والرضوخ لانكسارات الهزيمة، وانبثاق صوت مقاوم استنهاضي يرفض التسليم لليل/ الهزيمة ويعلن انتظار البلد للنهار/ الانتصار والخروج من عثرة الهزيمة وكبوة الانكسار، إنّه صوت الصحوة والتمرّد على أغلال الهزيمة:
والليل يلف ورا السواقي
زي ما يلف الزمان
وعلى النغم
تحلم بلدنا بالسنابل والكيزان
تحلم ببكرة واللى حيجيبه معاه
تنده عليه في الضلمة وبتسمع نداه
تصحى له من قبل الأدان
تروح تقابله في الغيطان
في المصانع والمعامل والمدارس والساحات
طالعة له صحبة جنود
طالعة له رجال أطفال بنات
كل الدروب واخدة بلدنا للنهار
واحنا بلدنا ليل نهار
بتحب موال النهار
لما يعدي في الدروب
ويغني قدّام كل دار.
يبدو في هذا المقطع من الأغنية تصاعد مقاومة الصحوة التي دبت في أوصال الذات بعد الهزيمة سعيًا إلى النهوض من الانتكاسة والتطلع نحو المستقبل القريب/ الغد/ النهار، ويكون التهيُّؤ لتلك المرحلة الجديدة من السعي لاستعادة الأمة روحها في عز الإظلام وفي كل فضاءات الدولة (الغيطان والمصانع والمعامل والمدارس والساحات) بتلاحم قوى وفئات المجتمع المدني وشرائح الأفراد (رجال/ أطفال/ بنات) فيصبح كل مواطن جنديًا في مجاله، فثمة إدراك واعٍ بأنّ الخروج من حالة الهزيمة إنّما يكون بتقوية المجتمع المدني وإصلاحه وليس إعادة تقويم الجيش والإعداد العسكري فحسب، فثمة تنامٍ لنبرة تحريضية في هذا المقطع من أجل لملمة شتات الأمة والاحتشاد المجتمعي استعدادًا لمعركة تحرير الأرض المسلوبة واستعادة الكرامة والكبرياء الوطني واسترداد الأمة اعتبارها.
وحتى الأبنودي نفسه عندما تغنى بنصر أكتوبر في أغنية “صباح الحير يا سينا” التي غناها عبد الحليم حافظ:
وصباح الخير يا سينا
رسيتي في مراسينا
قولنا يهون علينا
ده أول الشطآن
بدا شديد الاتزان بين الابتهاج بالنصر الذي تحقق باستعادة مصر للضفة الشرقية لقناة السويس وقطاع من أراضي سيناء، وفي الوقت نفسه لم ينفِ أنَّ الإنجاز العسكري الكبير الذي تحقق للجيش المصري لا زال بحاجة إلى مزيد من العمل والإجراءات، كما في استعارة (ده أول الشطآن) التي تعبِّر عن رؤية واقعية متزنة في تقدير الانتصار الذي تحقق ومحاولة استبصار القادم لاستكمال تحرير باقي الأرض وهو ما تحقق بالفعل بمبادرة الرئيس المصري الراحل أنور السادات باتفاقية السلام التي استردت مصر بموجبها كامل أرضها، لذا فالفن عمومًا والأدب بخاصة في تعاطيه مع الحدث التاريخي يبدو أكثر واقعية إذا كان متوازنًا في استبصار المواقف وتمثُّل الأحداث عبر وجوهها المتعددة.
وإذا كانت النماذج الأدبية الناصعة التي ارتبطت بالصراع العربي الإسرائيلي، لم تتخل في تقرير مرارة الألم والجرح العميق لأثر نكسة أو هزيمة يونيو/ حزيران 67 عن روح المقاومة ورفض الاستسلام للهزيمة ولم تخلو من توجيه سهام النقد والإدانة لأسباب تلك النكسة والمسؤولين عنها، مثلما عبرت نصوص أدبية عديدة عن ملحمة انتصار أكتوبر 1973، يبقى من الغريب والمثير لكثير من علامات الاستفهام والريبة أن يخرج علينا نص أدبي مثل رواية صلاة القلق ليدعي كتابة تاريخ آخر ويزعم مساءلة نكسة يونيو 67، فيدور المدى الزمني لحكايته في عشر سنوات من 67 حتى 77، متغافلاً حدث حرب أكتوبر وانتصار مصر فيها على إسرائيل رغم أنَّ خيوط أحداث الحكاية ترتبط بالحرب وبتغيُّر مصائر شخوص الحكاية بسبب هذه الحرب.
وتنسج كثير من أحداث رواية صلاة القلق على حدث مختلق وهو ادعاء انتصار مصر على العدو الإسرائيلي في الفترة من 10 يونيو 67 حتى 15 من نفس الشهر، وهو ما يتردد في غير موضوع من الرواية، كما يقول “نوح النحال”: “فعلى الرغم من اكتمال عملية التحرير منذ الخامس عشر من يونيو 67، وفقًا لرواية رسمية نقلتها الجريدة الحكومية الوحيدة التي يوزِّعها الخوجة… فإنَّ اليوم هو السبت السابع من أبريل” لسنة 1977، وما عاد مراد ولا زملاؤه حتى اليوم” (ص50)، فإنَّ عدم تعرُّض شخصيات الرواية التي يتكشف في آخرها أنَّ الذي يكتب عنهم ويتقمصهم هو حكيم، ابن خليل الخوجة، طوال هذه المدة من 67 إلى 77 إلى حدث انتصار أكتوبر الذي أنهى الحرب العسكرية برد اعتبار المصريين يضع الرواية موضع تساؤل في تجاهل ساردها أو كاتبها الافتراضي شخصية حكيم المتقمص شخصيات أبطال حكايتها الثمانية لحدث تاريخي فارق كحرب أكتوبر، تضايفًا مع التوجيه التسيسي والمؤدلج للكاتب التونسي عيسى الجابلي على ظهر الغلاف بزعم مساءلة قاع الرواية لهزيمة يونيو 67 وما زعمه بما تلاها من أوهام بالسيادة والنصر.
وحتى مع محاولة الصياغة الروائية المراوغة في التصريح باستعمال أسلوب الوثائق في الجزء الأخير من الرواية حيث تورد في تقرير رأي طبي “أرى أن المريض لا يختلق الأحداث بالكامل، لكنه ربما يجمع بين الوقائع التي عاشها وخيالات وأحلام وكوابيس طاردته” (ص351)، فالقول بتوزع مروية الحكاية التي قدمها الكاتب الافتراضي للنص بين وقائع معاشة وخيالات وأحلام، لا ينفي صورًا سلبية قُدِّمت عبر تلك المروية لقرية عاشت في أوهام انتصار كاذب، مع التلويح بأنَّ هذه القرية هي “استعارة” كما في توجيه كلمة ظهر الغلاف أي أنَّها قد تشير رمزيًّا للوطن.
وتعمل الصياغة السردية للحكاية على ترسيخ تغافل حرب أكتوبر، مع تأكيد امتداد الحرب بزعم انتصار مصر منذ 67 حتى عام 77، والغريب كذلك هو ذهاب أبناء نجع المناسي إلى جبهة القتال بلا رجعة طوال عشرة أعوام، فيصف “نوح النحَّال” حالة شباب النجع بأثر الحرب: “وهكذا طوَّقت الحربُ الشبابَ بسياجين؛ سياج خوفٍ يقبع في الصدور، وسياج ألغام يكبِّل رغبتهم في الرحيل، فكان أن هرب أغلبهم من رتابة الحواضر عبر التطوُّع للمشاركة في الحرب فورَ بلوغ سن القتال المحدَّدة بستة عشر عامًا، وتولّى الخوجة شؤون التطوع بالتنسيق مع السيارات المموهة (…) لاحظ الجميع أنَّ الذاهبين إلى الحرب لا يعود منهم أحد، واظب بعضهم على إرسال حوالات وكلمات مقتضبة نادرة لا تضيف إلى مدارك القوم جديدًا. وكنت أشفق على الأهالي التوّاقين إلى سماع خبر خبر جديد” (ص ص53- 54)
وعلى الرغم أنَّ الواقع التاريخي والحقيقة التاريخية هي توقف القتال بين مصر وإسرائيل عبر عدد من الاتفاقات برعاية الأمم المتحدة لفض الاشتباك بين الجيشين المتقاتلين بدءًا من نوفبر 1973 ومرورا بيناير 1974، ومن قبل قرار مجلس الأمن، القرار رقم 338 (22 أكتوبر(1973 وقضى بوقف جميع الأعمال العسكرية اعتبارًا من 22 أكتوبر، وهو ما ترتب عليه عودة المقاتلين المصريين من جبهات القتال إلى أهلهم وذويهم على دفعات عقب فض الاشتباك، فإنَّ الحكاية المروية في صلاة القلق تصر على الترسيخ لفكرة أنَّ ثمة حربًا واحدة ممتدة من 67 بادعاء نصر مصر في يونيو 67، دونما ذكر لحرب الاستنزاف وانتصار أكتوبر 73، وهو ما يفتح بابًا للتساؤل: كيف أنَّ الذين ذهبوا إلى جبهة القتال لم يعودوا بعد من 67 حتى 77 في ظل تغافل الحكاية السردية لحرب أكتوبر؟ وهو ما يشكل مغالطة تاريخية أخرى تتمثل في استمرار وجود المجندين على جبهة القتال حتى العام 77، رغم أنَّ الوقائع التاريخية والحقيقة التاريخية هي عودة المجندين إلى بلداتهم وأهاليهم بعد فض الاشتباك في أواخر عام 73 وأوائل عام 1974، فتتواطأ هذه المغالطة التاريخية في الحكاية الروائية في صلاة القلق مع تجاهل الرواية لحدث انتصار مصر في أكتوبر 73.
وبالطبع فإنَّ مثل هذا التغافل المخل بالسياق التاريخي لحرب أكتوبر 73، والمغالطة التاريخية بادعاء عدم عودة المجندين من الجبهة حتى العام 1977 يسقط رواية صلاة القلق في فرضياتها السردية لبنية الحدث ويصيب أحداثها بخلل في منطق تكوينها، فالفارق كبير بين فرضية كتابة الرواية والفن للتاريخ بمعنى إمكانية تقديم رؤية جمالية للتاريخ أو تصوُّر خاص يحاول أن يملأ ثغرات التاريخ، وقيام الأدب كما في هذه الحالة بتغافل حدث تاريخي مفصلي كحرب أكتوبر 1973، يقع زمنيًّا في منتصف المدى الزمني للحكاية ويغيِّر جذريًّا ما قبله ويترتب ما بعده عليه، لذا تصبح مثل هذه الكتابات عبثًا ساذجًا بالتاريخ لا إعادة كتابة له. فالتخييل التاريخي هو استلهام التاريخ ومحاولة تقديم تصوُّر لما وراء أحداثه الكبرى وتلمُّس أبعادًا متنوعة وربما استنتاج أبعاد لشخصياته لم تكن مُبرزة في النص التاريخي، أي رسم ظلال هذه الشخصيات، وربما أيضًا إسقاط حاضر آني على تاريخ ماضٍ، لكن كل هذه الطرق التي ترتكز على التاريخ وتعيد كتابته تخييليًّا لا تعني تحريف التاريخ وتجاوز أحداثه الكبرى المفصلية.
وقد جاءت بعض الاستعارات المسيسة في هذه الرواية صادمة تقدم صور سلبية شديدة الفجاجة والفحش كما في استعارة التمثال التي يمضي السرد في الرواية على اعتقاد أهل النجع أنَّه تمثال الزعيم جمال عبد الناصر الذي هشم النحال رأسه وكتفه، فيصوِّر السرد عبر شخصية نوح النحال في ص74 من الرواية التمثال يرتكب أبشع الفواحش بفلاحات النجع بأوصاف أفعال جنسية شديدة الفحش والفجاجة، ولكن بعدما ظن الأهالي أن التمثال للزعيم الخالد جمال عبد الناصر يعود حكيم ليبث التردد بين احتمالية أن يكون التمثال لمحمد نجيب أو زعيم آخر، بما يشكِّل استخفاف شخصيات الحكاية الروائية وضيقهم بمسألة اعتزاز الأمة بزعمائها الوطنيين.
استنساخ يوسف القعيد
تدور أحداث رواية صلاة القلق مكانيًّا في “نجع المناسي” (جمع المنسي) الذي يستدعي رواية يوسف القعيد، أخبار عزبة المنيسي، (1971) فتتجلى عديد من التشابهات بين النصين، ما يجعل نص صلاة القلق يبدو وكأنَّه يستنسخ بعض عناصر نص القعيد بدءًا من التسمية لمكان الأحداث، فكلًّ من العزبة والنجع يشيران إلى مكان ريفي صغير أصغر من القرية والبلدة، أما “المناسي” و”المنيسي” فيتشاركان في الجذر اللغوي “نسى” للدلالة على نسيان هذه الكيانات أو المستوطنات الصغيرة وهامشيتها، وبالفعل فكلا المكانين الصغيرين يقعان جغرافيًّا في موضع طرفي يكاد يكون معزولاً ويتاخم الصحراء، فعزبة المنيسي في رواية القعيد تبدو في أقصى الدلتا في محافظة دمنهور ونجع المناسي يقع في خاصرة الصعيد وأقصى المنطقة البينية بين أسيوط وسوهاج ويتاخم الصحراء أيضًا.
وتعتمد البنية الزمنية لزمن الحكاية في رواية أخبار عزبة المنيسي ليوسف القعيد على التأطير الزمني لمرحلة تحولية من تاريخ مصر في الفترة من 1952 حتى 1967، أي تبدأ بمستهل مرحلة جديدة سياسيًّا واجتماعيًّا وهي ثورة يوليو 52، وتنتهي أيضًا بسنة مفصلية 1967، حيث نكسة يونيو التي كانت صدمة دعت إلى إعادة النظر في مشروع يوليو، وبالمثل تعتمد رواية صلاة القلق على التأطير الزمني لمرحلة يضعها الكاتب من 1967 حيث النكسة التي تمثل بداية مرحلة مغايرة لما قبلها وتنتهي في 1977 حيث يشير الكاتب عيسى الجابلي في كلمته على ظهر الغلاف أنَّها قد تحيل إلى ما زعم أنَّه “السلام الزائف”، قاصدًا بذلك زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس والمفاوضات التي انتهت باستعادة مصر لبقية أراضيها في سيناء بعد أن استعادت جزءًا منها في حرب العبور والتحرير في أكتوبر 1973 التي تغافلت عنها رواية صلاة القلق بشكل غريب وساذج ومجاف للحدث التاريخي الأبرز في هذه الحقبة.
وإذا كان الحاج “هبة الله المنيسي” هو المهمين بقبضته على عزبة المنسي في رواية القعيد، فثمة شخصية “خليل” الخوجة” في “صلاة القلق”، هذا الرجل الباسط نفوذه وسطوته على نجع المناسي والمتحكم في مصائر وأرزاق أهله. كذلك تبدو بعض شخصيات رواية صلاة القلق شديدة الخصوصية في المهنة التي تعملها كمهنة “الكلاف” التي لا يلم بها إلا ريفي كاستثمار لشخصية الكلاف التي قدمتها رواية أخبار عزبة المنيسي للقعيد، كذلك ما تثيره شخصية “نوح النحال” في رواية صلاة القلق من أزمة الشعور بالظلم الشديد نظرًا لدفع “خليل الخوجة” بمراد، ابن نوح النحال إلى التجنيد بغير وجوب ذلك وبدون وجه حق لأنه كان وحيد والديه وذهاب مراد إلى الجبهة منذ العام 1967 وانقطاع أخباره حتى العام 1977 يتقاطع مع شخصية الشاب “مصري” ابن الخفير في رواية الحرب في بر مصر، ليوسف القعيد أيضًا، هذا المجند “مصري” الذي ذهب إلى التجنيد بدلاً من ابن العمدة ومات في حرب أكتوبر، فتشاركت كلتا الشخصيتين في الذهاب إلى التجنيد بغير حق وعدم استطاعة الأب الحصول على حق الابن وإثباته وكذلك الفقد في جبهة الحرب، إضافةً أيضًا إلى أنَّ شخصية النحال من شخصيات أهالي عزبة المنيسي عند القعيد.
نزيف اللغة/ تخثر السرد
إذا كان السرد يتشكَّل من شخصيات الحكاية وما يجري بينهم من أحداث ومواقف وما يدور بدواخلهم من مشاعر وما يحملونه من أفكار ورؤى ومعتقدات يمثَّل هيكل النص الروائي فإنَّ اللغة المستخدمة تعبيرًا عن مكونات الحكاية المتفاعلة فيما بينها تمثَّل اللحم الذي يشكِّل المظهر الخارجي للجسد السردي للنص الروائي، فإذا كانت اللغة المستخدمة نقلاً للحكاية بمكوناتها المتعددة مسرفة في تمددها التعبيري كمًا، فإنَّ ذلك يصيب جسد السرد بالترهل والاهتراء.
بدت لغة السرد في رواية صلاة القلق مترهلة في تعبيرها عن بنية الحدث، حيث استغراق الشخصيات التي تروي حكاياتها في النجع أو الذين يتقمصهم “حكيم” ابن خليل الخوجة في سرد الحدث في نزيف لغوي يشعر المتلقي إزاءه بتخثُّر السرد وإنَّه كان بإمكان الصياغة السردية أن تعبِّر عما تريد قوله بإيجاز تعبيري وتكثيف لغوي أكثر تحقيقًا لسيولة السرد.
يحفل السرد في رواية صلاة القلق بكثير من الاستطرادات المجانية التي تبدو حشوًا زائدًا عن الحاجة وتخمة في الوصف، كما في هذا المقطع من مرور “محجوب النجَّار” على الشيخ أيوب:
ومرَّ محجوب النجَّار بدار الشيخ أيّوب. زاره وهو يدفع أمامه عربة صفيحية فيها صندوق مملوء بعلب الغراء وورق النشارة والمسامير، وكماشة قديمة استعمرها الصدأ، علاوة على ثلاثِ فؤس جديدة وجاروف ضخم. ظل محجوب صامتًا دقائق طالت، وكان يتلفَّت مع كل التفاتة لعنق الشيخ، يداهم الظلام بعينيه بحثًا عن السر المخبوء. فربّت الشيخ على كتفه فانتفض، إذ كان تواقًا إلى تلقي الأسئلة والاستفسارات وإن جهل الإجابات. لكنَّه لم يتلقَّ طوالَ الأيام الأخيرة أسئلة. لم يسأله أحدٌّ عمّا يخص الدين وصحيح عقائده. (ص31).
إذا كان الحدث الرئيسي لهذا الموقف المسرود هو مرور محجوب النجَّار بدار الشيخ أيوب وتراوح مشاعرهما بين صمت محجوب القلق وتوق الشيخ لتلقي أسئلة في الدين والعقيدة، فيبدو واضحًا أنَّه من التزيُّد وصف السرد لأشياء النجار (عدة شغله) وحركته: (زاره وهو يدفع أمامه عربة صفيحية فيها صندوق مملوء بعلب الغراء وورق النشارة والمسامير، وكماشة قديمة استعمرها الصدأ، علاوة على ثلاثِ فؤس جديدة وجاروف ضخم) التي لا تضيف شيئًا للحدث المسرود، وكان يمكن الاستغناء عنها دونما التأثير في الرسالة المراد توصيلها.
وتأتي لغة الرواية كنسيج يفتقد في بعض مواضعه الاتساق المعجمي أو تناسب لغة التعبير مع وعي الشخصية كما في بوح شخصية “وداد القابلة” بجوهر مأساتها وارتباطها بشخصية “شواهي” الغجرية التي ألهبت النجع: “العقم سترٌ أحيانًا وراحة بال، إلا أنَّ امرأة مثلي أراح الله بالها من مشاكل البنين والبنات والأحفاد والحفيدات، تبحث عن بؤرة قلق أخرى تتمحور حول شواهي” (ص130)، فتأتي مفردة مثل (تتمحور) بعيدة عن لغة ووعي امرأة بسيطة (قابلة تولِّد النساء) أو حتى شاب يحاول تمثلها وتقمصها مثل شخصية “حكيم” الذي حصل قدرًا معقولاً من الثقافة ودأب على سماع أغنيات عبد الحليم حافظ”، فهي أقرب إلى معجم الأكاديميين المغاربة (تونس- الجزائر- المغرب) منه إلى معجم شاب يهوى فنًا شائعًا كغناء عبد الحليم حافظ برومانسيته المرهفة وبساطة ويسر كلمات أغانيه التي كان يدوِّنها.
وعلى الرغم مما حاولت أن تقدمه الصياغة السردية من تعددية في أصوات السرد حيث تروي ثماني شخصيات متنوعة حكايتها في النجع فإنَّ ثمة تناسخ للغة الشخصيات وفي شواغلهم بما يبدد ما كان يتوخى استثماره لهذه الشخصيات المتنوعة.
يسمعنا السرد شخصية وداد القابلة في بوحها بمعاناتها، وهي تستحضر “شواهي” رفيقتها التي بمثابة ابنة لم تلدها، لكن جمعتها بها صحبة وألفة:
-يقول الشيخ أيّوب إنَّ عيسى لم يُصلب وإنَّما شُبِّه للناس، ويستدل على ذلك بآيات من كتاب الله، وأنا مصلوبة بين المصلوبين، لا يهمني أن أستوثق من حقيقة صلب المسيح، ولا أبتغي نهاية كنهايته، لكنّي أشاطره الألم من دون مسامير! (ص124).
بدا الموضوع الذي يشاغل الشخصية وهو مسألة لاهوتية تتمثل في صلب السيد المسيح والاختلاف العقائدي حولها وتمثُّل الذات “وداد القابلة” نفسها مصلوبة كالمسيح- أمرًا بعيدًا عن وعي الشخصية، امرأة بسيطة وأمية تولِّد النساء.
لكنَّ شخصية أخرى هو “عاكف الكلّاف” يعبِّر عن نفسه بنفس الاستعارة “الصلب” ولكن في موقف آخر مغاير:
… وبعد صلاة الظهر تبدأ حركة الشراء حتى آذان المغرب. حرصتُ على الذهاب مبكرًا، وها أنا على الرغم من ذلك مصلوب في الطابور اللعين ذاته. (ص124).
فإذا كان تعبير شخصية القابلة عن شعور نفسي بمعاناة في حياتها وإحساس بالخواء والوحدة باستعارة الصلب غير مناسبة لشخصيتها أو ثقافتها فإنَّ تعبير شخصية أخرى بنفس الاستعارة (الصلب) عن موقف مكرور من نسيج اليومي كطول انتظاره في طابور للتسوُّق يبدو من قبيل الاستهلاك الاستعاري فضلاً عن عدم مناسبته أيضًا لمستوى الشخصية الفكري والثقافي.
لذا بدت محاولت استدارك الصياغة السردية في رواية صلاة القلق بتذييلها بملحق توثيقي من الخطابات والتقرير بالكشف عن أنَّ شخصية “حكيم” ابن خليل الخوجة هو من كتب هذه الشخصيات وتقمصَّها بعد أن عاشرها في نجع المناسي بدت كنتوء سردي وحيلة تبرر الإخفاق السردي في إيجاد تمايز بين شخصيات الحكاية المسرودة، فما أدعى السرد تقديمه من تنويع في أصوات البث السردي عبر تداول أشخاص الحكاية الثمانية بثَّها قد بدده بعدم استطاعته خلق خصوصية سردية لكل شخصية عن غيرها وحاول السرد تبرير الفشل في تخليق التنوُّع الدرامي والتمايز البولوفوني للسرد بحيلة أنَّ كاتب هذه الشخصيات هو شخصية واحدة، هو “حكيم” ابن “خليل الخوجة”.
وإذا كان حكيم ابن خليل الخوجة “مولود في الخامس من يونيو” عام 62 فتوافقت ذكرى ميلاده يوم هزيمة يونيو 67 التي بحسب تعبيره “تصورها الناس بعد أيام نصرًا مبينًا” (ص311)، كما تؤكد “وداد القابلة” عمر “حكيم” سنة 1977: “وحكيم طفل لا يكاد يخطو فوق عتبته الخامسة عشرة” (ص114)، فيبدو من عدم الاتساق المنطقي للحكاية أن يتقمص شاب في العام 1988، وقت كتابته لأحداث الحكاية ما دار بالنجع في الفترة من 1967- حتى 1977، وقت أن كان طفلاً صغيرا لم يزد عمره عن خمس سنوات من عمره حين بدأ الحكاية التي يسترجعها، ما يمثَّل خللاً فادحًا في تشكيل التكوين السردي للحكاية المروية يفتقد لمنطقية كافية لتبرير الدور الذي تمارسه الشخصية، شخصية “حكيم” كشاهد على الحكاية وراوٍ لها.
ومن العناصر المكرورة في الحكاية المسرودة في رواية صلاة القلق هو تعبير شخصيات الحكاية على اختلافهم عن عربات الجيش بوصف “العربات المموهة” فيصف “نوح النحال” ضيقه من تلك السيارات: “… فكنت أقذف السيارات المموَّهة بالحجارة إبان مغادرتها نجع المناسي” (ص46)، أما “محروس الدبَّاغ” فيحكي عن سيارات الجيش قائلا: “دأب الخوجة على شراء ما يتبقَّى من الزرع بنصف ثمنه المتفق عليه، ليبيعه عقب ذلك للسيارات المموهة” (ص81)، وتقول كذلك “وداد القابلة”: “… لا تمرُّ بنا القوافل منذ اندلعت الحرب، وحدها العربات المموّهة تفد إلى النجع” (ص121)، وكذلك “عاكف الكلَّاف” حين يتحدث عن زوجته: “كانت محقة في خوفها، فسلامة اليوم في الثالثة عشرة، وبعد سنوات ثلاث ستأتي العربة المموّهة ويتسلم سائقوها كشوف الأعمار من خليل الخوجة، وعندئذٍ سنودِّع سلامة كما ودَّع الآخرون أبناءهم بلا رجعة، فما من شابٍّ خرج للحرب وعاد إلى النجع منذ ما يزيد على عشر سنوات، منذ نصر 67 لم يعد أحد” (ص154)، فيبدو مما سبق تشارك شخصيات الحكاية الروائية في وصف عربات الجيش بالعربات المموهة، وهو تطابق غريب لا يتفق مع ما يفترضه تنوٌّع الشخصيات.
ولكن إذا كان عمل فني مهم، هو فيلم “الممر” قد استخدم وسم “المموه” على لسان ضابط الصاعقة “نور” (الممثل أحمد عز): “البسوا لهم المموه بيخافوا منه”، كعلامة للصاعقة المصرية في مقاومتها البطولية للعدو الإسرائيلي في حرب الاستنزاف، ليكون “المموه” شارة علاماتية لنضالات العسكرية المصرية تحريرًا للأرض المغتصبة في حرب يونيو/ حزيران 67، فإنَّ ما ورد هنا في رواية صلاة القلق وصف عربات الجيش بالعربات المموهة وباقترانها بوسوم سلبية لدى شخصيات النجع، كأخذ أبنائهم للحرب منذ عشر سنوات بلارجعة، في مغالطة تاريخية وخطأ فادح للسرد، واقتران مرور تلك العربات المموهة بالنجع بتوقف مرور القوافل به، أي انبتات صلات النجع بالعالم الخارجي، وحصول تلك العربات المموهة على المحاصيل التي ينتجها النجع عبر “خليل الخوجة”، وتعدي “نوح النحَّال” على العربات المموهة، كل هذه الاستحضارات السلبية للعربيات المموهة، في رواية صلاة القلق الصادرة في العام 2024، والمدوَّن انتهاء كاتبها منها في 2022، بدت وكأنَّها رد أو استعارة مضادة لتلك اللازمة الواردة بفيلم الممر التي تفخر بشارة العسكرية المصرية وتحديدًا، قوات الصاعقة في حرب الاستنزاف: “البسوا لهم المموه بيخافوا منه”.
وعمومًا بدت مثل هذه التكرارت والتماثلات بين شخصيات الرواية في تشارك الشواغل والتعبير عن نفس المعطيات بصيغ تكاد تكون موحَّدة قد أفقد السرد في رواية صلاة القلق ما كان يحتاجه من تمايز في منظور الشخصيات، كما أنَّ محاولة الصياغة السردية لاستدراك ذلك الخلل الفادح في لغة السرد باعتبار أنَّ كاتب هذه الشخصيات ومتقمصهم هو “حكيم” ابن خليل الخوجة لم يفد الرواية إلا كمحاولة تبرير واهٍ لفشل السرد في تشكيل شخصيات متمايزة دراميًّا، إذ تكون اللغة هي أبرز وسائل السرد في تصدير الشخصية.