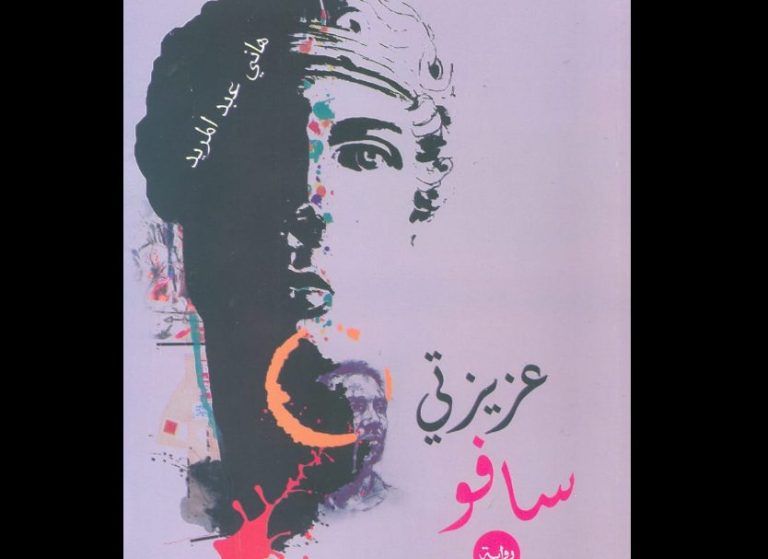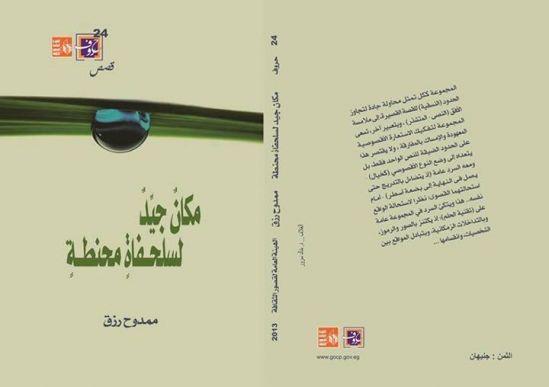محمد حسن الصيفي
استيقظت في العاشرة صباحًا كالمعتاد، الهاتف فوق رأسي، وضعت النظارة على وجهي، سحبت الهاتف وبدأت تصفح مواقع التواصل والبريد الإلكتروني لعلي أجد مهمة عمل جديدة، وتصفحت موقع الرسائل المجهولة “صراحة”، عادة لا تأتيني رسائل إلا كل عدة أشهر، لكني وجدت رسالة قبل ست ساعات، المفترض أنها فتاة، والمفترض أنها تريد مراسلتي والاتصال بي لكني على حد قولها “مستشيخ”، كنت متعطلا عن العمل منذ ثلاثة أشهر “لا شغلة ولا مشغلة” وتوأمي الأصغر بخمس دقائق غادر إلى عمله بالإذاعة قبل تمام الثامنة، قررت العمل بوصية صاحب/ة الرسالة وانتحال شخصية أخي لعدة ساعات في هذا اليوم نزولا على رغبة الشخصية المجهولة.
لن احتاج إلى خطة هوليودية للقيام بتلك المغامرة؛ فنحن الاثنان صورة طبق الأصل، نفس الصلعة، نفس الوزن، نفس العينين السوداوين، كل ما في الأمر أنني سأرتدي ملابسه الفجة؛ بسروالٍ من سراويله المقطوعة أعلى الفخذ، وقميص من قمصانه المهترئة، وسأضع على جسدي عطره الذي يصيبني بالتقزز، وارتدي نظارته الريبان وسلسلته الفضية التي أهدته أياها فتاته المائعة الملطخة بالمساحيق.
لم يكن الأمر ظاهريًا صعبا، لكن في الواقع ما أقسى هذا الموقف حين ترتدي عباءة أنت تكرهها وتنازع صاحبها طوال الوقت.
ارتديت ملابسه وألقيت تحيّة الصباح على أمي التي اندهشت وقالت: ألم تغادر منذ قليل، ما الذي دفعك للعودة؟
ـ نسيت الهاتف
سألتني عن أخي الذي هو في حقيقة الأمر “أنا”؛ قلت لها يغط في نومٍ عميق!
غادرت المنزل باتجاه وسط المدينة التي أكرهها ويعشقها أخي، يعشق الوسط في العموم، وسط البلد، وسط الفتاة التي يحبها، وسط الأمور، حتى أنه لا يؤمن بأي حكمة سوى بتلك التي تشير بأن “خير الأمور الوسط”.
كنت أشعر أنني أسير عاريًا في الشارع، وأن الناس يتغامزون عليّ من حولي، لكن في الحقيقة لا أحد ينظر إليّ، البشر أصبحوا مثل مجموعة من الأشباح، شاحبين يسيرون بقوة الدفع مثل الآلات المميكنة، كنت أشعر بالغربة داخل ملابس أخي المهترئة، لكني سئمت حياتي الرتيبة، أتطلع لشيء من الحرية، كان إحساسًا مختلطًا بين الاستغراب وبين سعادة التجريب، أنظر للأشياء من حولي وكأنها تُبعث من جديد، أشعر الآن بالتمرد، أنا الآن متمرد وفوضوي وعابث، أنظر للفتيات في أعينهن الجميلة من تحت نظارة أخي باهظة الثمن، ولا يهمني أي شيء سوى قضاء ساعات من التمرد واللهو الذي لا يعكره مثقال ذرة من فكرٍ أو ضمير.
وصلت وسط المدينة، سرت بلا هدف، سوى إعادة اكتشاف الأشياء والعالم من حولي، “مش بطالة” تلك الحياة التي يعيشها، التحرر، اللامركزية، يعيش خارج نفسه، يحب أو يكره، يأكل في أي مكان، يجلس على الأرض، يصاحب أنماطا مختلفة من البشر، يتحدث بالساعات في الهاتف لا لشيء غير حرق الوقت، وفي الأخير يرقد بلا حراك مثل التمساح، لا تدري هل هذا الذي يرقد أمامك نائمًا أم قتيلا من جراء الحرب؟ لا تدري من انتصر في الأخير؛ هو أم الحياة؟
ساعات من السير على قدمي بلا هدف، في الأخير اكتشفت أنني أمام نقابة الصحفيين، من هنا أعرف الوصول لأقرب مقهى رخيص، وقفت على عربة الكبدة، التهمت الأرغفة بنفس طريقته العشوائية وإمعانا في خلق التجربة الجديدة قلت للبائع أعطني “قرن فلفل” حامي يا بن عمي “بنفس طريقته”
أعطاني القرن فقمت بالتهامه من مرة واحدة فكان بمثابة الكارثة، لم يكن قرن فلفل، بل كان قطعة من جهنم، الشمس كانت على وشك المغادرة والليل يبدأ في إسدال ستائره وآذان المغرب فوق رأسي، شعرت بالذنب، وأن السماء تعاقبني على ما فعلت، في ثواني تحوّل فمي لفوهة بركان، وتحول وجهي لكرة حمراء لا تسر الناظرين، سقطت الأرغفة على الأرض في أثناء بحثي عن كوب الماء عند صاحب العربة، تجرعت الكوب الكبير دون أن أنظر فيه، لقد كان هو الآخر قذرًا بما يكفي أن أُعلن ندمي على كل شيء، قمت بدفع ثمن الأرغفة بالكامل وذهبت مسرعًا لصلاة المغرب، شعرت بالاضطراب، صليت وأنا مشتت الذهن مشغول البال، ساعد على التشتيت أكثر صوت الإمام الغليظ، خرجت مسرعًا، تذكرت هاتفي الذي لم أفكر أن ألقي عليه نظرة من الصباح، وأنا الذي أضع دائمًا نغمة رنين هادئة غير مسموعة على عكس أخي.
وجدت العديد من المكالمات الفائتة، عشر مكالمات من أخي الذي ألعب دوره الآن، اتصلت بسرعة. صمت وأصوات متداخلة. ظلت أردد: أيمن. أيمن!
ـ أيمن في ذمة الله، صدمته سيارة قبل ساعتين، ونُقل إلى المستشفى لكن بعد فوات الآوان!
بكيت، انتحبت، هبطت على الأرض، لم يخرج مني صوت، اختفى حيث اختفيت داخل ملابس أخي، لعنت نفسي، رفعت النظارة على عيني لكي لا أري شيئًا من حولي، ركبت أول تاكسي عائدًا للمنزل، دخلت الشارع، الناس حولي في ذهول حين رأوني بملابسه وكإني هو، يتمتمون، يستعيذون من الشيطان وينادون باسم الله الرحمن الرحيم، اندفعت نحوي الفتاة التي كان يحبها، احتضنتني بعنف، صرخت، أيمن لم يمت، أيمن حيّ. أيمن حي ها هو يسير على قدميه، احتضنتها بصمت ثقيل وكأن الكلام انتُزع من فمي بلا رجعة، ذهب ولم يعد، ربت على كتفيها وتركتها وأنا أسمع الكلام حولي والاندهاش وكأني أنا الميت وليس أخي، يتهامسون يتجاذبون الأحاديث الثنائية، يتسألون في حيرة عما حدث، وما الذي حملني على ارتداء ملابس أخي، كان همي الأول أن ًاصعد البيت وأخلع عني ملابسه قبل كل شيء، حتى قبل أن أدخل في نوبة من البكاء الحار. !
بعد ثلاثة أشهر
مروا كأنهم قرن من الزمان، أو كأنهم يومًا واحدًا. لا أدري، لكن ظلت حبيبة أخي قريبة مني، كانت تقف إلى جانبي بطريقة لا توصف، مهما حاولت الهرب لم يكن هناك مفر منها، أفر منها فأجدها أمامي، وأحاول أن أتلاشي هذا الشعور الذي يقول أنها.
وفي إحدى الأيام استيقظت كالمعتاد في العاشرة صباحًا. تصفحت بريدي الإلكتروني لعلي أجد مهمة عمل جديدة تخرجني من تلك البطالة الطويلة وتنسيني ألم الفراق الغادر، فتحت موقع الرسائل المجهولة مرة أخرى، وجدت رسالة منذ ثلاثة أشهر، تحديدا في مساء يوم وفاة أخي الرسالة تقول
“الله يخرب بيتك. يا شيخ”!
كانت تلك كلمتها دائمًا، أرسلت إليها صورة من الرسالة فابتسمت وقالت نعم أنا من أرسلت لك الرسالة وقتها، لم أكن أعرف أنك حمار؛ لكني أصبحت متأكدة الآن!