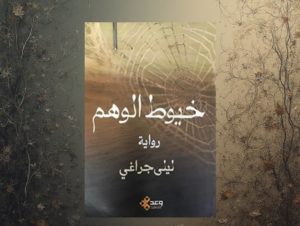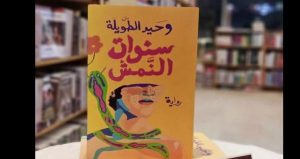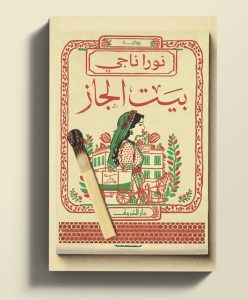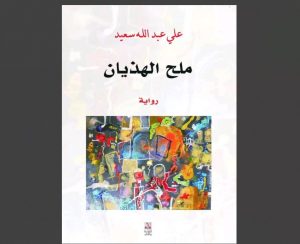د.فيصل الأحمر
عتبة دخول:
لقد بدأ الشاعر القديم صلته بالعالم وبالكلام مدونًا ما يحدث، فتماهى الشعر والتاريخ واختلطت على المدوِّن المواضيع التي يخبر عنها مع طرق التعبير عن هذه المواضيع، والتي تجعلها أكثر استساغة لدى جمهور السامعين.. ولنتذكر دائمًا أن الشاعر القديم متلفظ بالقول لملتقط للسمع. من هنا يمكننا أن نلتقط جيدًا الصلة بين الشعر والحياة: التقاط صور والتعبير عنها. الشاعر بهذا المعنى يحقق دور المدون القديم الذي هو راصد لما يحدث من حيث كون رصد ما يحدث مسبارًا لمعرفة ما يأتي ولإمكانية التصرف فيه، كما يحقق دورًا فنيًّا هو إمكانية النطق من عدة مواقع: الأنا والآخر.
كان أبو حيان التوحيدي يقول على آثار الفلاسفة: “الجوهر ما قام بنفسه والعرض ما ثبت بغيره” (البصائر والذخائر).. والشاعر اليوم وفي أكثر من أي زمن مضى يلعب هذا الدور فيكون هو ويكون غيره، ويكون غيره لأنه يكون هو، ثم يكون هو فيكون غيره من حيث يدري ولا يدري ومن حيث يشاء ومن حيث يجهل.
إن شاعر اليوم يقبع باختياره –كما سنبين ذلك جيدًا- تحت سلطة الواقع، واقع مليء بالمادة الحيوية إلى درجة تجعل الفهم في أغلب الأحيان متأخرًا عن ركب الحس.. فنحن نعيش اليوم عالمًا نحس فيه بالأشياء التي تحيط بنا أكثر مما نفهمها، وذلك بسبب كوننا نفتقر إلى المسافة الزمانية والمكانية والفلسفية الكافية لتحقيق فعل “الفهم”.
تنطلق القصيدة من الواقع بسلطته المنظمة والمنطقية والراسخة عبر عاداتنا، واقع يبدأ من الفيزيقي ليكتسح الميتافيزيقي من خلال سلطة أخرى منظمة تشبهه هي سلطة اللغة، ثم يأتي الشعر فيبدو عمومًا عاجزًا عن فرض منطقه المخالف ومن هنا ينشأ التوتر الوهمي (والقوي) بين الواقع أو اليومي من جهة والاستثنائي الشعري من الجهة المقابلة، وهذا ما يعطينا دائمًا الشعور بمحدودية الوعي الشعري بالعالم؛ فنحن عمومًا لا نلبث أن نترك المنطق الاستثنائي لنعود ونحتمي بالمنطق القار القوي المهيمن زمنيًّا ومكانيًّا.. إلا أن تجاربنا الشعرية الخارجة عن المألوف ترتبط باللغة متى حدثت وتصبح جزءًا من تاريخها فلا نقدر على تركها والتحول عنها، إنها تتحول إلى تراث تتمسك به اللغة في لا وعيها، “فتصبح محدودية هذا النوع من التجارب هي نفسها مصدر قوتها”(1).
الحديث/ الحداثي:
والديوان في المطلق رحلة وعي قصدي واضح صوب موضوع واضح تسير القصيدة (أو القصائد الكثيرة المشكلة للديوان) نحوه مباشرة، مسيرة شعرية حديثة وحداثية تحتكم إلى صدق التجربة والوفاء للحقيقة أو للواقع أكثر من كلفها بالوفاء للأحكام النقدية وللتقاليد الشعرية المعروفة، وفي وصف هذا الاتجاه يقول الشاعر السيريالي الكبير بول إيليوار Paul Eluard: “وحدها الإرادة قادرة على تحريرنا وإثراء تجاربنا، لا يشذ في ذلك أحد عن القاعدة؛ أفقر الناس في ذلك كأغناهم يستطيع ضخ دم جديد في وعينا؛ يكفيه في ذلك أن يتزود بحواس يقظة وعيون متلهفة للنظر والرؤية، يصبح الوعي العادي آنذاك كنوزًا لا تقدر بثمن من الأحلام والمواجد والمخاوف والآمال، ولن يهمنا حينها أن نصف التجربة بالجمال أو القبح بالرقة أو الفظاظة لأننا سنكون أغنى وأعلى من هذه الاعتبارات التي لم يكن لها يومًا أن تحدد الشعر مما هو ليس بشعر”(2).
يبحث الشاعر سمير درويش على امتداد ديوانه “تصطاد الشياطين” عن وجه امرأة تتجاوز تلك التي هي أمامه لأنها غير كافية، أو لأنها أوسع بكثير من الحدود المرسومة للفهم البشري كي يحيط به.. يقول مثبتًا السؤال الذي هو نقطة البداية الدائمة ومحاورًا الله تعالى خالق هذه المرأة العجيبة:
“هل قصدتها أنثى؟
أم كونا أتعبد في أركانه
ما حييت؟”(3).
وعلى هام ذكر الجسد كتيمة مسيرة لديوان “تصطاد الشياطين” فإنه لا بد من استحضار العنصر الرابط بين الاثنين والذي يتراوح بنا دائمًا بين البعد التراثي للجسد وبعده الآني الحاضر المهيمن على اللحظة الآنية.. يقول الناقد صلاح بوسريف: “إن شعر هذا الجيل سيستشعر الحاجة الماسة إلى لغة الجسد، إلى وحدة الحواس وتوالجها. وهو ما جعل من التوجه نحو الكتابات الصوفية، وشعراء أوروبا الأساسيين في كتاباتهم الاستثنائية نوعًا من حرية اتخاذ القرار. وهو ما لم يستجب للذوق النقدي العام الذي سيتخذ موقع الرافض لـ”كتابات ينقصها الوزن””(4)، وهذه الإشكالية تقف في صلب بعض من المشاكل التي ستواجهها قصيدة النثر التي سنتعرض لها في معرض حديثنا عن ديوان سمير درويش الحالي.
يقول الشاعر في هذا الاتجاه:
“كأن رموشك تفترش الأرض
وشفتيك الشبقتين تروي المشردين
السائرين على غير هدى”(5)
وفي مقطع غير بعيد عن هذه الحالة يقول:
“ليس على المشتاق إلا التمتع ما استطاع
ليس عليه إلا السمو على قوانين الفلسفة
إلا أن يصرخ مستنجدًا بالله..
وهو يتلوى إنما كي تخرج النار من مكمنها
أن يغرس أظفاره في الصحراء
لتنبت أطفالًا بيضًا وملائكة”(6).
من عادات القارئ العربي أن ينبعث بهمة عالية باحثًا عن إيقاع لما يقرؤه من شعر ولكننا هنا بصدد التعامل مع قصيدة النثر التي لها قوانينها ولها سننها التي لا يملك القارئ غير المتحيز إلا أن يندمج في إطارها مضحيًا بموسيقاه الصاخبة الضاربة بأطنابها في التاريخ الطويل للقصيدة العربية تاركًا روحه وحواسه كلها تتبع إيقاعًا جديدًا ينبعث من صلب نص جديد له موسيقى جديدة؛ “موسيقى الاستجابة لإيقاع تجاربنا المتوجة وحياتنا الجديدة، وهو إيقاع يتجدد في كل لحظة”(7).
الحب.. مرة أخرى:
إن ديوان سمير درويش هو قصيدة طويلة بتمفصلات واضحة هي مقاطع مرقمة.. ولكنها قصيدة واحدة بصورة امرأة واحدة وإن كان الشاعر يقتل نفسه محاولًا جعلها متعددة؛ إلا أنه أبدًا لا ينجح في “تعديدها”.. هي امرأة واحدة تصطاد الشياطين نفسها بالطريقة نفسها.. جميلة عصرية لعوب مثقفة، تعيش حياة جديدة لا صلة لها بأنموذج “جميلة” الشعر القديم.. امرأة بلا حياء ولا تمنُّع، ولا ابتعاد قهري عن الجنس، بلا إيماء ولا صمت يبعث الجنون في أبناء “وادي عبقر” ومن ابتُلي بهم من الشعراء.. لا شيء من كل هذا.. هي امرأة تركب سيارة رياضية حمراء، ولها كثافة عقيدية بميول إلحادية أو على الأقل متشككة، وهي – كذلك- تفهم في الفنون التشكيلية الحديثة:
“الجميلة التي تتأمل الفراغ وتلوم الله:
تضيء الشموع على سلم الصحفيين.
تجدِّف بحرفية في بحيرة قارون.
تأكل الآيس كريم في كازينو النيل.
تعلم المهندسين قوانين ما بعد الحداثة”(8).
هذا النموذج البشري لا بد أن له حياة خاصة تحتاج شكلًا ناشزًا عن القواعد كي يحيط به ويستوعبه كما ينبغي.. وهنا تأتي قصيدة النثر ببنيتها القوية المختصرة المجانية المجنونة التي تقول كل الأشياء دون أن توضح ذلك لأحد.. لقد كان الشاعر القديم محرومًا من المرأة بحيث تشكل تفاصيلها الجسدية والشعورية وحتى أقوالها وحركاتها وسكناتها وتصوراتنا حولها مادة لا بد من استنزافها بالوصف والرصد والتسجيل؛ في حين يعيش الشاعر اليوم تخمة في التفاصيل تجعله يهرب من جحيم التوسع والاستطراد.. ذلك أن القصيدة الجديدة تخضع لقانون الاقتصاد اللغوي؛ ولا بد من الوعي العميق بأن “الاستطراد الممل والتوسع الثقيل والتفاصيل المتكررة ليست من إواليات هذا النوع من الكتابة إذ تعتمد هذه النصوص على اللمحة، وعلى تكثيف اللحظة، على البرق والتكثيف.. وهي أمور لا تمنع كونها شاملة ومركزة وكثيفة ودقيقة في استرجاع الحالات الوجدانية التي تؤدي إلى القصيدة”(9).
ها هو ذا الشاعر يفتت حبيبته إلى تفاصيل جميلة أو عابرة، مختصرة أو تافهة، مكرورة أو ناشزة.. ولكنها قطع صغيرة تنتهي برسم صورة لا تخطئها العين (العين نفسها التي كثيرًا ما تمزج عبلة بليلى أو لبنى بمية في تماه خطير مبعثه غياب صفات مميزة.. وهو موضوع هام ليس المكان مناسبًا لولوجه):
“.. ليكتب النبض خلجاته على كفها قصيدة:
مفتوحة على كل حالاتها
ومغلقة على حالة سأظل أسيرًا بها.
..
سحبت كفها بتأن
كي لا ألمح النار التي تغزوها
رسمت نظرة لا مبالية على وجهها
وقالت: ماذا؟
مجرد قلب ينبض
..
العاشقات لا يقلن الحقيقة..
دائما”(10).
ثم يكسر الشاعر عمدًا امتداد نصه ووجود كائناته الورقية/ الواقعية وينطلق في رسم شاعري بالكلمات ينم عن عمق في التجربة جدير بإعادة النظر، يقول:
“الشهور، جميعها، تتواطؤ معنا
تتجمع بلهفة لتصنع تاريخًا لعشقنا:
من أول آذار إلى أخر الكون.
والشوارع نفسها
ألفت دهس أقدامنا على إسفلتها
تدبر المكائد لعجلات سيارتك الرياضية الحمراء
وتأخذها إلى شوارع أبعد،
لنظل مخلصين للحظاتنا الفاتنة”(11).
لن يخطئ من يعدُّ الحب هو التيمة الرئيسة لهذا الديوان.. ولكن علينا أن نكون حذرين أثناء التعامل مع كلمة “الحب” أو مع مفهومه، فالحب لم يعد مجرد شعور يربط الأشخاص بعضهم ببعض.. إنه لغة العصر، وأهم ما فيه هو بعده الميتافيزيقي.. وعلينا إضافة إلى كل ذلك أن نستحضر فكرة “أن الحب في المتخيل العربي كما يعلن عن نفسه في النص الإبداعي.. سواء كان في شكل تغن بالجسد ومفاتنه أو تلهف على الانغماس في اللذة أو في كل دعارة ونزق وإباحية، ليس مجرد علاقة تنشأ بين شخصين/ جسدين بل هو تجربة وجودية بالأساس”(12).
ها هو ذا تجلٍّ غير منتظر للحب يجترحه سمير درويس في أحد مقاطعه الجميلة متراوحًا بين التراجيدي والعابر، وكذلك بين القول الجميل البليغ والقول الذي يقترب من لغة الشارع التي لا كثافة لها.. ولكن النتيجة تأتي من بهاية المقطع.. يقول:
“مات الرجل بعد يوم واحد من عودته إلى الحياة
أعطاها: اسمًا مختلفًا وملامح غجرية
ومثالًا للتضحية..
ومضى.
ماتت المرأة بعد سنوات من الألم
ومصافحة المطارات والكراسي المتحركة
أعطتها: رأسًا يابسًا وساقين منحوتتين
ومضت.
أبوها وأمها التقيا في غفلة
كمسافرين جمعتهما محطة عابرة
ليصنعا لي بهجة عميقة..
أنا الذي أنام بين ثدييها
الآن”(13).
يعيدنا هذا المقطع مثلما يفعل غيره –وهو كثير- إلى ثنائية جديرة بالتوقف هي تلك التي فرقوا من خلالها بين النثر والشعراء وهي ثنائية تقف على الحدود الفاصلة بين قصيدة النثر وبين القصيدة كما ورثناها عن الجدود الغر الميامين.. يقول محمد بنيس: إن “كل من مصطلحي البيت الحر وقصيدة النثر يحملان وسم المغامرة على الحدود؛ إن البيت في اللاتينية versus يعني العودة إلى الوراء، فيما النثر prosus يعني التقدم إلى الأمام بطريقة شطرية.. وصفة “الحر” الملصقة بالبيت، وإضافة “النثر” إلى القصيدة تفيدان تجاوز التعارض أو تركيبه، إذ أصبح البيت يتقدم إلى الأمام والقصيدة تقبل باختيار تحديدات متباينة”(14) وتسمية الشعر الحديث بقصيدة النثر تجمع بشكل غير متوقع بين اتجاهين للمعنى حسب الترسيمة التي يقف عندها محمد بنيس وهو ما نلحظه في عدة مقاطع لدى سمير درويش حينما يتراوح بكل مثير للحواس القرائية بين المادة اليومية التي هي مادة نثرية إلى حد ما وبين المادة المتعالية الاستثنائية التي درجنا على عدها مادة شعرية:
“أخرج، الآن، من المشهد
تاركًا كتبًا على السرير، وصحفًا على الأرائك
وبقايا أعشاب مغلية في الأكواب
والكريمات الملينة على الكمود
وبصمات أصابعي على صدر يخصني”(15).
حول شعرية اليومي:
يمتلك اليومي بعدًا يقترب من التسجيلية التي لا تثير حواسنا الفنية بالضرورة بقدر ما تبدو بصدد محاورة عاداتنا التي هي تجارب صامتة نائمة كامنة.. يقول الشاعر في سطر من أبياته:
“لماذا نحب النوم على الجانب نفسه من السرير؟”(16).
ويواصل في البعد التسجيلي نفسه:
“ولماذا أحب رؤيتك عارية في الضوء الساطع
بينما تحبين تخيلي في ظلمة باهتة؟”(17).
عادات تكتسب شعريتها من زوايا أخرى سوى زوايا اللغة التي نحن متعودون عليها، عادات تتحول إلى مركزية اللحظة التي ننتظرها.. لحظة تخرج من الامتداد الزمني المألوف لتشكل انزياحًا زمنيًّا يعمل على مستوى الوعي؛ أو الوعي المفارق كما يسميه الفينومينولوجيون.. وفي ذلك يقول يقول غاستون باشلار “إن الحقيقة الزمنية تكمن في (اللحظة) بوصفها وجودًا بين عدمين؛ عدم الماضي وعدم الآتي، ومجموع اللحظات هو الذي ينتج الديمومة بتجددها المستمر، دون أن يرتبط هذا التجدد بنمو الماضي أو استمرار الحاضر”(18).
إن نمط الشعراء الذين ينتمي سمير درويش إليه هو نمط يعاني من فراغ الواقع من الكثافة، ومن افتقار العالم إلى المعنى، يعاني من غياب الأبعاد التراجيدية الكبرى في حياة واقعها بلا كثافة وأحداثها منتظرة معيشة سابقًا إنْ بشكل أو بآخر.
يخرج الشاعر من بين تفاصيل الحياة التي تربطه بهذه المرأة محمَّلًا بخيبة انتظار شيء لا يأتي وإنما تأتي القصيدة انتصارًا على الصمت ولكنها تقبع تحت وطأة التفاصيل والأشياء، يقول:
“.. أتحرك، الآن، بين أشيائك كعصفور
عصفور يسبح في الهواء كأنما خلق الهواء
..
رائحة ما تجذبني،
تأخذني من الإسفلت الممتد والبنايات المتماثلة
وتقذفني إلى عالم فوضوي محبب،
عالم يسبح في العتمة الخفيفة والقصائد
واللون البرتقالي ونثار الأنوثة
هل أزيل طلاء شفتيك لأراك حقيقية
كما أراك في أشيائك المنثورة
وأنا أتحرك، الآن، بينها كعصفور؟
..
المصباح الصغير المعلق فوق السرير
ينحت تفاصيل جسدك بالضوء والظل.
أحب جسدك حين يكون منحوتًا بالضوء والظل”(19).
إن الركود الذي يعانيه الواقع والتراكم الزمني يجعل الشاعر يميل إلى التقاط لحظات تمثل ذروات معينة، وذلك لخوف الشاعر من عدم قدرة الركام الواقعي على إنتاج معان شعرية.. وهنا تعود اللحظة لتكون أفقًا دلاليًّا وتمثل ذروة جمالية معينة، هي زمن يقيني لوعي الإبداع بنفسه، وعي من صفاته التراجيدية أنه منعدم في الماضي ومحكوم عليه بالإعدام في الآتي، فهو يتحول بذلك إلى الحاضر ولا مهرب له من هذا الحاضر(20).
إن قراءة ثانية لهذا المقطع تجعلنا نعود مرة أخرى للحديث عن الحب أو الجنس كتيمة مسيرة لأجزاء هامة من الديوان، وها هو ذا أحد النقاد المعاصرين الهامين يذكرنا بضرورة استحضار الجنس في بعده الميتافيزيقي: “يكفي أن نشير، تمثيلًا، إلى أن كتاب السيخ النفزاوي يبدأ في شكل ابتهال للسماء والقداسة والله ثم يجر الجميع: الله والقداسة والسماء لتصبح بمثابة خدم للذة والجسد. فيتحول الابتهال من إنشاد يرفع تمجيدًا للسماء إلى قداس يقام في حرة الأرض والجسد”(21).
الحب هنا يحيلنا على نمط عال من القول الشعري.. نمط يمتلك بلاغة تذكرنا بأن ما نقرؤه لا يخرج عن الشعرية العربية التي هي ميراث تقاليد تعود إلى آلاف السنين ربما.. بل إن الحب ليحيلنا على معان تقترب أن تكون فلسفية.. يقول الشاعر سمير درويش في بعض المقاطع ذات التوتر الشعري العالي:
“محاط بنخيل وأشجار عالية
تضج بخضرة الربيع في أوجه
بوشيش مكيف الهواء
بالأوراق المتناثرة في زوايا عقلي
في وحشة غرفتي
وبالصمت.
محاط بمواقف متفرقة من تاريخ
ليست فصولًا متشابهة السواد
برسائل متعالية
ووجوه لا تمنح نفسها لأصابعي
تلك التي لا تجيد القبض
على الملامح المارقة
محاط بذاكرة لا تستطيع الاحتفاظ بدمي”(22).
هي لعبة بأشكال لولبية، وبناء معقد عناصره التاريخ والحس واللغة الجميلة المتعالية التي درجنا –كما أسلفت– على تسميتها “باللغة الشعرية”.. لكن الشاعر يعود ليغرق بسرعة في التفاصيل التي تكاد لخصوصيتها تفرغ المقاطع من الشحنة الشعرية، العودة الدائمة والأبدية صوب صغائر الحياة اليومية ودقائقها:
“أعددت كوبيْ شاي خفيفين
أحدهما بسكر منزوع السعرات الحرارية
إكراما لبرنامج إنقاص وزنها”(23).
القاعدة في كل هذا هي أن الشاعري يكمن في العادي، وأن الاستثنائي حاضنته هي العادات المألوفة.. هذا النوع من الوعي يعيدنا على أفكار سيريالية معروفة لدى الجميع، لأنها أفكار التقطها التيار الحداثي بعد سقوط الراية السيريالية، لقد ورثت المذاهب المنتشرة على خريطة القرن العشرين هذه الأفكار واسترجعتها بأشكال كثيرة بعضها ظاهر مصرح به وكثير منها كامن مضمن غير مصرح به.. فالسيريالية -كما كان خليل حاوي يقول- “تفكيك للواقع ونثر له إلى جزئياته وإعادة بناء له من جزئيات الواقع الأخرى وفقًا للآلية النفسية التي تنقض مبدأ التثقيف والتأليف والإلهام.. هذه الآلية وحدها القادرة على تحرير النفس من سلطة العقل ومن مراقبته ومن ترصده الذي يميتها”(24).
وهنا نفهم أكثر الميل السيريالي أولًا ثم الحداثي في مطلق المذاهب صوب التقاط تفاصيل الحياة الواقعية الملموسة المعيشة التي تبدو بلا معنى بالنسبة للغير، والعزوف عن الموضوعات التي ألفناها كموضوعات “شعرية” بامتياز أو ما يمكننا أن نسميه “التيمات الكبرى للشعر”.. ونفهم كذلك الميل صوب البحث عن عناصر حياتية تحاول الوفاء للحالة الوجدانية وللتجربة المعيشة وإن كانت غريبة كأن تكون المكيف الهوائي أو الكومود في الغرفة أو السيارة الرياضية.. إلخ إلخ.. ذلك أن “السيريالية ديوان للأخيلة والصور الغريبة والمتناقضة العسيرة على الفهم؛ يقول لوي آراغون Louis Aragon: “السيريالية هي الاستعمال غير المنظم والهيجاني للصورة التي تولد الشعور بالغرابة والدهشة والشذوذ والذهول”(25).
يقول الشاعر في بعض أعطاف ديوانه الذي نحن بصدده:
“المنشفة البيضاء معلقة على مشجبها
تفتقد قطرات الماء العالقة على جسدي.
حزام الأمان/ أكواب الشاي/ جرس الباب/ الاعترافات/
أطباق الأرز/ اللغة العربية/ علب الشعير/
رنات الهاتف/ موسيقى الشعر/ نعومة البشرة/
أعمدة الصحف/ مناجاة الله/ إطارات الصور/ صوت شويكار/
السكر/ فرد الحراسة/ قمصان النوم/ السوق الشعبي/
المطبات الصناعية/ التأوهات/ النارجيلة/ لحم الضأن/
البرد المتربص/ أصوات الأحباب/ الاحمرار حول العنق/
الرغبة
“أين كنتَ منذ زمن”؟/”(26).
إن هذا الكم من التفاصيل التي تتكاثر فتبتلع الإنسان يعبر جيدًا عن الميل الشديد لشعراء اليوم صوب الوفاء للحياة من خلال النص؛ فمن غير المعقول أن يكون المرء محاطًا بتفاصيل الحياة المعاصرة ثم يأتي إلى الشعر فيجد موضوعات قديمة مسيطرة على الذوق وعلى زوايا النظر المألوفة ويجد طرقًا معبدة للتعبير عن هذه الموضوعات المعروفة، لهذا ظهرت نزعة حداثية عبر عنها شارل بودلير مبكرًا في مقالته الشهيرة “تصوير الحياة المعاصرة”peinture de la vie modern(27).. ثم تحولت هذه الآراء إلى نزعة مندمغة يؤمن بها الجميع ولا ترقى أي فكرة مناقضة لها أن تكون بمستواها، كل ذلك مع توالي التجارب والسنين وبإيعاز من فلسفتين كبريين أصرتا على ضرورة الاحتكام إلى التجارب الملموسة أثناء النظر في الأعمال الفنية؛ والمقصود هما “التحليل النفسي” و”الظواهرية”(28).
ونقرأ على هامش كل هذا المقطع الموالي مع سمير درويش:
“.. وعلى منشفة بيضاء تليق بالتائبين.
حول أبخرة الشاي نثرت حكاياي
وأعطيت صوتي لقصائد منزوية في الكتب
لا تنفخ فيها روحي
على شرشف يضج بالفرح تركت أطفالًا
يرقصون رقصة ناعمة
وعلى جسد روماني.
..
ردي إلي تاريخي إذن”(29).
وقف المنظرون –بدءًا من سوزان برنار- على إحدى أهم خصوصيات قصيدة النثر مشددين اللهجة والتركيز على أهمية الطابع “المجاني” للنص.. ألا يكون النص في خدمة هدف دلالي أو ربما أخلاقي، وألا يرتبط النص بقضية تبتلعه وتهمش ما كان النص لأجله.. إنها رحلة بحث تذكر بمقولة الألسني الكبير “فردينان دي سوسير” الذي كان يدعو أن تدرس اللغة في ذاتها ولذاتها.. كذلك قصيدة النثر -في عرف الشعراء الممارسين لها والشغوفين بها- عليها أن تكون مكتوبة من ذاتها ولأجل ذاتها.
يقول سمير درويش:
“البحر سيظل في مكانه،
والباعة يبتسمون بآلية للعابرين
والسيارات العجلى ستدهس الإسفلت
الصحفيون سيذهبون إلى صالات التحرير
المدرسون إلى قساوة فطرية
والأحباء إلى قسوتهم
بينما سيكون عليَّ أن أحمل حقيبتي
تلك التي أرهقتها المطارات
عائدًا من حيث أتيت
حيث بحر وباعة وسيارات وصحفيون
ومدرسون وأحباء
وقلب أثقل مما كان”(30).
إننا نلتقط هنا جيدًا هذه المجانية، إذ تكون القصيدة بناء لا يهدف إلى أي شيء سوى نفسه، حالة مكتفية بذاتها ليست تدوينًا ولا تدويلًا، لا تهول حادثة ولا تحول حالًا ولا تعطي بعدًا غير حقيقي لأي إحساس أو وجدان.. وكثيرًا ما وقف الباحثون في هذا النمط من القصيدة على ما سمته سوزان برنارد بالمجانية؛ وهو مصطلح ذو أصول برناسية؛ إذ كان هؤلاء يؤمنون بمجانية العمل الفني وضرورة تخليص النص مما حوله مما يثقل كاهله، فاشترطوا “ألا تكون لقصيدة النثر غاية روائية أو أخلاقية أو فلسفية”(31).
عتبة نهائية:
لقد تناولنا من خلال هذه الدراسة نقطة واحدة هامة جدًّا هي كيفية تعامل الشاعر سمير درويش مع الواقع، من منطلق كون الواقع إحدى المقولات العصية على الوعي الشعري، فالواقع يميل إلى التسطيح والشعري إلى التعمق، والواقع غارق أبدًا في التفاصيل في حين تعشق القصيدة التلميح والالتقاط غير المستقرئ.. ولكننا رأينا كيف أن الشاعر قد وجد طرقًا عديدة لتغطية آثار هذا الواقع بل وإلى تحويله بحيث يبدو حادثة استثنائية جديرة بأن تدونها القصيدة.
إن الشاعر من خلال إصراره على هذا اليومي يجعلنا نستعيد الطابع المأساوي للزمن الذي يحيط به، المأساة تسيطر على العقل فيصبح لا ينطلق إلا منها.
يعلمنا الديوان جيدًا كيف أن مساكن الأشياء الأصغر هي التفاصيل الصغيرة بل التفاصيل المتناهية في الصغر، تلك التي تكاد تعد اليوم روح الطابع “المأساوي” للحياة المعاصرة بعدما جعل الوقت ينسى القضايا الكبرى أو طرق الخوض فيها قديمًا.
الهوامش:
1- Henri Lemaitre: là poésie depuis Baudelaire، Armand colin، paris، 1965، p160.
2- ibid، p141.
3- سمير درويش: تصطاد الشياطين، دار شرقيات، مصر، ط1، 2001، ص40.
4- صلاح بوسريف: المغايرة والاختلاف في العر المغربي المعاصر”، دار الثقافة، المغرب، 1998، ص110.
5- الديوان، ص08.
6- الديوان، ص09.
7- سعيد بن زرقة: الحداثة في الشعر العربي- أدونيس نموذجا، أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2004، ص186.
8- الديون، ص71.
9- سعيد بن زرقة، م مذكور، ص187.
10- الديوان، ص13.
11- الديوان، ص14.
12- محمد لطفي اليوسفي: أسئلة الشعراء ونداء الهوامش، مجلة فصول، 21، مج16، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1997، ص32.
13- الديوان، ص15.
14- محمد بنيس: الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاتها (الجزء 2)، دار توبقال، المغرب، ط2، 2001، ص98.
15- الديوان، ص09.
16- الديوان، ص10.
17- الديوان، ص10.
18- غاستون باشلار: حدس اللحظة، تر: رضا عزوز وعبد العزيز زمزم، دار “آفاق عربية” ، العراق، 1986، ص18.
19- الديوان، ص12.
20- غاستون باشلار، م مذكور، ص20.
21- محمد لطفي اليوسفي، م مذكور، ص 35.
22- الديوان، ص22.
23- الديوان، ص21.
24- فيصل الأحمر: دائرة المعارف الحداثية، ج1، دار الأوطان، الجزائر، 2009، ص378.
25- م. نفسه، ص386.
26- الديوان، ص11.
27- Charles Baudelaire: curiosités esthétiques، art romantique، classiques Garnier، Paris،1963، chapitre «peinture de là vie moderne».
28- ينظر تفصيل ذلك في كتابنا “دائرة المعارف الحداثية”، ج1، صص162- 166.
29- الديوان، ص17.
30- الديوان، ص19.
31- فايز العراقي وناصر الحسن: القصيدة الحرة، قصيدة النثر نموذجا، مركز الإنماء الحضاري، ط1، 2008، ص36.